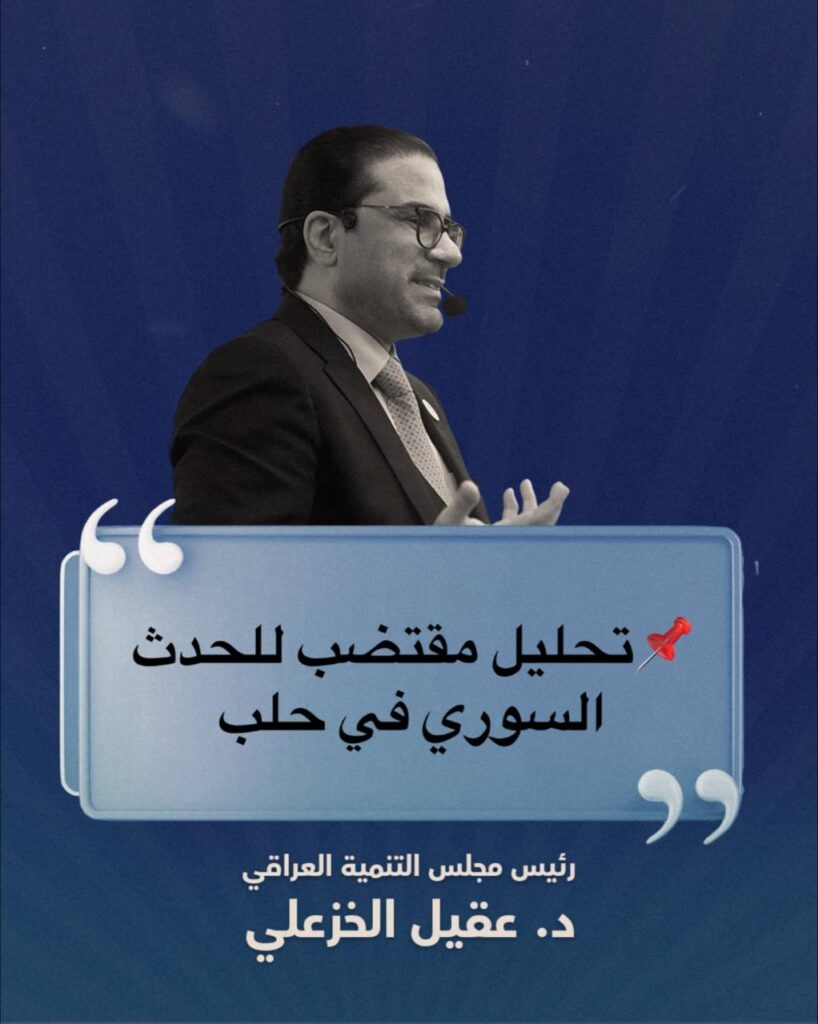
📌تحليل مقتضب للحدث السوري في حلب
د .عقيل الخزعلي
تشهد حلب تصعيدًا عسكريًا مفاجئًا في
الفترة الحالية، مع دخول المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى أحياء المدينة، مستغلة ضعف قوات النظام السوري وانشغال حلفائه مثل روسيا وإيران بمشاكلهم الدولية. يبدو أن انسحاب بعض الجماعات الحليفة للنظام، قد خلق فراغًا استغلته المعارضة لتحقيق مكاسب ميدانية.
الأطراف المستفيدة تشمل المعارضة المسلحة التي تسعى لاستعادة مناطق نفوذها، وربما تركيا التي قد ترى في هذا التصعيد فرصة للضغط على النظام. في المقابل، يعاني النظام من ضغوط شديدة، خاصة مع تقليص دعم حلفائه وانشغالهم بأولويات أخرى.
أما السيناريوهات المتوقعة، فقد تشمل تصعيدًا أكبر مع تدخل روسي مباشر، أو مفاوضات لوقف إطلاق النار لتخفيف التوتر، أو حتى تغييرات ميدانية تؤثر على خريطة السيطرة في المنطقة. الوضع يظل معقدًا، ولا يمكن التنبؤ بمساره بسهولة.
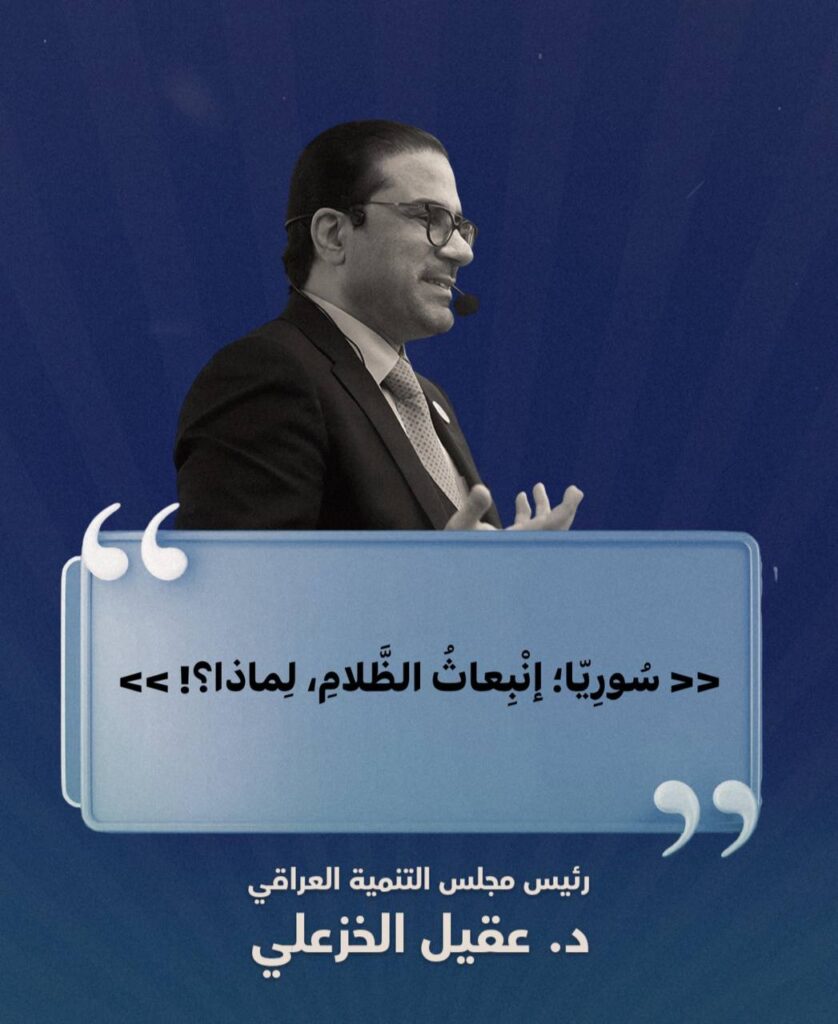
<< سُورِيّا؛ إنْبِعاثُ الظَّلامِ، لِماذا؟! >>
✍🏼اعداد: د.عقيل الخزعلي / رئيس مجلس التنمية العراقي
=======================
منذ اندلاع الأزمة في عام 2011 ، تشهد سوريا صراعاً معقداً ومتشابكاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تحول خلالها البلد إلى مسرح لصراعات القوى الكبرى وتصفية الحسابات الإقليمية. ومع سيطرة “هيئة تحرير الشام”، المصنفة إرهابياً دولياً، على أجزاء من محافظة حلب وسعيها للتوسع إلى مناطق جديدة، تعود الأزمة السورية إلى الواجهة بشكل أشد تعقيداً، حيث تطرح هذه التطورات تساؤلات عميقة حول خلفياتها وأهدافها، ولماذا تحدث في هذا التوقيت تحديداً، وما الجهات التي تقف وراءها، والجهات المستفيدة والمتضررة منها، فضلاً عن السيناريوهات والتداعيات المحتملة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
🚩 خلفيات الأزمة
منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا، تحولت البلاد إلى ساحة صراع عسكري وسياسي متعدد الأطراف. برزت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كأحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد السوري، حيث نجحت في تعزيز وجودها في شمال غرب البلاد، مستفيدة من ضعف الدولة السورية والانقسامات داخل المعارضة.
في السنوات الأخيرة، حاولت الهيئة التكيف مع التغيرات السياسية والعسكرية من خلال تقديم نفسها كقوة محلية تهدف إلى إدارة المناطق الخاضعة لها، لكنها في الواقع تحتفظ بأيديولوجيتها الجهادية واستراتيجياتها التي تعتمد على استخدام القوة لتحقيق أهدافها.
على مدار الأزمة، تمكنت الهيئة من بناء شبكات تمويل ودعم لوجستي معقدة، استفادت فيها من فراغ السلطة في بعض المناطق ومن علاقاتها الظرفية مع قوى إقليمية ودولية.
وعلى رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية، فإن بعض الجهات الإقليمية قد استغلت وجودها لأغراض تكتيكية، مثل محاولات تقويض نفوذ الأكراد أو الضغط على النظام السوري.
اليوم، تسعى الهيئة إلى توسيع نطاق نفوذها خارج إدلب، مستغلة تراجع القوة العسكرية للفصائل المعارضة الأخرى وعدم قدرة النظام على السيطرة على كامل البلاد.
⁉️ لماذا هذا التوقيت؟
من الواضح ان توقيت تحركات هيئة تحرير الشام لا يمثل مصادفة، بل يعكس حسابات دقيقة مرتبطة بالتحولات الإقليمية والدولية الجارية، وأبرزها:
📍1. التغيرات الإقليمية
تأتي هذه التحركات في ظل تقارب تركي-روسي وسعي أنقرة لإعادة ضبط علاقاتها مع دمشق، مما قد يدفع تركيا لاستخدام الهيئة كورقة ضغط في مفاوضاتها مع النظام السوري والقوى الكردية.
📍2. انشغال القوى الكبرى
انشغال الولايات المتحدة وأوروبا بأزمات أخرى، مثل الحرب الأوكرانية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أضعف التركيز الدولي على الأزمة السورية.
📍3. الفراغ الأمني والإداري
منح انسحاب بعض الفصائل المعارضة المدعومة من تركيا وتراجع نفوذها الهيئة فرصة للتوسع وفرض نفسها كلاعب أساسي.
📍4. إعادة التموضع التركي
تواجه تركيا ضغوطاً داخلية لإعادة اللاجئين السوريين، مما قد يجعلها تتبنى سياسات أكثر مرونة تجاه الجماعات المسلحة التي قد تخدم أجندتها في الشمال السوري.
🌐 الجهات التي تقف وراء التحركات
رغم تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، فإن تحركاتها لا تحدث بمعزل عن دعم مباشر وغير مباشر من قوى إقليمية ودولية محتملة، أهمها؛
❗️تركيا، تشير تقارير إلى أن تركيا قد تغض الطرف عن توسع الهيئة بهدف تعزيز نفوذها في المناطق الشمالية لسوريا وتقويض نفوذ القوى الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، كما قد تستخدم الهيئة كورقة ضغط في مفاوضاتها مع النظام السوري.
❗️قطر، هناك اتهامات بدعم غير مباشر عبر تمويل منظمات إنسانية تعمل في مناطق تخضع للهيئة.
❗️الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، قد تستفيد واشنطن وتل أبيب من استمرار حالة الفوضى في سوريا لضمان عدم استقرار النظام السوري وتقويض النفوذ الإيراني والروسي، والعمل على احداث تسويات جديدة في المنطقة، مبنية على هندسة سياسية واجتماعية لا تخلو من دهاء.
🚨الأطراف متضررة، أبرزها:
🔻النظام السوري وحلفاؤه، إذ ترى دمشق وطهران وموسكو في توسع الهيئة تهديداً مباشراً لمشروع استعادة السيطرة الكاملة على البلاد.
🔻 العراق والاردن، حيث تخشى بغداد من انتقال عناصر جهادية ارهابية إلى أراضيها مما يهدد أمنها الداخلي.
🚦السيناريوهات والتداعيات المحتملة
تتراوح التداعيات المحتملة لتحركات هيئة تحرير الشام بين استمرار الفوضى وتصعيد عسكري واسع النطاق:
🔺١-استمرار الفوضى
قد يؤدي توسع الهيئة إلى ترسيخ التقسيم الجغرافي الفعلي في سوريا وزيادة تعقيد المشهد الأمني.
🔺٢-تصعيد عسكري
قد يدفع توسع الهيئة النظام السوري وحلفاءه، بدعم روسي وإيراني محتمل، إلى شن عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة.
🔺٣-زيادة التوتر الإقليمي
قد تتصاعد التوترات على الحدود التركية-السورية، مع احتمال تدفق مزيد من اللاجئين إلى دول الجوار.
🔺٤-تعزيز الإرهاب العابر للحدود
قد يؤدي هذا التوسع إلى انتقال العناصر الجهادية إلى دول مجاورة، مما يهدد أمن المنطقة بأكملها.
✅ الخيارات والفرص
رغم تعقيد المشهد، هناك خيارات وفرص لمعالجة الأزمة:
🟢 التوافق الإقليمي
يمكن لتعاون (تركي-روسي-إيراني) أن يساهم في الحد من نفوذ الهيئة وفرض الاستقرار في المناطق المتضررة.
🟢 تعزيز الفصائل المعتدلة
دعم فصائل المعارضة المعتدلة يمكن أن يخلق توازناً يمنع توسع الجماعات المتطرفة.
🟢 إعادة الإعمار
قد يساهم تسريع مشاريع إعادة الإعمار في المناطق الشمالية في تقليل الاعتماد على الجماعات المسلحة.
🎯 الحلول الممكنة
🔫 ١-الحل العسكري
شن عمليات عسكرية منظمة لاستعادة السيطرة على المناطق المتضررة.
🎙️الحل السياسي
دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى مفاوضات شاملة تشمل جميع الأطراف المؤثرة في المشهد السوري.
🏗️الحل الاقتصادي
تقديم حوافز اقتصادية لإعادة استقرار المناطق، مع تعزيز مشاريع التنمية التي تقلل من اعتماد السكان المحليين على الجماعات المسلحة.
🏁 وبالمُحَصِّلَة،
فأن التطورات الأخيرة في سوريا تعكس تعقيد الأزمة وتداخل المصالح الإقليمية والدولية. استمرار حالة الفوضى يخدم أطرافاً محددة على حساب استقرار البلاد ومعاناة الشعب السوري.
يتطلب الخروج من هذا الوضع إرادة سياسية حقيقية وتعاوناً دولياً وإقليمياً شاملاً لمعالجة جذور الأزمة وليس فقط التعامل مع تداعياتها.
إن مستقبل سوريا يعتمد على استعادة سيادتها ووحدتها، وهو أمر يتطلب توازناً دقيقاً بين الحلول العسكرية والسياسية والاقتصادية.
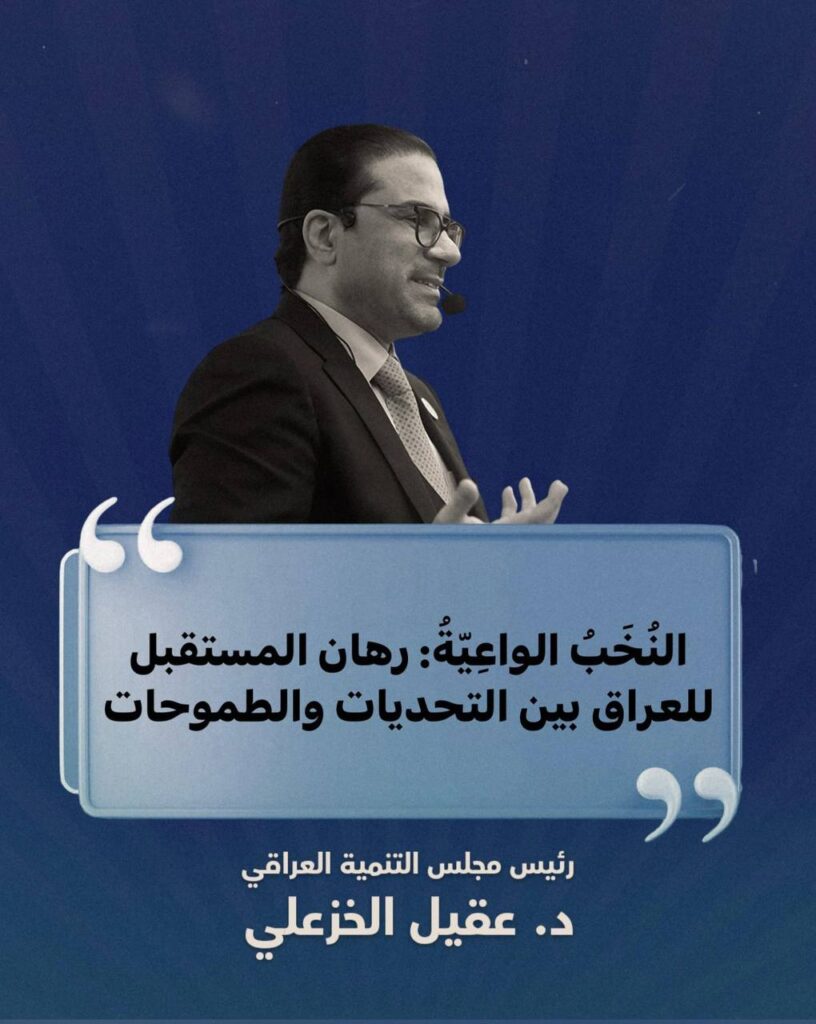
النُخَبُ الواعِيّةُ: رهان المستقبل للعراق بين التحديات والطموحات
تحرير: د.عقيل الخزعلي / رئيس مجلس التنمية العراقي
في لحظة فارقة من تاريخ العراق المثقل بالتحديات، أطلّ سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني ببيانه الأخير ليضع النقاط على الحروف حول واقع العراق الراهن وآفاق مستقبله، حيث أشار المرجع الأعلى استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (بتاريخ 4/11/2024م) إلى حجم المعاناة التي يواجهها الشعب على أكثر من صعيد، داعياً العراقيين، وعلى وجه الخصوص “النخب الواعية”، إلى أن يستلهموا العِبر من التجارب الماضية ويتحملوا مسؤولياتهم في تجاوز إخفاقاتها. ليس ذلك مجرد دعوة عابرة، بل هو نداء يحمل بين طياته أبعاداً استراتيجية تستهدف إيقاظ وعي هذه الفئة المؤثرة، وتوجيه بوصلتها نحو تحمل الدور المحوري في قيادة العراق نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرُّقي.
ولكن، من هم النخب الواعية التي قصدتها المرجعية؟ وما الدور الذي تنتظره منهم في هذه المرحلة الحرجة؟ لماذا ركزت المرجعية على هذه الفئة تحديداً دون غيرها؟ وما الأدوات التي يجب أن تمتلكها لتتمكن من أداء هذا الدور الجوهري؟ إن هذه التساؤلات تتطلب تأملاً عميقاً يتجاوز السطحية إلى البحث في جوهر المعنى والغاية التي انطوت عليها كلمات المرجعية.
النخب الواعية – بحسب فهمنا – ليست مجرد مجموعة من المثقفين أو الأكاديميين أو القادة السياسيين؛ إنها تمثل الطبقة التي تمتلك القدرة على استيعاب الواقع بكل تعقيداته وأبعاده، وتحليل مشكلاته بنظرة موضوعية قائمة على العلم والمعرفة والخبرة. هذه النخب تشمل العلماء والأكاديميين الذين يملكون الأدوات الفكرية لرسم السياسات، والمثقفين الذين يسهمون في تشكيل الوعي العام، والقادة السياسيين والإداريين الذين يتحلون بالنزاهة والكفاءة، والإعلاميين الذين يستطيعون توجيه الرأي العام نحو المسار الصحيح، والشباب المبدعين الذين يحملون روح التغيير وطموح التجديد. إنهم باختصار من يمتلكون المفاتيح لفهم التحديات وابتكار الحلول، بشرط أن يتحلّوا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.
لكن، لماذا ركزت المرجعية على دور هذه النخب؟ لأن العراق، وهو يرزح تحت وطأة أزمات متراكمة من الفساد وسوء الإدارة والتدخلات الخارجية، يحتاج إلى قيادة واعية قادرة على قراءة المشهد الحالي بحكمة، واستشراف المستقبل برؤية علمية وعملية، فالنخب الواعية – كما هو الواقع في الدول المتحضّرة – هي القادرة على انتشال البلاد من مستنقع الفوضى إلى بر الأمان، لأنها تمتلك الأدوات الفكرية والمعرفية التي تؤهلها لفهم أسباب الإخفاقات ووضع استراتيجيات متينة لتجاوزها. تدرك المرجعية أن النخب ليست مجرد مراقب محايد، بل هي القلب النابض للمجتمع، القادرة على ضخ الوعي وتحريك عجلة الإصلاح.
إن المهام التي تنتظرها المرجعية من هذه النخب ليست بالهينة؛ فهي تدعوهم إلى استيعاب دروس الماضي بكل مرارتها وفشلها، والعمل الجاد على صياغة خطط علمية وعملية قائمة على مبدأ الكفاءة والنزاهة. كما طالبتهم المرجعية بتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، ومنع التدخلات الخارجية التي تستهدف سيادة العراق واستقلاله. هذه المهام تمثل ركائز أساسية لأي عملية إصلاح شاملة، ولكنها تتطلب جهداً استثنائياً وإرادة حقيقية من النخب، تتجاوز مجرد التنظير إلى العمل الميداني الفعّال.
ولكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن للنخب أن تؤدي هذه الأدوار الكبيرة؟ الإجابة تكمن في تبني منهجية شاملة تقوم على عدة محاور أساسية. أولها؛ الوعي الكامل بالمشكلات الحقيقية التي يعاني منها العراق، من خلال دراسة معمقة تستند إلى بيانات دقيقة وتحليل علمي موضوعي. ثانيها؛ تطوير المهارات القيادية للنخب من خلال التدريب والتأهيل المستمر، بما يمكنهم من قيادة عمليات الإصلاح بفعالية. ثالثها؛ بناء شبكات تعاون قوية بين مختلف مكونات النخب، سواء كانت أكاديمية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها نحو تحقيق الأهداف المشتركة. رابعها؛ تعزيز القيم الأخلاقية كالشفافية والنزاهة، لتكون النخب قدوة للمجتمع، وخامسها؛ التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى الذي يتعامل مع العراق كدولة ذات إمكانيات هائلة تحتاج إلى توظيفها بشكل عقلاني ومدروس.
غير أن هذه المهام تتطلب توفير بيئة مواتية للنخب للقيام بدورها، وهنا يأتي دور الدولة والمجتمع في تمكين النخب من خلال بناء مؤسسات بحثية تدعم عملها، وتوفير مناخ سياسي مستقر بعيد عن الضغوط والتدخلات، وإصلاح النظام التعليمي ليكون رافداً مستداماً لإنتاج نخب جديدة، فضلاً عن توظيف الإعلام لنشر الوعي وتقديم صورة إيجابية عن التغيير والإصلاح.
إن العراق في هذه المرحلة الحرجة بحاجة ماسة إلى نخب واعية تحمل على عاتقها مسؤولية إعادة بناء الوطن وترميم
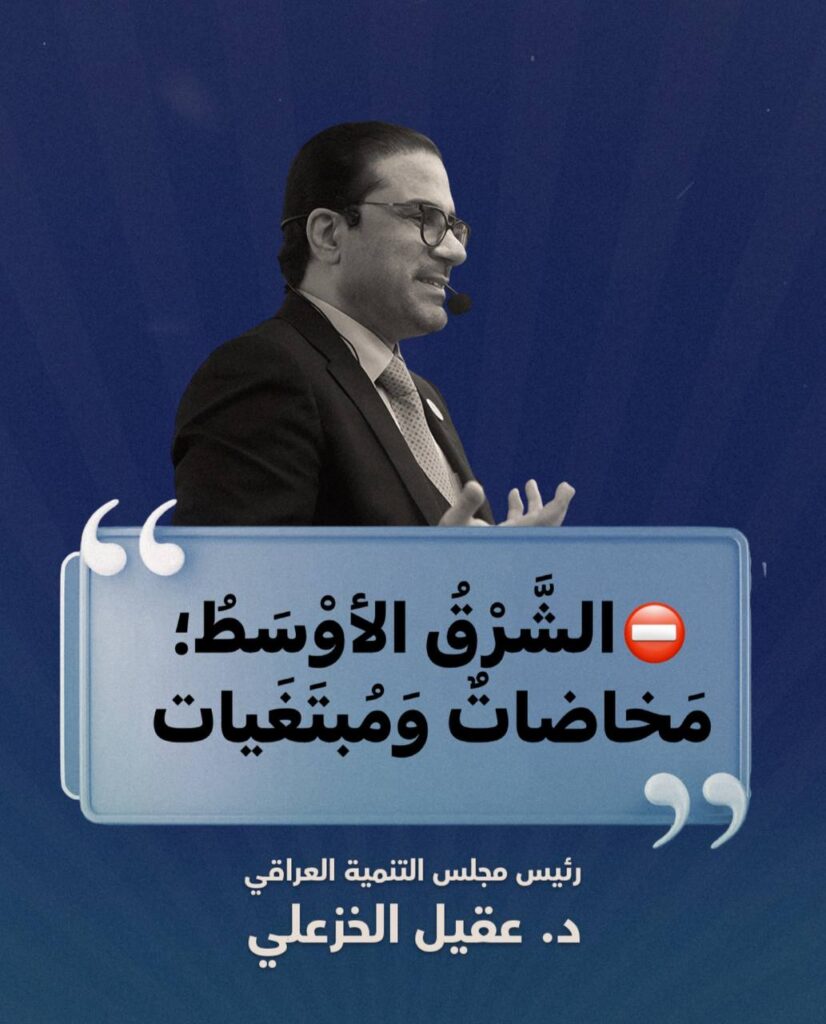
⛔️الشَّرْقُ الأوْسَطُ؛ مَخاضاتٌ وَمُبتَغَيات
✍🏼د.عقيل الخزعلي
يشهد الشرق الأوسط تحوّلاتٍ جذريةً تتسارع وتيرتها في ظلِّ تصعيدٍ عسكريٍّ متنامٍ ومواجهاتٍ محتدمةٍ، تعكس أبعادًا أعمق لصراع المحاور الإقليميّة والدوليّة. هذا الصراع، الذي بات يُدار بأدواتٍ متنوّعةٍ، يمتدّ من الحروب بالوكالة إلى إعادة رسم خرائط النفوذ والمصالح، مرحليًّا واستراتيجيًّا. وفي هذا الإطار، تبدو المنطقة وكأنّها في قلبِ زلزالٍ سياسيٍّ وجيوسياسيٍّ يعيد تشكيل قواعد اللعبة الدوليّة ويُمهّد لموازين جديدة للقوى.
🔺التّصعيد العسكريّ في سوريا: تداعياتٌ إقليميّةٌ ودوليّةٌ
تمثّلُ سوريا اليوم محورًا رئيسًا للتّصعيد العسكريّ المستمرّ، حيث تتداخل فيها المصالح الاستراتيجيّة للقوى الكبرى والإقليميّة. فمنذ المشاركة العسكريّة الروسيّة عام 2015، برزت موسكو كفاعلٍ أساسيٍّ يسعى إلى إعادة تثبيت نفوذه التاريخيّ في المنطقة، ليس فقط عبر حماية النظام، ولكن أيضًا من خلال تثبيت نفسه كرقمٍ صعبٍ في معادلة الشرق الأوسط. على الجانب الآخر، تستمرّ الولايات المتّحدة في الحفاظ على وجودٍ عسكريٍّ محدودٍ شمال شرق سوريا، بالتّوازي مع دعمها لقوّات سوريا الديمقراطيّة، كجزءٍ من استراتيجيةٍ أوسع تهدف إلى الحدِّ من النفوذ الإقليمي ومواجهة الطموحات الروسيّة.
في المقابل، يعتمد الكيان الإسرائيلي سياسة “الضربات الاستباقيّة”، حيث تستهدف بشكلٍ منتظمٍ مواقعَ تابعةً لإيران وحزب الله في سوريا، في محاولةٍ لتعطيل جهود نقل الأسلحة وتأسيس البنية التحتيّة العسكريّة. ومع ذلك، يبدو أنّ هذه الضربات لم تُقلِّل من تصميم الاطراف على تعزيز وجودها العسكريّ في سوريا كجسرٍ استراتيجيٍّ ومنطقة مجال حيوي مستدام.
🔺لبنان: بين حزب الله والتّصعيد الإسرائيليّ
على الساحة اللبنانيّة، يظلّ حزب الله القوّة الأبرز في معادلة الصّراع، حيث تمثّل ترسانته العسكريّة المتنامية أداةَ نفوذٍ قويّةٍ في المنطقة. وفي ظلِّ التّوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبيّة، يُحذّر المراقبون من احتماليّة انزلاق الوضع إلى مواجهةٍ شاملةٍ قد تُغيِّر معادلات القوّة في لبنان. يُدرِكُ الكيان الإسرائيلي خطورة الموقف، خاصّةً مع امتلاك حزب الله قدراتٍ صاروخيّةٍ متقدّمةٍ تُهدّد العمق الإسرائيليّ. وفي الوقت ذاته، يسعى الحزب إلى تعزيز صورته كقوّة ردعٍ محليّةٍ وإقليميّةٍ، معتمدًا على دعم حلفائه المتواصل.
💣 الحروب بالوكالة: أداةٌ لإعادة تشكيل النّفوذ
لا يُمكن فهم المشهد الراهن دون الإشارة إلى الحروب بالوكالة كأداةٍ مركزيّةٍ في صراع المحاور. اذ تعتمد الاطراف المتصارعة على شبكةٍ من المجموعات المسلّحة في الارض السوريّة لتحقيق أهدافٍ استراتيجيّةٍ مختلفة، ومنها مثلاً التوجّه التركي المتسارع لمنع قيام كيانٍ كرديٍّ مستقلٍّ على حدودها الجنوبيّة.
⚠️ إعادة رسم الخرائط: الطموحات والمخاطر
مرحليًّا، يبدو أنّ جميع الأطراف تسعى إلى تعزيز مواقعها التفاوضيّة. روسيا، من جانبها، تُحاول تثبيت أقدامها في الشرق الأوسط كقوّةٍ لا يُمكن تجاوزها، بينما تُركّز الولايات المتّحدة على احتواء النفوذ الروسي والايراني. أمّا الصين، فتُفضِّل العمل من خلف الكواليس عبر استثماراتٍ اقتصاديّةٍ ضخمةٍ، مستغلّةً تراجع الدّور الأمريكيّ التقليديّ في المنطقة، كما تشهد دول الخليج والعراق والاردن ومصر مناقشات جادّة ومُعمّقة من اجل الفهم الشامل والاستجابة وفقاً للمصالح.
استراتيجيًّا، يُثير الحديث عن إعادة رسم الخرائط الجيوسياسيّة مخاوف متزايدة. إعادة تقسيم مناطق النفوذ قد تُعزِّز من حالة عدم الاستقرار، خاصّةً في ظلِّ غياب توافقٍ دوليٍّ واضحٍ حول شكل النظام الإقليميّ الجديد. وبالتّالي، فإنّ خطر انفجار صراعاتٍ جديدةٍ يظلّ حاضرًا بقوّةٍ.
🔮استشراف المستقبل: سيناريوهاتٌ مفتوحةٌ
المشهد في الشرق الأوسط مفتوحٌ على عدّة سيناريوهات. أوّلها، استمرار حالة الصراع المستدام الذي يُبقي المنطقة رهينةً لمعادلات القوى الكبرى. ثانيها، احتمال بروز تفاهماتٍ إقليميّةٍ ودوليّةٍ تُمهِّد لمرحلة تهدئةٍ نسبيّةٍ. ومع ذلك، يبقى تحقيق هذه التفاهمات رهينًا بمدى استعداد الأطراف للتنازل عن بعض المكاسب الآنيّة لصالح تحقيق استقرارٍ استراتيجيٍّ طويل الأمد.
وبالمُحَصِّلَة، فإنّ الشرق الأوسط يمرّ بمخاضٍ عسيرٍ قد يطول أمده. وفي ظلِّ هذه التحدّيات، تبقى آمال شعوب المنطقة في تحقيق السلام والاستقرار مرهونةً بحكمة القادة، وقدرتهم على تجاوز المصالح الضيّقة نحو بناء نظامٍ إقليميٍّ يُحقِّق التوازن ويحفظ الحقوق للجميع.
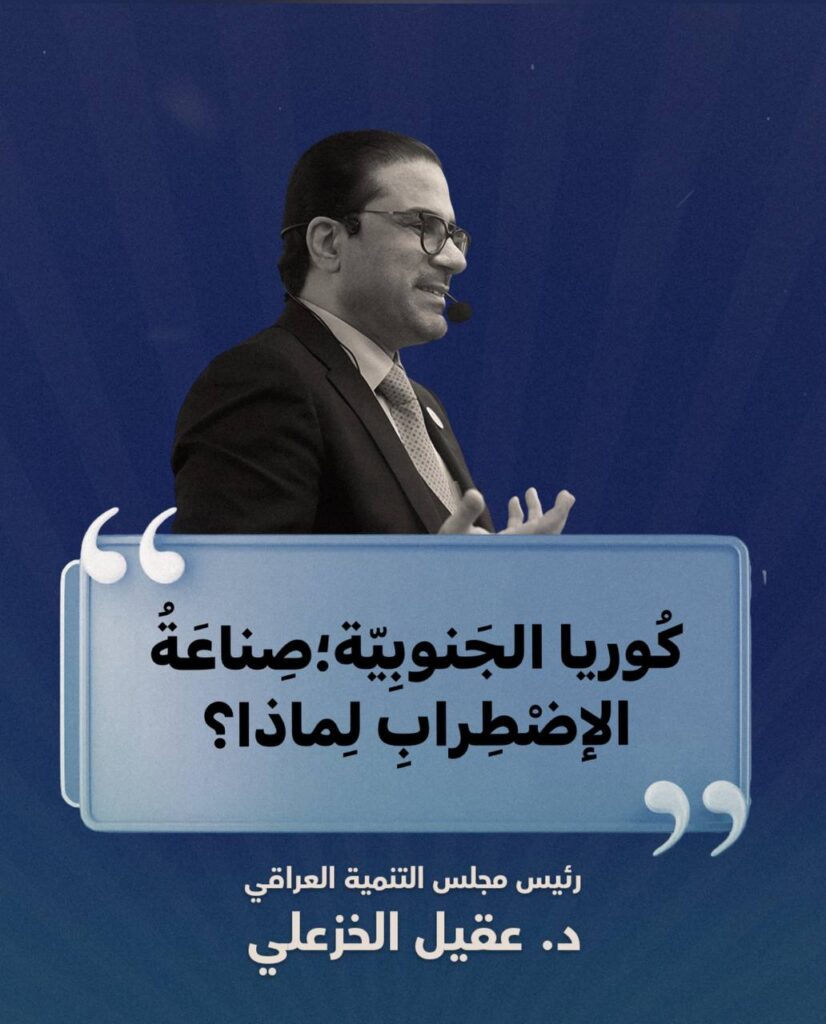
كُوريا الجَنوبِيّة؛صِناعَةُ الإضْطِرابِ لِماذا؟
🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷🇰🇷
✍🏼اعداد:د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
————————————————-
(أولاً/ الحَدَثُ في حَيّزِهِ الكوري)
بِحَسَبِ المَصادِر المُعْلَنةِ، تَشهَدُ كوريا الجَنوبِيّةُ في الآونةِ الأخيرةِ تَصعيداً سياسياً ملحوظاً بينَ الرئيسِ يون سوك يول وحزبِهِ الحاكمِ “قوة الشعب” والمعارضةِ المتمثّلةِ في الحزبِ الديمقراطي. تَتجلّى هذه التوتراتُ في سِياقِ الانتخاباتِ التشريعيةِ الأخيرةِ التي جَرَت في أبريل 2024، حيثُ فازَت المعارضةُ بعددٍ أكبرَ من المقاعدِ البرلمانيةِ، مما أدّى إلى تراجعِ مقاعدِ الحزبِ الحاكمِ من 114 إلى 108 مقاعدٍ فقط.
تَفاقَمَت الأوضاعُ مع تعرّضِ زعيمِ الحزبِ الديمقراطي، لي جاي ميونغ، لِهجومٍ بالطعنِ في يناير 2024، أثناءَ زيارةٍ لمدينةِ بوسان، مما زادَ من حِدّةِ التوتراتِ السياسيةِ في البلاد.
يُعزى هذا التصعيدُ إلى عدةِ عواملَ، منها الخلافاتُ حولَ السياساتِ الداخليةِ والخارجيةِ، خاصةً فيما يتعلّقُ بالعلاقاتِ مع كوريا الشمالية والولاياتِ المتحدةِ. يَسعى الرئيسُ يون إلى تعزيزِ التحالفِ مع واشنطن واتخاذِ مواقفَ أكثرَ صرامةً تجاهَ بيونغ يانغ، مما يَلقى معارضةً من الحزبِ الديمقراطي الذي يَدعو إلى نهجٍ أكثرَ توازناً.
في هذا السياقِ، تَبرزُ عدةُ أطرافٍ مستفيدةٍ من هذه التوتراتِ. داخلياً، تَسعى بعضُ الفصائلِ السياسيةِ إلى تعزيزِ نفوذِها واستقطابِ الدعمِ الشعبيِّ من خلالِ تأجيجِ الخلافاتِ. خارجياً، قد تَستفيدُ دولٌ مثل كوريا الشمالية من الانقساماتِ الداخليةِ في الجنوبِ لتعزيزِ مواقفِها التفاوضيةِ.
أما الأسبابُ المعلنةُ فتَتضمّنُ الخلافاتِ حولَ السياساتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، في حينِ تَكمنُ الأسبابُ الخفيةُ في الصراعاتِ على السلطةِ والنفوذِ بينَ النخبِ السياسيةِ.
يأتي هذا التصعيدُ في توقيتٍ حساسٍ، حيثُ تَشهدُ المنطقةُ توتراتٍ أمنيةً متزايدةً، مما يَجعلُ الساحةَ السياسيةَ الكوريةَ الجنوبيةَ أكثرَ عرضةً للتأثرِ بالتحدياتِ الداخليةِ والخارجيةِ.
(ثانياً/ الحَدَثُ في مَنْظورِهِ الأوسَع)
في زَمنٍ يَشهدُ فيهِ العالمُ تَصعيداً مُستَمِرّاً للصِّراعاتِ الإقليميّةِ والدّوليّةِ، وتَعاظُمَ الحُروبِ بِالوَكالةِ، تَتّجهُ الأنظارُ نَحوَ كُوريا الجَنوبِيّةِ، هذا البلدُ الذي يَحملُ في طَيّاتِهِ مُفارَقاتٍ جُغرافيّةٍ وسياسيّةٍ تَجعلهُ في قلبِ مَعادلاتِ النُّفوذِ والمَصالِحِ العالميّةِ. الأوضاعُ الحاليّةُ في شبهِ الجَزيرةِ الكوريّةِ ومِنطَقةِ الشّرقِ الأوسطِ، وخاصّةً في سوريا، تَبدو كأنّها خُيوطٌ مُتشابِكةٌ في نَسيجِ صِراعِ المحاوِرِ الإقليميّةِ والدّوليّةِ، حيثُ تَتقاطعُ الأهدافُ والغاياتُ بينَ القُوى العُظمى مثلَ الوِلاياتِ المُتّحدةِ، والصّينِ، ورُوسيا، وكوريا الشّماليّةِ.
التّصعيدُ الحاليُّ في كُوريا الجَنوبِيّةِ يَتّخذُ أبعاداً تَخطّتِ الخُطوطَ العَسكريّةَ التّقليديّةَ، لتَشمَلَ بُعداً اقتصاديّاً واستراتيجيّاً، حيثُ تُحاولُ كوريا الجنوبيّةُ، تحتَ مِظلّةِ التّحالفِ مع الوِلاياتِ المُتّحدةِ، تَعزيزَ مَوقِعِها كَقاعدةٍ أمنيّةٍ متقدّمةٍ في وجهِ الطُّموحاتِ الصّينيّةِ المُتزايدةِ. الصّينُ، التي تَرَى في التّحالفِ الأمريكيّ الكوريّ الجنوبيّ تهديداً لمصالحِها الاستراتيجيّةِ، تُواصِلُ سَعيَها لِتعزيزِ نُفوذِها الإقليميِّ عبرَ ضَغطٍ مُتعدِّدِ الجَوانبِ على كوريا الجنوبيّةِ واليابانِ، مَع سِباقٍ مَحمومٍ على النّفوذِ في بَحرِ الصّينِ الجنوبيِّ ومَضائقِ المحيطِ الهادئِ.
في هذا السّياقِ، يَتّضِحُ أنّ التّصعيدَ في كوريا الجنوبيّةِ لا يَقتصرُ على تَطوُّراتٍ إقليميّةٍ مُنفصِلةٍ، بل يُمثِّلُ حلقةً في سِلسلةِ مُحاوَلاتٍ لإعادةِ رَسمِ خرائِطِ المَصالِحِ والنّفوذِ على المُستوى الدّوليِّ. مِنطَقةُ الشّرقِ الأوسطِ، وخاصّةً سوريا، تُعَدُّ مِثالاً واضِحاً على الحُروبِ بالوكالةِ، حيثُ تَتصارَعُ القُوى العالميّةُ على بَسطِ نُفوذِها مِن خِلالِ دُوَلٍ ووُكلاءِ مَحلّيينَ، مع تَشابُهٍ واضحٍ في الطُّرقِ والأهدافِ بينَ ما يَحدُثُ في سوريا وما يَجري في شبهِ الجَزيرةِ الكوريّةِ.
تَتجلّى الأسبَابُ المُعلَنةُ للتّوتّرِ في كوريا الجنوبيّةِ في سِياقِ ما تُسمّيهِ الوِلاياتُ المُتّحدةُ “حِمايةَ المَصالحِ الدّوليّةِ”، خُصوصاً أمامَ تَزايدِ الطُّموحاتِ العسكريّةِ لكوريا الشّماليّةِ وتَجرِباتِها النَّوويّةِ. إلّا أنّ هذهِ الأسبَابَ تُخفي وراءَها مَصالحَ استراتيجيّةً أوسَعَ، تَتعلّقُ بالضّغطِ على الصّينِ ورُوسيا، وإعادةِ صِياغةِ التّحالفاتِ العالميّةِ. الدَّورُ الأمريكيُّ في هذا الصِّراعِ لا يُمكنُ فَصلُهُ عن سِياقِ الحربِ بالوكالةِ في سوريا، حيثُ تُسعى الوِلاياتُ المُتّحدةُ إلى استخدامِ كوريا الجنوبيّةِ كَوَرقةِ ضَغطٍ في…
…تُواجِهُ ضُغوطاً داخليّةً وخارجيّةً تُسهِمُ في صِناعةِ حالةِ الاضطِرابِ. الدّاخِلُ الكوريُّ يَشهدُ استِقطاباً سياسيّاً واجتماعيّاً يُفاقِمُهُ الحَربُ الإعلاميّةُ والدّعائيّةُ بينَ المُعسكراتِ السياسيّةِ. خارجيّاً، يُستَخدمُ الصّراعُ في كوريا الجنوبيّةِ كأداةٍ لتحقيقِ أهدافٍ استراتيجيّةٍ مُتعدّدةِ الأبعادِ، حيثُ تُحاوِلُ الوِلاياتُ المُتّحدةُ إبقاءَ الصّينِ وكوريا الشّماليّةِ في حالةِ ضغطٍ مُستمرٍّ، في حينِ تَسعى الصّينُ إلى تَفكيكِ التّحالفاتِ الأمريكيّةِ في المِنطَقةِ.
استِشرافاً للمُستقبَلِ، يُمكِنُ القَولُ إنّ الصِّراعَ في كوريا الجنوبيّةِ سَيُشكّلُ مَرحلةً مِفصليّةً في إعادةِ تَرسيمِ خَرائطِ النّفوذِ الدّوليّةِ. المَرحلةُ الحاليّةُ تَشهَدُ تَحوّلاتٍ استراتيجيّةً تَنعكِسُ على الوَضعِ الإقليميِّ في آسيا والشّرقِ الأوسطِ، مَع فَرَضِيّةِ أن تَتّسعَ دائرةُ الحُروبِ بالوكالةِ لتَشمَلَ مَناطِقَ أُخرى. التّصعيدُ المُتنامي يَفرِضُ على القُوى العُظمى إعادةَ تَقييمِ استراتيجيّاتِها في ظِلِّ تَحدّياتِ العَصرِ الحَديثِ، حيثُ تُشكّلُ التكنولوجيا والمَوارِدُ الطّاقويّةُ مَفاتيحَ الصِّراعِ القادِمِ.
بِالتالي، فإنّ كُوريا الجنوبيّةَ ليست فقط ساحةً لصِراعِ المَصالِحِ، بل يُمكِنُ اعتبارِها واحِدَةً من المحركات لصِناعةِ السَّلامِ أو الاضطرابِ في المِنطَقةِ والعالمِ.
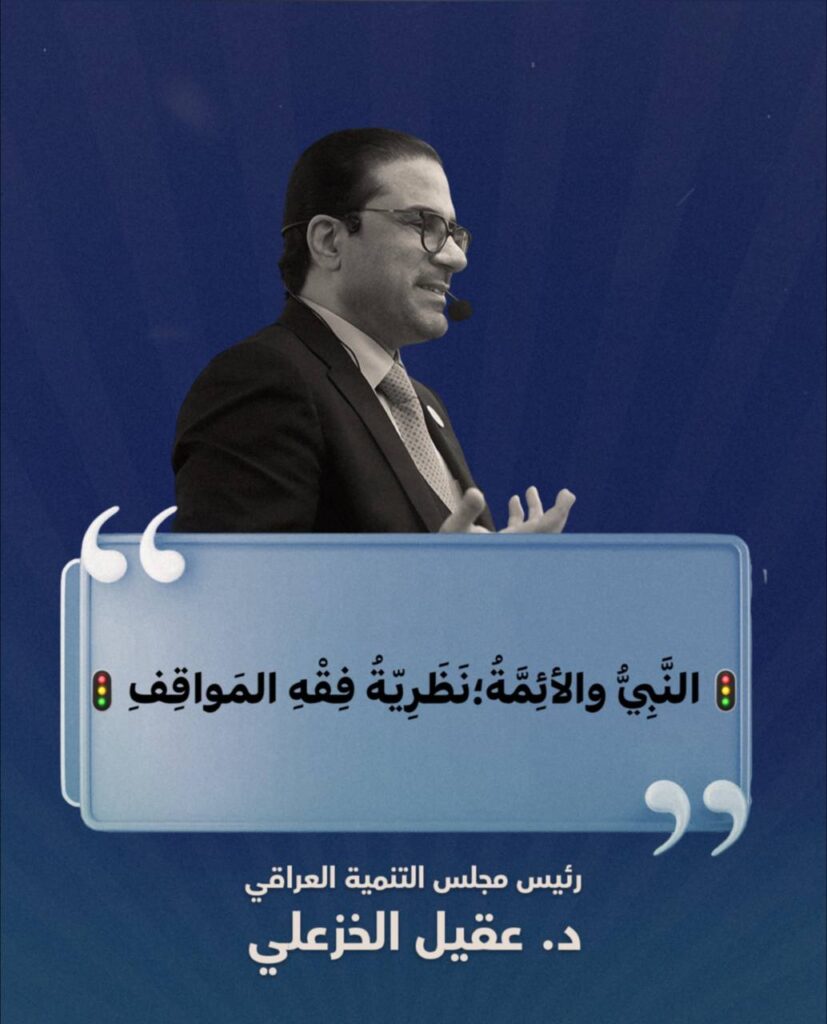
🚦النَّبِيُّ والأئِمَّةُ؛نَظَرِيّةُ فِقْهِ المَواقِفِ🚦
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
=======================
{مقاربة تأصيلية تجمع القيادة الموقفية والتحويلية في سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام)}
📜الملخص
تتناول هذه الورقة التأصيلية نموذج القيادة الموقفية والتحويلية في سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السلام)، مع استحداث نظرية شاملة تُسمَّى “نظرية فقه المواقف”. تستند النظرية إلى فهم مواقفهم من الأحداث والقضايا التي واجهوها في مختلف الظروف، حيث اتسمت قيادتهم بالمرونة والحكمة والقدرة على تحقيق التحول العميق في الأمة مع مراعاة متطلبات اللحظة. تشمل الدراسة تحليلًا لمواقف النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) والسيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) والأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بهدف تقديم نموذج قيادي شامل يتسق مع مفاهيم القيادة الموقفية والتحويلية.
🏁المقدمة
تشكل القيادة الموقفية والتحويلية محورًا أساسيًا في الفكر القيادي المعاصر، حيث تُركّز الأولى على اختيار الأسلوب القيادي الأنسب بناءً على طبيعة الموقف، فيما تسعى الثانية إلى إحداث تغييرات جذرية في القيم والسلوكيات لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى. في هذا السياق، تسلط هذه الدراسة الضوء على سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام) بوصفهم نماذج عملية تمثل مزيجًا من القيادة الموقفية والتحويلية.
فقد واجهوا تحديات متنوعة، شملت السياقات السياسية والاجتماعية والدينية، وتميزت قيادتهم بالتوازن بين الاستجابة الفورية للأحداث وقيادة التغيير المستدام. تجمع هذه الورقة بين فهم مواقفهم من تلك التحديات واستنباط المبادئ العامة التي يمكن أن تُشكّل أساسًا لنظرية قيادية متكاملة في إدارة المواقف.
📝الإطار النظري: القيادة الموقفية والتحويلية
🔍القيادة الموقفية
تقوم القيادة الموقفية على فكرة أن القائد يختار أسلوبه بناءً على الموقف الراهن، مع مراعاة عوامل مثل جاهزية الأفراد وطبيعة التحدي. من أبرز ملامحها:
1. المرونة في التفاعل مع المتغيرات.
2. القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بناءً على السياق.
3. تحقيق التوازن بين السيطرة والمشاركة.
🧮القيادة التحويلية
تركز القيادة التحويلية على إحداث تغييرات عميقة ومستدامة في قيم الأفراد ومبادئهم وسلوكياتهم لتحقيق رؤية بعيدة المدى. من أبرز سماتها:
1. الرؤية الاستراتيجية الواضحة.
2. التأثير العاطفي والإلهام.
3. بناء الثقة والتمكين.
📌النبي محمد (صلى الله عليه وآله): القيادة الموقفية والتحويلية في أرقى صورها
📍القيادة الموقفية في السيرة النبوية
تميز النبي (صلى الله عليه وآله) بقدرته الفائقة على قراءة الواقع واتخاذ القرارات التي تراعي مصلحة الأمة في كل ظرف. على سبيل المثال:
🖌️• صلح الحديبية: رغم اعتراض بعض الصحابة، اختار النبي (صلى الله عليه وآله) الصلح مع قريش حقنًا للدماء وتمهيدًا لفتح مكة لاحقًا. هذا القرار يُظهر فهمًا عميقًا للمصلحة الكبرى، مع تكييف القيادة بناءً على طبيعة الموقف.
📍القيادة التحويلية في بناء الأمة
منذ بداية الدعوة، عمل النبي (صلى الله عليه وآله) على إحداث تحول جذري في القيم الاجتماعية والثقافية السائدة، متمثلًا في:
👣• الهجرة إلى المدينة: لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل بداية لبناء مجتمع جديد قائم على العدالة والتآخي.
🗣️• خطبة حجة الوداع: كانت إعلانًا لرؤية متكاملة لقيم الأمة الإسلامية التي ترسخ مبدأ المساواة وحقوق الإنسان.
📌السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام): نموذج القيادة التحويلية المرتبطة بالموقف
📍القيادة الموقفية في الدفاع عن الحق
بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله)، لعبت السيدة فاطمة (عليها السلام) دورًا محوريًا في الدفاع عن الإمامة وحقوق أهل البيت. مواقفها، كخطبتها الشهيرة في مسجد النبي، تُظهر قدرة استثنائية على مخاطبة الجمهور وتكييف الرسالة بناءً على طبيعة الظرف السياسي والاجتماعي.
📍القيادة التحويلية في حفظ القيم
رغم قصر حياتها، تركت الزهراء (عليها السلام) أثرًا تحويليًا في الأمة من خلال تثبيت القيم الإسلامية الأصيلة، مثل الدفاع عن العدالة ورفض الظلم، مما جعلها رمزًا خالدًا للإصلاح.
📌الأئمة الاثنا عشر: القيادة بين الموقف والتحول
📍الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)
قدّم الإمام علي (عليه السلام) نموذجًا فريدًا للقيادة الموقفية من خلال التزامه بالصبر بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) حفاظًا على وحدة الأمة. وفي ذات الوقت، كان مثالًا للقيادة التحويلية من خلال إصلاحه الاجتماعي والسياسي عندما تولى الخلافة.
📍الإمام الحسن (عليه السلام)
اختار الإمام الحسن (عليه السلام) الصلح مع معاوية بناءً على…
…في الوقت ذاته قيادة تحويلية بإصراره على تثبيت القيم الإسلامية الأساسية رغم التحديات.
📍الإمام الحسين (عليه السلام)
نهضته في كربلاء تمثل أرقى صور القيادة التحويلية، حيث قدم رؤية إصلاحية للأمة، قائلاً: “إني لم أخرج أشراً ولا بطراً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي.” موقفه يُظهر أيضًا القيادة الموقفية في اختياره اللحظة المناسبة للقيام.
📍الأئمة من زين العابدين إلى الإمام المهدي (عليهم السلام)
تميّز هؤلاء الأئمة بالقدرة على الموازنة بين القيادة الموقفية والتحويلية. على سبيل المثال:
🖋️• الإمام زين العابدين (عليه السلام) ركز على البناء الروحي من خلال “الصحيفة السجادية”، محولًا آلام كربلاء إلى طاقة إصلاحية.
🖋️• الإمام الصادق (عليه السلام) أسس مدرسة علمية واسعة، مما ساهم في تحول فكري عميق للأمة.
🖋️.في الغيبة الكبرى، تتجلى القيادة التحويلية في إعداد الأمة لمشروع عالمي قائم على العدالة المطلقة.
📕نظرية فقه المواقف: تأصيل جامع
تُستنبط نظرية فقه المواقف من الجمع بين القيادة الموقفية والتحويلية في سيرة النبي وأهل بيته (عليهم السلام). ترتكز هذه النظرية على:
1. المرونة القيادية: الاستجابة للظروف دون المساس بالمبادئ.
2. الرؤية التحويلية: بناء مستقبل مستدام قائم على القيم.
3. التوازن بين المصلحة الآنية والهدف البعيد.
🗞️الخاتمة
يُقدّم هذا البحث نموذجًا قياديًا شاملًا مستمدًا من سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السلام)، حيث تمثل القيادة الموقفية والتحويلية أسسًا راسخة لإدارة المواقف وتحقيق التحولات العميقة. إن نظرية فقه المواقف ليست فقط دراسة تاريخية، بل هي منهج عملي قابل للتطبيق في سياقات القيادة المعاصرة.
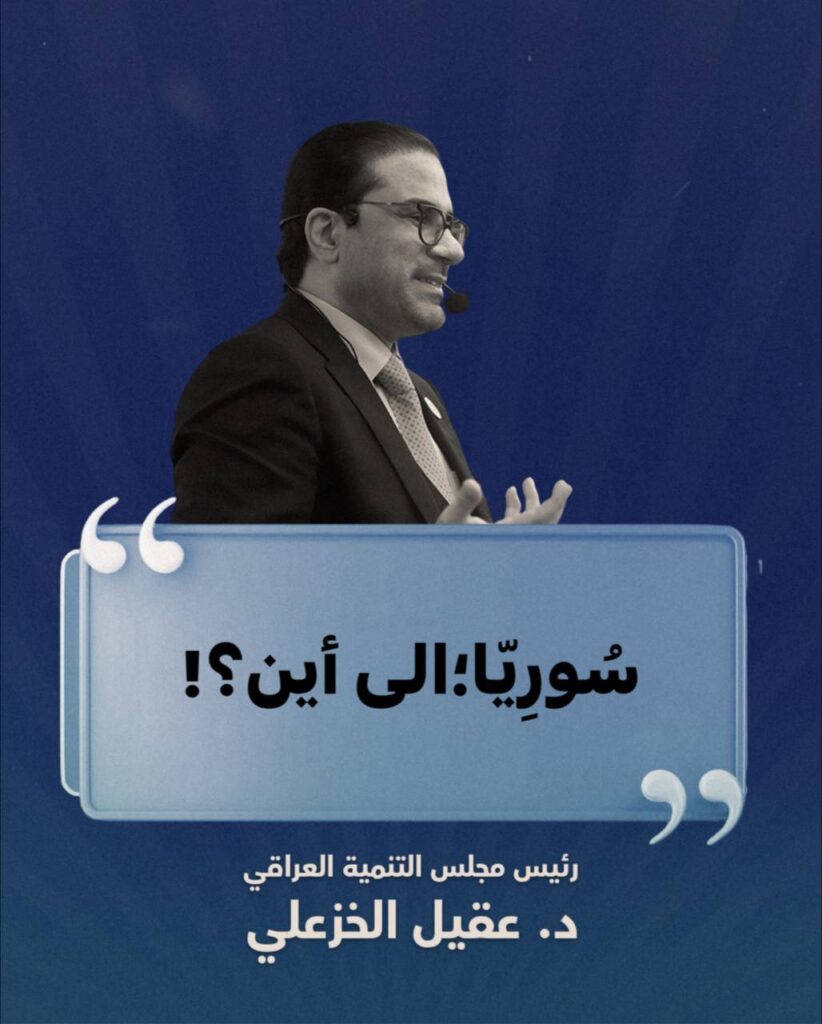
سُورِيّا؛الى أين؟!
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
” في قلب الشرق الأوسط الملتهب، تقف سوريا مثقلة بجراح الصراع الذي تجاوز العقد من الزمن.
تطوراتُ اليوم جعلت البلاد مسرحاً لتشابك المصالح المحلية والإقليمية والدولية، حتى تحولت إلى مرآة تعكس التعقيدات التي يعيشها العالم بأسره، وتُظهر خُبث خريطة التآمر والانقلاب الذي تقوده حُزمة المصالح والتغييرات الدراماتيكية في المواقف، والتوظيف الأدهى لنتائج الصراع في لبنان وفلسطين، والاستثمار الاخطر في الحروب بالوكالة والمعارك بالإنابة، والاغتنام الامثل لفترة ما قبل استلام ترامب للسلطة، وارتباط كل ذلك بالحرب في اوكرانيا، والشدّ الجيواستراتيجي بين الاطراف المتصارعة والمتنازعة، حتى باتت معادلات التغيير القادمة تتضح من خلال توافقات اقليمية ودولية مريبة، تتخذ من دهاء الهندسة السياسية والاجتماعية الدمويّة غير الخلّاقة، سبيلاً لتقاسم النفوذ والمصالح على ركام الجماجم ومخلّفات التدمير.
في مشهد يختلط فيه الألم بالأمل، يبقى السؤال الجوهري مُعَلَّقاً: *هل يمكن لسوريا أن تخرج من دوامة الحرب والفوضى إلى أفق جديد من السلام والاستقرار؟*
بصراحة، تُخيّم على المشهد السوري احتمالات مظلمة تعكس سيناريوهات كارثية قد تُفاقم المأساة الإنسانية وتُعمّق الأزمة، من بين هذه السيناريوهات، يلوح شبح التفكك الكامل للدولة السورية، حيث قد يؤدي استمرار الصراع إلى انهيار المؤسسات الوطنية وتحوّل البلاد إلى مناطق نفوذ متناحرة تديرها أطراف محلية ودولية، هذا التفكك سيخلق فراغاً أمنياً هائلاً قد تستغله التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، مما يعيد سوريا إلى دائرة جديدة من الفوضى.
على الجانب الآخر، يبرز سيناريو الحرب الإقليمية الشاملة كأحد أكثر التهديدات خطورة، حيث قد يؤدي تصاعد التوتر بين إيران والكيان الإسرائيلي أو بين تركيا والأكراد إلى مواجهة إقليمية تمتد لتشمل دولاً كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة، ودول المنطقة، هذه المواجهة قد تُغرق المنطقة في حالة من الفوضى العارمة وتُحوّل سوريا إلى بؤرة صراع دائم.
كما أن احتمال عودة التنظيمات الإرهابية بقوة وقضم المزيد من الاراضي لا يزال قائماً، حيث قد تستغل الفوضى المستمرة لإعادة تنظيم صفوفها والسيطرة على مناطق جديدة، مما يُعيد التهديد الأمني ليس فقط لسوريا بل للشرق الأوسط والعالم بأسره.
أما سيناريو التدهور الإنساني، فهو نتيجة حتمية لاستمرار النزاع، حيث ستُواجه البلاد موجة جديدة من المجاعة والأمراض، مع تفاقم أزمة اللاجئين وانعدام الخدمات الأساسية.
رغم هذه السيناريوهات القاتمة، يبقى الأمل قائماً في أن تتمكن سوريا من تجاوز أزمتها عبر تسويات وحلول شاملة تُعيد بناء الدولة وترمم النسيج الاجتماعي والاقتصادي، والطريق إلى هذا الأمل يبدأ بتسوية سياسية متكاملة تُرسّخ الاستقرار وتُعيد للبلاد وحدتها وسيادتها، بعيداً عن ضغط الارهاب وتعنّت المواقف.
في نهاية المطاف،ونتيجةً للمخططات الكبرى الوبيلة تبقى سوريا أمام مفترق طرق تاريخي؛ إما أن تستمر في دوامة الصراع والدمار، مما يُفاقم الألم ويُرسخ السيناريوهات الكارثية، أو أن تتخذ خطوة شجاعة نحو التسويات (الوطنية والاقليمية والدولية) عبر حلول شاملة تعيد بناء الدولة وترسم مستقبلاً جديداً لأجيالها القادمة.
الأمل في سوريا ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وتعاوناً دولياً واسعاً يضع مصلحة الشعب السوري فوق أي اعتبارات أخرى.
وسط الدمار والدماء، يبقى الأمل شعلة يجب أن تُحافظ عليها سوريا وشعبها حتى تشرق شمس السلام مجدداً على أرضها، ويجب على الجميع اسنادها في نكبتها ومحنتها بما تُمليه الالتزامات الانسانية والاخلاقية والشِرعة الدولية، ويبقى لزوم الحذر واليقظة والاستعداد واجباً لأي طارىء ، فالمُخطَطُ التآمري (نتن)، والإختبارُ التأريخي صَعَبٌ، ولله في خَلْقِهِ شُؤون
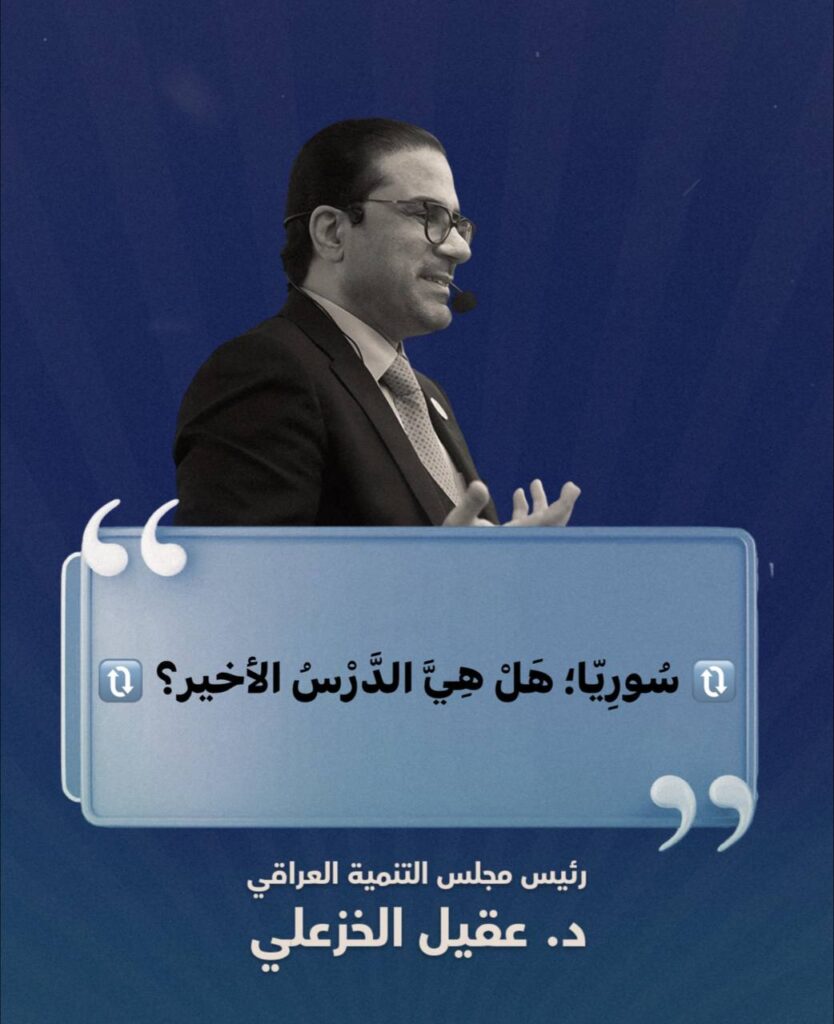
🔃 سُورِيّا؛ هَلْ هِيَّ الدَّرْسُ الأخير؟ 🔃
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
—————————————————
” ها نَحنُ مُجدداً مع الأزمة السورية التي يتصاعَدُ أُوارُها لِتُثبِتَ أنها ليست مجرد صراع محلي داخل حدود دولة واحدة، بل هي مثال حي على التداخل المعقد بين المصالح (المحلية، الإقليمية، والدولية) في منطقة تعد من أكثر المناطق حساسية في العالم.
من خلال النظر في مجريات الأحداث السورية وفي الشرق الأوسط بشكل عام، تظهر لنا دروس موضوعية عميقة تشمل جميع الأبعاد السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الأمنية، والإنسانية، هذه الدروس تؤخَذُ كَحُزمَةٍ مُتكاملة بدُفعَةٍ واحدَةٍ بعيداً عن (التجزئة والقص والتشويه والتحريف والتهوين والتخوين)، بل مَنطوقٌ موضوعيٌّ يفرضُ نفسه كإرث فكري واستراتيجي يُمكن الاستفادة منه لفهم ديناميكيات المنطقة ومنع تكرار السيناريوهات الكارثية مستقبلاً، يحكمه محاولات التَّجَرُّدِ العقلي الموضوعي المفروغ من الشَحنِ العاطفي اللاواعي، لإستخلاصِ دروسٍ عِدّةٍ أبرَزُها :
📌١-أثبتت الأزمة السورية أن غياب العدالة والمشاركة السياسية يُشعِلُ فتيل الاحتجاجات، ويحوّل الأزمات البسيطة إلى نزاعات مستعصية، حيث ان الأنظمة التي ترفض الإصلاح المتدرج أو القبول بالتغيير المُستَوعِب تُنتج معارضاتٍ وتدخلاتٍ عنيفةٍ يصعب السيطرة عليها لاحقاً.
ففي سوريا، بدأ النزاع باحتجاجات تطالب بالإصلاح، لكن الردود الأمنية غير المشفوعة بالحلول السياسية والاجتماعية دفع الوضع إلى مواجهاتٍ شاملة.
👈🏼الدرس هنا هو أن الحكومات التي تتجاهل مطالب شعوبها تُخاطر بفقدان شرعيتها، ما يفتح الباب أمام الفوضى والتدخلات الخارجية، خصوصاً اذا كانت هذه الدول هَشّة أو مُكابِرة.
📌٢-الصراعات المحلية الفوضويّة تصبح ساحة لحروب الوكالة، فالأحداث السورية أثبتت أن أي صراع محلي في منطقة استراتيجية مثل الشرق الأوسط لن يظل محصوراً داخل حدود الدولة المعنية، فقد أصبحت سوريا ساحة صراع مفتوحة، حيث تصادم النفوذ المحلي مع الإقليمي مع الدولي، كل طرف دعم وكلاءه على الأرض لتحقيق أجنداته الخاصة، مما زاد من تعقيد الأزمة وأطاح بأي فرص لحل سريع.
👈🏼الدرس هنا هو أن دول المنطقة بحاجة إلى آليات لحل النزاعات داخلياً قبل أن تتحول إلى أدوات في أيدي القوى الكبرى.
📌٣- هشاشة الأنظمة الإقليمية تُغذي الصراعات، اذ كشفت الأزمة السورية أن الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط تعاني من ضعف هيكلي يجعلها غير قادرة على مواجهة الأزمات الداخلية. الدول ذات المؤسسات القوية تستطيع احتواء التوترات، لكن عندما تكون المؤسسات هشة أو منخورة، فإن الصراعات الداخلية تتفاقم بسرعة، وهذا الضعف يُغري الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لملء الفراغ، كما حدث مع تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام.
👈🏼 الدرس هنا هو أن بناء أنظمة سياسية قوية وشاملة، تعتمد على حكم القانون والمشاركة، هو الحل الجذري لتجنب الانهيارات.
📌٤- تكلفة التدخلات الدولية والإقليمية كارثيّة على الجميع، فتدخل القوى الكبرى الدوليّة والإقليميّة في الأزمة السورية أظهر كيف يمكن أن تتحول هذه التدخلات إلى عامل يعمّق الصراع بدلاً من حله، فكل طرفٍ دعمَ أجندته الخاصة دون اعتبار لمعاناة الشعب السوري، وهذه التدخلات بدورها، لم تسهم في تحقيق السلام، بل أضافت طبقات جديدة من التعقيد.
👈🏼الدرس هنا هو أن التدخلات الخارجية يجب أن تُركز على دعم الحلول الشاملة وليس تعزيز الانقسامات، وإلّا لاخَيرَ فيها.
📌٥- الكارثة الإنسانية كمأساة عابرة للحدود، حيث خلفت الأزمة السورية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، فملايين اللاجئين والنازحين داخل سوريا وخارجها أصبحوا رمزاً للمعاناة، بينما فشلت المنظومة الدولية في التعامل مع حجم الكارثة، فضلاً عن ان غياب التنسيق الدولي أدى إلى تفاقم معاناة اللاجئين، سواء في المخيمات أو في الدول المستضيفة.
👈🏼 هذا يُبرز درساً مهماً، وهو أن المجتمع الدولي بحاجة إلى آليات أكثر فعالية وسرعة للاستجابة للأزمات الإنسانية، مع ضمان توزيع عادل للأعباء بين الدول.
📌٦-الإعلام كسلاح استراتيجي، لقد
أظهرت الأزمة السورية الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في توجيه الرأي العام العالمي بإنحياز مصلحي مُوجّه، من نشر صور الأطفال المتضررين إلى مقابلات الشخصيات البارزة مثل ما تكرر مع الارهابي ( أبو محمد الجولاني) وآخرها لقاءه قبل يوم امس مع CNN الاخبارية، بحيث أصبح الإعلام أداة لتشكيل السرديات، سواء لتشويه طرف أو لتلميع صورة آخر. 👈🏼الدرس هنا هو أن السيطرة على السرد الإعلامي تُعد جزءاً من المعركة السياسية والعسكرية في الحروب الحديثة.
📌٧- الحاجة إلى حلول شاملة ومتوازنة، اذ بيّنت الأزمة السورية أن الحلول الجزئية أو المؤقتة لا تُسهم في إنهاء النزاعات، بل تُعيد إنتاجها، ومحاولات فرض الحلول من الخارج دون مراعاة خصوصيات الشعب السوري أثبتت عدم فعاليتها.
👈🏼الدرس المستفاد هنا هو أن أي حل مستدام يجب أن يكون شاملاً، يُراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل جميع الأطراف ذات الصلة.
📌٨- تداعيات الفوضى على الأمن الإقليمي والدولي، حيث لم تبقَ الأزمة السورية داخل حدودها، بل امتدت تداعياتها إلى دول الجوار والعالم، من تدفق اللاجئين إلى تصاعد التوترات بين القوى الكبرى، أصبحت سوريا نقطة انطلاق لأزمات متداخلة.
👈🏼الدرس هنا هو أن استقرار الشرق الأوسط ليس مجرد شأن إقليمي، بل هو ضرورة للأمن والسلم الدوليين.
📌٩- أهمية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، لقد أظهرت التجربة السورية أن الصراعات المسلحة لا يمكن إنهاؤها دون معالجة الانقسامات الداخلية العميقة، فالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ضرورية لبناء مجتمع مستدام، وتجاهل الانتهاكات أو محاولة فرض السلام بالقوة فقط يؤدي إلى عودة الصراعات في المستقبل.
👈🏼الدرس هنا هو أن السلام الحقيقي يبدأ من الاعتراف بالمظالم والعمل على معالجتها.
📌١٠- انتقال الفعل الاستخباري الاستباقي الى مهندس لصناعة الاحداث، حيث أظهرت الازمة السورية عمق الدهاء والبُعد الاستراتيجي في التخطيط السياسي والامني، وتوظيف ذلك بعمليات التجنيد والتدريب والتاهيل لخوض المعارك بالنيابة لتحقيق اغراض ميدانية وجغرافية خطيرة.
👈🏼الدرس هنا يكمن في اهمية منظومات (التنظير والتفكير والتخطيط والتدبير ) الاستراتيجي في المجالات السياسية والاجتماعية والامنية والاستخبارية، اذ بدونها تكون الدولة عمياء في تيه،وتخبط خبط عشواء حتى يأتي أجلها بفعل غباءها وعنتها ونرجسيتها.
📌١١- عودة للقواعد الحاكمة في النظام الدولي، “فليس هناك عداوات دائمة وصداقات دائمة، بل مصالح دائمة”، ” إذا تلاقَت مصالح الاضداد الكبّار؛ خَسِرَت الادوات وسقط الصِغار “، ” الحربُ خُدعة “، ” العقائد حاكمة؛ اداتها القوّة وقلبها الاقتصاد وعصاتُها الردع وجزرتها السياسة وبوصلتها المصالح ودبلوماسيتها الدهاء”،
“البقاء للأكثرِ تَكيُّفاً” “من لا يتغيّر يتدهور ومن لا يتقدّم يتقادَم” ” لا دوام لحال وان استطال” “الدول الحديثة دينها مصالحها” “بالدهاء تضحى الأقليّةُ أكثريّة، وبالغباء لا يَنفَعُ غُثاء السيّل””مغادرة الفرصة غصّة” “التعنّت أول السقوط””النرجسية والمكابرة والزهو خسارة مُعجّلة””الاستهانة بالخصم؛ غرور ماحق وانهيار لاحق”
♻️وبالمحصلة، الدروسُ مُتكاثرة وستتجّلى أجِنّتُها لاحقاً بصورة أوضح وأكثر إتساعاً ، فالأزمة السورية بكل ما حملته من معاناة وتعقيد، تقدّم نموذجاً حياً للصراعات التي تُدار بطرق خاطئة، لكنها في الوقت نفسه تُمثل فرصة لفهم أعمق لديناميكيات الشرق الأوسط. الدروس المستخلصة من هذه الأزمة تُبرز الحاجة إلى أنظمة سياسية أكثر شمولية استيعابية، ومؤسسات دولية أكثر فعالية، وحلول تستند إلى العدالة والتنمية.
سوريا اليوم ليست مجرد قضية محلية، بل هي مرآة تعكس تحديات الشرق الأوسط بأسره، وفرصة للعالم لإعادة التفكير في كيفية منع الكوارث المستقبلية ومعالجتها بطرق تضع الإنسانية في صميم الأولويات.،
فالمتفرج والمتورّط والشامت سيكون له من السُنن الحاكمة نصيب، ” فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ “؟!.
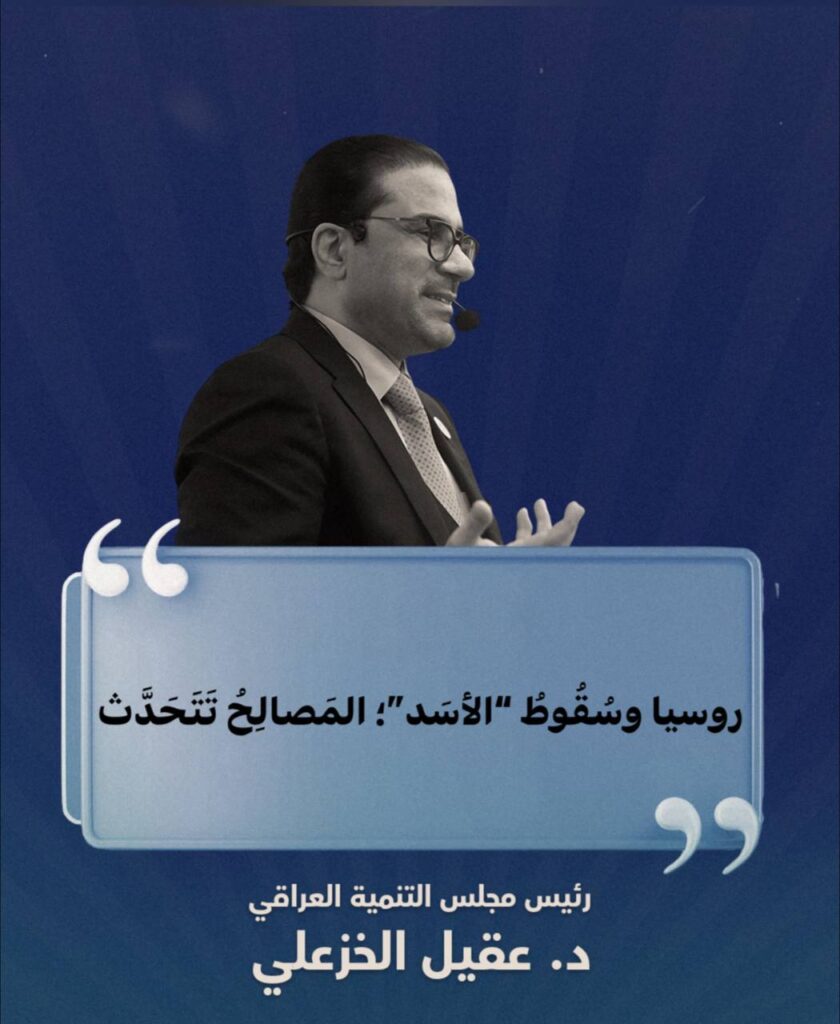
روسيا وسُقُوطُ “الأسَد”؛ المَصالِحُ تَتَحَدَّث
-قراءةٌ تحليليّة-
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄🔄
” في تحول دراماتيكي وغير متوقع، شهدت سوريا سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بعد أكثر من عقد من الصراع المرير، وبينما كانت روسيا الحليف الأقوى للنظام منذ بداية الأزمة، إلا أن تخليها عنه في اللحظات الحرجة يُثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.
في عالم السياسة الدولية، لا وجود للعواطف، والمصالح دائماً ما تكون المتحدث الأول والأخير.
🔄 على مدار السنوات الماضية، كانت روسيا تُقدّم الدعم للنظام السوري كجزء من استراتيجيتها لإعادة تأكيد مكانتها كقوة عظمى على الساحة الدولية. تدخلها العسكري عام 2015 كان نقطة تحول رئيسية، حيث أنقذت نظام الأسد من الانهيار وأمنت سيطرته على مساحات واسعة من البلاد. ومع ذلك، فإن الوضع تغير بشكل كبير مؤخراً.
🔄 الحرب في أوكرانيا وضعت روسيا في مواجهة استنزاف اقتصادي وعسكري غير مسبوق، مما جعل دعمها للنظام السوري عبئاً ثقيلاً لا تستطيع تحمله. العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا عمّقت من أزماتها الداخلية، وأجبرتها على إعادة ترتيب أولوياتها. إنفاق المزيد من الموارد على النظام السوري أصبح خياراً غير منطقي بالنسبة لقيادة الكرملين، خاصة مع تضاؤل المكاسب الاستراتيجية التي يمكن أن تحققها من هذا الدعم.
🔄 في الادراك الروسي، لم يعد بشار الأسد حليفاً مثالياً بالنسبة لروسيا، بل أصبح بمرور الوقت عبئاً سياسياً واقتصادياً. النظام السوري فشل في تحقيق الاستقرار داخل البلاد، وأظهر عجزاً في معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي أثارت السخط الشعبي حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها.
🔄 روسيا، التي تدخلت في سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار بطلب من الحكومة، وجدت نفسها عالقة مع نظام غير قادر على تقديم أي تطورات ملموسة. بالنسبة لموسكو، أصبح الحفاظ على قواعدها العسكرية في طرطوس وحميميم أكثر أهمية من الدفاع عن شخص الأسد نفسه، خاصة إذا كانت هناك فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية تُبقي على هذه المصالح دون الحاجة لتحمل عبء دعمه.
🔄إلى جانب الضغوط الداخلية، تواجه روسيا واقعاً جديداً في العلاقات الإقليمية والدولية. التقارب بين موسكو ودول مثل تركيا وإسرائيل، بالإضافة إلى حوارها مع دول الخليج، ومجيء الادارة الامريكية الترامبية فرض عليها تبني نهج أكثر مرونة في سوريا، ولعله سيكون مقدمة لترتيبات وصفقات تتعلق باوكرانيا.
🔄في الوقت الذي كانت فيه روسيا تسعى للحفاظ على دورها كوسيط رئيسي في الشرق الأوسط، أصبحت ترى أن الأسد ليس ورقة رابحة يمكن المساومة بها. بدلاً من ذلك، يمكن أن يؤدي دعم بديل سياسي إلى تحقيق مصالحها مع تعزيز مكانتها كطرف يمكن الوثوق به في التفاهمات الدولية.
🔄 تغير الموازين العسكرية والدبلوماسية في سوريا كان أيضاً عاملاً مهماً في قرار روسيا. مع انشغالها بحربها في أوكرانيا، تراجعت قدرات موسكو على تقديم الدعم العسكري المباشر للنظام السوري، خاصة في المعارك الأخيرة التي شهدت غياباً ملحوظاً للطيران الروسي.
🔄 تدرك روسيا أن الصراع في سوريا لن يُحسم عسكرياً، وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد القابل للتحقيق. هذا الإدراك جعلها أكثر استعداداً للتخلي عن الأسد، إذا كان ذلك يساعدها على تقليل الخسائر وضمان دورها في أي تسوية سياسية مستقبلية.
🔄 العزلة الدولية التي عانى منها نظام الأسد على مدى سنوات لعبت دوراً إضافياً في تسريع تخلي روسيا عنه. استمرار العقوبات الدولية، إلى جانب فشل الأسد في تحسين العلاقات مع العالم العربي والغربي، جعل من الصعب على موسكو الدفاع عنه أمام المجتمع الدولي.
🔄 روسيا، التي تسعى للحفاظ على صورتها كقوة مؤثرة ومسؤولة، قد تكون وجدت في التخلي عن الأسد خطوة ضرورية لإعادة بناء صورتها الدبلوماسية واستعادة جزء من الشرعية التي فقدتها بسبب تدخلاتها الأخرى، خاصة في أوكرانيا، واقحام هذا الموضوع ضمن حملة الصفقات الجديدة على المستوى الاقليمي والدولي.
🔄 في نهاية المطاف، سقوط نظام الأسد يُظهر أن التحالفات في السياسة الدولية ليست دائمة، وأن المصالح هي المعيار الوحيد الذي يُحدد بقاء أو انهيار هذه التحالفات. بالنسبة لروسيا، كانت مصلحتها تقتضي دعم الأسد في الماضي، لكنها اليوم ترى أن استمراره لم يعد يخدم استراتيجياتها.
🔄 تخلي موسكو عن الأسد كرئيس ليس مجرد خطوة سياسية عابرة، بل هو جزء من إعادة ترتيب شاملة لأولوياتها في المنطقة وفي العالم. ومن الواضح أن روسيا اختارت أن تضع مصالحها فوق أي اعتبارات شخصية أو تاريخية، لتؤكد مرة أخرى أن السياسة الدولية لا تعرف سوى لغة “المصالح” و”القوّة” في سياق مبدأ ” لا ثابِتَ في السياسة إلا المُتَغيّر”، فَهَلْ يَعي المؤدلَجونَ الجَزميون ذلك؟!.
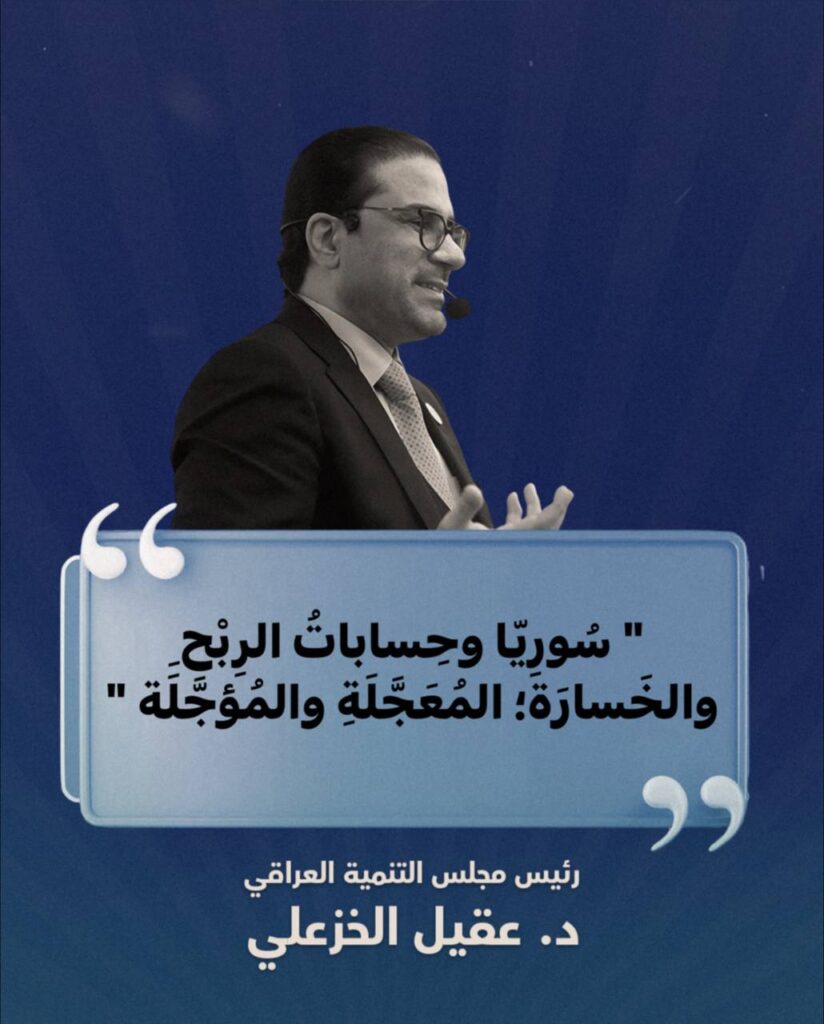
” سُورِيّا وحِساباتُ الرِبْحِ والخَسارَة؛ المُعَجَّلَةِ والمُؤجَّلَة “
إعداد: د.عقيل الخزعلي
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
على الرغمِ من ان خيوط مُتلازمة سقوط نظام الاسد في سوريا لم يترشّح منها الا النُزر اليسير ، الا ان سقوط نظام السوري فَتَحَ أبواب المنطقة على مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية والأمنية، التي لا تقتصر تداعياتها على الداخل السوري فحسب، بل تمتد لتشمل الجوار الإقليمي والدولي، إذ يشكل الحدث لحظة مفصلية في تاريخ سوريا والمنطقة، حيث تتشابك مصالح الأطراف المختلفة، وتتعقد حسابات الربح والخسارة سواء في المدى القريب أو البعيد، فالتطورات الجارية تكشف عن إعادة ترتيب شامل لموازين القوى، حيث تتصارع الأطراف المعنية على تثبيت مكاسبها أو تقليل خسائرها وسط مشهد ضبابي ومفتوح على جميع الاحتمالات.
في سوريا، تأتي حسابات الربح والخسارة متشابكة ومركّبة فعلى المدى القريب، تواجه البلاد تحديات عميقة تشمل الفوضى الأمنية والاقتصادية والسياسية، وسط غياب مؤسسات قوية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية، والمعارضة المسلحة التي تسلمت الحكم تجد نفسها أمام اختبار صعب، حيث يُتوقع منها – جُزافاً – أن توحد صفوفها وتقدم رؤية متماسكة للمستقبل، في حين أن الانقسامات الداخلية والخلافات الأيديولوجية قد تؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار. مع ذلك، فإن فرصة إعادة بناء سوريا على أسس جديدة ديمقراطية وشاملة تبقى مكسباً بعيد المدى، إذا ما تم التوصل إلى توافق داخلي ودعم دولي صادق.
🇱🇧 في لبنان، فإن سقوط الأسد يمثل ضربة مباشرة لحُلفائِه، الذين اعتمدوا لعقود على سوريا كقاعدة لوجستية وممر استراتيجي للدعم العسكري والسياسي، مما يضعهم في مواجهة تحديات داخلية متزايدة في لبنان، حيث تصاعدت بالفعل الانتقادات في الصراع السوري، في المقابل، قد يرى بعض الأطراف اللبنانية في سقوط الأسد فرصة لتخفيف النفوذ الإقليمي وإعادة التوازن السياسي الداخلي، إلا أن هذا يعتمد على كيفية إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا ومدى انعكاسها على الساحة اللبنانية.
🇮🇶 في العراق، تأتي التطورات السورية كمصدر قلق مبرر وفرصة محتملة في الوقت ذاته، فأمن الحدود المشتركة يمثل تحدياً مباشراً، خاصة مع احتمالية تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية مثل داعش في ظل الفوضى. في الوقت نفسه، فإن قيادة عراقية حكيمة قد تستغل التغيرات لتعزيز التعاون الاقليمي والدولي لضمان المصالح الوطنية والامن القومي، ولكن يبقى التحدي الأكبر للعراق هو كيفية إدارة علاقته مع القوى الإقليمية والدولية المتنافسة على النفوذ في سوريا، مع ضمان ألا تتحول البلاد إلى ساحة صراع جانبية.
🇯🇴 في الأردن، يأتي سقوط الأسد ليزيد من تعقيد المشهد الأمني والاقتصادي. من ناحية، قد يخف الضغط الأمني على الحدود الشمالية إذا ما تمكنت الحكومة السورية الجديدة من فرض سيطرتها، ومن ناحية أخرى، فإن الأردن يخشى من تصاعد الفوضى التي قد تؤدي إلى موجات جديدة من اللاجئين، وهو ما يضعف اقتصاده الهش أصلاً، ومع ذلك، يمكن لعمان أن تلعب دوراً إيجابياً كوسيط إقليمي في دعم الاستقرار في سوريا، مستفيدة من علاقاتها مع الأطراف الدولية والإقليمية.
🇵🇸 في فلسطين، يظل المشهد السوري ذا تأثير غير مباشر، لكنه ليس غائباً عن الحسابات. الفصائل الفلسطينية التي كانت تستخدم سوريا كقاعدة دعم واسناد، قد تجد نفسها في وضع ضعيف، بينما قد تستفيد السلطة الفلسطينية لدفع أجندتها السياسية على الساحة الإقليمية والدولية.
🇮🇷 إيران، التي كانت الحليف الأقوى لنظام الأسد، تواجه خسارة استراتيجية كبيرة بسقوطه، حيث كانت دمشق تمثل جزءاً من “المجال الحيّوي” الذي يعزز نفوذ طهران في المنطقة، وخسارة هذا الرابط الحيوي تعني تقليص قدرتها على دعم حلفائها في الشام . مع ذلك، قد تسعى إيران إلى إعادة ترتيب أوراقها في سوريا من خلال دعم بعض الفصائل المحلية أو إقامة شراكات مع الحكومة الجديدة، إذا سمحت الظروف بذلك، وكان ذلك لا يشكل تهديداً على مصالحها الاستراتيجية كما فعلت مع طالبان افغانستان.
🇹🇷 تركيا، التي لعبت دوراً محورياً في دعم المعارضة المسلحة والاسهام في مجريات الاحداث الحالية ضمن صفقات لا تخلو من ذكاءٍ ودهاء، تبدو في وضع مريح نسبياً بعد سقوط الأسد، فقد ترى أنقرة في التغيرات فرصة لتوسيع نفوذها في شمال سوريا وضمان عدم تصاعد قوة الأكراد هناك. مع ذلك، فإن التحديات لا تزال قائمة، خاصة إذا تصاعدت الخلافات مع القوى الدولية حول مستقبل سوريا، أو إذا وجدت نفسها مضطرة للتعامل مع موجات نزوح جديدة.
🌊 دول الخليج، التي دعمت المعارضة السورية، ترى في سقوط الأسد فرصة لتعزيز نفوذها في سوريا وإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة.
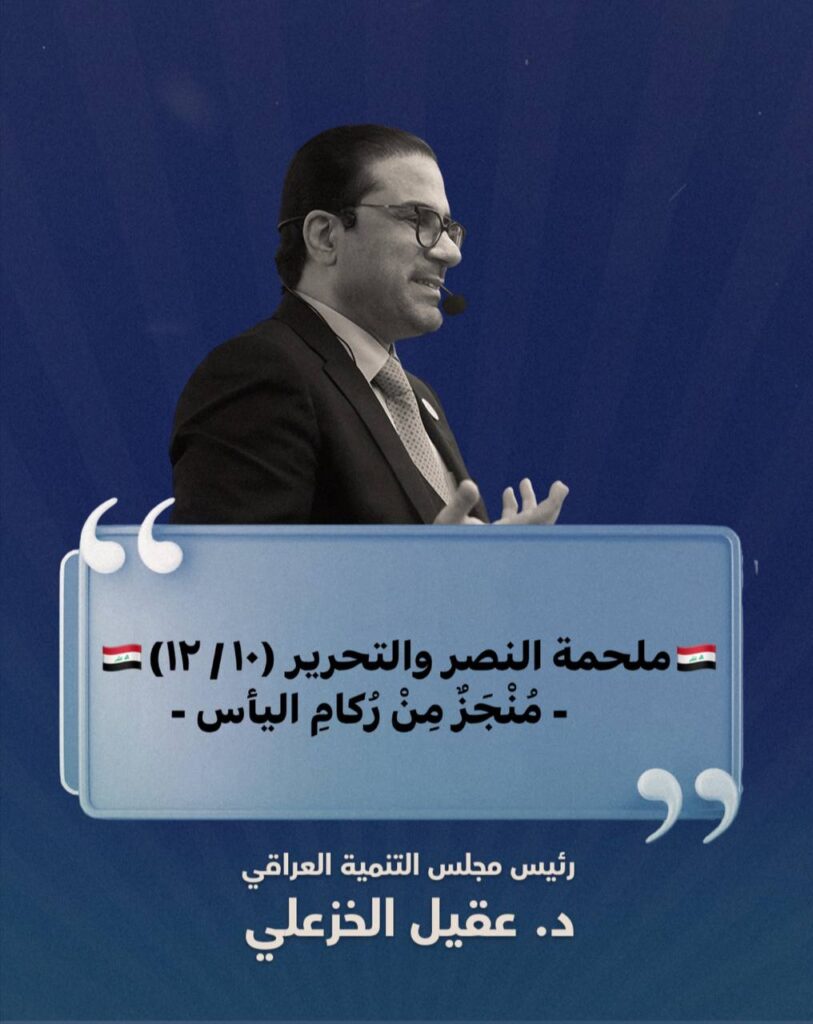
🇮🇶(١٠ / ١٢) ملحمة النصر والتحرير🇮🇶
– مُنْجَزٌ مِنْ رُكامِ اليأس –
✍🏼د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنمية العراقي
✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼
🎖️يوم العاشر من ديسمبر 2017 ليس مجرد تاريخ عابر في ذاكرة العراق، بل هو محطة فارقة في مسيرة هذا الشعب العظيم، وملحمة كتبتها سواعد العراقيين بدمائهم وتضحياتهم، لتصبح شاهداً على قدرتهم الاستثنائية على دحر الإرهاب واستعادة الكرامة، إنه اليوم الذي أعلن فيه العراق انتصاره الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، وتحريره للأراضي التي دنّستها هذه العصابة الظلامية.
🎖️لقد كان الانتصار العراقي أكثر من مجرد حدث عسكري أو سياسي، بل كان شهادة حية على قوة الوحدة الوطنية حينما تتجاوز الفوارق الطائفية والعرقية، وحينما يجتمع الشعب بمختلف أطيافه وألوانه خلف هدفٍ سامٍ هو الحفاظ على الوطن.
🎖️لقد كان هذا النصر تتويجاً لجهود متضافرة شارك فيها الجميع: الجيش، الشرطة، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، البيشمركة، والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، في صورة منسجمة أظهرت للعالم المعنى الحقيقي للتكاتف الوطني.
🎖️وفي قلب هذه الملحمة، كان للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني الدور المحوري الذي لا يُمكن تجاهله، فقد جاءت فتواه التاريخية بالدفاع الكفائي كنداء أبوي حكيم، استنهضت بها العزائم وأعادت إحياء روح المقاومة في نفوس العراقيين، فهذه الفتوى لم تكن مجرد دعوة للسلاح، بل كانت دعوة للكرامة والوحدة وحماية الأرض والعرض من عدو لا يعرف حدوداً للظلم والوحشية.
🎖️إن النصر الذي تحقق لم يكن ليتحقق دون تلك العوائل العراقية الأصيلة التي قدمت أبناءها شهداء وجرحى، ودون تلك الأمهات والآباء الذين زرعوا في قلوب أبنائهم حب الوطن وقيم التضحية. هؤلاء الشهداء والجرحى هم العمود الفقري لهذا النصر، وهم النبراس الذي يجب أن يضيء لنا طريق المستقبل.
🎖️اليوم، ونحن نقف على أعتاب هذه الذكرى العظيمة، وفي أجواءٍ إقليميةٍ ودوليّةٍ مُضطَرِبَة ومُقلِقة، نجد أنفسنا أمام دروس بالغة الأهمية يجب أن نستلهمها ونبني عليها. فقد أكدت هذه التجربة أن الوحدة الوطنية ليست مجرد شعار، بل هي السلاح الأهم في مواجهة أي خطر يهدد الوطن. كما أظهرت أهمية التكاتف بين الشعب وقواته الأمنية، حيث أثبت العراقيون أن الجيش والشعب حينما يكونان يداً واحدة فإنهما لا يُهزمان، فضلاً عن أيادي الدعم والإسناد من الأشقاء والاصدقاء، الذين أعطوا بُعداً انسانياً مُشرِقاً ووضّاءً.
🎖️هذا النصر يحمل في طياته رسالة أعمق تتجاوز حدود العراق، فهو دليل على أن الإرادة البشرية قادرة على الانتصار حتى في أحلك الظروف. لقد أظهر العراقيون للعالم أن الإرهاب ليس قدراً محتوماً، وأن الشعوب قادرة على النهوض مهما كانت التحديات.
🎖️وعلى الرغم من أن النصر تحقق على أرض المعركة، إلا أن المهمة لم تنتهِ بعد، بل إن ما تحقق يجب أن يكون بداية لبناء مستقبل جديد.
علينا أن نعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة، وأن نهتم بذوي الشهداء والجرحى، فهم الأحق بالرعاية والتقدير والتخليد.
كما يجب أن نحول هذه التجربة إلى نموذج يُحتذى به في محاربة الإرهاب، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على المستوى الدولي، حيث يمكن للعراق أن يقدم خبراته للعالم في مواجهة التطرف ومكافحة نزعة التدمير والقتل، وإرادة النهوض والبناء.
🎖️إن ذكرى النصر العراقي ليست مجرد يوم للاحتفال، بل هي فرصة للتأمل في الماضي واستخلاص العبر، وفرصة للتطلع نحو المستقبل ببصيرة مستنيرة. إنها تذكير بأن العراق، رغم كل جراحه، يبقى قوياً بأبنائه، وأنه قادر دائماً على النهوض وتحقيق المستحيل.
🎖️وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نرفع أيدينا بالدعاء لأرواح الشهداء الأبرار وجرحانا البواسل وقواتنا الامنية الظافرة الذين كانَ لنا الشرف في المشاركة معهم وهم يصنعون هذه المُعجِزَة الوطنيّةَ الفريدة، ونأمل أن يبقى هذا النصر منارة تضيء درب العراق والعالَم نحو مستقبل أفضل، مستقبل يسوده العدل والسلام والازدهار والتسامح.”
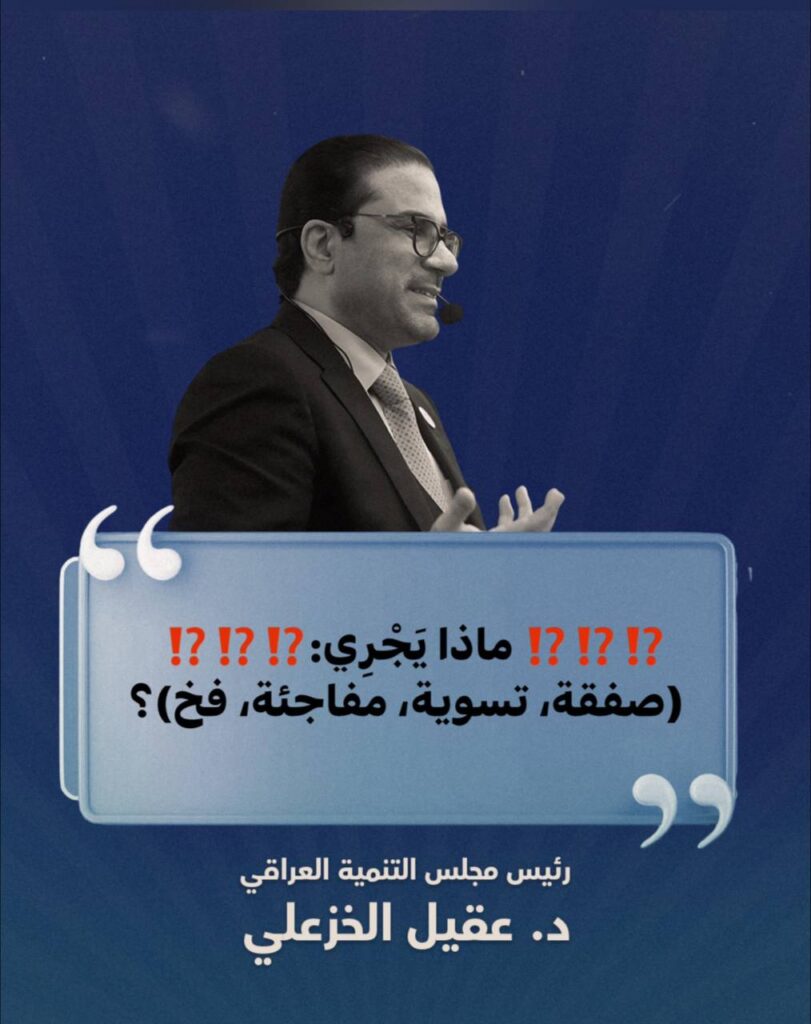
⁉️⁉️⁉️ ماذا يَجْرِي:⁉️⁉️⁉️
(صفقة، تسوية، مفاجئة، فخ)؟
-قراءة تحليلية-
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
=======================
قَبَلَ أكثر من أربعة أشهر، وبالتحديد في يوم الجمعة الموافق ( ٢ / ٨ / ٢٠٢٤ ) وكَجُزءٍ من طقسي التواصلي مع المعارف والاصدقاء، والذي اسبك فيه مقطعاً يتناسب مع حدث او فكرة او لواعج، ووقتئذٍ كان الصراع محتدماً نتيجة الانتهاكات الاسرائيلية على غَزّة والمنطقة، فبدأتُ بتحليل وتقييم الاوضاع، سابِراً خلفياتها ومُستَشرِفاً تداعياتها، فنشرتُ حينها الآتي:
” *في معادلة الصراع (المادي)* :
📌مع الأسف، يفوزُ الأكثرُ (دَهاءً) لا الأكثر (نُبلاً) !.
📌القوّة (الذكيّة) هي من تحسم النتيجة، ولكن؛(الصدفة والغباء والحظ والغفلة) قد يُغيّروا من موازين القوى !.
📌يَكسِبُ الطرفُ: الأحنكُ (قيادةً) والأنفذُ (بصيرةً) والأدقُّ (تخطيطاً) والأفضلُ (تنظيماً) والأقدرُ (حيلةً) والأرسخُ (عقيدةً) والأمضى (عُدّةً) والأجدرُ (عَديداً) والأكثرُ (توحُّداً) والأيقنُ (استخباراً) والأوسعُ (ارادةً) والأشدُّ (عزيمةً) والأقوى (حَزماً) والأزيدُ (تحمّلاً) والأدومُ (صبراً) والأطول (صموداً) والأكرمُ (بذلاً) والأشنعُ (ارعاباً)…!.
📌لا خير فيمن يربح المعركة (النصر المُعَجّل) ويخسر الحرب (النصر المؤجّل)! .
📌الخسارةُ النهائيةُ قرينةُ كلِّ زيغٍ وطيشٍ ورعونةٍ وسفاهةٍ وشطط !.
📌يفوزُ من يكتشفُ الكمائنَ قبل ان تُهلِكََهُ فنون الاستدراج !.
📌يربحُ من يستثمر الغليان لإدامة الزخم وتسديد الرمية !.
📌أفلحَ من أدركَ أن؛ للإقدامِ أركانُهُ وللاقتحامِ شروطُهُ وللإحجامِ مُسوِّغاتُهُ !.
📌التوقيتُ بيد القادة إما أن يكون عامِلَ حسمٍ في الظفر أو سبيلَ مَهلكةٍ في الخُسران!.
📌لا خيرَ في نصرٍ ثمنُهُ رِبحُ (القِلّة) وخسارةُ (المجموع)، أو ربح (الحاضر) التكتيكي وخسارةُ (المستقبل) الاستراتيجي ، أو إثباتُ (الذاتِ) بتكديسِ (إعاقاتٍ) -بنيوية وتنموية- شاملةٍ دائمةٍ !.
📌العقلُ (قائدٌ) والقلبُ (رافدٌ) والقوّةُ (وسيلةٌ) والمصالحُ (غايةٌ)، فلا خيرَ بقائِدٍ مَقُودٍ، ولا خير بالوسائل اذا اضرّت بالمصالح”.انتهى
🪒 وها هي الحرب تضعُ حَفنةً من اوزارِها، فمع سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة هيئة تحرير الشام على دمشق، دخلت سوريا منعطفاً تاريخياً جديداً يحمل في طياته أبعاداً معقدة تتجاوز حدود الصراع الداخلي لتشمل ترتيبات إقليمية ودولية متشابكة، فما جرى ويجري في سوريا اليوم هو نتاج صفقات سرية، تسويات براغماتية، مفاجآت غير متوقعة، وأفخاخ استراتيجية نُصبت بعناية للأطراف المتصارعة، ما تم الكَشفُ عنه أضألُ مما هو متكتم عليه . 🪒لقد باتت الساحة السورية مرآة لتجاذبات القوى الكبرى وتنافساتها، حيث أصبحت دمشق محوراً لصراعات عابرة للحدود وميداناً لحسابات دقيقة أُعدّت لتغيير موازين القوى في المنطقة.
🪒خلال الأعوام الماضية، ظلت سوريا مركزاً لتنافس القوى الكبرى والإقليمية. روسيا وإيران كانتا أبرز الداعمين للنظام السوري، حيث اعتمدت موسكو على سوريا كقاعدة لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، بينما استخدمت إيران الأراضي السورية لمد نفوذها نحو لبنان عبر حزب الله. لكن مع تعقيد المشهد الدولي، وجدت روسيا نفسها غارقة في مستنقع أوكرانيا، وهو ما دفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها في سوريا. في المقابل، إيران، التي كانت تعد دمشق ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية، بدت أكثر براغماتية في التعاطي مع المتغيرات الأخيرة، مركزة على حماية نفوذها الاستراتيجي.
🪒تركيا بدورها لعبت دوراً معقداً في الصراع السوري، حيث وجدت في سقوط الأسد فرصة لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية. كانت أنقرة تسعى جاهدة للقضاء على التهديد الكردي في شمال سوريا من خلال دعم المعارضة المسلحة. لكن سقوط النظام السوري وضع تركيا في موقف صعب، إذ باتت أمام مشهد جديد يتطلب التعامل مع هيئة تحرير الشام التي تُعد فاعلاً جديداً في المعادلة السورية. المفارقة أن هذا الدور التركي تداخل مع سياسات دولية أخرى، حيث يبدو أن أنقرة أُجبرت على الموازنة بين مصالحها الوطنية وضغوط حلفائها في الناتو.
🪒على الجانب الآخر، الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لم تخفيا أهدافهما في إضعاف النفوذ الإيراني في سوريا وضمان تفكيك الدولة إلى كيانات ضعيفة. واشنطن، رغم غموض سياستها أحياناً، لعبت دوراً غير مباشر في دعم الجماعات المسلحة بما يخدم استراتيجياتها طويلة المدى. إسرائيل، بدورها، ركزت على ضرب البنية التحتية للقوات الإيرانية وحزب الله، لكنها وجدت في صعود الجماعات المسلحة فرصة لتحقيق أهدافها عبر تمزيق سوريا من الداخل وتحويلها إلى ساحة صراع دائم.
🪒لكن أكثر ما أثار الدهشة كان التحوّل المفاجئ في خطاب هيئة تحرير الشام. الهيئة، التي كانت تُعتبر جماعة متطرفة، استطاعت تقديم نفسها بوجه أكثر اعتدالاً، مما أكسبها دعماً
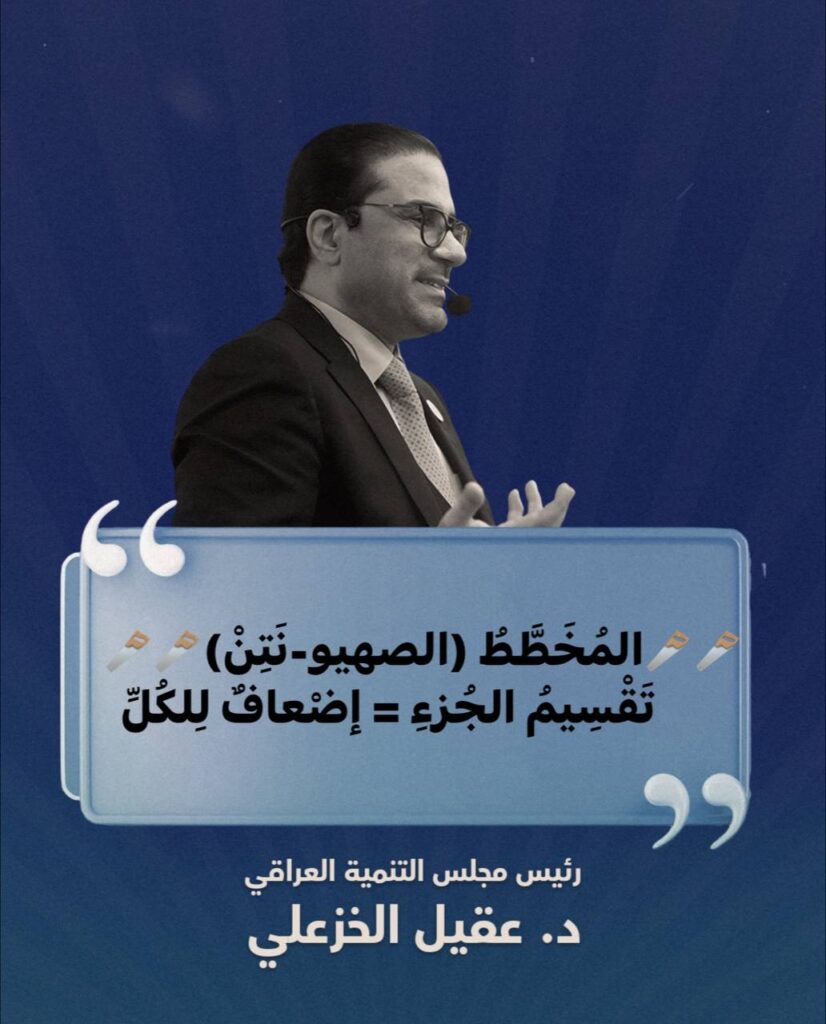
🪚🪚المُخَطَّطُ (الصهيو-نَتِنْ)🪚🪚
تَقْسِيمُ الجُزءِ = إضْعافٌ لِلكُلِّ
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
><><><><><><><><><><><><
{ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ } آل عمران118
” في خضم التعقيدات السياسية والجيوستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتحديدًا في ظل المستجدات المتسارعة في الملفات السورية واللبنانية والفلسطينية، وبالاخص بعد سقوط النظام السوري، يبدو أن الأحداث حُبلى بعد. سقوط كُرة الثلج التي سوف لن تتوقف عند الاعتاب السورية بل سيتسع مداها التدميري للمنطقة بأجمع وفقاً لنظرية “الدومينو” سيئة الصيت.
➗ لقد أصبحت سيناريوهات التفتيت وإعادة رسم الحدود الجغرافية والسياسية لدول المنطقة من أبرز الأدوات المستخدمة لتحقيق أجندات دولية وإقليمية تهدف إلى إضعاف هذه الدول وتشتيت قواها.
🔪 التقسيم، الذي إنْبَعَثَ مُجدداً لِيُطرح بصيغ مختلفة كالأقلمة الطائفية أو الكونفدرالية أو حتى التجزئة الكاملة، ليس سوى مشروع خطير يُراد منه تفكيك دول المنطقة إلى كيانات صغيرة وضعيفة، مما يضمن السيطرة عليها وتحجيم دورها على الساحة الدولية. هذا المسار، إذا ما تم المضي فيه، لن يضر فقط بدولة بعينها، بل سيمثل تهديدًا وجوديًا للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ككل، والعالم أجمع.
🌋 لقد حَفِلَتِ الأدبياتُ الصهيونية والهندساتُ الاستراتيجيةُ الغربيةُ بالكثير من مخططات واطروحات التقسيم والتفكيك لجُغرافيات وشعوب الدول المنافسة والخصمة والعدوّة، كمرتكز أصيل في عمليات تجريف القدرات وتفتيت عوامل القوّة وإنهاك الطاقات كمقدمة لاحداث مشاريع مستدامة للإختلال والإحتلال والهيمنة والنفوذ والسيطرة على (الأقدار والثروات) واعادة تشكيل الدول والجماعات والمستقبل، ولعل ابرز ما طُرِحَ ونُفّذَ هو “اتفاقية سايكس-بيكو”، ومايجري تنفيذه حالياً “خارطة حدود الدم ” و “الشرق الاوسط الجديد” وغيرها، من الهندسات (الصلبة) والهندسات (الناعمة)، ومن خلال ادوات مَحَليّة وخارجيّة؛ ظاهرةً ومستترةً.
📚 يعلمنا التاريخ أن تقسيم الدول على أسس طائفيةٍ أو عرقيةٍ أو فئويةٍ ليس حلاً للأزمات السياسية أو الاجتماعية، بل هو وصفة مؤكدة للمزيد من الصراعات والحروب، فتجربة التقسيم التي شهدتها فلسطين عام 1948، وما تبعها من نكبات ومعاناة مستمرة، تؤكد أن التمزق لا يولد سوى المزيد من الفوضى، وكما حدث في السودان والصومال وغيرها من الدول، والسيناريو ذاته يُعاد طرحه بأشكال مختلفة في العراق وسوريا ولبنان (حالياً) ولجميع المنطقة (مستقبلياً)، حيث يُروَّج لخيار الأقاليم الطائفية أو الكونفدرالية باعتبارها حلولًا سحرية للأزمات الراهنة، لكن الحقيقة أن هذه الخيارات، بعيدًا عن أي دعوات للتنظيم أو الإدارة المحلية، تحمل في طياتها مخاطر هائلة ستقود إلى تفكيك الدولة الوطنية وفقدان سيادتها.
🧨 الأقلمة الطائفية، التي تبرز كأحد الخيارات المطروحة من قبل دوائِر التآمر الانتهازي أو أقطاب الغباء الاستراتيجي في دول مثل العراق وسوريا ولبنان، تُصور على أنها وسيلة لتقليل النزاعات من خلال منح الطوائف المختلفة حكمًا ذاتيًا ضمن إطار فيدرالي، لكن هذا النموذج، في واقع الأمر، يعزز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، ويُحوّل الدولة إلى كيانٍ هش مقسم إلى دويلات صغيرة متنافسة، حيث يسعى البعض إلى تحويل البلاد إلى أقاليم قائمة على الانتماء الطائفي أو العنصري البَحت، مما يؤدي إلى تآكل الوحدة الوطنية، ويُمَهّد لأزماتٍ أكبر، وهو عَينُ المُبتَغَيات الصهيونية التي طالما رددوها وما زالوا.
🍕 أما خيار الكونفدرالية، الذي يُطرح كحل وسط بين الوحدة والتقسيم، فهو لا يقل خطورة، فالكونفدرالية تُضعف الحكومة المركزية إلى حد كبير، حيث تمنح الأقاليم شبه استقلال كامل في إدارة شؤونها، مع الاحتفاظ بحد أدنى من التنسيق في القضايا السيادية، وفي الشرق الأوسط، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية بشكل كبير، مثل هذا الخيار سيجعل الدول أكثر عرضة للتدخلات الخارجية، حيث ستسعى كل قوة إقليمية أو دولية إلى بسط نفوذها على أحد الأقاليم، مما يخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار والصراع.
🪓 التقسيم الكامل، الذي يُطرح أحيانًا كحل نهائي للأزمات، هو الأخطر على الإطلاق، حيث سيؤدي تفكيك الدول إلى كيانات صغيرة إلى صراعات حدودية طويلة الأمد، إذ ستتنازع الدويلات الجديدة على الموارد الطبيعية والأراضي. في سوريا، على سبيل المثال، قد يتحول التقسيم إلى صراع دائم بين الكيانات الجديدة على حقول النفط أو الموانئ أو الأراضي الزراعية. في العراق، ستكون المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسهل نينوى بؤرًا للنزاع المستمر. هذا التقسيم لن يُضعف فقط الدول المعنية، بل سيمتد تأثيره إلى دول الجوار،…
…الجواب يكمن في أن هذه السيناريوهات تخدم مصالح القوى الكبرى التي تسعى إلى ضمان سيطرتها على المنطقة. تقسيم الدول يُضعف قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة، ويجعلها أكثر اعتمادًا على الدعم الخارجي. كما أن الدول الصغيرة والهشة تُسهل من عمليات استغلال الموارد وفرض الإملاءات السياسية، اما القوى الإقليمية الطامحة للنفوذ تجد أيضًا في هذه السيناريوهات فرصة لتعزيز هيمنتها على أجزاء من الدول المجاورة، مما يزيد من حالة الفوضى والتنافس الإقليمي.
🚨 في مواجهة هذه المخاطر، يصبح من الضروري البحث عن نُهُجٍ أكثر استدامة تحقق الاستقرار والتنمية دون التضحية بوحدة الدول وسيادتها.
🎯 النَهْجُ الأولُ والأهم هو تعزيز مفهوم الدولة الوطنية الجامعة، التي تقوم على أساس المواطنة المتساوية بين جميع أطيافِها، وهذه الرؤية تتطلب إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة تهدف إلى القضاء على التهميش والإقصاء، وتعزيز المشاركة السياسية لكل المجموعات دون تمييز، ففي العراق وسوريا ولبنان، يمكن أن تُشكّل الهوية الوطنية الجامعة درعًا ضد محاولات التقسيم إذا تم تعزيزها عبر التعليم والإعلام والمبادرات الوطنية.
🎯 النَهْجُ الثاني هو التركيز على التنمية الاقتصادية المتوازنة، التي تُقلل من مشاعر التهميش وتُعزز من الوحدة الوطنية، فدول الشرق الأوسط تمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة، لكن سوء الإدارة والفساد والتدخلات الخارجية أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة. الاستثمار في التنمية المتوازنة يمكن أن يُعيد توزيع الثروات بشكل عادل، مما يُقلل من النَزَعاتِ الانفصالية.
🎯 النَهَجُ الثالث هو تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الشرق الأوسط، بدلًا من السعي إلى تقسيمها، فالتكامل الاقتصادي والسياسي بين دول المنطقة يمكن أن يُحقق فوائد مشتركة لجميع الأطراف، ويُقلل من التوترات والصراعات، وهذا التكامل يمكن أن يبدأ بمشاريع تنموية مشتركة في مجالات مثل الطاقة والنقل والتجارة، ليُؤسس لاحقًا لمنظومة إقليمية تُحقق الأمن والاستقرار.
🚧 في النهاية، تقسيم الشرق الأوسط ليس حَلّاً، بل كارثة تُهدد بإضعاف الجميع. الحفاظ على وحدة الدول وتعزيز التعاون الإقليمي هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية، والشرق الأوسط يمتلك كل المقومات ليكون منطقة قوية ومزدهرة، لكن ذلك يتطلب رؤية وطنية وإقليمية مشتركة تُدرك أن قوة الكل تكمن في وحدته، وأن تقسيمه لن يخدم سوى أعدائه. تقسيمُ البَعضِ هو إضعافٌ للكل، وتَقسيمٌ مؤجَّلٌ للكُل، والوحدة هي الطريق إلى المستقبل الأفضل، فَهَلْ تَعي شعوبُنا ذلك، وَهَل سيتم التعامل بحزمٍ ممن بدأ لإحياء هذه المشاريعِ المُهلِكة.
“مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. هَلْ يَجْتَنُونَ مِنَ الشَّوْكِ عِنَبًا، أَوْ مِنَ الْحَسَكِ تِينًا؟” (مت 7: 16).”.
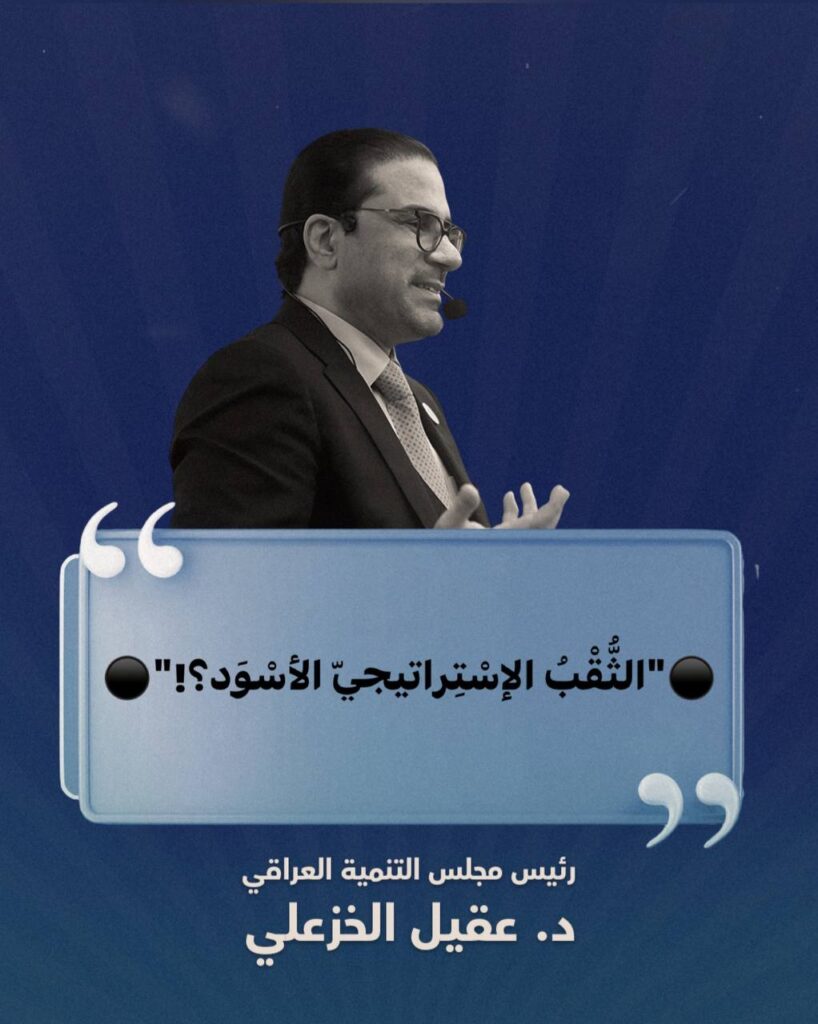
⚫️”الثُّقْبُ الإسْتِراتيجيّ الأسْوَد؟!”⚫️
إعداد:د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
“⚫️ يشهد الشرق الأوسط تحولات كبرى تهدد جغرافيته السياسية وهويته الثقافية، وسط مشهد تداخلت فيه المصالح الدولية والإقليمية بشكل غير مسبوق.
⚫️ هذه التحولات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن إطار استراتيجيات طويلة الأمد، بدأت منذ اتفاقية سايكس-بيكو (1916) التي قسّمت العالم العربي إلى كيانات سياسية صغيرة لتخدم المصالح الغربية، ووصلت إلى ذروتها في ما يُعرف بـ”مشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي اقترحه المستشرق (برنارد لويس)، ويهدف إلى تفتيت الدول العربية إلى كانتونات عرقية وطائفية (Lewis, 1990).
⚫️ أن فكرة “الثقب الأسود الاستراتيجي” تُعبّر عن واقع المنطقة اليوم، حيث تتعرض الدول العربية والاسلامية والكبرى لعملية تفريغ من قوتها واستقلالها لصالح مشاريع دولية تُعيد تشكيل الخرائط بما يخدم مصالح القوى العظمى، وما يُميّز هذا المشروع الجديد أنه لا يقتصر على التقسيم الجغرافي كما حدث في سايكس-بيكو، بل يمتد إلى تحويل الدول إلى ما يُسمّى “دول-شركات” (Corporate States) تُدار بآليات تخدم المصالح الخارجية، مع إضعافها عسكرياً واقتصادياً وعلمياً ، حيث يُشكّل هذا التحوّل جوهر مشروع برنارد لويس الذي يُحذّر من إمكانية قيام دول قوية تُهدد الهيمنة الغربية (Mitchell, 2011).
⚫️ في قلب هذا المخطط يأتي دور موارد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، كأحد المحركات الرئيسية للصراع، فمشروع “نابوكو” الذي كان يُفترض أن ينقل الغاز من آسيا الوسطى إلى أوروبا عبر تركيا، كان يهدف إلى تقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، وهو جزء من استراتيجية غربية لكبح نفوذ موسكو. بالمثل، خط الغاز القطري الذي كان مخططاً له أن يمر عبر سوريا ليصل إلى أوروبا، قوبل برفض سوري قاطع بسبب التزام دمشق بتحالفها مع موسكو، وهذا الرفض كان أحد الأسباب التي دفعت قوى غربية وإقليمية إلى دعم مشاريع تغيير النظام السوري (Mitchell, Carbon Democracy).
⚫️ أما تُركيا التي تُعد نقطة عبور استراتيجية للطاقة بين الشرق والغرب، فقد استفادت من هذه التحولات لتعزيز موقعها الجيوسياسي، ومع ذلك، فإن هذا الطموح التركي لم يكن خالياً من التعقيدات، حيث تضاربت مصالح أنقرة مع روسيا وإيران، فضلاً عن القوى الغربية التي ترى في تركيا شريكاً ضرورياً ولكن غير موثوق به بالكامل ولأسبابٍ عديدة.
⚫️ الثقافة والفكر أيضاً لم يكونا بمنأى عن هذه التحولات، حيثُ يتم الترويج لفكرة “الدولة-الشَّرِكَة” كبديل لفكرة الدولة القومية، حيث تُدار الدول كأنها وحدات اقتصادية صغيرة، تخدم مصالح قوى خارجية دون أي استقلال حقيقي، اذ يأتي هذا الترويج الثقافي ضمن ما يُدعى بـ”الصهيونية العربية”، التي تعمل على تعزيز الهويات الطائفية والعرقية على حساب الهوية الجامعة، وكما أوضح إدوارد سعيد في كتابه “الثقافة والإمبريالية”، فإن الاستعمار الجديد لا يعتمد فقط على الاحتلال المباشر، بل على الهيمنة الثقافية التي تُعيد تشكيل الوعي الشعبي بما يخدم أهداف القوى الكبرى (Said, 1994).
⚫️ الشرق الأوسط اليوم يبدو وكأنه ينجرف نحو “ثقب أسود استراتيجي”، يبتلع كل مقومات القوة والاستقلال، فالدول المهمة في المنطقة، مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر والسعودية وتركيا وايران وباكستان، فضلاً عن الدول ذات الثقل النوعي الاخرى، تُعتبر أهدافاً رئيسية لهذه المشاريع، لأنها تمثل قلب العالم جغرافياً وثقافياً، والهدف من تفتيت هذه الدول هو ضمان عدم وجود أي قوة إقليمية يمكن أن تُهدد الهيمنة الإسرائيلية أو المصالح الغربية، والإسهام أيضاً في خلق فراغ سياسي وأمني يُمكّن القوى الكبرى من فرض رؤيتها دون مقاومة تُذكر.
⚫️ لكن هل هذا المصير حتمي؟ الإجابة تكمن في قدرة هذه الدول على استعادة وعيّها الشامل وبناء استراتيجيات جماعية تتصدى لهذه المشاريع، فمن خلال تعزيز الوحدة الوطنيّة، والاستثمار في الابتكار والبحث العلمي، وبناء اقتصادات قوية ومستقلة، يمكن أن تكون أدوات فاعلة لمواجهة هذا التحدي، كما أن بناء تحالفات جديدة مع دول صاعدة مثل الصين والهند قد يُعطي للمنطقة فرصة لإعادة التوازن في علاقاتها الدولية، عَلاوَةً على العلاقات مع الجانب الغربي المهم.
⚫️ من الواضح ان الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة تتطلب رؤية استراتيجية عميقة وإرادة سياسية قوية، فالنجاح في تجاوز هذا الثقب الأسود لن يكون مجرد انتصار سياسي، بل سيكون خطوة نحو إعادة بناء هوية المنطقة واستعادة مكانتها على الخريطة العالمية، وإلا فلا عَزاءَ للأغبياءِ ومحدودي الأُفق ومُغامِري الأنانيّة.”
(المصادر)
1. Lewis, Bernard. “The Roots of Muslim Rage,” The Atlantic, 1990.
2. Mitchell, Timothy. “Carbon Democracy: Political Power in the Age of Oil,” Verso, 2011.
3. Said, Edward. “Culture and Imperialism,” Vintage, 1994.
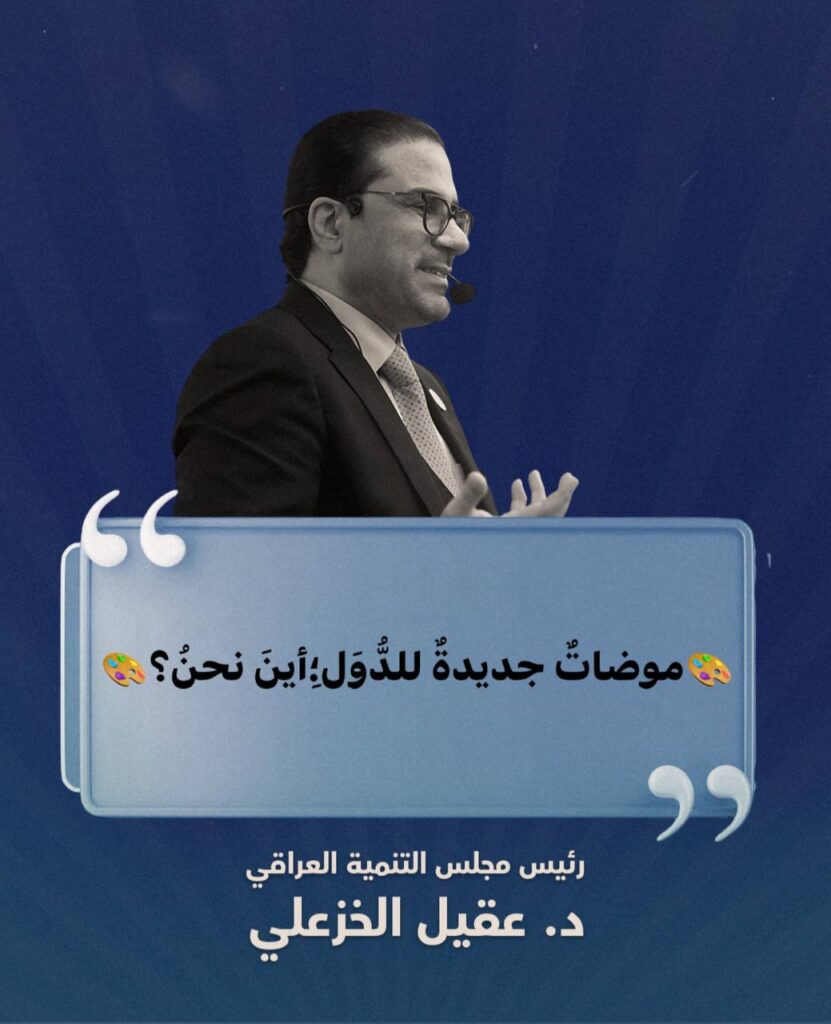
🎨موضاتٌ جديدةٌ للدُّوَلِ؛أينَ نحنُ؟🎨
إعداد:د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🚥🌎 شَهِدَ العالمُ في العقودِ الأخيرةِ تحوُّلاتٍ جذريَّةً في طبيعةِ الدَّولةِ، أدوارِها، وعلاقاتِها مع مواطنيها، وبيئتِها، والاقتصادِ العالميِّ. هذه التَّحوُّلاتُ لم تأتِ من فراغٍ، بل كانت استجابةً لتغيُّراتٍ عميقةٍ في السِّياقاتِ السِّياسيَّةِ، الاقتصاديَّةِ، الاجتماعيَّةِ، والتِّكنولوجيَّةِ. يُمكنُ وصفُ هذه التَّحوُّلاتِ بأنَّها ظُهورُ “موضاتٍ جديدةٍ للدُّوَلِ”، وهي نماذجُ حديثةٌ للدَّولةِ تسعى للتَّكيُّفِ مع واقعٍ معقَّدٍ وديناميكيٍّ في ظلِّ تحدِّياتِ العَوْلَمةِ، التَّحوُّلِ الرَّقْميِّ، والاضطراباتِ السِّياسيَّةِ والاقتصاديَّةِ. هذه الموضاتُ ليست مجردَ تغيُّراتٍ شكليَّةً، بل تعكسُ تحوُّلاً في فلسفةِ الحَوْكَمَةِ وإعادةَ تعريفٍ لدورِ الدَّولةِ في العالمِ المُعاصِرِ.
🌎 خَلْفيَّةُ هذه النَّماذجِ تعودُ إلى سلسلةٍ من التَّطوُّراتِ التي اجتاحت العالمَ في النِّصفِ الثَّاني من القرنِ العشرينِ واستمرَّت إلى اليومِ؛ 🔰أوَّلًا، أفضت العَوْلَمةُ إلى تداخلٍ غيرِ مسبوقٍ بين الاقتصاداتِ الوطنيَّةِ، مما دفع الدُّوَلَ إلى التفكيرِ في كيفيةِ الحفاظِ على سيادتِها مع الانخراطِ في نظامٍ عالميٍّ مترابطٍ. 🔰ثانيًا، أحدثت الثَّورةُ الرَّقميَّةُ تغييرًا عميقًا في كيفيةِ تفاعلِ الدُّوَلِ مع مواطنيها، حيث أصبحتِ التِّكنولوجيا أداةً أساسيَّةً للحُكْمِ والإدارةِ. 🔰ثالثًا، أدَّت الأزماتُ البيئيَّةُ إلى ظهورِ الحاجةِ إلى نماذجَ جديدةٍ تأخذُ في الاعتبارِ الاستدامةَ والحفاظَ على المواردِ للأجيالِ القادمةِ.
🔰وأخيرًا، ساهمت التَّوتُّراتُ السِّياسيَّةُ والصِّراعاتُ الدَّاخليَّةُ في دُوَلٍ عديدةٍ في التفكيرِ في نماذجَ أكثرَ شمولًا واحتواءً للتَّنوُّعِ الثقافيِّ والاجتماعيِّ.
🌎 ظهرت هذه النَّماذجُ الحديثةُ نتيجةَ دوافعَ متعدِّدةٍ. أحد أهمِّ هذه الدوافعِ هو البحثُ عن الكفاءةِ في مواجهةِ التحدياتِ الاقتصاديَّةِ والإداريَّةِ. على سبيلِ المثالِ، تتَّجه (الدُّوَلُ الذَّكيَّةُ) إلى اعتمادِ التِّكنولوجيا لتعزيزِ كفاءةِ الخدماتِ الحكوميَّةِ وخفضِ التَّكاليفِ. من جهةٍ أخرى، تسعى الدُّوَلُ (الاحتوائيَّةُ) إلى تعزيزِ الاستقرارِ السِّياسيِّ والاجتماعيِّ من خلالِ التَّمثيلِ العادلِ والشَّاملِ لجميعِ مكوِّناتِ المجتمعِ، وهو أمرٌ ضروريٌّ بشكلٍ خاصٍّ في الدُّوَلِ التي تعاني من الانقساماتِ العرقيَّةِ والدِّينيَّةِ. إضافةً إلى ذلك، أصبحتِ (الدُّوَلُ الخضراءُ) استجابةً ضروريَّةً للأزماتِ البيئيَّةِ المتفاقمةِ، حيث تسعى إلى التَّوفيقِ بين التَّنميةِ الاقتصاديَّةِ وحمايةِ البيئةِ.
🌎 الفوائدُ التي تُقدِّمُها هذه النَّماذجُ متعدِّدةٌ، حيث إنَّ كلَّ نموذجٍ يحملُ في طيَّاتِهِ إجاباتٍ مبتكَرةً لتحدياتٍ محدَّدةٍ. (الدَّولةُ الذَّكيَّةُ)، على سبيلِ المثالِ، تُعزِّزُ الشَّفافيَّةَ وتُقلِّلُ من الفسادِ من خلالِ رقمنةِ الخدماتِ وتوفيرِ البياناتِ المفتوحةِ. أمَّا( الدَّولةُ الاحتوائيَّةُ) فتُسهمُ في تعزيزِ الوحدةِ الوطنيَّةِ وتقليلِ احتمالاتِ الصِّراعِ من خلالِ إشراكِ الجميعِ في عمليَّةِ صُنْعِ القرارِ. (الدَّولةُ الخضراءُ)، بدورِها، تضمنُ استدامةَ المواردِ الطَّبيعيَّةِ وتَحْفَظُ البيئةَ للأجيالِ القادمةِ. هذه النَّماذجُ تُقدِّمُ أيضًا فرصةً لتحسينِ العلاقاتِ بين الدَّولةِ والمجتمعِ، حيث تضعُ المواطنَ في قلبِ عمليَّةِ الحَوْكَمَةِ.
🌎 ومع ذلك، فإنَّ هذه النَّماذجَ ليست خاليةً من التَّحدياتِ، حيث يبرزُ التَّساؤلُ عن مَن المستفيدُ الحقيقيُّ من تَبَنِّيها. في بعضِ الحالاتِ، يمكنُ أن تتحوَّلَ هذه النَّماذجُ إلى أدواتٍ تُخدِمُ النُّخَبَ السِّياسيَّةَ أو الاقتصاديَّةَ إذا لم تكنْ هناك رقابةٌ ومساءلةٌ قويَّةٌ. الشَّركاتُ متعدِّدةُ الجنسيَّاتِ، على سبيلِ المثالِ، قد تكونُ أحدَ أبرزِ المستفيدينَ من (الدَّولةِ-المِنَصَّةِ) او (الدول-الشركات)، حيث تُوفِّرُ لها هذه النَّماذجُ فرصًا للتَّوسُّعِ والنُّفوذِ. من ناحيةٍ أخرى، تُسهِمُ مراكزُ الأبحاثِ والجَامعاتُ في التَّنظيرِ لهذه النَّماذجِ، حيث تعملُ على تقديمِ رؤًى وخططٍ لتنفيذِها بشكلٍ فعّالٍ.
🇮🇶 بالنظرِ إلى العراقِ، فإنَّ السُّؤالَ عن النَّموذجِ الأنسبِ لهُ يحملُ أهميَّةً استراتيجيَّةً خاصَّةً، نظرًا لتعدُّدِ أزماتِه وتعقيداتِه. العراقُ دولةٌ ذاتُ تعدُّديَّةٍ دينيَّةٍ وعرقيَّةٍ وثقافيَّةٍ تحتاجُ إلى (نموذجٍ احتوائيٍّ) يَضْمنُ مشاركةَ جميعِ المكوِّناتِ في صُنْعِ القرارِ وتوزيعِ المواردِ. في الوقتِ نفسهِ، يُعاني العراقُ من اعتمادٍ مُفرِطٍ على النَّفطِ وغيابِ التَّنويعِ الاقتصاديِّ، مما يجعلُ نموذجَ (الدَّولةِ الرِّيعيَّةِ المُعاصِرَةِ) ضروريًّا، ولكن بتطويرِهِ ليشملَ الاستثمارَ في قطاعاتٍ إنتاجيَّةٍ مُستدامةٍ.
التَّحدياتُ البيئيَّةُ التي يُواجهُها العراقُ، من شُحِّ المياهِ إلى التَّصحُّرِ، تتطلَّبُ تبنِّيَ سياساتٍ بيئيَّةٍ صارمةٍ، مما يجعلُ نموذجَ (الدَّولةِ الخضراءِ) جزءًا أساسيًّا من الحلِّ.
🇮🇶 علاوةً على ذلك، يحتاجُ العراقُ إلى بناءِ مؤسَّساتٍ قويَّةٍ وفعَّالةٍ تعتمدُ على الكفاءةِ والشَّفافيَّةِ، مما يجعلُ عناصرَ من (الدَّولةِ الذَّكيَّةِ) و(الدَّولةِ الاحترافيَّةِ) ضروريَّةً لتحقيقِ هذا الهدفِ. التَّحوُّلُ الرَّقميُّ يمكنُ أن يُساعِدَ في تقليلِ الفسادِ وتعزيزِ كفاءةِ الإدارةِ العامَّةِ، بينما يَضْمَنُ الاحترافيَّةَ تقديمَ خدماتٍ حكوميَّةٍ عاليةِ الجودةِ. وبالنَّظرِ إلى الظُّروفِ الأمنيَّةِ والسِّياسيَّةِ التي يَمُرُّ بها العراقُ، فإنَّ نموذجَ (الدَّولةِ المرنةِ) يُعَدُّ مطلبًا مُلِحًّا لضمانِ صُمودِ الدَّولةِ في مواجهةِ الأزماتِ الدَّاخليَّةِ والخارجيَّةِ.
🇮🇶 إذن، النَّموذجُ الأنسبُ للعراقِ هو نموذجُ “الدَّولةِ العراقيَّةِ المُستدامةِ متعدِّدةِ الأبعادِ”، الذي يمزجُ بينَ الاحتواءِ السِّياسيِّ، الكفاءةِ الاقتصاديَّةِ، الحَوْكَمَةِ الرَّقميَّةِ، الاستدامةِ البيئيَّةِ، والمرونةِ الأمنيَّةِ. ولتحقيقِ هذا النَّموذجِ، يتطلَّبُ الأمرُ رؤيةً وطنيَّةً شاملةً تستندُ إلى (التَّخطيطِ الاستراتيجيِّ، بناءِ المؤسَّساتِ، وتعزيزِ الوحدةِ الوطنيَّةِ). كما يحتاجُ العراقُ إلى (إرادةٍ سياسيَّةٍ قويَّةٍ ودَعْمٍ مجتمعيٍّ) لتحويلِ هذا النَّموذجِ من رؤيةٍ نظريَّةٍ إلى واقعٍ عمليٍّ.
🌎 في النِّهايةِ، النَّماذجُ الحديثةُ للدُّوَلِ ليست مجردَ “موضاتٍ”، بل هي انعكاسٌ لحاجةِ الدُّوَلِ إلى التَّكيُّفِ مع تحدِّياتِ العالمِ المُعاصِرِ. هذه النَّماذجُ تُقدِّمُ فرصًا كبيرةً لتحقيقِ التَّنميةِ والاستقرارِ، لكنها تتطلَّبُ تَبَنِّيَها بعقلانيَّةٍ ومسؤوليَّةٍ لضمانِ أن تكونَ في خدمةِ الشُّعوبِ وليسَ النُّخَبِ.
🇮🇶 العراقُ، بتاريخِهِ العريقِ وثرواتِهِ الهائلةِ، يملكُ فرصةً فريدةً لتبنِّي نموذجٍ حديثٍ يُلبِّي تطلُّعاتِ شعبِهِ ويضعُهُ على طريقِ النَّهضةِ، ولا يُمكنُ تحقيقُ ذلكَ إلا (برؤيةٍ وإرادةٍ وتنجيزٍ) من (قادةٍ ونُخَبٍ وجماهيرٍ ومؤسساتٍ).
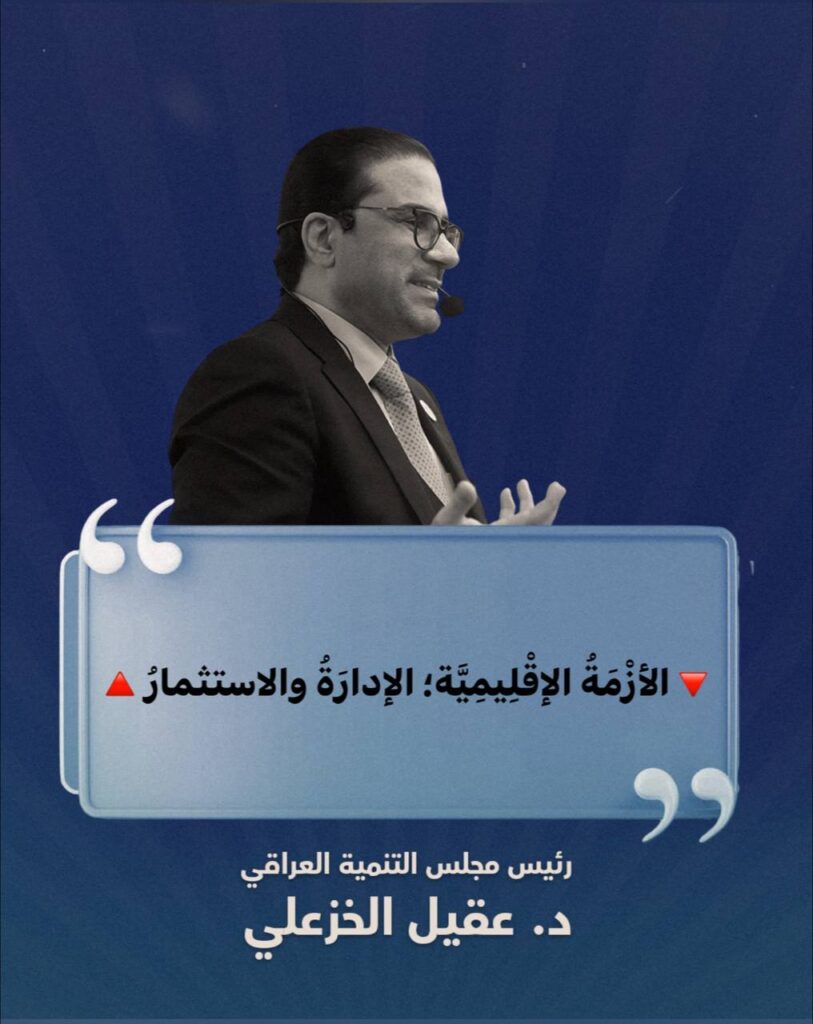
🔻الأزْمَةُ الإقْلِيمِيَّة؛ الإدارَةُ والاستثمارُ🔺
– ما هو المُمكِن؟ –
اعداد؛د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنمية العراقي
🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬
” 🧮 تَشْهَدُ المِنطَقَةُ اليومَ تحوُّلاتٍ جَذْرِيَّةً في المشهدِ الإقْلِيمِيِّ، مع سُقُوطِ النِّظامِ السُّورِيِّ الذي كانَ يمثِّلُ أحدَ الأعْمِدَةِ الأساسيَّةِ في تَوازُنِ القُوَى الإقْلِيمِيَّةِ، حَيثُ تَمَّتْ إعادةُ رَسْمِ مَلامِحِ المَعادِلَةِ السِّياسِيَّةِ والأمْنِيَّةِ في الشَّرْقِ الأوْسَطِ، وتَرَكَ هذا التَّطوُّرُ العراقَ أمامَ مَفْتَرَقِ طُرُقٍ جَدِيدٍ، يَتطلَّبُ مِنْهُ إدارةً استراتيجيَّةً مُحْكَمةً للظُّرُوفِ المُتَغَيِّرَةِ، واستثماراً ذَكِيًّا في الفُرَصِ المُتَاحَةِ لِضَمَانِ تَحقيقِ أعْلى المَنافِعِ الوَطَنِيَّةِ بأقَلِّ تَكالِيفَ مُمْكِنَةٍ.
🌋 إنَّ سقوطَ النِّظامِ السُّورِيِّ يُمَثِّلُ زِلْزالاً سِياسِيًّا وَجيواستراتيجياً (لمْ تَكُنْ مَلامِحُهُ مُفاجِئَةً، لكنَّ تداعياتِهِ استثنائيَّةٌ مِنْ حَيثُ اتِّساعِها وتَعقيدِها).
🇮🇶 العراقُ، بِوَقَعِهِ الجُغرافِيِّ المُتَوَسِّطِ والمُؤثِّرِ، يَجِدُ نَفْسَهُ في مَوْضِعِ التَّقاطُعِ بَيْنَ القُوى الإقْلِيمِيَّةِ والدَّوْلِيَّةِ، فالولاياتُ المُتَّحِدَةُ تُواصِلُ إدارةَ صِراعاتِها مع إيرانَ وروسيا على السَّاحةِ السُّوريَّةِ، بينما تُحاوِلُ تركيا تَثبيتَ نُفُوذِها في الشَّمالِ السُّورِيِّ لِتَحْقِيقِ أهدافِها الأمنيَّةِ والاقتصاديَّةِ والاستراايجية، أما منظومةُ الكيانِ الإسرائيلي، منْ جِهَتِها، تَستَغِلُّ حالةَ الفَراغِ السِّياسِيِّ في سوريا لِتُعَزِّزَ مَكانَتَها، بَيْنما تَسْعَى دُوَلُ الخليجِ إلى إعادةِ صِياغَةِ عَلاقاتِها الإقْلِيمِيَّةِ في ضَوْءِ المَشهدِ الجَدِيدِ.
🧶 أمامَ هذا المَشهَدِ المُعقَّدِ، يَتَوجَّبُ على العراقِ التَّصرُّفُ بحِكْمَةٍ واستباقِيَّةٍ لِضَمَانِ (أنْ يَكونَ لاعِباً أساسِيًّا في المرحلةِ القادِمَةِ، لا ضَحِيَّةً للصِّراعاتِ القائِمَةِ)، وأولى الأولوياتِ في هذا السِّياقِ هِيَ إدارةُ التَّحدِّياتِ الأمْنِيَّةِ الَّتي قدْ تَنْجُمُ عنْ حالةِ الفَوضى في سوريا، خاصَّةً على الحُدودِ الغَرْبِيَّةِ، إذ يَتَوَجّبُ أنْ تُكثِّفَ الأجهِزَةُ الأمْنِيَّةُ العِراقِيَّةُ التَّعاوُنَ معَ جِهاتٍ (إقْلِيمِيَّةٍ ودَولِيَّةٍ) حَلِيفَةٍ لِضَمانِ مَنْعِ تسَلُّلِ الجَماعاتِ الإرهابيَّةِ وحِمايةِ الوَطَنِ مِنْ أيِّ تَصعيدٍ أمنيٍّ.
🧩 في المَجالِ السِّياسِيِّ، يَحْتاجُ العراقُ إلى تَبَنِّي دَوْرِ الوسيطِ بَيْنَ الأطرافِ الإقْلِيمِيَّةِ المُتصارِعَةِ، وهذا الدَّوْرُ يُمكِنُ أنْ يَضَعَ العراقَ في مَوقِعٍ مُحايدٍ ومُؤثِّرٍ، خُصوصاً في المَباحِثاتِ المُتعلِّقَةِ بتحقيقِ الإستقرارِ وإعادةِ الإعمارِ وتَثبِيتِ الاستِقرارِ في سوريا. بَيْدَ أنَّ تَحقيقَ هذا الأمرِ يَتطَلَّبُ عَلاقاتٍ مُتوازِنَةً معَ الجِوارِ الاقليمي السُّورِيِّ، بما في ذلكَ تركيا وإيران والأردن ودول الخليج ومصر.
🧱 عَلَى الصَّعيدِ الاقتصاديِّ، تُشكِّلُ إعادةُ الإعمارِ في سوريا فُرصةً كَبيرةً لِلشَّركاتِ العِراقِيَّةِ لِتَوسيعِ نِطاقِ أعْمالِها. بإمكانِ العراقِ أيضاً استِثمارُ مَنافِذِه الحُدوديَّةِ مع سوريا كطَريقٍ تجاريٍّ يُساهِمُ في تَخفِيفِ الاعتمادِ على المَوانئِ الجَنوبيَّةِ ويُتيحُ وَصْلَ الأسواقِ الأوروبِيَّةِ عَبْرَ مَساراتٍ جَدِيدَةٍ.
⚠️ لكن، لا يُمكنُ تَجاهُلُ التَّحدِّياتِ المُرتَبِطةِ بالمَصالِحِ الإقْلِيمِيَّةِ المُتنافِسَةِ، إذ يَحتاجُ العراقُ إلى تَفاهُماتٍ واسِعَةٍ مع دولِ الجِوارِ، خاصَّةً تركيا وإيران، لِضَمانِ ألَّا تُستَغلَّ الحُدودُ المُشتَرَكَةُ في صِراعاتِ الوَكالةِ أو المَشاريعِ الطَّائفِيَّةِ العَنيفَة.
إنَّ تَكامُلَ المَصالِحِ يَفرِضُ حِواراً مُتوازِناً ومَبنيًّا على أساسِ الاحترامِ المُتبادَلِ.
💞 في المُستَوى الدَّاخِلِيِّ، يَتوجَّبُ على القُوَى السِّياسِيَّةِ العِراقِيَّةِ أنْ تُوحِّدَ جُهودَها لِمُواجَهَةِ المَخاطِرِ الخارِجِيَّةِ، مِن خلالِ إعادةَ تَرتيبِ الأولوِيَّاتِ لِتَحقيقِ الاستِقرارِ الداخليِّ وضَمانِ ألَّا تُستَغَلَّ الخِلافاتُ الطَّائفِيَّةُ أو السِّياسِيَّةُ في إشْعَالِ النِّزاعاتِ المُجتَمَعِيَّةِ. عَلاوَةً على ذلك، تُعَدُّ إعادةُ بناءِ الثِّقَةِ بَيْنَ الشَّعبِ والقيادَةِ السِّياسِيَّةِ ضَرورَةً حَيَويَّةً لِتَعزِيزِ الوَحدةِ الوَطَنِيَّةِ.
وبالمُخَصِّلَة، فأن الأزمَةُ السُّورِيَّةُ وَسُقُوطُ النِّظامِ السُّورِيِّ لَيْسَا مُجرَّدَ مَرْحَلَتَيْنِ في التَّاريخِ الإقْلِيمِيِّ، بَلْ هُما مَنعَطَفٌ استراتيجيٌّ يَفتَحُ البابَ أمَامَ العراقِ لِيَكونَ لاعِباً فاعِلاً في صياغَةِ مستقبلِ المِنطَقَةِ، والتَّحدِّي الآنَ يَكمُنُ في القُدرَةِ على إدارةِ المُعادَلاتِ الإقْلِيمِيَّةِ المُعقَّدَةِ، واستِثمارِ الفُرَصِ لِضَمانِ مُستَقبلٍ آمنٍ ومُستقِرٍّ لِلشَّعبِ العِراقِيِّ وشعوبِ المِنطقة على أساسِ السلامِ والإزدهارِ، وإلا سَتتحَوّلُ الأزمَةُ الى زِلزالٍ مُمتَد لا يوقِفُهُ أيُّ حَد !.”
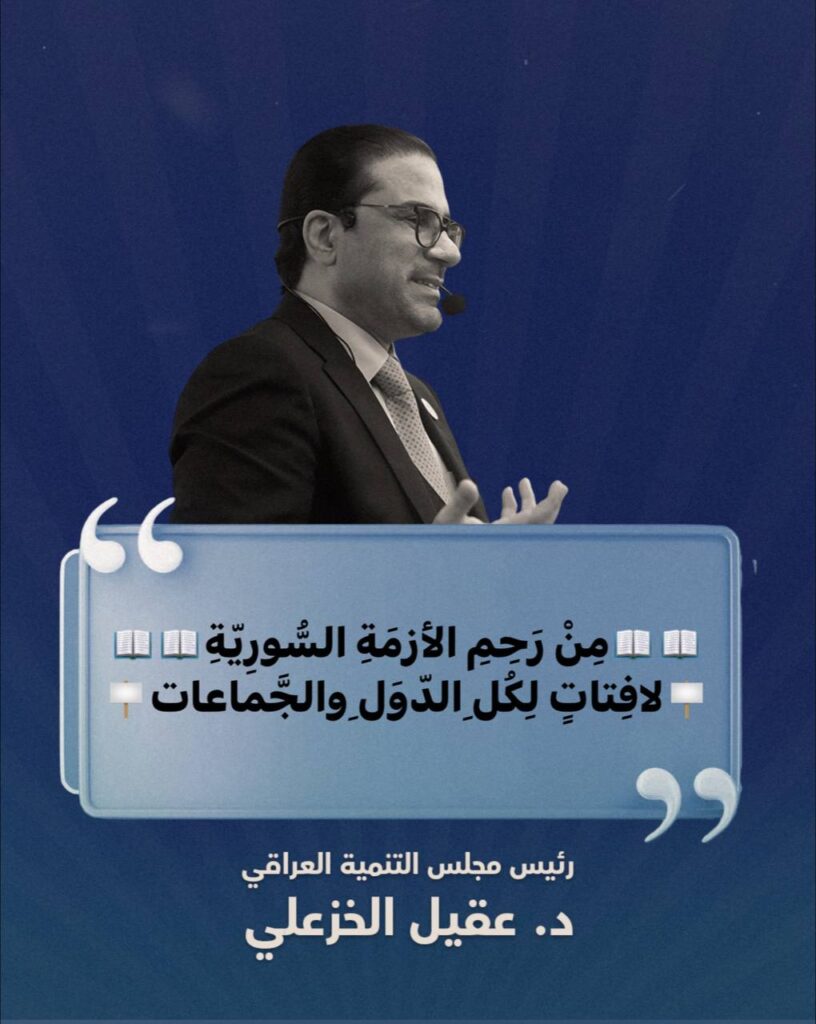
📖📖مِنْ رَحِمِ الأزمَةِ السُّورِيّةِ📖📖
🪧لافِتاتٍ لِكُلِ الدّوَلِ والجَّماعات🪧
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️
ونَحنُ نعيشُ في قلب المتغيّرات العاصفة إقليمياً ودولياً ، ينبري السؤال كشرارةٍ صاحبت الانسان وساهمت في بناء مجده، ولعل واحداً من اهم هذه الاسئلة؛ ما هي العبر والدروسُ والخُلاصات من الازمات التي تُحدق بنا او تُسايرنا، ليكون درسُ الحكمة العملية هو اكبر ربح ورصيد من رحم الازمات، ليستأنف بعدها الانسان العمل متجاوزاً اخطاءه المكرورة ومُعاوداً بناء ذاته ومحيطه على ضوء التجارب المُستفادة.
فعند سبر اغوار ما حدث في سوريا ، تتجلّى أمامنا مجموعة لافِتاتٍ لدروسٍ عظيمةٍ ، تستأهلُ منّا وقفاتٍ للتدّبر والتأمّل وحسن التوظيف، ولعلي اقتنصُ حُزمةً مما تأملتُهُ واستنتجتهُ منها، وأهمها:
🪧عندما تَغيبُ العدالةُ تُولَدُ الفُوضى.
🪧عندما يتنازعُ الأهلُ، يَسْتَثْمِرُ الغريبُ في حُروبِ الوَكالةِ ومعارِكِ الإنابة.
🪧عندما تَضعُفُ المؤسساتُ وتتآكَلُ الهَياكِلُ، تُصابُ الدَّولَةُ بِداءِ الهَشاشَة وتَتَغَذّى الصِّراعاتُ مِن بَدَنِها الهَزيل.
🪧عندما يَتَدَخَّلُ الغُرباءُ، تَتَعَمَّقُ الأزمَةُ وتَتَضاعَفُ التَّكلُفةُ وتؤذِنُ التَّهْلُكَة.
🪧عندما تَتأخَرُ الحُلولُ الوَطَنيّةُ، تَتباطأُ العقلانيّةُ وتَنْحَسِرُ العَدالَةُ وتَتعَمَلَقُ الأزمَةُ وتَتَأهَّبُ الكارِثَة.
🪧الإعلامُ أعتى سِلاحٍ ناعِمٍ إستراتيجيٍّ وتكتيكيٍّ يَحسِمُ الحروبَ بِفصولِ مَعارِكِها كُلِّها.
🪧الحُلولُ التَّرقِيعيَّةُ تُرَّسِخُ المَشاكِل، فالأزماتُ الوطَنِيّةُ تحتاجُ جُرأةً في إجتِراحِ مُعالَجاتٍ شامِلَةٍ عادِلةٍ مُتَوازِنَة.
🪧(الزَّهو والعَنَت والمُكابَرة والنَّرجِسيّة والوَهَم والغِشاوة والتّغابي والأُحادِيّة والإستبداد والجمود..) أمراضٌ نَفسيّة ومُقدِماتٌ لخسائر مادِيّةٍ مَصيرِيّة.
🪧الأنظمة المركزيّة الهَشَّة لَنْ تَصمدَ كَثيراً لمواجهةِ التحوّلات والضغوطات.
🪧بلا تَوازِن بينَ القوّة السياسيّة الداخلية والدعم الشعبي الجماهيري الواسع، كُلُّ التَداعياتِ مُتَوَقّعَة.
🪧المُراجَعاتُ الشُّجاعَةُ ضَرورَةٌ للتَكيُّف، والإصلاحُ الشّامِلُ وجوبٌ للاستدامَة .
🪧(الإقْتِصادُ) هُوَّ أبو السياسة، وقائدُ التحوّلات، وأساسُ النِّظام، ومُهندِسُ التغيير، ومحور السلام، ومُرتَكزُ الإستقرار، وعَمودُ السِّيادَة.
🪧 الأمنُ قرينُ التَّنميّة، والسَّلامُ قرينُ العَدالة، والابداع قرينُ الحُريّة، والاستدامةُ قرينُ المرونة، والتَّلاحم قرينُ الكَرامة، والتَّماسك قَرينُ الإنصاف.
🪧لا تنميّة بلا ثقافة مُتَجددة، ولا نمو بلا فِكرٍ جَريءٍ متوثّب، ولا استقرار بلا وعي، ولا صمود بلا وَحدة.
🪧بلا مهنيّة واحترافيّة واستقلاليّة ونزاهة وولاء، فالمؤسسات والجيوش مُجرّد هياكِل استنزاف ونمورٍ مِن ورق.
🪧الغَباءُ الإستراتيجي يسببُ التيه المرحلي، وينتهي بتدمير الحاضر وتبديد المُستقبَل.
🪧من لا يَعي (النظريات والمُعادلات والقواعد) الحاكِمة على (المُباريات والصفقات والتسويات) الاقليمية والدولية، فانهيارُهُ مجرد وقت.
🪧بلا تحالفاتٍ براغماتيّةٍ مصلحيّةٍ مَرِنَةٍ و ذكيّة، تتفكك أي قوّة صلبة وقُدرةٍ ناعِمة.
🪧(التَغَيُّرُ) سُنَّةٌ كونيّةٌ، وهو سيّدُ الثوابِت، مَنْ لا يُدرِكُهُ ويستثمِرَهُ سُرعانَ ما يَتَحَطَّم.
🪧الراهِنُ العالميُّ هو عَصرُ المصالح بامتياز، فالمَصالِحُ هِيَّ دينُ الدّول وديدَنُها، فلا خير في ايديولوجيّة لا تُعزّز الكرامة والازدهار والعَيشَ الرَّغيدِ لأهلِها.
🪧منظومات الاستخبارات والاعلام والاتصالات والذكاء الرقمي، هي عين واذن ولسان وعقل الدولة، وبدونها الدولة بلا حواس،وستخبط خبط عشواء.
🪧القرارُ؛ ذكاء ودهاء، وموازنات وتسويات، وتوقيتات ولحظات، ومن لا يُدركُ ذلك فلا ينفعه قضاء ما في الذمّة.
🪧القيادةُ الحكيمةُ هي التي تركنُ للعقلانيّة والعدالة والمصلحة الوطنيّة، وتسترشد بالقيم المرنة، وتَلوذُ بهمومِ وتطلعاتِ شعوبِها، وتُلهِمُ طاقةَ التغيير، وتتشبثُ بالمُتاح لصناعةِ مَجدِ أوطانها.
🪧(الحوكمة والرشادة والرقابة والمسائلة والمُحاسبة والحزم والاستجابة والتكيّف والاستدامة)؛أسسٌ لِتشييدِ المصلحة العامة وخنق المصالح الفئويّة الضيّقة.
🪧(الإعترافُ بالأخطاءِ) أولُ عَتَبةٍ للتغيير الإصلاحي الشامل، و(الإنكارُ والعِزّةُ بالإثم) أولُ مَدارِك الهَلاك.
🪧بلا روحٍ وطنيّةٍ وثّابَة، وبلا معنوياتٍ نفسيّةٍ مُستدامة، فلا خير يُرتجى لأي قُدراتٍ ماديّةٍ مُتَجَحفِلَة.
🪧مَنْ لا يَضمِنُ (الإعلامَ ومواقِعَ التّواصل الإجتماعي) لِصالِحِ الوَطن، فقد تركَ بابَهُ مَفتوحاً لِأعاصيرِ الاقتلاع.
🪧(الدعاياتُ والإشاعاتُ والأكاذيب والآضاليلُ) طائراتٌ مُسيّرَةٌ في الفضاء الإفتراضي؛ تَقصفُ العقلَ والوِجدان لإحتلالِ الأقدارِ والأوطان.
🪧(مُفكرو الأمّةِ ومثقفوها وأكاديميوها وتربويوها وإعلاميوها وفنانوها)، هُم عِمادُ الوَطن ومهندسو أقداره.
🪧من لا يُدرُكُ ثقافةَ (الأجيال الشبابية الجديدة الناشئة) وقيمهم وتفضيلاتهم وتوجهاتهم؛ فقد خسرَ وقودَ التغيير وأعمدة الاستقرار ومثابات التنمية ومرتكزات (الابداع والابتكار والريادة والاستدامة).
🪧إذا تراكَمتْ أخطاءُ (الساسةِ والقادةِ والزعماء)، فالتَصدّع والإنهيار هو المَصيرُ المُحَتّم.
🪧السُلطةُ القضائيّةُ الوطنيّةُ العادلةُ المُستقلّةُ هي (الضمان والملاذ) إذا أعيَّتِ الشعوبَ السُّبُلُ.
🪧المَظالِمُ المُتَكَدِّسةُ قنابلٌ موقوتةٌ سيتلاعبُ بزِنادِها المُتَرَبِصُ الدَنيءُ.
🪧تنهارُ البُلدان عندما؛ (يفسد القادة ويتواطأُ العلماءُ ويخرس المصلحون ويُقصى المثقفون ويُحاصَرُ المُجدِدون وتتخادم الزبانيّة وينبطِح العاملون وتغيب العدالة ويتسيّدُ الحيف ويرتع الفساد ويربض الجمود وتُحيا العصبيات وتمتدح العَمالَة ويُفنى التمدّن ويضمحل الشّغف وتُغتالُ الإرادة..)
🪧تَحديثُ (العقليات والمنهجيات والسياسات والأخلاقيات والممارسات) مُقَدّمَةُ التَّعافي الشامِل والإقلاع الحضاري المستدام.
🪧مقتلُ الشُّعوب ب؛ (تصنيم القادة،، احتكار الحقيقة، إطلاقيّة الافكار، اجترار الشعار، تأبيد الممارسات والاساليب، خنق التنوّع، قمع العقل، كبح التغيير، دفن الأصالة، حصار الابداع والابتكار..)
وأختُنمُ اللافتات بالمقولة المقتبسة: “أولئك الذين لا يتعلمون من الماضي محكوم عليهم بتكراره.”
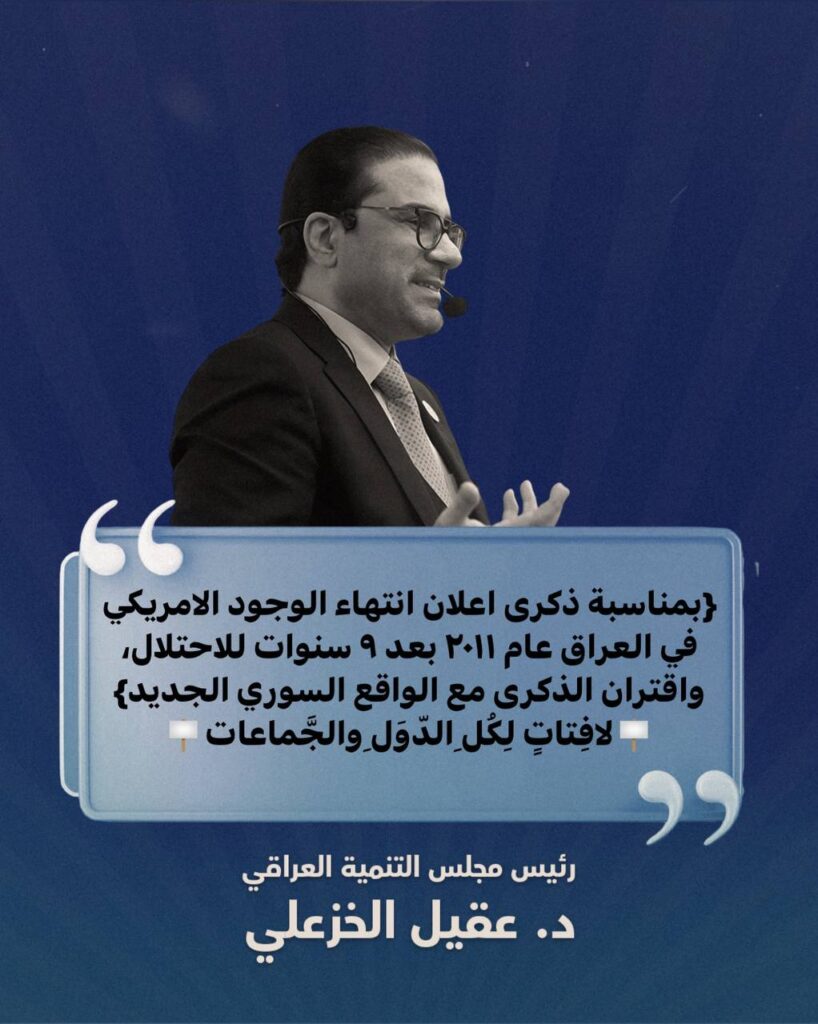
{بمناسبة ذكرى اعلان انتهاء الوجود الامريكي في العراق عام ٢٠١١ بعد ٩ سنوات للاحتلال، واقتران الذكرى مع الواقع السوري الجديد}
🪧لافِتاتٍ لِكُلِ الدّوَلِ والجَّماعات🪧
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️🖍️
ونَحنُ نعيشُ في قلب المتغيّرات العاصفة إقليمياً ودولياً ، ينبري السؤال كشرارةٍ صاحبت الانسان وساهمت في بناء مجده، ولعل واحداً من اهم هذه الاسئلة؛ ما هي العبر والدروسُ والخُلاصات من الازمات التي تُحدق بنا او تُسايرنا، ليكون درسُ الحكمة العملية هو اكبر ربح ورصيد من رحم الازمات، ليستأنف بعدها الانسان العمل متجاوزاً اخطاءه المكرورة ومُعاوداً بناء ذاته ومحيطه على ضوء التجارب المُستفادة.
فعند سبر اغوار ما حدث في سوريا ، تتجلّى أمامنا مجموعة لافِتاتٍ لدروسٍ عظيمةٍ ، تستأهلُ منّا وقفاتٍ للتدّبر والتأمّل وحسن التوظيف، ولعلي اقتنصُ حُزمةً مما تأملتُهُ واستنتجتهُ منها، وأهمها:
🪧عندما تَغيبُ العدالةُ تُولَدُ الفُوضى.
🪧عندما يتنازعُ الأهلُ، يَسْتَثْمِرُ الغريبُ في حُروبِ الوَكالةِ ومعارِكِ الإنابة.
🪧عندما تَضعُفُ المؤسساتُ وتتآكَلُ الهَياكِلُ، تُصابُ الدَّولَةُ بِداءِ الهَشاشَة وتَتَغَذّى الصِّراعاتُ مِن بَدَنِها الهَزيل.
🪧عندما يَتَدَخَّلُ الغُرباءُ، تَتَعَمَّقُ الأزمَةُ وتَتَضاعَفُ التَّكلُفةُ وتؤذِنُ التَّهْلُكَة.
🪧عندما تَتأخَرُ الحُلولُ الوَطَنيّةُ، تَتباطأُ العقلانيّةُ وتَنْحَسِرُ العَدالَةُ وتَتعَمَلَقُ الأزمَةُ وتَتَأهَّبُ الكارِثَة.
🪧الإعلامُ أعتى سِلاحٍ ناعِمٍ إستراتيجيٍّ وتكتيكيٍّ يَحسِمُ الحروبَ بِفصولِ مَعارِكِها كُلِّها.
🪧الحُلولُ التَّرقِيعيَّةُ تُرَّسِخُ المَشاكِل، فالأزماتُ الوطَنِيّةُ تحتاجُ جُرأةً في إجتِراحِ مُعالَجاتٍ شامِلَةٍ عادِلةٍ مُتَوازِنَة.
🪧(الزَّهو والعَنَت والمُكابَرة والنَّرجِسيّة والوَهَم والغِشاوة والتّغابي والأُحادِيّة والإستبداد والجمود..) أمراضٌ نَفسيّة ومُقدِماتٌ لخسائر مادِيّةٍ مَصيرِيّة.
🪧الأنظمة المركزيّة الهَشَّة لَنْ تَصمدَ كَثيراً لمواجهةِ التحوّلات والضغوطات.
🪧بلا تَوازِن بينَ القوّة السياسيّة الداخلية والدعم الشعبي الجماهيري الواسع، كُلُّ التَداعياتِ مُتَوَقّعَة.
🪧المُراجَعاتُ الشُّجاعَةُ ضَرورَةٌ للتَكيُّف، والإصلاحُ الشّامِلُ وجوبٌ للاستدامَة .
🪧(الإقْتِصادُ) هُوَّ أبو السياسة، وقائدُ التحوّلات، وأساسُ النِّظام، ومُهندِسُ التغيير، ومحور السلام، ومُرتَكزُ الإستقرار، وعَمودُ السِّيادَة.
🪧 الأمنُ قرينُ التَّنميّة، والسَّلامُ قرينُ العَدالة، والابداع قرينُ الحُريّة، والاستدامةُ قرينُ المرونة، والتَّلاحم قرينُ الكَرامة، والتَّماسك قَرينُ الإنصاف.
🪧لا تنميّة بلا ثقافة مُتَجددة، ولا نمو بلا فِكرٍ جَريءٍ متوثّب، ولا استقرار بلا وعي، ولا صمود بلا وَحدة.
🪧بلا مهنيّة واحترافيّة واستقلاليّة ونزاهة وولاء، فالمؤسسات والجيوش مُجرّد هياكِل استنزاف ونمورٍ مِن ورق.
🪧الغَباءُ الإستراتيجي يسببُ التيه المرحلي، وينتهي بتدمير الحاضر وتبديد المُستقبَل.
🪧من لا يَعي (النظريات والمُعادلات والقواعد) الحاكِمة على (المُباريات والصفقات والتسويات) الاقليمية والدولية، فانهيارُهُ مجرد وقت.
🪧بلا تحالفاتٍ براغماتيّةٍ مصلحيّةٍ مَرِنَةٍ و ذكيّة، تتفكك أي قوّة صلبة وقُدرةٍ ناعِمة.
🪧(التَغَيُّرُ) سُنَّةٌ كونيّةٌ، وهو سيّدُ الثوابِت، مَنْ لا يُدرِكُهُ ويستثمِرَهُ سُرعانَ ما يَتَحَطَّم.
🪧الراهِنُ العالميُّ هو عَصرُ المصالح بامتياز، فالمَصالِحُ هِيَّ دينُ الدّول وديدَنُها، فلا خير في ايديولوجيّة لا تُعزّز الكرامة والازدهار والعَيشَ الرَّغيدِ لأهلِها.
🪧منظومات الاستخبارات والاعلام والاتصالات والذكاء الرقمي، هي عين واذن ولسان وعقل الدولة، وبدونها الدولة بلا حواس،وستخبط خبط عشواء.
🪧القرارُ؛ ذكاء ودهاء، وموازنات وتسويات، وتوقيتات ولحظات، ومن لا يُدركُ ذلك فلا ينفعه قضاء ما في الذمّة.
🪧القيادةُ الحكيمةُ هي التي تركنُ للعقلانيّة والعدالة والمصلحة الوطنيّة، وتسترشد بالقيم المرنة، وتَلوذُ بهمومِ وتطلعاتِ شعوبِها، وتُلهِمُ طاقةَ التغيير، وتتشبثُ بالمُتاح لصناعةِ مَجدِ أوطانها.
🪧(الحوكمة والرشادة والرقابة والمسائلة والمُحاسبة والحزم والاستجابة والتكيّف والاستدامة)؛أسسٌ لِتشييدِ المصلحة العامة وخنق المصالح الفئويّة الضيّقة.
🪧(الإعترافُ بالأخطاءِ) أولُ عَتَبةٍ للتغيير الإصلاحي الشامل، و(الإنكارُ والعِزّةُ بالإثم) أولُ مَدارِك الهَلاك.
🪧بلا روحٍ وطنيّةٍ وثّابَة، وبلا معنوياتٍ نفسيّةٍ مُستدامة، فلا خير يُرتجى لأي قُدراتٍ ماديّةٍ مُتَجَحفِلَة.
🪧مَنْ لا يَضمِنُ (الإعلامَ ومواقِعَ التّواصل الإجتماعي) لِصالِحِ الوَطن، فقد تركَ بابَهُ مَفتوحاً لِأعاصيرِ الاقتلاع.
🪧(الدعاياتُ والإشاعاتُ والأكاذيب والآضاليلُ) طائراتٌ مُسيّرَةٌ في الفضاء الإفتراضي؛ تَقصفُ العقلَ والوِجدان لإحتلالِ الأقدارِ والأوطان.
🪧(مُفكرو الأمّةِ ومثقفوها وأكاديميوها وتربويوها وإعلاميوها وفنانوها)، هُم عِمادُ الوَطن ومهندسو أقداره.
🪧من لا يُدرُكُ ثقافةَ (الأجيال الشبابية الجديدة الناشئة) وقيمهم وتفضيلاتهم وتوجهاتهم؛ فقد خسرَ وقودَ التغيير وأعمدة الاستقرار ومثابات التنمية ومرتكزات (الابداع والابتكار والريادة والاستدامة).
🪧إذا تراكَمتْ أخطاءُ (الساسةِ والقادةِ والزعماء)، فالتَصدّع والإنهيار هو المَصيرُ المُحَتّم.
🪧السُلطةُ القضائيّةُ الوطنيّةُ العادلةُ المُستقلّةُ هي (الضمان والملاذ) إذا أعيَّتِ الشعوبَ السُّبُلُ.
🪧المَظالِمُ المُتَكَدِّسةُ قنابلٌ موقوتةٌ سيتلاعبُ بزِنادِها المُتَرَبِصُ الدَنيءُ.
🪧تنهارُ البُلدان عندما؛ (يفسد القادة ويتواطأُ العلماءُ ويخرس المصلحون ويُقصى المثقفون ويُحاصَرُ المُجدِدون وتتخادم الزبانيّة وينبطِح العاملون وتغيب العدالة ويتسيّدُ الحيف ويرتع الفساد ويربض الجمود وتُحيا العصبيات وتمتدح العَمالَة ويُفنى التمدّن ويضمحل الشّغف وتُغتالُ الإرادة..)
🪧تَحديثُ (العقليات والمنهجيات والسياسات والأخلاقيات والممارسات) مُقَدّمَةُ التَّعافي الشامِل والإقلاع الحضاري المستدام.
🪧مقتلُ الشُّعوب ب؛ (تصنيم القادة،، احتكار الحقيقة، إطلاقيّة الافكار، اجترار الشعار، تأبيد الممارسات والاساليب، خنق التنوّع، قمع العقل، كبح التغيير، دفن الأصالة، حصار الابداع والابتكار..)
وأختتمُ اللافتات بالمقولة المقتبسة: “أولئك الذين لا يتعلمون من الماضي محكوم عليهم بتكراره.”
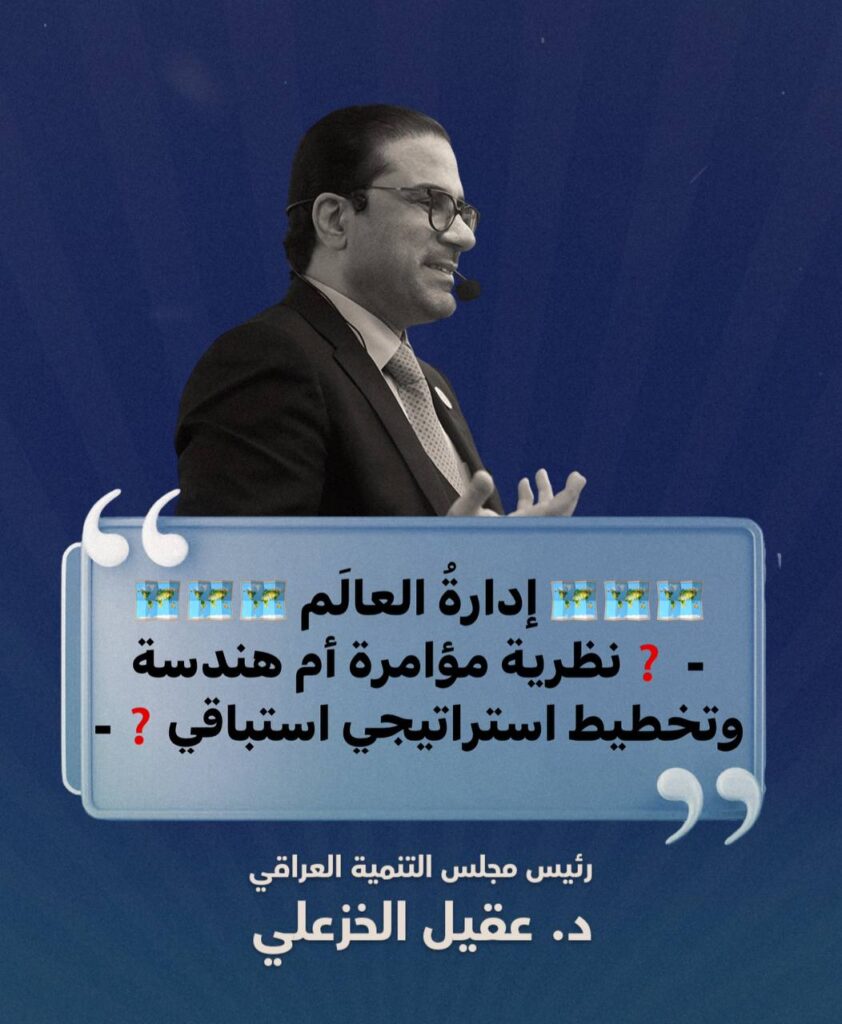
🗺️🗺️🗺️ إدارةُ العالَم 🗺️🗺️🗺️
– ❓نظرية مؤامرة أم هندسة وتخطيط استراتيجي استباقي❓-
✍🏼اعداد:د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنمية العراقي
•••••••••••••••••••••••••••••••••
” 🛰️ في عصرٍ يتسارعُ فيه انتقالُ المعلوماتِ وتتداخلُ فيه الأحداثُ بشكلٍ غيرِ مسبوقٍ، يجدُ الإنسانُ نفسَهُ أمامَ سؤالٍ دائمِ الحضورِ: هل ما يجري من أحداثٍ كبرى في العالمِ هو نتاجٌ لمؤامراتٍ خفيةٍ تُديرها قوى غامضةٌ، أم أنَّ هذه الأحداثَ هي انعكاسٌ لهندسةٍ دقيقةٍ وتخطيطٍ استراتيجيٍّ بعيدِ المدى؟ الإجابةُ عن هذا السؤالِ تتطلبُ الغوصَ في عمقِ النفسِ البشريةِ لفهمِ دوافعِها من جهةٍ، وفي طبيعةِ الأنظمةِ السياسيةِ والاجتماعيةِ لفهمِ أدواتِها وآلياتِها من جهةٍ أخرى.
🪬 الإيمانُ بنظرياتِ المؤامرةِ ليس جديدًا على المجتمعاتِ البشريةِ، بل هو جزءٌ من منظومةِ التفكيرِ التي تلجأُ إليها العقولُ لتفسيرِ الأحداثِ الغامضةِ أو الكارثيةِ. فعندما يواجهُ الإنسانُ أحداثًا معقدةً تفوقُ قدرتَهُ على الفهمِ أو لا يجدُ لها تفسيرًا منطقيًا مباشرًا، تميلُ نفسُهُ إلى تبني رواياتٍ تتسمُ بالبساطةِ والوضوحِ، حتى وإنْ كانتْ خياليةً. هذه الرواياتُ، التي تُعرفُ بنظرياتِ المؤامرةِ، تستمدُّ قوتَها من قدرةِ الإنسانِ على ربطِ النقاطِ بطريقةٍ تخدمُ اعتقادَهُ بوجودِ قوى خفيةٍ تتحكمُ في مجرياتِ الأمورِ. كما أشارَ جوزيف أوسينسكي في كتابِه Conspiracy Theories and the People Who Believe Them، فإنَّ هذه النظرياتِ تُعبّرُ عن حاجةٍ نفسيةٍ ملحّةٍ لدى الإنسانِ لفهمِ العالمِ والسيطرةِ على مآلاتِه.
🧠 غير أنَّ هذا النوعَ من التفكيرِ، على الرغمِ من انتشارهِ، يتجاهلُ طبيعةَ العالمِ المعاصرِ الذي يعتمدُ بشكلٍ متزايدٍ على التخطيطِ الاستراتيجيِّ والهندسةِ الاجتماعيةِ لتحقيقِ الأهدافِ. التخطيطُ الاستراتيجيُّ ليس مفهومًا غامضًا أو سريًّا، بل هو عمليةٌ منظمةٌ تعتمدُ على دراسةٍ مستفيضةٍ للبياناتِ، وتحليلٍ للواقعِ، واستشرافٍ للمستقبلِ. هذه العمليةُ تُستخدمُ على نطاقٍ واسعٍ من قبلِ الدولِ والمؤسساتِ لتحقيقِ مصالحِها، وتوجيهِ مواردِها، والتعاملِ مع التحدياتِ التي تواجهُها. وفي هذا السياقِ، يمكنُ النظرُ إلى العديدِ من الأحداثِ التي يُعتقدُ بأنها مؤامراتٌ، على أنها نتيجةٌ طبيعيةٌ لتخطيطٍ طويلِ الأمدِ تمَّ تصميمُهُ وفقَ أدواتٍ علميةٍ دقيقةٍ.
📐 تمثلُ الهندسةُ الاجتماعيةُ بُعدًا مهمًا من أبعادِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ، إذ تسعى إلى تشكيلِ سلوكِ الأفرادِ والجماعاتِ وفقَ أهدافٍ محددةٍ. هذه الهندسةُ ليستْ دائمًا سلبيةً أو خبيثةً كما يُروجُ أنصارُ نظرياتِ المؤامرةِ، بل إنها تُستخدمُ في كثيرٍ من الأحيانِ لتحقيقِ الاستقرارِ، وتعزيزِ التنميةِ، ومواجهةِ الأزماتِ. على سبيل المثالِ، يمكنُ أنْ نأخذَ تجربةَ “خطة مارشال” التي تبنتها الولاياتُ المتحدةُ بعدَ الحربِ العالميةِ الثانيةِ نموذجًا للتخطيطِ الاستراتيجيِّ والهندسةِ السياسيةِ. هذه الخطةُ لم تكن مجردَ مساعداتٍ اقتصاديةٍ، بل كانتْ جزءًا من استراتيجيةٍ أوسعَ لإعادةِ بناءِ أوروبا كحليفٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ ضدَّ التوسعِ السوفيتي. كما أوضحَ دانييل كانيمان في كتابِه Thinking Fast and Slow، فإنَّ القراراتَ الكبرى تُبنى على تحليلٍ دقيقٍ للبياناتِ والسيناريوهاتِ المستقبليةِ، وهو ما اتبعتهُ الولاياتُ المتحدةُ في تنفيذِ هذه الخطةِ.
🌎 في العلاقاتِ الدوليةِ، يظهرُ التخطيطُ الاستراتيجيُّ بوضوحٍ من خلالِ سياساتِ الدولِ الكبرى، التي تسعى إلى تحقيقِ توازنٍ دقيقٍ في علاقاتِها مع القوى الأخرى وضمانِ مصالحِها الاقتصاديةِ والأمنيةِ في آنٍ واحدٍ. العلاقاتُ الدوليةُ، التي تبدو أحيانًا عشوائيةً أو خاضعةً للظروفِ الطارئةِ، تُدارُ في الواقعِ وفقَ قواعدَ صارمةٍ تعتمدُ على تحليلِ البياناتِ، واستشرافِ السيناريوهاتِ المستقبليةِ، وبناءِ التحالفاتِ، وتوظيفِ الأدواتِ الاقتصاديةِ والدبلوماسيةِ وحتى العسكريةِ عندَ الضرورةِ. هذه المنهجيةُ، التي تبدو للبعضِ وكأنها مؤامرةٌ محكمةٌ، هي في جوهرِها انعكاسٌ لتخطيطٍ استراتيجيٍّ شاملٍ طويلِ الأمدِ، يُمكِّنُ الدولَ من تحقيقِ الهيمنةِ أو الحفاظِ على موقعِها ضمنَ النظامِ الدوليِّ المتغيرِ.
🇺🇸 يمكنُنا أن نستشهدَ هنا بالتغيراتِ التي شهدتْها السياسةُ الدوليةُ بعدَ انهيارِ الاتحادِ السوفيتيِّ، حيثُ قامتِ الولاياتُ المتحدةُ بوضعِ استراتيجياتٍ متعددةٍ للحفاظِ على تفوقِها في النظامِ الدوليِّ. من بينِ هذه الاستراتيجياتِ مشروعُ “العولمةِ”، الذي استُخدمَ كأداةٍ لبسطِ النفوذِ الأمريكيِّ اقتصاديًا وسياسيًا، من خلالِ فرضِ أنماطٍ اقتصاديةٍ جديدةٍ تعتمدُ على حريةِ الأسواقِ والتجارةِ المفتوحةِ.
هذا التحولُ، الذي وصفَهُ البعضُ بأنَّهُ “مؤامرةٌ للهيمنةِ الاقتصاديةِ”، كانَ في الواقعِ نموذجًا واضحًا للتخطيطِ الاستراتيجيِّ، الذي استفادَ من نقاطِ الضعفِ في النظامِ الدوليِّ لتحقيقِ مصالحٍ محددةٍ.
🇨🇳 ومن الأمثلةِ الأخرى التي تسلطُ الضوءَ على تعقيدِ التخطيطِ الاستراتيجيِّ في العلاقاتِ الدوليةِ، سياسةُ “الاحتواءِ”، التي انتهجتْها الولاياتُ المتحدةُ تجاهَ الصينَ منذُ بداياتِ القرنِ الحادي والعشرينَ. هذه السياسةُ، التي تتمثلُ في بناءِ تحالفاتٍ قويةٍ مع الدولِ المجاورةِ للصينِ مثلِ اليابانَ وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبيةِ، إلى جانبِ تعزيزِ التواجدِ العسكريِّ الأمريكيِّ في منطقةِ آسيا والمحيطِ الهادئِ، ليستْ مجردَ ردودِ فعلٍ عشوائيةٍ على صعودِ الصينَ كقوةٍ اقتصاديةٍ، بل هي استراتيجيةٌ مدروسةٌ تهدفُ إلى الحدِّ من النفوذِ الصينيِّ وإعادةِ توازنِ القوى في المنطقةِ بما يخدمُ المصالحَ الأمريكيةَ على المدى الطويلِ. في ذاتِ السياقِ، يرى البعضُ أنَّ مبادرةَ الصينِ “الحزامِ والطريقِ” جاءتْ كردٍّ استراتيجيٍّ لتعزيزِ نفوذِها الدوليِّ وكسرِ طوقِ الاحتواءِ الأمريكيِّ، من خلالِ استثماراتٍ ضخمةٍ في البنيةِ التحتيةِ تربطُ الصينَ بالعالمِ.
📊 تلعبُ الهندسةُ السياسيةُ والاجتماعيةُ دورًا محوريًا في تنفيذِ هذه الاستراتيجياتِ الدوليةِ، إذ تُستخدمُ أدواتُ التأثيرِ الناعمةِ لتوجيهِ الرأيِ العامِّ المحليِّ والدوليِّ بما يتماشى مع المصالحِ الاستراتيجيةِ. على سبيلِ المثالِ، يمكنُ ملاحظةُ استخدامِ الإعلامِ والمؤسساتِ الثقافيةِ والمنظماتِ الدوليةِ كأدواتٍ لإعادةِ تشكيلِ السردياتِ العامةِ وتعزيزِ الشرعيةِ السياسيةِ لبعضِ السياساتِ المثيرةِ للجدلِ. كما أشارَ كريستوفر هادناجي في كتابِهِ Social Engineering: The Science of Human Hacking، فإنَّ التأثيرَ على سلوكِ الجماعاتِ والمجتمعاتِ لا يتمُّ فقط من خلالِ القوةِ المباشرةِ، بل عبرَ أدواتٍ ناعمةٍ تستهدفُ القناعاتِ والقيمَ.
🗳️ وفي هذا الإطارِ، نجدُ أنَّ الدولَ الكبرى تعتمدُ أيضًا على ما يُعرفُ بـ”الهندسةِ الانتخابيةِ” كجزءِ من تخطيطِها الاستراتيجيِّ. هذا المفهومُ لا يقتصرُ فقط على الدولِ ذاتِ الأنظمةِ غيرِ الديمقراطيةِ، بل يشملُ حتى الديمقراطياتِ الراسخةِ التي تسعى لتوجيهِ نتائجِ الانتخاباتِ داخلَها أو في دولٍ أخرى لصالحِ مصالحِها. مثالٌ على ذلكَ ما كشفتْهُ التحقيقاتُ حولَ تدخلاتِ قوى أجنبيةٍ في الانتخاباتِ الرئاسيةِ الأمريكيةِ لعامِ 2016، حيثُ استُخدمتْ وسائلُ التواصلِ الاجتماعيِّ وتقنياتُ تحليلِ البياناتِ كأدواتٍ للتأثيرِ على الناخبينَ وتوجيهِ خياراتِهم.
🌍 أما على المستوى الإقليميِّ، فإنَّ صراعاتِ الشرقِ الأوسطِ تقدمُ نموذجًا واضحًا على كيفيةِ تقاطعِ نظرياتِ المؤامرةِ مع التخطيطِ الاستراتيجيِّ والهندسةِ السياسيةِ. فالحروبُ التي اندلعتْ في سوريا واليمن، والتوتراتُ المزمنةُ بينَ إيرانَ ودولِ الخليجِ، غالبًا ما يُنظرُ إليها من منظورِ المؤامراتِ الدوليةِ. ومع ذلكَ، فإنَّ التحليلَ الاستراتيجيَّ لهذه الصراعاتِ يكشفُ أنَّها ليستْ مجردَ أحداثٍ عشوائيةٍ أو نتيجةِ مؤامراتٍ غامضةٍ، بل هي انعكاسٌ لسياساتٍ معقدةٍ تخضعُ لحساباتٍ دقيقةٍ تتعلقُ بالمصالحِ الجيوسياسيةِ والطموحاتِ الإقليميةِ والدوليةِ.
لقد إنتقلتِ الدُّوَلُ الذّكيّة من طَورِ (الإنفعالِ) الى مَرحَلَةِ (الفاعلية)، وها هيَّ اليوم تدخلُ في عصر (الإستباقيّة)، ولم يبقَ في الكِنانةِ سَهمُ عَزاءٍ لِمَن أدمَنَ العيشَ في أسوارِ الماضي أو كُهوفِ
الحاضر المُنغَلِق !، متى نَعِي؟ متى نقتحِم؟ متى نَرتقي؟ ، أسئِلَةٌ بِرَسمِ حِكمَةِ المَصالِح.
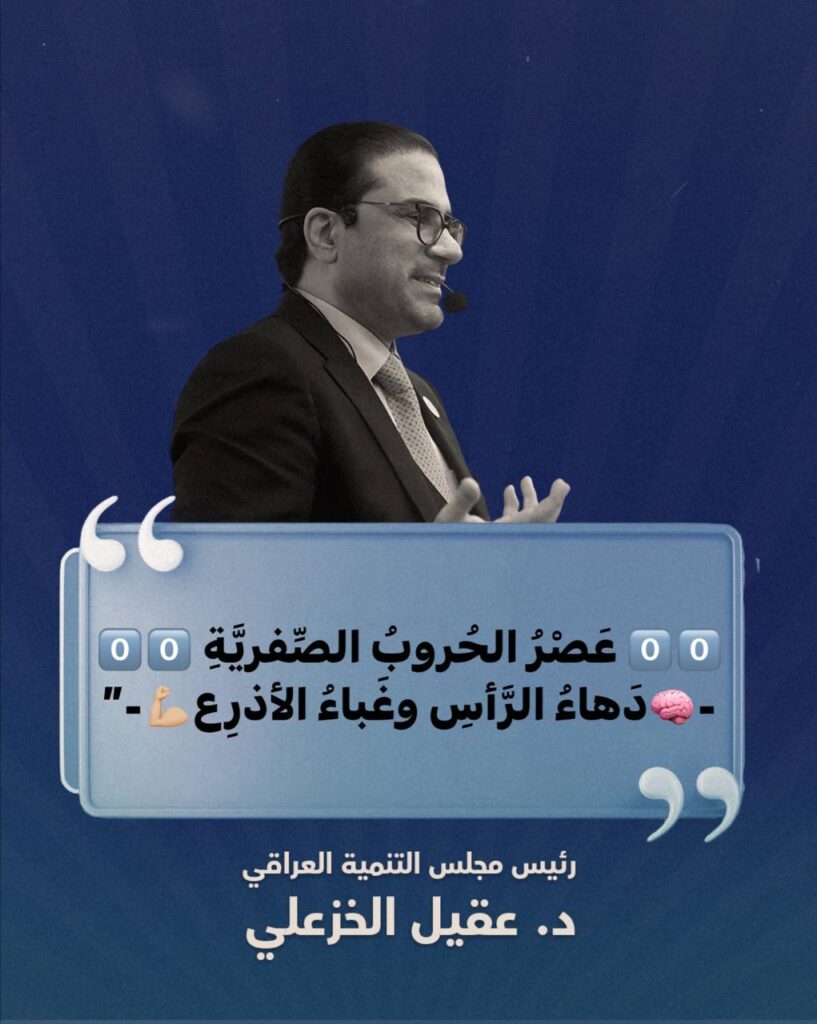
0️⃣0️⃣ عَصْرُ الحُروبُ الصِّفريَّةِ 0️⃣0️⃣
-🧠دَهاءُ الرَّأسِ وغَباءُ الأذرِع💪🏼-”
اعداد:د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي.
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
” 🕹️ باتت الحروب بالوكالة إحدى السمات المميزة للنظام العالمي المعاصر، حيث تُستخدم الدول والجماعات كأدوات لتحقيق مصالح قوى كبرى دون أن تُورّط هذه القوى نفسها بشكل مباشر في ميادين القتال. المفهوم يتسم بالتعقيد والمرونة؛ فهو لا يقتصر على استخدام الجماعات المسلحة المحلية، بل يتسع ليشمل استخدام دول بأكملها كأذرع وُكلاء لمواجهة خصوم استراتيجيين، ولعل منطقة الشرق الأوسط هي أبرز ساحات هذه الحروب اليوم، نتيجة تعقيداتها السياسية والجغرافية والاقتصادية.
📓 المفهوم والأركان
—————————-
الحروب بالوكالة تُعرف، كما يشير الباحث أندرو مامفورد في كتابه “Proxy Wars: The New Politics of Conflict” (2013)، بأنها “الصراعات التي تُدار من قبل قوى كبرى من خلال أطراف محلية لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية على حساب طرف ثالث”. ترتكز هذه الحروب على أربعة أركان أساسية: الجهة الراعية التي تقدم الدعم المادي والعسكري، الوكيل المحلي الذي ينفذ الأجندة مقابل منافع سياسية أو مالية، ساحة الصراع التي غالبًا ما تكون دولًا ضعيفة، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى الجهة الراعية لتحقيقها.
ووفقًا لما قدمه مالك محسن العيساوي في كتابه “الحروب بالوكالة: إدارة الأزمة الدولية” (2015)، تُعَدّ هذه الحروب أدوات أساسية في يد الدول لتجنب التورط المباشر، فهي تُحقق مصالحها مع الحفاظ على مساحة الإنكار السياسي والقانوني.
📜 لمحة تاريخية وتطور الظاهرة
———————————————
على الرغم من أن الحروب بالوكالة قديمة بقدم الحروب نفسها، إلا أنها برزت بوضوح خلال الحرب الباردة (1947-1991)؛ حين استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وكلاء محليين لخوض صراعات أيديولوجية، كما في حرب كوريا وفيتنام وأفغانستان، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، تطورت الحروب بالوكالة لتصبح أكثر تعقيدًا، خاصة بعد أحداث ( 11 سبتمبر 2001 )وصعود حروب الجيل الرابع، التي تعتمد على تفكيك الدول من الداخل باستخدام أدوات غير نظامية.
🌍 الشرق الأوسط؛لماذا؟
————————————
وفق دراسة “الحروب بالوكالة في الشرق الأوسط” (2021) الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية، تُعد المنطقة بيئة خصبة لهذه الحروب بسبب تعقيدات سياسية وتاريخية، وضعف بعض الدول، وتعدد الولاءات المذهبية والعرقية، إلى جانب موقعها الجغرافي وثرواتها النفطية التي تجعلها محط أطماع دولية، حيث باتت سوريا نموذجًا كلاسيكيًا لحروب القوى الدولية والإقليمية.
🦼توظيفها وفلسفتها
——————————
إن توظيف الحروب بالوكالة يرتكز على تقليل تكلفة الحرب البشرية والاقتصادية وتجنب التداعيات السياسية أمام المجتمع الدولي. تُبرهن الفيلسوفة السياسية ماري كالدو في كتابها “New and Old Wars” (2012) أن الحروب بالوكالة باتت البديل الأقل تكلفة للتدخلات العسكرية التقليدية، خاصة في عصر “الحروب غير المتماثلة”، حيث تستخدم الدول الكبيرة موارد محلية لإضعاف خصومها وتحقيق مصالحها الاستراتيجية.
🌋الآثار والتداعيات
—————————
تُخلِّفُ الحروب بالوكالة آثارًا كارثية على الدول والشعوب، كما تشير تقارير الأمم المتحدة حول النزاعات في الشرق الأوسط.
هذه الحروب تُضعف سيادة الدول المستهدفة وتُحوّلها إلى ساحات صراع دائمة، كما تؤدي إلى تدمير البنى التحتية، تفاقم الأزمات الإنسانية، وتشريد ملايين السكان، ففي؛( العراق وافغانستان وسوريا وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين واليمن)، على سبيل المثال، أدّت الحروب إلى أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث وفق تقارير برنامج الغذاء العالمي.
💲أشكال الحروب الحديثة بالوكالة
———————————————-
لم تعد الحروب بالوكالة محصورة على الجماعات المسلحة، بل باتت تأخذ أشكالًا جديدة، إذ أصبحت الدول الكبرى والعُظمى (الدول المهيمنة) تُوظف دولًا أخرى (الدول المُسْتَلَبَة) لتقاتل نيابة عنها ضمن تحالفات إقليمية ودولية، كما في الصراع الأوكراني الذي تُقاتل فيه أوكرانيا نيابة عن القوى الغربية ضد روسيا، مما يعكس استمرارية مبدأ إدارة الحروب من بعيد.
🧯كيفية مواجهة الحروب بالوكالة
———————————————-
تستدعي مواجهة هذه الظاهرة استراتيجيات متعددة الجوانب، أبرزها:
🛡️تعزيز الانتماء والولاء الوطني
——————————————
من خلال تطوير مناهج التنشئة والتربية والتعليم ، والفصل الموضوعي بين ماهو وطني عن ما هو عقائدي ايديولوجي، وترسيخ المواطنة والهوية الوطنية الجامعة، وتَعرِيّة الدول والحهات الاجنبية التي تستغل التنوّع الديني او العرقي لصالح أجندتها المشبوهة، ودعم القيادات والرموز الوطنية التي لا تمثل مشاريع وادوات بيد الآخر الاجنبي.
🛡️(تقوية مؤسسات الدولة)
—————————————
غالبًا ما تكون الدول الهشة الهدف الأول لهذه الحروب، لذا فإن بناء مؤسسات سياسية وعسكرية قوية قادر على ملء الفراغ الأمني يُعد أولوية قصوى.
🛡️تفعيل القوانين الدولية
————————————
وفق ميثاق الأمم المتحدة، يجب تعزيز الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل، كما يجب تفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد الدول الراعية لهذه الحروب.
🛡️تعزيز التنمية الشاملة
———————————-
الفقر والبطالة يجعلان الشباب أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وبالتالي فإن توفير فرص العمل والتعليم يُشكل سدًا أمام تنامي نفوذ هذه الجماعات.
🛡️حل النزاعات بالطرق السلمية
———————————————
إشراك الأطراف الإقليمية والدولية في مفاوضات شاملة تُحقق التوازن السياسي والاستقرار، كما حدث في اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية.
🛡️التوعية الإعلامية
—————————
فضح الأجندات الخفية وراء الحروب بالوكالة من خلال حملات إعلامية ومجتمعية، يُعدُّ أداة فعّالة لمواجهة التضليل السياسي.
🚜الحَصاد🚜
——————-
في عصر الحروب الصفرية، تتجلى عبقرية الدول الكبرى في إدارة الصراعات من بُعد، حيث تتقن لعبة “دهاء الرأس وغباء الأذرع”.
هذه الحروب تُعد سلاحًا مزدوجًا؛ فهي تُحقق مصالح الرؤوس المدبرة بينما تترك الأذرع المنفذة في فوضى ودمار دائم.
العالم اليوم بحاجة إلى استراتيجيات مبتكرة تتجاوز منطق “الاستنزاف بالوكالة” لتبني حلول حقيقية تحفظ الأمن والسلم الدوليين وتُعيد للدول الهشّة سيادتها واستقرارها، ومن لا يصطف مع هذه الحقيقة اليوم سيكتوي بنار الحرب بالوكالة غداً، و”على الباغي تدور الدوائر”.
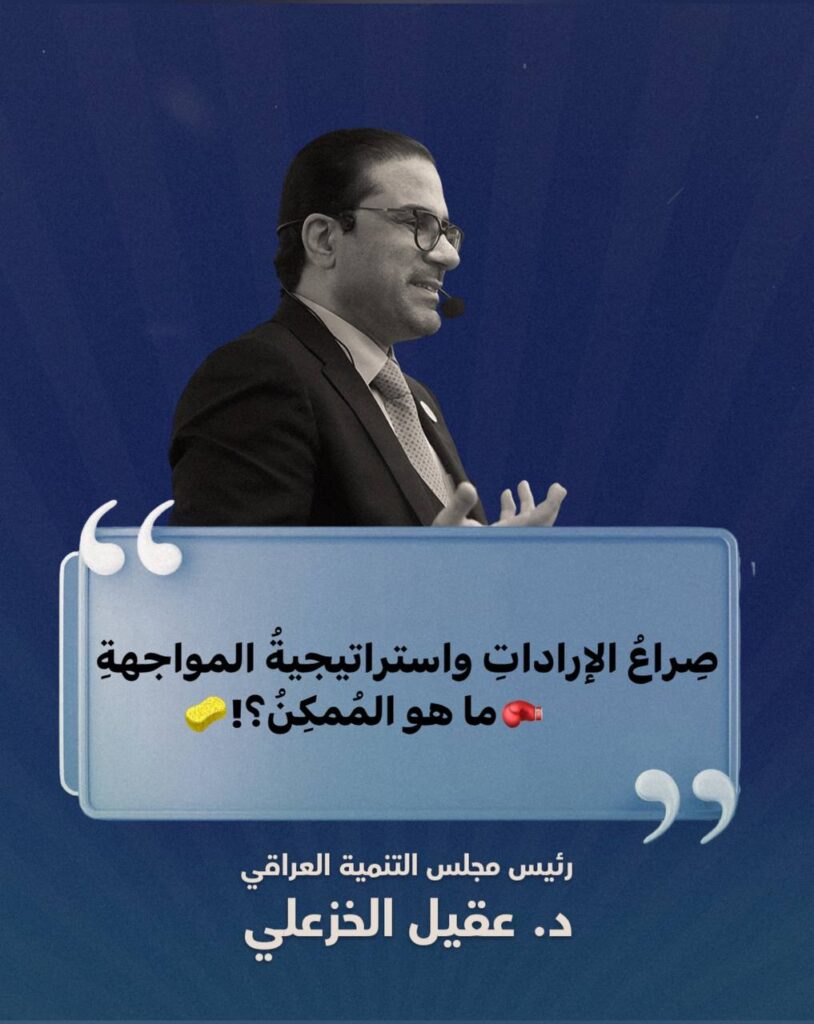
صِراعُ الإراداتِ واستراتيجيةُ المواجهةِ
🥊ما هو المُمكِنُ؟!🧽
اعداد:د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنميّة العراقي
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
“🌊 في خضم عالمٍ مضطربٍ تموج فيه (المخططات/المؤامرات) والتدخّلات، حيثُ تُرسَم خرائط التقسيم وتُخطَطَ استراتيجيات الهيمنة -وكما أشرنا إليها في مقالنا السابق بعنوان “خرائط التفتيت”-، تبرز أمام الدول المُهدَدة ضرورة التفكير بذكاء وحكمة وبراغماتية.
😈 إن تحديات البقاء والاستمرار في ظل هذه البيئة العدائية تتطلب استراتيجية شاملة تجمع بين (القوة السياسية والاقتصادية والمرونة الدبلوماسية)، مع استعداد (للتكيف واستغلال الفرص)، لأن السيادة الوطنية والكرامة السياسية لا تُحفظ فقط برفع الشعارات، بل بإدارة حكيمة وذكية للواقع الذي يفرض نفسه.
🪤 إن مواجهة هذه المخططات تبدأ بمعرفة الأسباب الجذرية التي تجعل الدول عرضةً لهذه التهديدات، فعندما تفشل الأنظمة السياسية في تحقيق (العدالة والشفافية وتعزيز سيادة القانون)، تصبح هذه الدول ساحةً مفتوحةً للتدخلات الخارجية.
🏁 لذا، يبدأ الحل بإصلاح الأنظمة الداخلية من خلال بناء (مؤسسات سياسية واقتصادية وأجتماعية) قادرة على مواجهة الضغوط الخارجية مع (تقوية الأجهزة الأمنية) وتحقيق (التكامل بين السلطة والشعب).
🪢إن الدولة التي تفتقد لهذا التماسك الداخلي تصبح هدفاً سهلاً في لعبة القوى الكبرى.
🧽 وفي هذا الإطار، تحتاج الدول المهدَدَة إلى تفعيل (استراتيجيات مرنة) وبناء (تحالفات ذكية) تُوازن بين المصالح الوطنية والدولية، حيثُ ليس من المنطقي مواجهة العالم برؤى جامدة أو خطابات متشنجة، بل المطلوب الانفتاح على الأطراف المختلفة وعقد شراكات استراتيجية تُحقق مصالح متبادلة، وهذه الشراكات يمكن أن تتحقق من خلال تقديم مبادرات اقتصادية وتنموية مشتركة، تجعل الجميع شريكاً في استقرار الدولة المستهدفة، بدلاً من أن يكون مشاركاً في زعزعتها.
🏟️ تلعب (الدول الكبرى ومهندسو الحروب وادوات الجشع) على وتر الفوضى والتفرقة، وتسعى لاستغلال الثغرات السياسية والاجتماعية في الدول الضعيفة، لذلك فإن بناء اقتصاد قوي ومتوازن هو السلاح الأقوى في مواجهة هذه المخططات من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، مع التركيز على اقتصاد المعرفة والتقنيات وتنويع مصادر الدخل، مثل تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا. 🏦 فالاقتصاد المستقل والمستدام لا يمنح الدولة فقط القوة لمواجهة الضغوط الخارجية، بل يخلق أيضاً بيئة داخلية صلبة تمنع التفكك والاختراق.
⚽️ في ظل التحولات العالمية والإقليمية، تلعب الدبلوماسية دوراً محورياً في استقرار الدول المهددة، إذ عليها أن تعمل لبناء صورة دولية إيجابية من خلال تقديم نفسها كلاعب رئيسي في حل الأزمات الإقليمية، من خلال طرح رؤى متوازنة لحل الأزمات المحيطة بها، تظهر عبرها أنها قوة استقرار وليست طرفاً في تأجيج الصراعات.
🗣️ هذه الدبلوماسية يجب أن تكون قائمة على (الحوار والبراغماتية)، بعيداً عن (التصعيد أو الاستقطاب)، والتدرّج في كل الحلول المُتاحة والمعالجات الممكِنة.
🕹️إن استثمار القوة الناعمة أصبح اليوم عنصراً أساسياً في إدارة اللعبة الدولية،(الإعلام، والتعليم، والدبلوماسية الثقافية) أدوات فعالة يمكن استخدامها لتغيير الصورة النمطية عن الدول المهدَدة وتعزيز مكانتها، وهذه الأدوات يجب أن تُدار بحرفية عالية لضمان استغلالها بالشكل الأمثل في خدمة المصالح الوطنية.
🚀 وفي ميدان الأمن والدفاع، يجب التركيز على تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية لتكون قادرة على مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية. هذا لا يعني فقط تعزيز القدرات التقليدية، بل أيضاً الاستثمار في (الأمن السيبراني والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة).
كما يجب تقوية التعاون الأمني الإقليمي
لضمان ضبط الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية والعناصر التخريبية التي تُستخدم كأدوات في تنفيذ مخططات التقسيم، هذا التعاون الإقليمي لا يعني فقط توقيع الاتفاقيات، بل يجب أن يتضمن عمليات استخبارية مشتركة، ومناورات تدريبية متبادلة، وآليات مستدامة للتنسيق الأمني.
ومن الجوانب الحاسمة، تأتي الحاجة إلى (تعزيز الوحدة الوطنية في الدول)، كون الشعب الموحد هو الحصن الأول في وجه أي مؤامرة خارجية.
🎙️ كما يقتضي أن تعمل الحكومات على بناء خطاب جامع يعزز الانتماء الوطني ويُشرك كل الفئات في عملية صنع القرار.
⚖️ ومن البداهة بمكان، من انه لا يمكن مواجهة المخططات التفتيتية دون تحقيق (عدالة اجتماعية) تُزيل الشعور بالتهميش-الحقيقي والمُفتَعَل-، وتعطي الجميع فرصة عادلة للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية.
🌐 أما على مستوى العلاقات مع القوى الكبرى، فيستدعي الامر أن تُدار بحنكة وذكاء لتحقيق التوازن بين المصالح (الوطنية والاقليمية ومتطلبات المجتمع الدولي) عبر تقديم مبادرات تخلق مصالح مشتركة مع القوى المحوريّة والكبرى، بحيث تصبح هذه القوى أكثر ميلاً للحفاظ على استقرار الدولة بدلاً من دعم مخططات تقسيمها.
لذا ، يتوجب على الدولة تبني دبلوماسية قائمة على البراغماتية🤩، فلا انحياز كامل ولا عداء مطلق، بل إدارة متوازنة للعلاقات وفق ما تقتضيه المصالح الوطنية.
🪠 أما فيما يخص الذرائع التي تستخدمها القوى الكبرى لتبرير تدخلاتها، فيقتضي العمل على سحب هذه الذرائع من خلال تطبيق إصلاحات شاملة، عبر التركيز على (إنفاذ القانون، معالجة حكيمة لاوضاع الجماعات المسلحة، السيادة الاقتصادية، مكافحة الفساد، وتعزيز الديموقراطية التشاركية والحكم الرشيد والشفافية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية)، فالدولة القوية داخلياً هي الدولة التي لا تمنح الأطراف الخارجية فرصة للتدخل تحت أي مسمى كان أو ذريعةٍ تُختَلَق.
🤾♂️ ولقلب الطاولة على المخططات التفتيتية، يجب أن تتبنى الدول المُهدَدَة استراتيجيات هجومية ذكية. على سبيل المثال، يمكنها تقديم مبادرات إقليمية ودولية تُعيد تشكيل موازين القوى لصالحها، مع العمل على تعزيز الحضور في المنظمات الدولية واستخدامها كمنصات للدفاع عن مصالحها.
🤝 إن العمل الجماعي مع الدول المهدَدَة الأخرى يُعدُّ أيضاً خياراً استراتيجياً مهماً، حيث يتوجب أن تنسق هذه الدول جهودها لبناء تكتلات سياسية واقتصادية وأمنية قادرة على مواجهة التحديات المشتركة، وهذه التكتلات يمكن أن تكون بمثابة مظلة توفر الحماية الجماعية وتقلل من الضغوط الفردية.
🧮 وبالمحصلة، فإن مواجهة خرائط التفتيت والمخططات التآمرية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة وجودية، فالدول التي تريد الحفاظ على سيادتها واستقرارها وكرامتها يجب أن تتحلى بالمرونة والذكاء في التعامل مع التحديات، وعليها أن تُثبت للعالم أنها قادرة على تحقيق التوازن بين الاستجابة للتحديات الداخلية والمناورة في المشهد الدولي.
♟️إنها (لعبة شطرنج معقدة) تتطلب عقلاً استراتيجياً، وإرادة صلبة، وقدرة على التفكير في المدى البعيد، وبهذا فقط يمكن أن تتجنب الدول مصير التفكك وتضمن مكانتها كأطراف قوية ومستقرة في النظام العالمي، فالعقلُ زينة والحكمة تاج والمُداراةُ سؤدد !.”
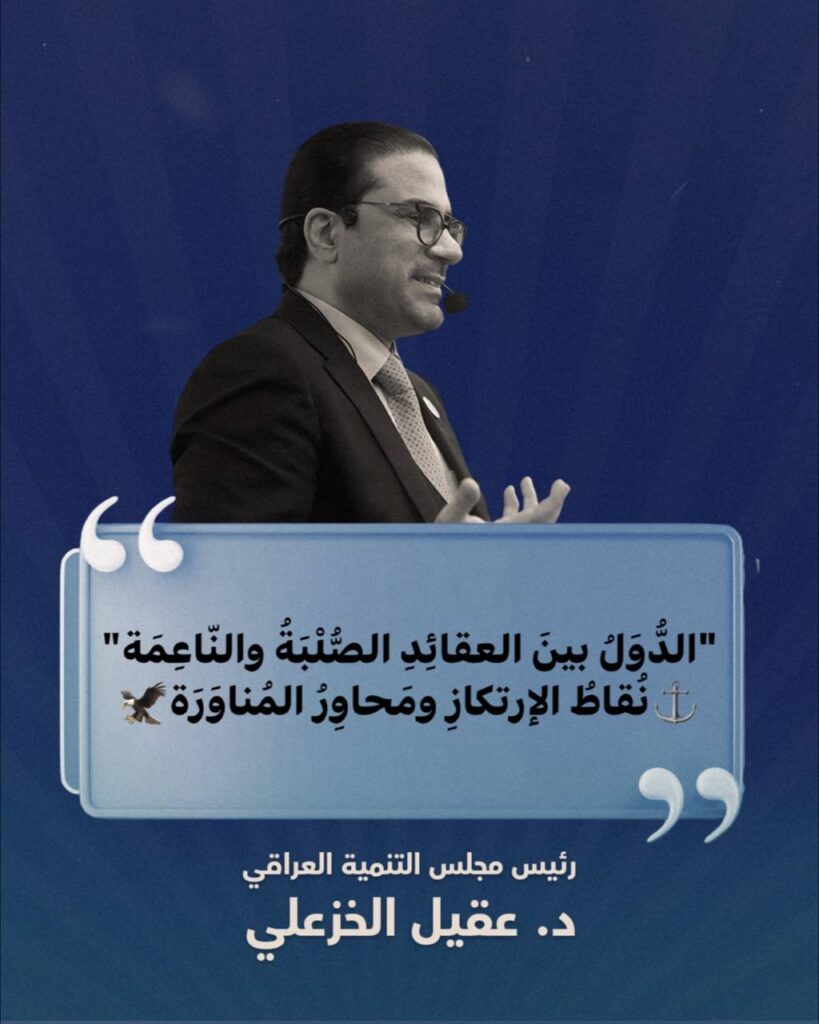
“الدُّوَلُ بينَ العقائِدِ الصُّلْبَةُ والنّاعِمَة”
⚓️نُقاطُ الإرتكازِ ومَحاوِرُ المُناوَرَة🦅
اعداد:د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنميّة العراقي
🩶🩶🩶🩶🩶🩶🩶🩶🩶🩶🩶
“🌐 تشهد الساحة الدولية تحولات جذرية في طبيعة الدولة وأدوارها، تحت ضغط مستجدات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقنية متسارعة.
🔂هذه التحولات لم تعد تسمح للدولة بالبقاء على حالها ضمن القوالب التقليدية التي تأسست عليها بعد الحربين العالميتين، أو حتى بعد انتهاء الحرب الباردة.
🎭 لقد أصبحت الدول مطالبة بالاختيار بين تبني عقائد (صلبة) أو (ناعمة) لتحديد هويتها واستراتيجياتها على المستوى المحلي والدولي.
🪨 تشيرُ (العقائدُ الصلبةُ) إلى ذلك الإطار الفكري الصارم الذي يبني الدولة على أسس واضحة لا تقبل التأويل، وغالبًا ما تكون مستمدة من أيديولوجيات قومية أو دينية أو اقتصادية واضحة.
تمتاز الدول التي تتبنى (العقائد الصلبة) بالتماسك الداخلي ولكنها تميل إلى الانغلاق على نفسها ورفض التعددية، مما يجعلها عُرضة للتأخر عن مواكبة التحولات الدولية، ومثال ذلك، الاتحاد السوفيتي السابق، الذي اعتمد على أيديولوجيا شيوعية صارمة، ما جعله يصطدم بواقع عالمي لم يعد يقبل تلك الرؤية الأحادية، وانتهى الأمر بتفككه بسبب عدم قدرته على التكيّف.
🗿 على مستوى آخر، نجد أن الأنظمة التي تتبنى العقائد الصلبة قد تحقق استقرارًا داخليًا لفترة مؤقتة، لكنها تعاني من ضعف في القدرة على بناء علاقات خارجية مرنة، مما يؤثر على مكانتها في النظام الدولي.
🪶🪶🪶في المقابل،تمثل (العقائد الناعمة) فلسفة مرنة تعتمد على القدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية دون التضحية بالهوية الوطنية، من خلال سياسات تقوم على تعزيز قوة الدولة من خلال (الدبلوماسية والثقافة والتعليم والابتكار).
🖼️ تسعى الدول ذات العقائد الناعمة إلى بناء صورة إيجابية على الساحة الدولية، مما يمنحها قوة ناعمة تجذب الحلفاء والشركاء بدلًا من مواجهتهم. 🎇 أحد أبرز الأمثلة على هذه العقيدة هو التجربة الإسكندنافية التي نجحت في تحقيق نموذج متوازن يجمع بين القيم المحلية والتفاعل الإيجابي مع العالم، حيث استطاعت دول مثل السويد🇸🇪 والنرويج 🇳🇴والدنمارك 🇩🇰تقديم نفسها كقوى مؤثرة في مجالات حقوق الإنسان والاستدامة البيئية والتعليم.
➕ لكن السؤال الجوهري يبقى: هل يمكن للدول أن تجمع بين العقائد الصلبة والناعمة⁉️
هنا يظهر التحدي الحقيقي، فالدول التي تنجح في المزج بين العقيدتين تمتلك القدرة على تحقيق استقرار داخلي من خلال تبني إطار فكري صلب يحمي هويتها، مع الانفتاح على الخارج باستخدام أدوات ناعمة، وتجربة الصين الحديثة🇨🇳 تمثل مثالًا بارزًا على هذا المزج، حيث تعتمد على أيديولوجيا الحزب الشيوعي كعقيدة صلبة في الداخل، لكنها تتبنى سياسة خارجية ناعمة تستند إلى (الاقتصاد والثقافة)، ومشروع “الحزام والطريق” يعكس هذا النهج، حيث تسعى الصين إلى تحقيق الهيمنة الاقتصادية عبر أدوات ناعمة تغطي أكثر من 60 دولة، مما يعزز مكانتها دون الحاجة إلى المواجهة العسكرية.
🤖 هذه التحولات تطرح أيضًا أسئلة حول دور التكنولوجيا في تعزيز العقائد الصلبة والناعمة.
📱ففي عصر (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتقنيات الرقمية)، أصبح من الممكن للدول استخدام هذه الأدوات لتعزيز قدراتها على المستويين الداخلي والخارجي.
🕹️تستفيد العقائد الصلبة من التكنولوجيا لتعزيز سيطرة الدولة على شعوبها من خلال الرقابة والتحكم، كما هو الحال في تجربة بعض الدول التي تعتمد على نظم المراقبة المتقدمة لتقوية قبضتها الأمنية.
🎞️ بينما تستخدم الدول ذات العقائد الناعمة التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والتعليم والتفاعل الثقافي، مما يجعلها قادرة على بناء قوة ناعمة مستدامة.
🏝️ على المستوى الإقليمي، تتضح هذه المعادلة بشكل جلي في الشرق الأوسط، حيث تتصارع الدول بين العقائد الصلبة والناعمة، حيث تعتمد بعضها على أيديولوجيا دينية قوية (صلبة) لتعزيز دورها الإقليمي، لكنها تواجه تحديات كبيرة في بناء علاقات خارجية مرنة. في المقابل، نجد أن الاخرى نجحت في بناء نموذج للعقيدة الناعمة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، والتعليم، والدبلوماسية الثقافية، مما جعلها محورًا إقليميًا ودوليًا رغم صغر حجمها الجغرافي.
👈🏼في المحصّلة، يمكن القول إن المستقبل سيشهد صراعًا محتدمًا بين الدول التي تتبنى العقائد الصلبة وتلك التي تعتمد على العقائد الناعمة.
🎢 الدول التي ستنجح في تحقيق التوازن بين الجانبين هي التي ستتمكن من البقاء والتفوق في عالم سريع التغير.
🔀 ان المزج بين صلابة المبدأ ومرونة التطبيق يمثل الطريق الأمثل لدولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في آن واحد.
لقد أذِنَ العَصرُ السيّالُ الهجينُ بتقلُباتِهِ، فهل ستتمكّنُ الدُّوَلُ من مُجاراتِهِ، أم أنها أدمنت العمى ودفع الضرائب، وسيبقى الوجودُ مُرَجِّحاً للأكثِرِ تَكيّفاً (دولاً، أمماً، مؤسسات، جماعات، أفراد )!.
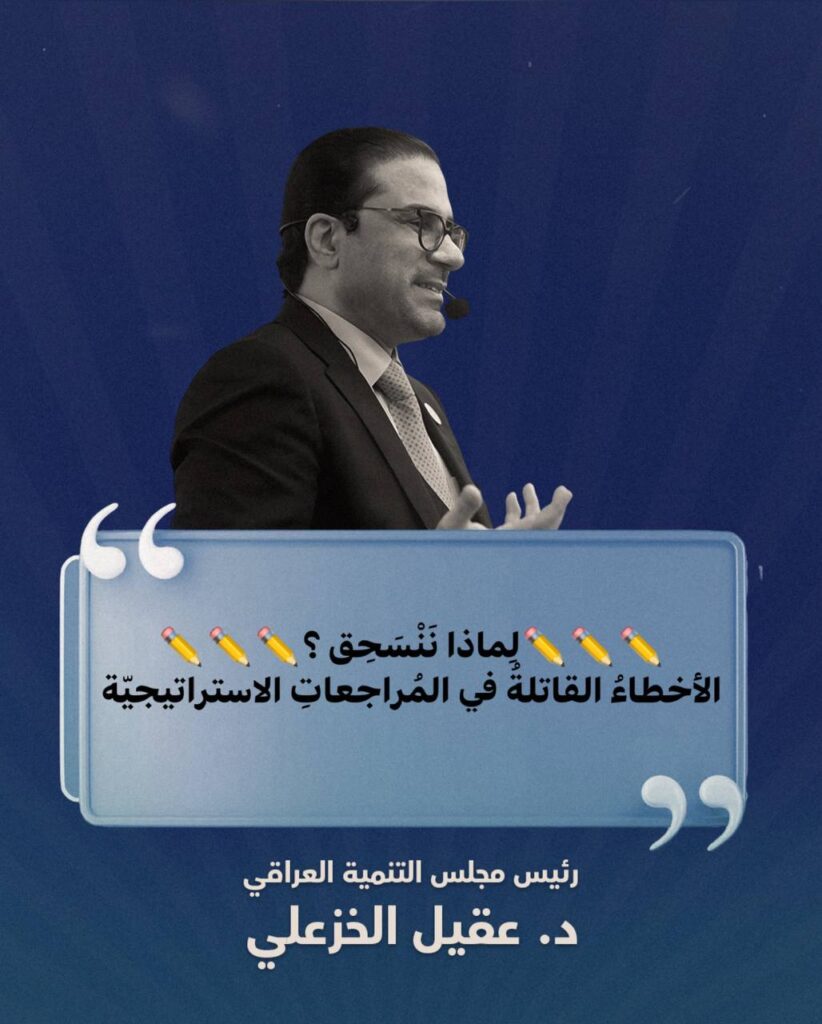
✏️✏️✏️لِماذا نَنْسَحِق ؟✏️✏️✏️
الأخطاءُ القاتلةُ في المُراجعاتِ الاستراتيجيّة
اعداد:د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنميّة العراقي
🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️🕳️
” 🧠 إنّ العقل الإنساني في سعيه الدؤوب لفهم الديناميكيات المعقدة للعلاقات بين الدول والمؤسسات والجماعات غالباً ما يقع في محاكاة تجريبية (لتقييم الأداء، مراجعة الاستراتيجيات، وصياغة التغذية العكسية) بهدف تصحيح المسارات وتحقيق الأهداف الكبرى، غير أن هذا المسعى الفكري والتنفيذي، الذي يبدو للوهلة الأولى بسيطاً أو بديهياً، ينطوي في الواقع على تحديات عميقة وأخطاء قاتلة تقود إلى (الفشل أو الهدم المنهجي للمنظومات)، لا سيما حينما يتم إغفال المكونات الأساسية (للعقلانية الاستراتيجية) و(أسس التجارب الناجحة)، ولفهم هذا الإشكال، لا بد من الغوص في المفاهيم المرتبطة (بالعقل الاستراتيجي، طبيعة المراجعات، ومنهجية التغذية العكسية المستدامة)، مع تحليل الأخطاء الجوهرية التي تقوّض الجهود وتعرّض النظم للخطر.
🧠⚖️🧠 في ميزان العقل والتجارب، تظهر الدول والمؤسسات والجماعات على هيئة كائنات ديناميكية تتفاعل مع بيئات متغيرة باستمرار، محكومة بقوانين معقدة تجمع بين الحتمية والتكيف، حيث ان تجربة التاريخ الحديث مليئة بشواهد ساطعة على الأدوار المحورية (للعقلانية الاستراتيجية) في نجاح الدول، من (اليابان🇯🇵) التي نهضت من رماد الحرب العالمية الثانية🔥 بفضل المراجعات العميقة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى (ألمانيا🇩🇪)التي تجاوزت آثار الانقسام والصراع لتصبح قوة اقتصادية عالمية.
غير أن هذه النجاحات ليست معصومة من الخطأ؛ إذ (إن الخطأ في مراجعة الاستراتيجيات وتوظيف التغذية العكسية قد يحوّل الإنجاز إلى كارثة). أحد الأمثلة الحديثة لذلك يتمثل في الأزمة المالية العالمية لعام 2008، التي نشأت جزئياً عن التغذية العكسية غير السليمة للنظم الاقتصادية العالمية، حيث أغفلت الدول الكبرى إشارات التحذير المرتبطة بالمخاطر الهيكلية في النظام المالي.
💣 الخطأ القاتل الأول في هذا السياق هو (التمركز حول الذات)، سواء كان ذلك في الدول أو المؤسسات أو الجماعات. حينما تُغلّب المصالح الفردية الضيقة على المصالح العامة، تصبح المراجعات الاستراتيجية غير موضوعية، ويُساء فهم البيئة الخارجية، والأمثلة متعددة على ذلك، فمن السياسات (الأمريكية🇺🇸) في الشرق الأوسط التي اتسمت بفشل مستمر نتيجة عدم قراءة دقيقة للمجتمعات المحلية، إلى انهيار (الاتحاد السوفيتي⚒️ )الذي عجز عن التعامل مع التغيرات الداخلية والخارجية بمرونة كافية. هذا التمركز يؤدي أيضاً إلى تجاهل أهمية الانفتاح على النقد البنّاء والآراء البديلة، وهو خطأ قاتل في كل مراجعة استراتيجية.
💣 الخطأ الثاني يكمن في التعامل مع المراجعات الاستراتيجية (كتقارير روتينية) تُقدّم في مواعيد محددة دون أن تكون جزءاً من عملية مستدامة تتسم بالتكيف والتطوير، وهنا تتحوّل التغذية العكسية إلى ممارسة شكلية تغفل التفاصيل الحيوية والمؤشرات المبكرة التي قد تكون حاسمة لتجنب الكوارث.
ان المؤسسات التي تتبع هذا النهج غالباً ما تفشل في الاستفادة من تجاربها، مثلما حدث مع شركات عملاقة مثل (نوكيا📞 وكوداك🎞️)، اللتين تجاهلتا إشارات التغير في سوق التكنولوجيا، مما أدى إلى انهيارهما أمام المنافسين.
💣 الخطأ الثالث هو (نقص الاستباقية)، حيث تُركّز المراجعات الاستراتيجية والتغذية العكسية على معالجة الأزمات بعد وقوعها بدلاً من منعها. هذا الخطأ غالباً ما ينتج عن غياب الرؤية بعيدة المدى أو استهانة بصغائر الأمور التي قد تتحول لاحقاً إلى تحديات كبرى. المثال هنا هو (الأزمة البيئية العالمية🌪️)، التي تفاقمت بسبب تجاهل مؤشرات مبكرة على خطورة التغير المناخي، ما أدى إلى وضع العالم على حافة كارثة بيئية غير مسبوقة ومستدامة.
💣 الخطأ الرابع يتجسد في (غياب التكامل) بين الأبعاد المختلفة للمراجعات الاستراتيجية والتغذية العكسية، ففي كثير من الأحيان، يتم التعامل مع (السياسة، الاقتصاد، الأمن، والمجتمع) كجزر معزولة دون الأخذ بعين الاعتبار التداخل العميق بين هذه القطاعات، وهذا التجزؤ يؤدي إلى حلول غير مكتملة أو حتى متناقضة. مثال على ذلك هو الفشل في تحقيق الاستقرار في دول ما بعد الصراع مثل (أفغانستان🇦🇫)، حيث أدى غياب استراتيجية متكاملة تجمع بين البعد الأمني والتنموي والاجتماعي إلى خلق أزمات متجددة.
💣 اما الأمر الأكثر خطورة هو التعامل مع التغذية العكسية (كعملية نهائية) بدلاً من كونها جزءاً من حلقة مستمرة للتعلم والتطور، فالتغذية العكسية المستدامة تعني أن النتائج المستخلصة من المراجعات يجب أن تُعاد إلى المنظومة بشكل يضمن التحسين المستمر للسياسات والإجراءات.
ان عدم الالتزام بهذا المبدأ يؤدي إلى (تكرار الأخطاء)، كما في الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من (دول العالم الثالث🌍) نتيجة افتقارها لمنظومات رصد وتحليل حقيقية.
💊 لتجنب هذه الأخطاء، لا بد من تبني نهج شامل يعتمد على العقلانية والتحليل المتوازن للتجارب.
✅أولاً، يجب أن تكون المراجعات الاستراتيجية والتغذية العكسية عملية مستدامة ومتكاملة، تبدأ من تحديد أهداف واضحة ومؤشرات دقيقة للقياس، مع تعزيز آليات التكيف السريع.
✅ثانياً، يجب تشجيع ثقافة الانفتاح على النقد البنّاء وتعزيز التفكير الجماعي الذي يدمج كافة الأطراف المعنية.
✅ثالثاً، لا بد من الاستثمار في البنية التحتية للمعلومات والبيانات التي تشكل حجر الزاوية لأي مراجعة استراتيجية ناجحة.
✅وأخيراً، يجب تطوير نماذج متقدمة للذكاء الاستراتيجي تستفيد من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم عملية اتخاذ القرار.
🎯 في النهاية، فان الدرس الأكبر الذي يقدمه التاريخ والتجارب هو أن (الاستراتيجيات الناجحة ليست تلك التي تتجنب الأخطاء بالكامل، بل تلك التي تتعلم منها باستمرار)، وان (العقلانية والتجربة) هما الميزان الحقيقي لنجاح الدول والمؤسسات والجماعات، وكل خلل في هذا الميزان يقود إلى نتائج قد تكون كارثية على المدى البعيد، وكل مايجري في الشرق الاوسط والعالم هو خير شاهد ودليل، ويبقى السؤال؛ هل من مُراجِع ومُتَّعِظ ومُصَحِّح🤔؟!.
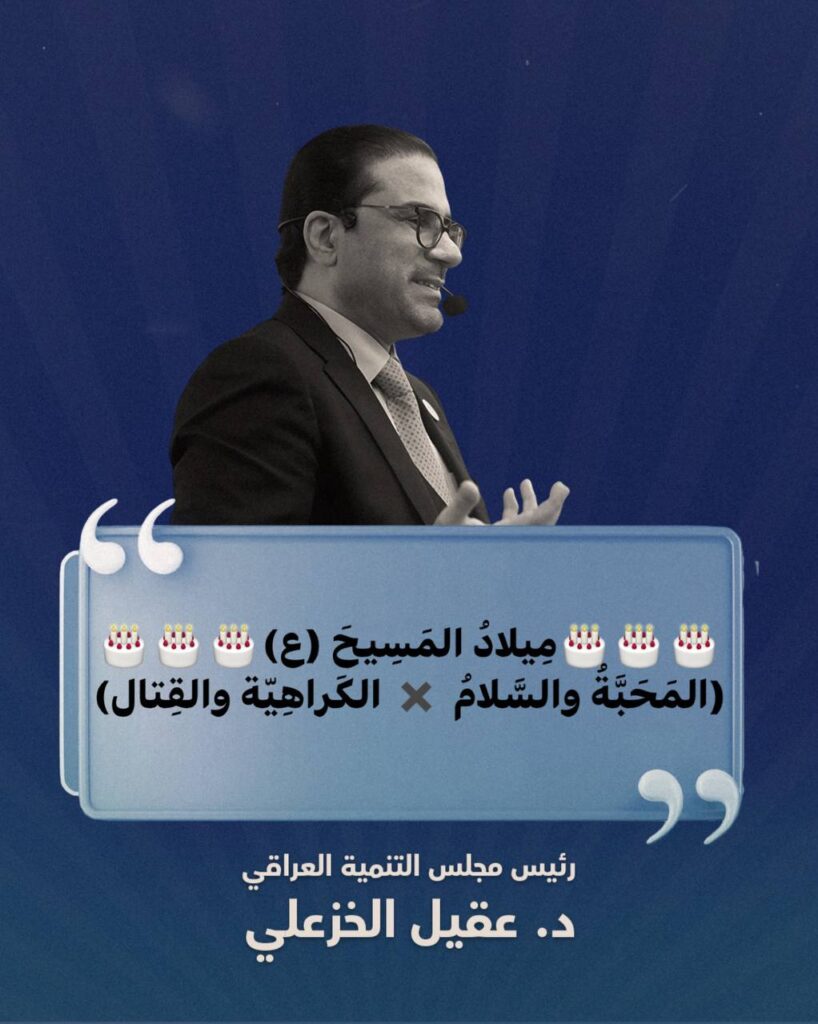
🎂🎂🎂مِيلادُ المَسِيحَ (ع)🎂🎂🎂
(المَحَبَّةُ والسَّلامُ ✖️ الكَراهِيّة والقِتال)
د.عقيل الخزعلي
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
🌟 “المِيلادُ المَجيدُ؛ هِدايَةٌ في عَصْرِ التَّطَرِّفِ والظَّلام، وَدَعْوَةٌ لِلْمَحَبَّةِ فِي زَمَنِ الكَراهِيّةِ وَالانقِسَام.”
🤝 “وُلِدَ المَسِيحُ لِيُعَلِّمَنَا أَنَّ الطَّريقَ إِلَى اللهِ يَمُرُّ مِن خِدْمَةِ الإِنسَانِ وَمَحَبَّتِهِ.”
🌉 “فِي ذِكرَى الوِلادَةِ المُجِيدَةِ، لِنَكُن صُنَّاعَ سَلامٍ وَبَانِيِي جُسُورِ الوِئَام.”
❤️ “مَقولَةُ المَسِيحِ: (أَحِبُّوا أَعدَاءَكُم)، أعظَمُ تَرجُمانٍ (للقُوَّةِ وَالعَظَمَةِ)، فالسَّلامُ بِحاجَةٍ لِقُوَّةِ (البَصيرة)، والحَربُ نُزوعٌ لِلَوثَّةِ (التَّوَحش).”
✨ “طُوبَى لِمَن يَجْعَلُ مِنَ (المَحَبَّةِ رَسَالَةً)، وَمِنَ (العَدلِ سَبِيلاً)، وَمِنَ (السَّلامِ عِبَادَةً).”
🕯️ “لِتَكُن كَلِمَةُ المَسِيحِ: ‘أَحبُّوا بَعضَكُم بَعضاً’ عَهدًا يُجَدِّدُ (الوَطَنَ) وَيُحَرِّرُ (النُّفوسَ).”
🌾 “وِلادَةُ المَسِيحُ فِي مَغَارَةٍ تُعَلِّمُنَا أَنَّ العَظَمَةَ فِي (التَّواضُعِ)، وَالقُوَّةَ فِي (المَحَبَّةِ).”
🕊️ “السَّلامُ لَيسَ كَلِمات، بَل (مشروع) يزرَعُ فِي القُلُوبِ (المَحَبَّةِ)، وفي السلوكِ (المِصداقيّة).”
🌟 “فِي عِيدِ المِيلَادِ، عَلينا أن نَسَجِّل عَهدَ الإِنسَانِ الجَدِيدِ: (كُرْهٌ لِلكَراهِيّةِ وَحُبٌّ لِلمَحَبَّةِ).”
✨ “مَيلادُ المَسِيحِ هُوَ تَذكِرَةٌ للمِيعَاد الأَزَلِيّ لِلقِيَمِ التِي تُنهِضُ الإِنسَانَ: (المَحَبَّةُ، العَدلُ، وَالسَّلامُ).”
❌ “لَا سَلامَ فِي عَالَمٍ تَحكُمُهُ (الكَراهِيّة)، وَلَا مَحَبَّةَ فِي قَلبٍ تُغلِّفُهُ (الأَنَانِيّة).”
🤲🏼*اللهم اكفنا شَر الحروبِ وصُنّاعِها، وأيد مهندسي السّلامِ وبُناتَه*🤲🏼
🎄🎄🎄يومكم مبارك🎄🎄🎄
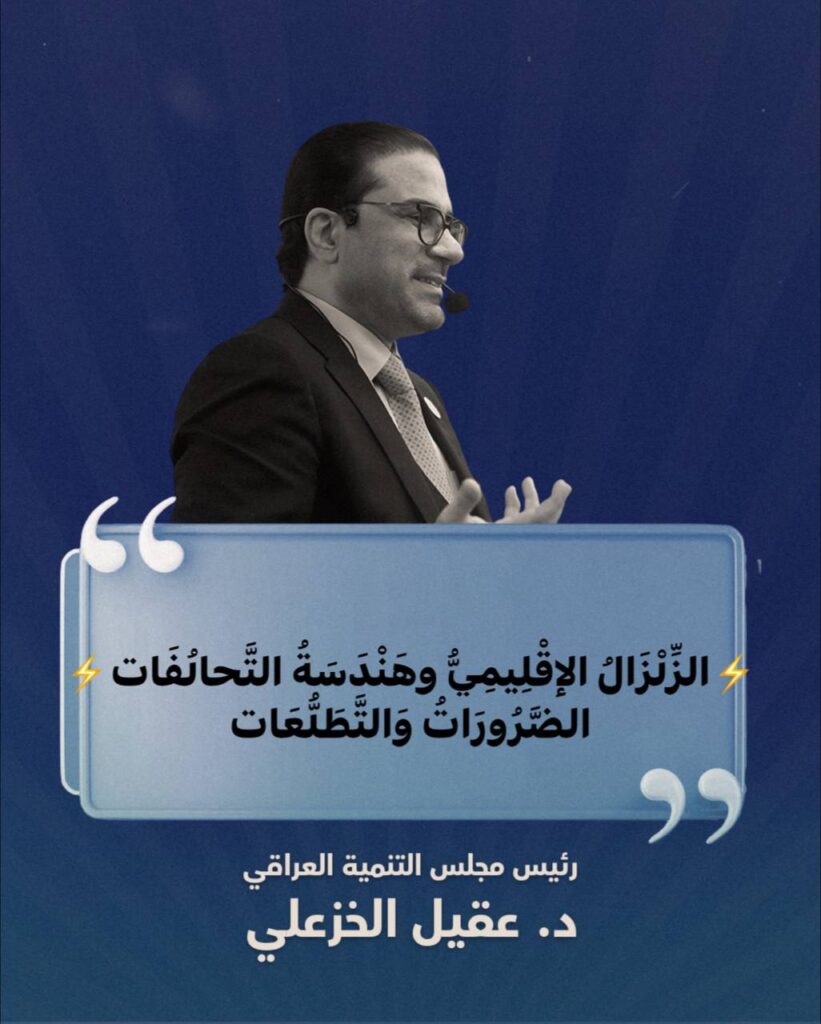
⚡️الزِّلْزَالُ الإقْلِيمِيُّ وهَنْدَسَةُ التَّحالُفَات⚡️
———الضَّرُورَاتُ وَالتَّطَلُّعَاتُ————
اعداد:د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐
“🌍 بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا والشرق الأوسط، فأن المنطقةُ الإقليمية تواجِهُ (زلزالًا جيوسياسيًّا🫨) يَعْصِفُ بثوابتها، ويُعيدُ (تشكيلَ خرائطها🗺️)بفعلِ طموحاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ تُخطِّطُ (لتفتيتِ الدولِ 🔪)و(إعادةِ صياغةِ النفوذِ🍰) وفقَ مصالحِها الضيِّقة.
⚡️لا يتجلَّى هذا (الزلزالُ) فقط في التحركاتِ العسكريةِ والمشاريعِ التوسُّعيةِ، بل يتوغَّلُ في الثقافاتِ والهوياتِ، فيسعى إلى (تآكلِ السيادةِ وإضعافِ الإرادةِ الوطنيةِ) لصالحِ منظوماتٍ أيديولوجيةٍ واقتصاديةٍ جديدةٍ تخدمُ القوى المهيمِنَةَ.
🔃 من هنا، تبرزُ الحاجةُ إلى بناءِ تحالفٍ إقليميٍّ عربيٍّ جامعٍ، ليكونَ صَمَّامَ أمانٍ أمامَ هذه المخططاتِ، وحائطَ صَدٍّ قِبالَ اراداتِ القضمِ والتجريفِ والتَّغَوّل، وقوَّةً متكاملةً تُعيدُ للمنطقة العربية الإقليميّة دورَها الرياديَّ في رسمِ ملامحِ مستقبلِ المنطقة، بَعيداً عن أحلام القوى والامبراطوريات الكُبرى – البائدة والناشئة – .
🤝 التنسيقُ الاقليمي العربيُّ المنشودُ ليسَ مشروعًا سياسيًّا عابرًا أو تحركًا تكتيكيًّا قصيرَ المدى، بل هو استجابةٌ حضاريةٌ واستراتيجيةٌ لتحدياتِ الزمانِ والمكانِ. فكما قالَ الفيلسوفُ الجيوسياسيُّ ماكندر: “مَنْ يُسيطِرُ على القلبِ الجغرافيِّ، يُسيطِرُ على العالم”. والمنطقةُ العربيةُ بما تملِكُهُ من موقعٍ استراتيجيٍّ وثرواتٍ طبيعيةٍ، هي هذا (القلبُ🫀) الذي يسعى الجميعُ للهيمنةِ عليهِ. لذلك، فإنَّ توحيدَ جهودِ الدولِ الاقليمية المُهدَدَة تحتَ مظلةِ (تحالفِ استراتيجي) يُعَدُّ ضرورةً وجوديةً تُمليها تحدياتُ الواقعِ وطموحاتُ المستقبلِ.
🪢 في الميدانِ السياسيِّ، تكمُنُ أهميةُ التحالفِ في توحيدِ المواقفِ تجاهَ القضايا الإقليميةِ والدوليةِ، لإنَّ السياسةَ لم تَبُتْ (فنَّ الممكنِ ) فقط، كما وصفَها بسمارك، بل هي فنُّ تحقيقِ المستحيلِ حين تتضافرُ الإراداتُ. لذلك، فإنَّ هذا تحالفَ يمكنُ أن يُصبحَ منصةً لتنسيقِ الجهودِ الدبلوماسيةِ وتعزيزِ الحضورِ العربيِّ في المحافلِ الدوليةِ، سواءٌ في مواجهةِ التدخلاتِ التي تسعى لإحياءِ الإرثِ البائِد، أو التصدّي للتَعَدّياتِ الإسرائيليةِ التي تهدفُ إلى تقسيمِ المنطقةِ وإضعافِ كياناتِها، من خلال تحالفه – اي الكيان الاسرائيلي- مع دوائِر وتيارات عالميّة واقليميّة (مشبوهة ومُريبة).
🛡️ أما في الجانبِ (الأمنيِّ والعسكريِّ)، فإنَّ التحالفَ يهدفُ إلى تنسيق الجهود الامنية لِمواجَهَةِ التهديداتٍ خارجيةٍ المُشتَرَكَة، فقد أثبتَ التاريخُ، وكما أكدَ كلاوزفيتز، (أنَّ الحروبَ تُحسَمُ بالإعدادِ الجيدِ والتنسيقِ المتكاملِ). ومن هنا، يمكنُ للتحالفِ تعزيز التعاونِ الاستخباراتيِّ بينَ الدولِ الأعضاءِ لمواجهةِ التهديداتِ الوجوديّة المشتركةِ.
🪙 في المجالِ الاقتصاديِّ، يُشَكِّلُ التحالفُ فرصةً لتحقيقِ التكاملِ بينَ الدولِ الأعضاءِ. وكما قالَ الاقتصاديُّ بول كروغمان: “الاقتصادُ ليسَ لعبةَ محصِّلةٍ صفريةٍ، بل هو ساحةٌ للفرصِ المشتركةِ🏟️”. لذلك، فإنَّ تعزيزَ التعاونِ الاقتصاديِّ عبرَ مشاريعَ مشتركةٍ في مجالاتِ الطاقةِ والبنيةِ التحتيةِ والتجارةِ يمكنُ أن يُساهِمَ في تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ وتقويةِ اقتصاداتِ الدولِ الأعضاءِ، مما يجعلُها أقلَّ عرضةً للابتزازِ الخارجيِّ، ويُحَصِّن امنها القومي المشترك.
🎭📺 الثقافةُ والإعلامُ هما جبهتانِ لا تقلانِ أهميةً عنِ السياسةِ والأمنِ والاقتصادِ، فمن خلالِ تعزيزِ الهويةِ العربيةِ المشتركةِ، يمكنُ للتحالفِ أن يُواجهَ محاولاتِ التفتيتِ الثقافيِّ والفكريِّ التي تستهدفُ المنطقةَ. وكما قالَ غرامشي: “السيطرةُ الثقافيةُ هي أساسُ الهيمنةِ السياسيةِ”. لذلك، فإنَّ إطلاقَ مَشروعاتٍ إعلاميةٍ مشتركةٍ وبرامجَ ثقافيةٍ وتعليميةٍ تُساهِمُ في تعزيزِ الوعيِ الجمعيِّ بمخاطرِ المرحلةِ يُعَدُّ من أولوياتِ التحالفِ.
🌦️ إنَّ هذا التحالفَ لا يهدفُ فقط إلى مواجهةِ التحدياتِ، بل يسعى أيضًا إلى تحويلِها إلى فرصٍ. فالتحدياتُ⚠️، كما وصفَها هنري كيسنجر، ليستْ سوى أزماتٍ تحملُ في طياتِها إمكانياتٍ جديدةً للتغييرِ، ومن هنا، يمكنُ لتحالفِ “مسار عام” أن يُصبحَ نموذجًا يُحتذى بهِ في التعاونِ الإقليميِّ، مما يُعيدُ للمنطقة مكانتَها في النظامِ العالميِّ.
🎯 وبالمُحَصّلَة، فأن التحالف ليسَ خيارًا تكتيكيًّا، ولا مَشروعَ إستعداءٍ لأي:(حليف وشقيق وصديق)، بل هو ضرورةٌ استراتيجيةٌ لِصَدِّ مُخططات التفتيتِ والهيمنةِ في المنطقة الاقليمية، كما ان التحالف هو (نواةُ شروعٍ) لدخول اي طرفٍ فيه متى ما آمن بأهدافه وانسجم مع مراميه، وكما قالَ ابن خلدون: “الملكُ لا يتمُّ إلا بالعصبيةِ”.
فإنَّ وحدةَ الدولِ وتكاملَ جهودِها هما السبيلُ الوحيدُ لضمانِ مستقبلٍ مستقرٍّ وآمنٍ للأجيالِ القادمةِ. وعلى الرغمِ من (التحدياتِ🔨) التي قد تواجهُ إنشاءَ هذا التحالفِ، فإنَّ (الإرادةَ السياسيةَ💪🏼 والرؤيةَ المشتركةَ👁️) يمكنُ أن تُحَوِّلاهُ إلى (حقيقةٍ ملموسةٍ🏣) تُمَثِّلُ ركيزةَ الأمنِ والاستقرارِ والإزدهار في المنطقةِ الإقليمية، لِذَلَكَ يَنبَغي الإستعجال قبل تدحرج (كُرة الإنهاكِ والتقسيمِ☄️) الى جُغرافياتٍ اخرى تُحاصرها (الأطماع🤤) من كل (الإتجاهات🧭) !.”
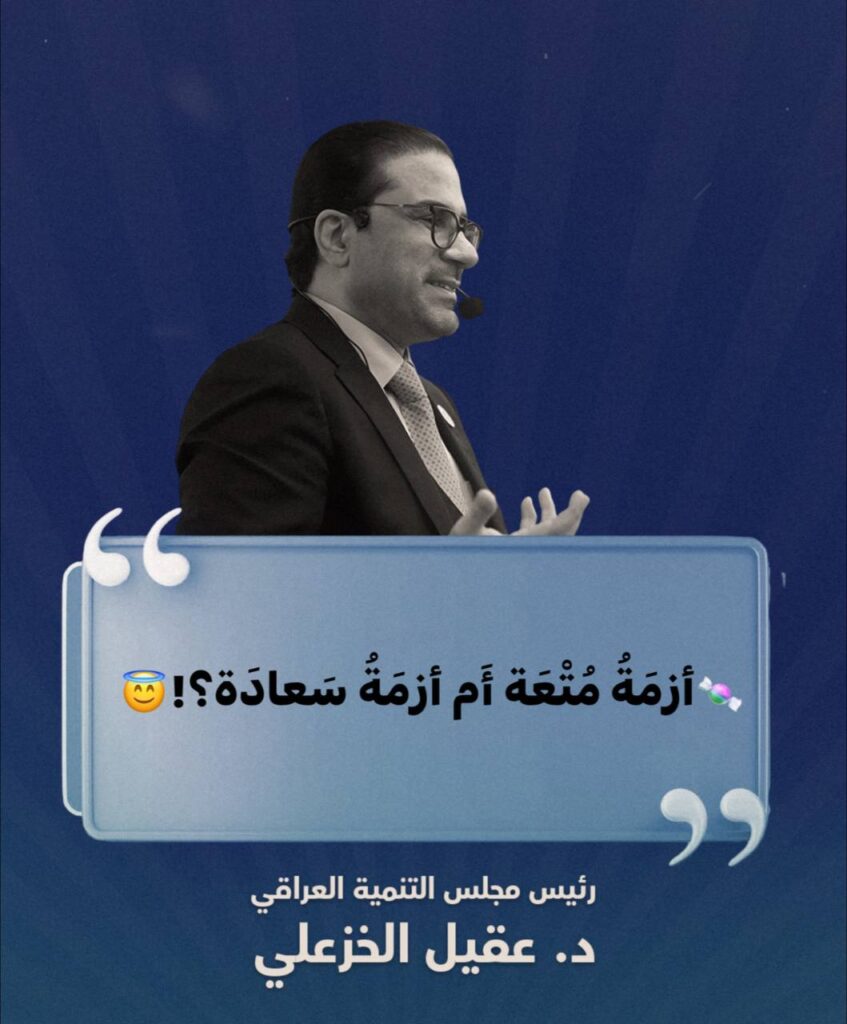
🍬أزمَةُ مُتْعَة أَم أزمَةُ سَعادَة؟!😇
اعداد:د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنميّة العراقي
😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
” 📱 في عصرنا الراهن، حيث تُفرَضُ على الإنسان أنماط حياتية متسارعة ومتشابكة، يُطرح السؤال الأهم: هل نبحث عن (السعادة أم المتعة)؟ ، هذا التساؤل العميق يستدعي تفكيك مفهومين يُستعملان كثيرًا في الخطاب اليومي، لكنهما مختلفان في جوهرهما. (السعادة🤗) مفهوم شامل وراسخ، يرتبط بالإحساس العميق بالرضا عن الحياة وتحقيق الذات، في حين أن (المتعة🎰) هي تجربة لحظية عابرة تتعلق باللذة الحسية أو العاطفية. لذا، فإن الاختيار بينهما ليس مجرد قرار شخصي بل (فلسفة حياة🎨).
🤗السعادة تُعتبر حالة دائمة نسبياً، ترتكز على (القيم، المعاني، والعلاقات الإنسانية العميقة)، إنها تتجاوز الأوقات الجيدة أو السيئة لتكوّن شعوراً بالقبول والامتنان، إذ تُشير الأبحاث النفسية إلى أن السعادة تعتمد بشكل كبير على الشعور (بالانتماء الاجتماعي، الإنجاز الشخصي، والقدرة على التعامل مع التحديات). في المقابل، تعتمد (المتعة🍭 ) على محفزات خارجية تُثير مراكز اللذة في الدماغ، مثل تناول وجبة لذيذة أو مشاهدة فيلم ممتع. هذا الفارق الجوهري يجعل المتعة قصيرة الأمد وتزول بزوال المُحفز، بينما السعادة تمتد وتتحقق من خلال عمليات داخلية عميقة.
☕️ على سبيل المثال، لنتأمل في شخص ينغمس في حياة المتعة، سواء كان ذلك عبر تسوق مستمر، أو تناول الأطعمة الفاخرة، أو الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي. قد يشعر هذا الشخص بالسعادة اللحظية، لكن سرعان ما يعود إلى حالة من الفراغ الداخلي، لأن المتعة وحدها لا تمنحه إحساساً بالهدف أو الإنجاز.
🎯من جهة أخرى، إذا نظرنا إلى شخص يستثمر في بناء علاقات صحية، أو يسعى لتحقيق أهداف شخصية أو مهنية، فإن هذا الشخص يعزز شعوره بالسعادة، حتى في غياب المتع اللحظية، الفرق هنا أن السعادة تُبنى على استراتيجيات طويلة المدى تؤسس لمعنى أعمق للحياة.
🔬 يُبرهن علم النفس الإيجابي على هذا الاختلاف. أظهرت دراسة قام بها مارتن سليجمان، أحد أبرز مؤسسي هذا المجال، أن السعادة تنبع من ثلاثة عناصر رئيسية: (العاطفة الإيجابية، الانخراط، والمعنى).
(العاطفة الإيجابية♥️) تشمل اللحظات السعيدة، لكن (الانخراط والمعنى😇) يتطلبان مجهوداً واعياً لبناء حياة ذات (قيمة⬆️).
في المقابل، ترتبط (المتعة🍧) فقط بالعنصر الأول، مما يوضح ضحالة تأثيرها على تحقيق (الإشباع الكلي🫃).
👨🔬من الشواهد الحية لهذا النقاش هو تجربة الكاتب النمساوي فيكتور فرانكل، الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية. في كتابه “البحث عن المعنى”، يُظهر فرانكل كيف أن (الشعور بالمعنى🎯) كان المحرك الأساسي لبقائه على قيد الحياة، حتى في أشد الظروف قسوة😖. بينما كان منغمساً في الألم والحرمان، استطاع أن يجد السعادة من خلال إيمانه بأن لحياته رسالة أكبر💌. وهذا يوضح أن السعادة الحقيقية تتطلب عمقاً وقدرة على تجاوز اللحظة الراهنة.
🤏🏽على الرغم من ذلك، لا يجب التقليل من شأن المتعة. (فالمتعة🎮) بحد ذاتها، جزء من التجربة الإنسانية، ولا غنى عنها لتوازن الحياة.
👈🏼لحظة (المتعة🕹️) قد تكون شرارة تساعدنا على الاستمرار أو تمنحنا استراحة نحتاجها في خضم الضغوط. لكن (الخطر🔥) يكمن في تحويل (المتعة🤾♂️) إلى هدف أساسي، لأن ذلك يؤدي إلى حلقة مفرغة من (الإدمان🦠 ) على البحث عن اللذة دون تحقيق الإشباع النفسي الحقيقي.
🎭 في السياق الاجتماعي، يمكن ملاحظة الفرق بين مجتمع يركز على السعادة وآخر يركز على المتعة. المجتمعات التي تعزز (القيم💕) مثل (التكافل الاجتماعي، التعليم، والتطوير الذاتي) تميل إلى إنتاج أفراد أكثر سعادة واستقراراً🔺.
أما المجتمعات التي تُغرق أفرادها في (ثقافة الاستهلاك والترفيه السطحي🎲)، فإنها غالباً ما تشهد ارتفاعاً في معدلات (القلق والاكتئاب☹️)، رغم وفرة الموارد المادية💲.
في نهاية المطاف، الاختيار بين السعادة والمتعة ليس خياراً مطلقاً بين أحدهما على حساب الآخر، بل هو (توازن ذكي ⚖️) بين (اللحظة الحاضرة❣️ والطموحات المستقبلية🌅).
تقتضي السعادةُ (رؤية بعيدة المدى 👁️) واستثماراً مستمراً في (الذات والعلاقات والمجتمع🤝)، بينما تُكمل المتعة هذه الرحلة بمنحنا (جرعات🧪) من الفرح العابر. لذا، إذا كنت تبحث عن حياة ذات معنى، فالخيار الأذكى هو السعي وراء السعادة مع ترك مساحة للمتعة، لأن كلاهما يُثري التجربة الإنسانية بطرق فريدة ومتكاملة، و” لاخيرَ في النوافِلِ إذا أضرتْ بالفرائِض”.
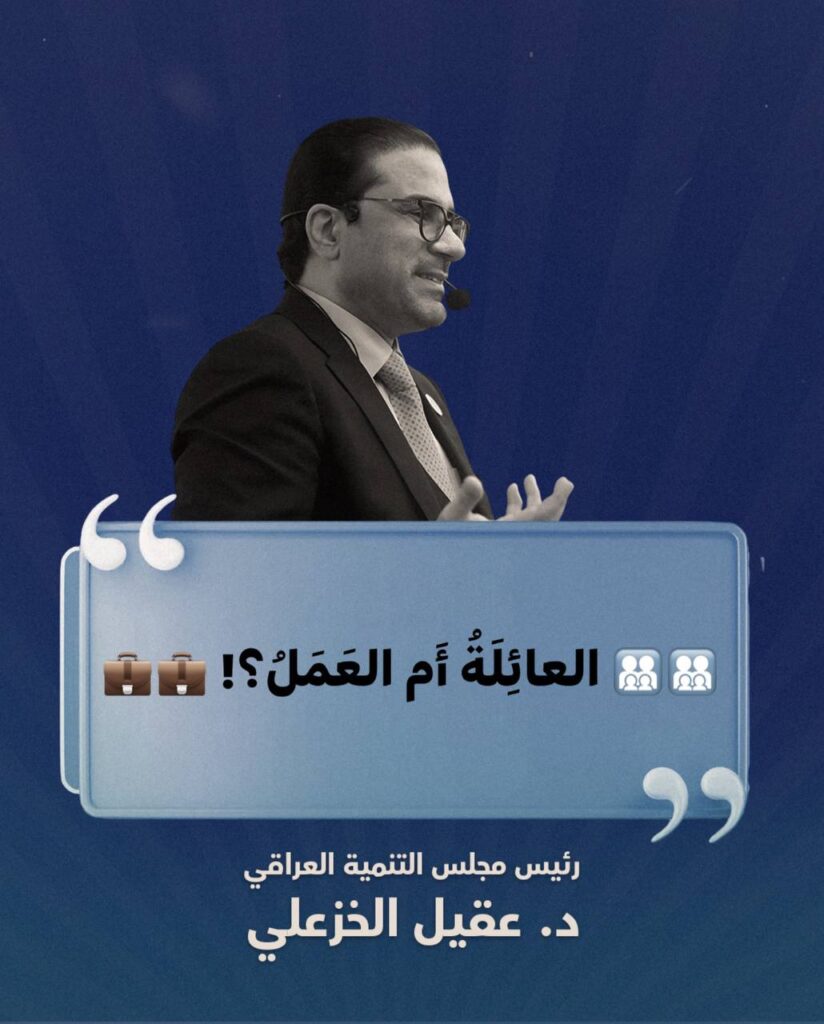
🧑🧑🧒🧒🧑🧑🧒🧒 العائِلَةُ أَم العَمَلُ؟! 💼💼
– كلمةُ السّر “معا” –
اعداد:د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞
” 👨🚀 يعيشُ الإنسان المعاصر اليوم في معادلةٍ بالغة التعقيد بين متطلبات العمل الذي يسعى من خلاله إلى (تحقيق الذات، واستقرار الموارد المالية، ومواجهة تحديات السوق)، وبين احتياجات الأسرة التي تشكل محورًا أساسيًا من حياته الإنسانية والاجتماعية.
🌗 هذه الثنائية، التي قد تبدو أحيانًا متناقضة، تفرض على الفرد أن يجد توازنًا دقيقًا يُبقي كفتي العمل والعائلة في حالة انسجام. في هذا السياق، تبرز ثلاثية “معا”، المتمثلة في (م=الموارد، ع=العمليات، ا=الأولويات)، كمنهج عملي لفهم هذه الإشكالية وإدارتها بفعالية.
🧱 (الموارد)/بناء الأساس المتين
تعتبر الموارد في هذا السياق حجر الزاوية للتوازن بين العمل والعائلة، وتشمل الموارد (الزمنية⌚️، والمالية💲، والإنسانية❤️).
فالوقت⌚️، باعتباره المورد الأكثر ندرة، يُمثل التحدي الأكبر، حيث إن إدارة الوقت بين ساعات العمل ومتطلبات العائلة تستدعي وعيًا عميقًا بأهمية تخصيص فترات منتظمة للتفاعل الأسري، مثل تناول الوجبات معًا، أو قضاء عطلات نهاية الأسبوع بعيدًا عن ضغوط العمل.
كذلك، تأتي الموارد المالية💲كعنصر حاسم، فغياب الاستقرار المالي يُلقي بظلاله على التوازن، مما يجعل التخطيط المالي السليم ضرورة لإشباع احتياجات الأسرة دون المبالغة في ساعات العمل. أما الموارد الإنسانية❤️ فتتمثل في بناء شبكة دعم، مثل تعاون الزوجين، أو الاستعانة بالأصدقاء والعائلة عند الحاجة، لضمان استدامة التوازن.
⚙️ (العمليات)/ديناميكية التنفيذ
إذا كانت الموارد هي الأساس، فإن العمليات تمثل الطريقة التي تُدار بها تلك الموارد لتحقيق التوازن.
تشمل إدارة العمليات (التخطيط📈 والتنظيم⚖️ والاتصال👥)،
فالتخطيط الجيد📈 يبدأ بوضع أهداف مشتركة لكل من العمل والعائلة، وتحديد خطوات واضحة للوصول إليها، مثل (تقسيم المهام اليومية بين أفراد الأسرة أو تحديد أوقات محددة للتركيز على المشاريع المهنية).
بينما يتطلب التنظيم⚖️ تقسيم الأدوار والمسؤوليات، سواء كان ذلك في مكان العمل أو داخل الأسرة. فإشراك الشريك أو الأبناء في مهام الأسرة يُخفف العبء ويعزز الشعور بالمشاركة.
أما الاتصال👥، فهو المفتاح لضمان فهم متبادل بين جميع الأطراف. فمثلاً، يمكن للفرد أن يشرح لضغوط العمل لشريك حياته بشكل يعزز التفاهم، أو أن يوضح لرؤسائه أهمية الالتزام بوقت الأسرة دون المساس بالإنتاجية.
🧭(الأولويات)/بوصلتك نحو الانسجام
يبقى تحديد الأولويات هو التحدي الأكبر. لا يمكن تحقيق التوازن دون إدراك واضح لما هو أكثر أهمية في لحظة معينة، فالأولويات تتغير مع مرور الوقت؛ فقد تكون هناك أوقات يتطلب فيها العمل اهتمامًا مكثفًا لإنجاز مشروع معين، وأوقات أخرى تحتاج فيها العائلة إلى دعم كامل مثل عند مواجهة أزمة شخصية أو مناسبة خاصة. يعتمد النجاح✅ في إدارة الأولويات على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات واعية بناءً على الموقف، على سبيل المثال، إذا تزامن اجتماع عمل مع مناسبة عائلية هامة، فإن وضع مصلحة الأسرة في المقدمة أحيانًا يعزز العلاقات العائلية بشكل يدعم العمل على المدى الطويل.
👈🏼وبالمحصّلة، فأن الثنائية بين العمل والعائلة ليست صراعًا بل فرصة لبناء حياة أكثر توازنًا واستقرارًا، وثلاثية “معا”، التي تستند إلى الموارد والعمليات والأولويات، تقدم إطارًا شاملًا لإدارة هذه الثنائية بوعي ومسؤولية، (بالاستثمار في الموارد بحكمة)، (وتطبيق العمليات بكفاءة)، (وتحديد الأولويات بمرونة)، يمكن للإنسان أن يحيا حياة متوازنة تُلبي تطلعاته المهنية وتُثري علاقاته العائلية. ⚖️التوازن ليس هدفًا يُحقق مرة واحدة، بل هو عملية مستمرة تتطلب تأملًا دوريًا وقرارات مستنيرة. ففي النهاية، (العمل والعائلة ليسا طرفين متناقضين، بل شريكان في رحلة الحياة، بكل افراحها واتراحها).
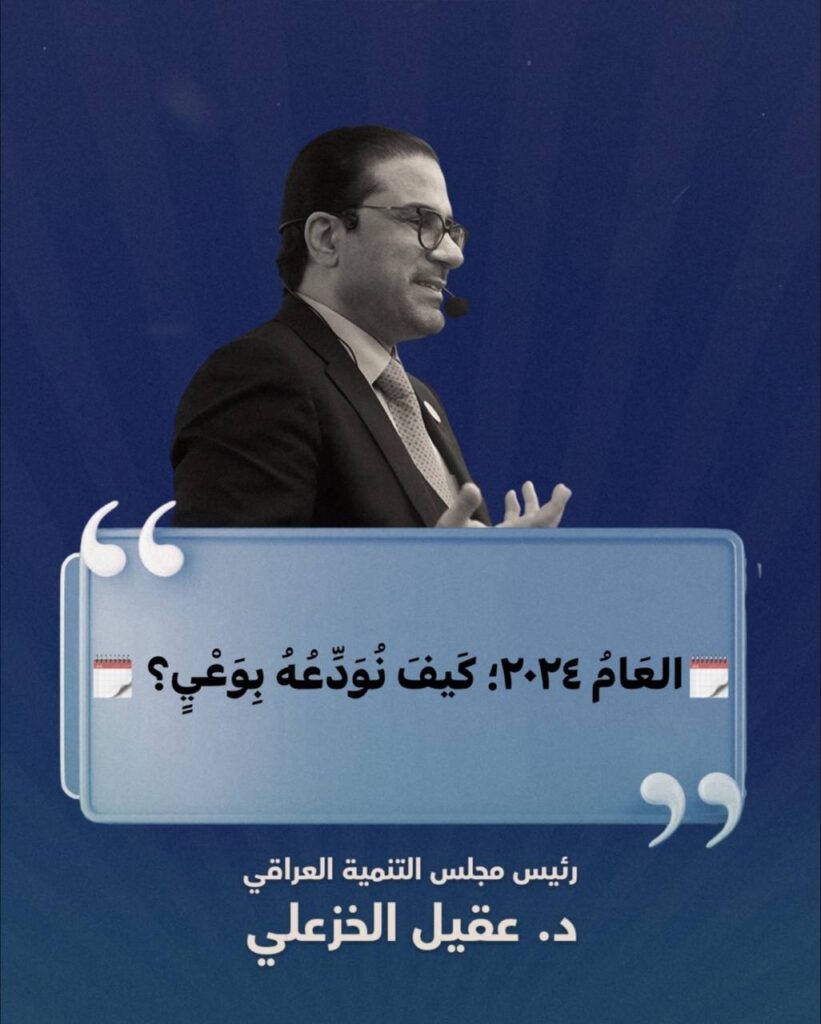
🗓️العَامُ ٢٠٢٤؛ كَيفَ نُوَدِّعُهُ بِوَعْيٍ؟ 🗓️
✍🏼د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقيّ
👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋
📄1. “الأعوام لا تُقاس بعدد أيامها، بل بما تُعلّمنا من دروس، والعام 2024 كان مدرسةً كبرى لمن أراد أن يتعلم.”
📄2. “الحياة تضعنا في مواجهة الألم لنكتشف قدرتنا على تحويله إلى أمل، وهذا ما جسّدته أحداث العام 2024.”
📄3. “الأزمات هي اختبارات لوعينا، فإما أن نخرج منها أقوى وإما أن نبقى أسرى ضعفنا.”
📄4. “الطبيعة لا تنتقم، بل تُذكّر الإنسان بحقيقة ضعفه حين يظن أنه قادر على السيطرة عليها.”
📄 5. “التغيرات المناخية ليست مشكلة جيلٍ واحدٍ، بل هي نداء إلى كل إنسانٍ على وجه الأرض لتحمل مسؤوليته.”
📄6. “السلام الحقيقي ليس غياب الحرب، بل هو قدرة الإنسان على أن يمد يده إلى خصمه ليصنع عالماً أفضل.”
📄7. “من يتجاهل دروس التاريخ، يفتح أبواب المستقبل على مصراعيها أمام الكوارث نفسها.”
📄8. “العالم في العام 2024 أظهر لنا أن المصير الإنساني واحد، وأن أي محاولة للانعزال مصيرها الفشل.”
📄9. “الصراعات السياسية تذكّرنا بأن القوة لا تُبنى بالسلاح وحده، بل بالحوار والسلام الذي يُرمّم الجراح.”
📄10. “حين نتأمل العام الذي مضى، ندرك أن كل تحدٍّ واجهناه كان فرصةً لنصبح أكثر وعياً ونضجاً.”
📄11. “الوعي ليس مجرد معرفة ما حدث، بل إدراك كيفية الاستفادة مما حدث لصياغة مستقبلٍ أفضل.”
📄12. “العام الذي يرحل دون أن نستلهم منه الحكمة هو عامٌ ضائعٌ من أعمارنا.”
📄13. “الأمل يولد من رحم المعاناة، والعام 2024 كان شاهداً على قدرة الإنسان على النهوض من بين الأنقاض.”
📄14. “العواصف التي تهبّ في حياتنا ليست عقاباً، بل هي فرصة لنكتشف جذورنا ومدى قدرتنا على الثبات.”
📄15. “من يعتقد أن الزمن مجرد أرقام يمر بها، لن يدرك أبداً أن كل لحظة تحمل درساً ينتظر أن يُفهم.”
📄16. “الحكمة ليست في تجاوز الأزمات فقط، بل في بناء مستقبلٍ يمنع تكرارها.”
📄17. “العالم مرآةٌ لإنسانيتنا؛ إذا أردنا أن نراه أكثر سلاماً، علينا أن نزرع السلام في داخلنا أولاً.”
📄18. “الطريق إلى الوعي يبدأ من سؤالٍ بسيط: ماذا تعلمت من كل ما مرّ بي؟”
📄19. “حين تلتقي إرادة الإنسان مع دروس الحياة، يولد التغيير الذي ينهض بالبشرية.”
📄20. “العام الذي لا ينتهي بوعيٍ جديدٍ هو عامٌ يكرر نفسه، وكل وعيٍ جديدٍ هو بدايةٌ لعالمٍ أجمل.”
🌲🌲🌲طِبْتُم وبورِكْتُم 🌲🌲🌲
💝د.عقيل الخزعلي💝
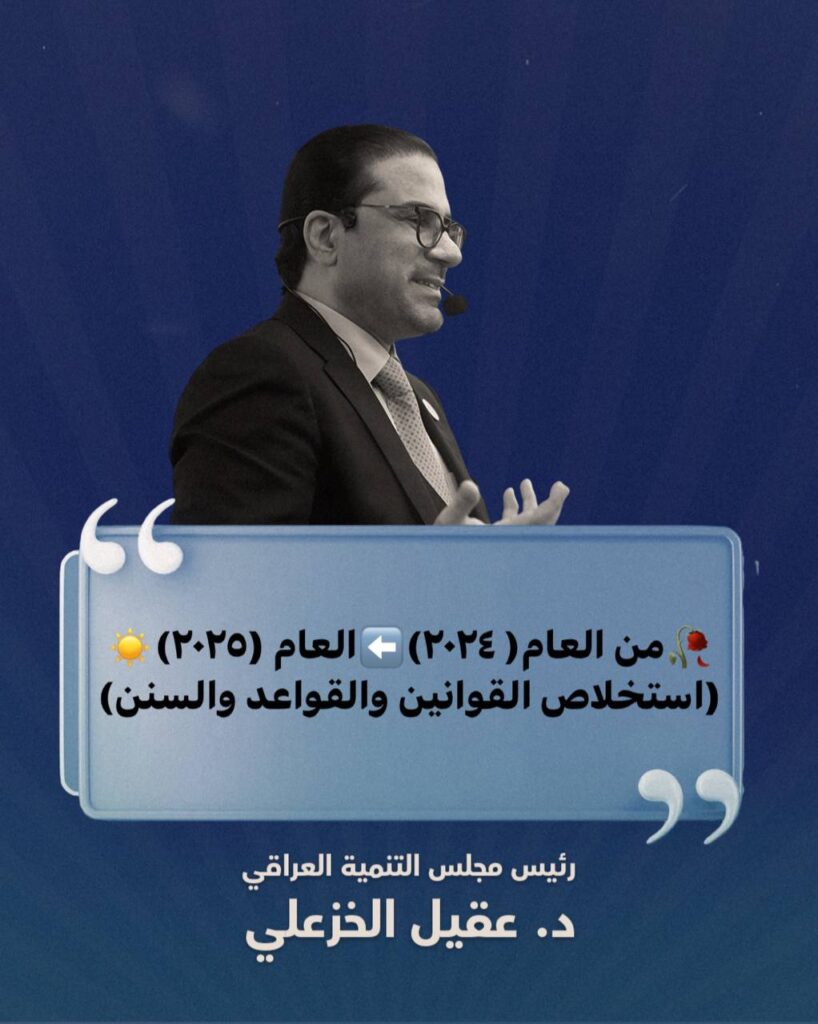
🥀من العام( ٢٠٢٤)⬅️العام (٢٠٢٥)☀️
(استخلاص القوانين والقواعد والسنن)
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
“🤺 من الأحداث الجيوسياسية الكبرى التي شهدتها المنطقة والعالم، ك(التَّغَيُّر في موازينِ القوى وسقوط الأنظمة وتحوّلات السلطة والحروب الهجينة وغير المتماثلة) ، يقتضي ذلك قراءة عميقة تتجاوز الظواهر السطحية إلى استنباط المبادئ الحاكمة في النظام الدولي والإقليمي، أبرزها:
♻️الطبيعة الديناميكية للسلطة♻️
(السلطة لا تعرف فراغاً؛ سقوط نظام يعني ظهور بديل، حتى وإن كان مؤقتاً أو غير مؤهل، وطنياً أم تابعاً، فالفاعلون الأقوى والأكثر تخطيطاً وتنظيماً، سواء كانوا دولاً أو جماعات غير حكومية، يميلون إلى الاستفادة من الفراغ الناجم عن سقوط الأنظمة.)
🪫قاعدة الحتمية التراكمية🪫
(الأنظمة التي تفشل في معالجة الأزمات الداخلية المتراكمة تُصبح معرضة للسقوط، بغض النظر عن قوتها العسكرية أو تحالفاتها الخارجية، فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إذا لم تُعالج تتحول إلى تهديد وجودي للنظام.)
♟️🪖قانون “منطق القوة”🪖♟️
(تُعتبر القوة المادية (العسكرية) العامل الحاسم في لحظات الفوضى أو الانتقال السياسي، فالفاعلون المسلحون غالباً ما يحسمون الصراع عندما تضعف مؤسسات الدولة.)
🗺️الجغرافيا تُحدد المصير🗺️
(يفرض الموقع الجغرافي للدول عليها أدواراً جيواستراتيجية محددة. سوريا، بحكم موقعها المحوري، ستظل نقطة ارتكاز للصراعات والتحالفات الإقليمية،
والدول المجاورة والاقليمية (العراق، تركيا، الأردن، لبنان، السعودية، مصر، ايران، الامارات) تتأثر مباشرة بما يحدث داخل سوريا، لأسباب عديدة متنوّعة.)
🌊 قاعدة الموجات المتتابعة 🌊
(ان التغيرات الجيوسياسية في دولة محورية غالباً ما تؤدي إلى سلسلة من التغيرات في الدول المحيطة، فسقوط نظام في دولة ما يُحدث موجات من عدم الاستقرار، بما في ذلك تعزيز النفوذ الأجنبي أو تنامي حركات التمرد أو سلسلة التدمير والتخلّف.)
🔃 التحالفات المتغيرة 🔃
(التحالفات ليست ثابتة؛ الدول والمجموعات الفاعلة تُعيد تشكيل تحالفاتها بناءً على موازين القوى الجديدة، “فليس هنالك صداقات دائمة ولا عدوات دائمة، بل مصالح دائمة.)
💪🏼الفاعل الأقوى يُعيد رسم الحدود💪🏼
(القوى الدولية الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا) أو الإقليمية، تُعيد تشكيل الخريطة السياسية وفقاً لمصالحها، فضعف أو سقوط أنظمة محلية يُتيح للقوى الكبرى تحقيق مكاسب جيوسياسية جديدة.)
😈 قاعدة الاحتواء المزدوج😈
(تسعى القوى الكبرى لاحتواء صعود أي نظام جديد في منطقة النزاع، خصوصاً إذا كان يحمل أيديولوجيا أو توجهات مناقضة للمصالح الغربية، فالحركات المحليّة قد تواجه ضغوطاً شديدة، حتى من حلفاء محتملين، لتطويع سياساتها بما يتوافق مع التوازن الدولي.)
🫷 سنن التدخل غير المباشر 🫸
(التدخل الدولي غالباً ما يتم من خلال وكلاء محليين بدلاً من التدخل المباشر، فالجماعات المسلحة أو المعارضة السياسية تُستخدم كأدوات لتحقيق الأجندات الدولية.)
🔮 الأيديولوجيا كأداة جذب 🔮
(تُصبح الأيديولوجيات المتطرفة أكثر جذباً في أوقات الأزمات، لكنها تُضعف من قدرة الجماعات المسيطرة على بناء نظام سياسي مستدام.)
⚔️التشرذم الداخلي يزيد الضعف⚔️
(تُستخدم الانقسامات الطائفية والعرقية داخل الدول كأدوات لإضعاف النظام السياسي وتبرير التدخل الأجنبي).
🫴🏼 قاعدة الحاجة إلى الشرعية 🫴🏼
(لا يمكن لأي نظام سياسي جديد البقاء طويلاً دون اكتساب شرعية داخلية وخارجية.)
💰💰الاقتصاد كعنصر حاسم💰💰
(ضعف الاقتصاد الوطني يؤدي إلى فشل الدولة حتى في ظل نظام سياسي قوي، وحتى الجماعات المسلحة التي تسيطر على دول تواجه تحدياً مزدوجاً: (إدارة الاقتصاد ومعالجة الدمار)، مما سيقضم من شرعيتها تدريجيّاً، لتبدأ دورة اخرى من التغيير الجديد.
🛢️البنية التحتية كمسرح صراع🛢️
{تصبح الموارد والبنية التحتية (النفط، المياه، الموانئ) أهدافاً استراتيجية،
فالسيطرة على الموارد ستحدد مَن يمتلك القوة الحقيقية في النظام الجديد.}
🛐 قاعدة التبعية القسرية 🛐
(الأنظمة الجديدة التي تُبنى على جماعات مسلحة غالباً ما تُصبح تابعة للقوى الإقليمية أو الدولية التي دعمتها).
👊🏼✊🏼القوة تولّد المقاومة✊🏼👊🏼
(أي نظام جديد يعتمد فقط على القوة العسكرية سيواجه مقاومة داخلية مستدامة.)
🌋 الحدود المرنة للصراع🌋
(الصراعات الإقليمية لا تبقى داخل حدود دولة واحدة؛ بل تمتد إلى الدول المجاورة.)
👁️👂الاستخبارات أولاً👂👁️
(تُحدد أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية مسارات الصراع وتوجهاته عبر عمليات سرية تؤثر على مخرجات الأحداث.)
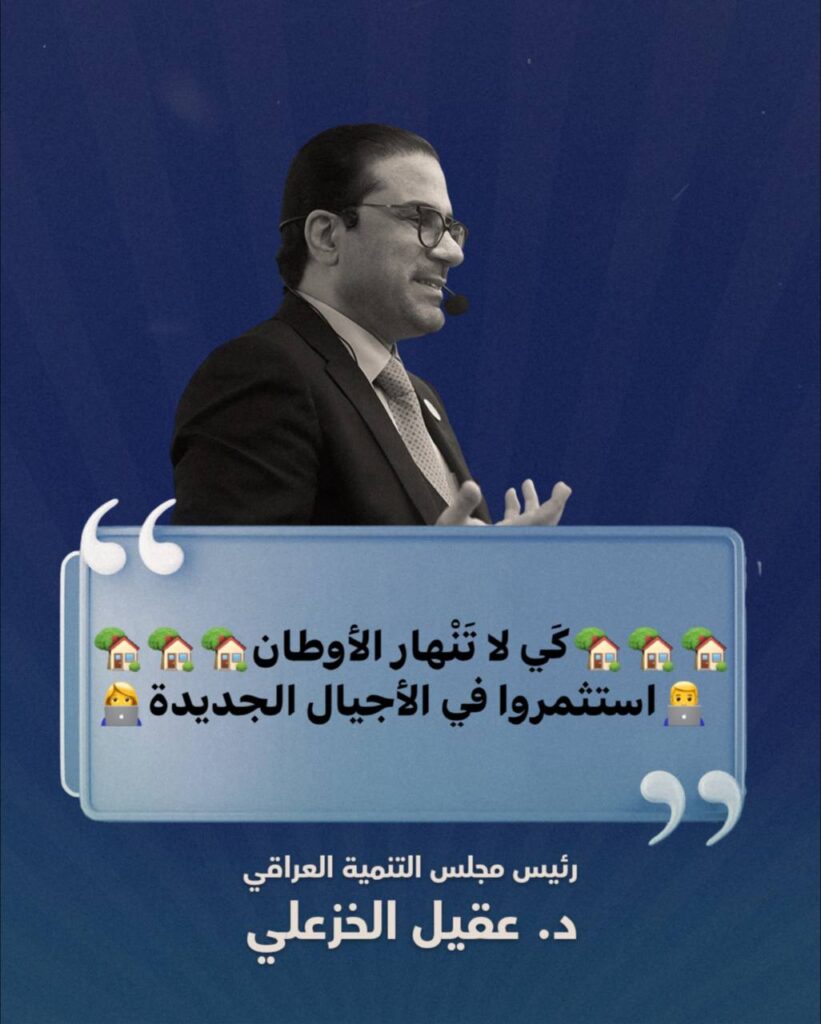
🏡🏡🏡كَي لا تَنْهار الأوطان🏡🏡🏡
👨💻استثمروا في الأجيال الجديدة👩💻
د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنميّة العراقيّ
🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️🏗️
“☀️١- إنبلجَ عصرُنا الجديدُ بولادةِ أجيالٍ حديثةٍ تحملُ بَصمةَ التحوّلِ الشاملِ والتغييرِ الجذري على مُختلف الأصعدةِ والمجالات والمستويات، فجيلُ “زد” (Z) وجيلُ “ألفا” الحاليين، وسيلتحق بهم في (العام ٢٠٢٥) جيلُ “بيتا” ، مما يُسفِرُ عن إنتقالةً هائلةً بالمفاهيمِ والتطبيقاتِ التي تَعكسُ الثوراتَ القفزاتَ المُتساوِقةِ مع إنفجارات العصر (الثقافي،الرقمي، التكنولوجي، القيمي) الراهن.
٢- 👈🏼لقد اقتضى ذلك إلفاتَ الجميعِ الى وجوبِ ادراكِ حقيقةٍ مفادُها ؛ إنَّ بناء الأوطان لا يكون فقط بإنشاء البنى التحتية🧱 أو تعزيز الاقتصاد💰، بل يكمن جوهره الحقيقي في الاستثمار في الإنسان🙋♂️، لا سيَّما في الأجيال الجديدة، حيث تتجلّى فيهم آمال الشعوب وتطلعات الأمم.
٣- 👨🏭يُعدّ قطاع الشباب الركيزة الأساسية لكل مشروع نهضوي، فهم الطاقة الكامنة التي تقود المجتمع نحو التقدم، والقوة الدافعة التي تكسر جمود الحاضر لتفتح آفاق المستقبل. لكنّ هذه الأجيال، وفي ظل التحديات المعاصرة🌪️، تحتاج إلى (استراتيجيات ذكية ومُحكمة🧠 )تُعزِّز من قيمتها وتُهيِّئ لها بيئة تُمكّنها من المشاركة الفعّالة في صنع القرار وبناء الدولة.
🇮🇶 ٤- إنّ العراق، كغيره من البلدان التي تسعى للانتقال من واقع مليء بالتحديات إلى مستقبل زاهر، يواجه إشكاليات معقّدة ترتبط بالشباب، بدءاً من البطالة، وضعف الفرص التعليمية، وتردّي الأوضاع الاقتصادية، وانتهاءً بالتهميش المجتمعي والسياسي، لكن هذه التحديات، على صعوبتها، يمكن أن تتحوّل إلى فرص إذا ما تمّت معالجتها بأساليب استراتيجية تجمع بين (الابتكار، والتخطيط السليم، والرؤية البعيدة).
🎬 ٥- في البداية، يتوجّب الاعتراف بأنّ الشباب العراقي ليس شريحة واحدة متجانسة، بل هو مجتمع مصغر تتباين فيه (الظروف، والطموحات، والاحتياجات). في هذا السياق، تأتي أهمية التعليم📚 كأحد الأعمدة الرئيسية للاستثمار في الأجيال. لا يمكن لدولة أن تزدهر إذا كان شبابها يفتقر إلى التعليم الجيد. لكن التعليم الذي نقصده هنا لا يقتصر على المناهج التقليدية المكرّرة التي قد تفصل الطالب عن واقعه، بل تعليم تفاعلي ديناميكي يربط المعرفة بالحياة والاقتصاد وجودة الحياة، ويُمكِّن الشباب من المهارات العملية مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والحاجات المتجددة في اسواق العمل، وعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى مبادرات مثل “مساحات الابتكار الشبابية” التي أُطلقت في بعض الدول، حيث تُقدّم مختبرات تقنية للشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع تجارية، وهو نموذج يمكن أن يُحتذى به في العراق الذي بدءَ بمبادرة رائدة وهي “مبادرة ريادة”، فضلاً عن “المجلس الاعلى للشباب”.
🏦💕٦- لا يتوقّف الأمر عند التعليم، بل يمتدّ إلى تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا. يُمكن للدولة أن تُطلق برامج وطنية لتمويل المشاريع الصغيرة، بحيث تُتيح للشباب فرصًا حقيقية لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس. تخيّل شابًّا من البصرة يحلم بمشروع زراعي حديث يستخدم تقنيات الزراعة العمودية، وآخر في بغداد يرغب في إطلاق منصة رقمية لتعليم اللغات. دعم هذه الأحلام ليس فقط تحقيقًا لطموحات فردية، بل هو استثمار في اقتصاد البلاد بأكمله، وهو ما بوشِر به ضمن حملة طموحة في “مبادرة ريادة”.
💻📱📡٧- من جانب آخر، تأتي أهمية الإعلام كأداة تأثير فعّالة. في عصر تتسارع فيه الأحداث وتتداخل المعلومات، يصبح الإعلام منصّة حاسمة يمكن من خلالها توجيه الشباب نحو التغيير الإيجابي، فالإعلام التقليدي 📺 والحديث معًا يمكن أن يُستخدما لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز قيم الوطنية والعمل الجماعي.
📹برامج تلفزيونية تناقش قصص نجاح شبابية، وقنوات يوتيوب تديرها مؤسسات تعليمية، ومنصات بودكاست تُبرز تحديات الشباب العراقي وتُقدّم حلولاً مبتكرة، كلّها وسائل يمكن أن تلعب دورًا محوريًا.
🚨 ٨- لكنَّ أي استثمار في الشباب لن ينجح إذا لم يُعزز من شعورهم بالانتماء. الانتماء هو الدافع الذي يجعل الشاب يسعى لبناء وطنه، بدلاً من الهجرة إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل، وفي هذا الصدد، تأتي أهمية تعزيز المشاركة السياسية للشباب، ليس فقط عبر التمثيل الرمزي في الانتخابات، بل من خلال منحهم أدوارًا قيادية حقيقية. يجب أن يُتاح لهم المجال لتقديم رؤاهم والتأثير في السياسات العامة. تخيّل مجلسًا شبابيًا استشاريًا يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لرسم سياسات تنموية تتناسب مع احتياجات الأجيال الجديدة، وهو ما بدء بخطوة مهمة واعدة ضمن “المجلس الاعلى للشباب”.
🎭🎨🏟️٩- من جهة أخرى، لا يمكن أن نتحدّث عن بناء الأجيال دون التطرّق إلى الثقافة والفنون كأدوات لصقل الهوية الوطنية.
إنّ استثمار الدولة في المسرح، والسينما، والموسيقى، والفنون التشكيلية، لا يهدف فقط إلى الإثراء الثقافي، بل يُشكّل كذلك جسرًا للتواصل بين الأجيال ويعزّز من فهمهم لقضايا مجتمعهم.
١٠- 👈🏼أخيرًا، يجب أن نفهم أن الاستثمار في الأجيال الجديدة ليس مشروعًا محدودًا ببرنامج أو حملة، بل هو رؤية شاملة تتطلّب تعاونًا بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
⚠️إنّها مسؤولية الجميع لأنّ الشباب هم (مستقبل الوطن🌇)، وإذا أردنا أن نحمي أوطاننا من الانهيار، فعلينا أن نؤمن بأنّ (مفتاح النجاح🔑) يكمن في تمكين الأجيال القادمة، لا بالوعود الخطابية، بل بالعمل الحقيقي الجاد والمستدام، لأن “التمنيّات ليست كافيّة”.
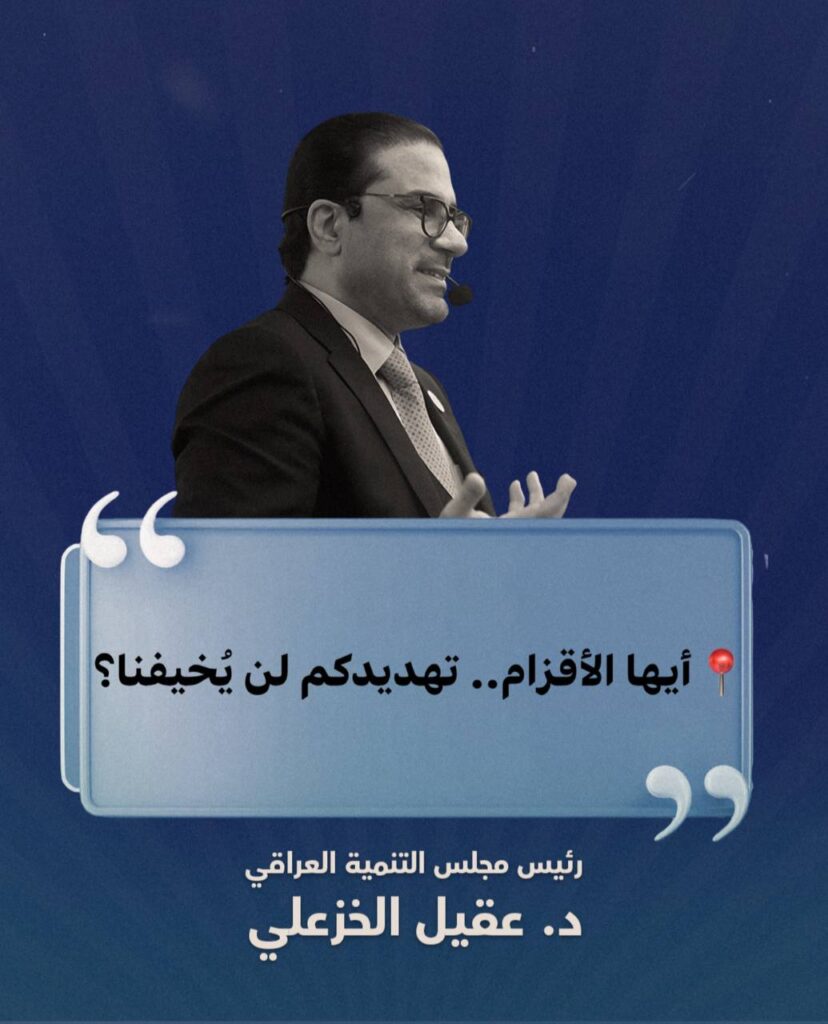
📍أيها الأقزام.. تهديدكم لن يُخيفنا؟
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️🕸️
١- 📲في زمنٍ تلاشت فيه الحدود بين الحقائق والزيف، وأصبح فيه الصوت الحر الذي يتحدث عن الوطنية والسيادة يُعتبر بمثابة الجريمة في نظر البعض، يظل المبدئيون الذين يحملون القضية الوطنية بصدقٍ وإخلاص، من أبرز أهداف التهديدات والمضايقات التي لا هم لها سوى قمع الحقيقة وكتم الصوت الذي يرفض المساومة أو المهادنة، فكيف يمكن أن يُفزع من يملك الحقيقة الكاملة، أو يُرهب من ينشد الكرامة ويصر على أن يكون له وطنٌ حيّ يُعانق السيادة ويدافع عن الاستقلال؟ هكذا هم، أولئك الذين يختارون الوقوف مع العراق وشعبه في وجه الرياح العاتية، في مواجهة المواقف الضبابية التي يسعى البعض لفرضها باسم التوازنات والمصالح المبعثرة، هؤلاء لا يشغلهم سوى حقيقة واحدة: العراق هو الأصل، والسيادة هي الغاية. لا يملكون سلاحًا سوى الفكر النبيل الذي لا يساوم، ولا يملكون درعًا سوى الضمير الذي يظل يقظًا رغم قسوة الأيام.
٢- 🏹 إنه لمن المؤلم أن تُستهدف المبادئ الوطنية بالتهديدات والاتهامات، وكأن كل ذنبنا أننا نريد لعراقنا أن يكون مستقلاً، قادراً على اتخاذ قراراته بعيدًا عن أية تدخلات أو ضغوط خارجية. ولعل أكثر ما يزعج أولئك الذين يهددوننا هو أن صوتنا ليس محميًا بحزبٍ يضمن لنا الحصانة الفئوية أو جماعة مسلحة توفر لنا ملاذًا آمنًا من أيدي من يحاولون كسرنا. لكننا نعلم تمامًا أن ما نملك هو فكرٌ شجاع يسعى للحقيقة، وضميرٌ لا ينام على ما يُرتكب من ظلم، وقلوبٌ تهيم حبًا للعراق بكل أطيافه وألوانه، وطنٍ لا نريد له إلا العزة والكرامة، بعيدًا عن أي صراع طائفي أو تحزب ضيق.
٣-👾إلى أولئك الذين يتوهمون أنهم قادرون على إخافة صوتنا أو إخضاع قلمنا، نقول لهم بوضوح: تهديداتكم لن تُرعبنا، فأنتم الأقزام الذين يحاولون إخفاء الحقيقة وراء أكاذيبكم، ولا يملكون من قوة سوى السعي وراء تصفية الحسابات الشخصية. إن محاولاتكم لكسر إرادتنا لا تساوي شيئًا أمام الإيمان الذي نحمله لهذا الوطن، فكل تهديد توجهونه إلينا هو مجرد هدر للكلمات لن يُوقفنا عن الاستمرار في قول الحقيقة، وكل محاولة لبث الرعب في قلوبنا لا تزيدنا إلا تمسكًا بقضيتنا.
٤-🇮🇶 إننا نعلم جيدًا أن الكتابة والمقالة والمحاضرة التي ننشرها وتصدر منّا ليست مجرد كلمات، بل هي مواقف مؤثرة تنبض بدماء وطنية حقيقية، هي شهادات حية لما نعيشه من معاناة وآمال، وهي سعي صادق لرسم مستقبل أفضل للعراق وأبنائه. تلك الأقلام التي تكتب وتنطق بالحقيقة لا تسعى إلى إثارة الفتن أو نشر الكراهية، بل هي تُنادي بوطنٍ واحد، يسع الجميع دون تفرقة أو تمييز، ويتنعم بالاستقلال والسيادة بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو ضغوط داخلية.
٥- 💪🏼 لا خوف لدينا من أي تهديد يوجهه الأقزام الذين لا يفهمون معنى الحرية، ولا يدركون أن الفكر الحر لا يمكن أن يُسكت، وأن الحقيقة لا تُغتال بتهديد أو ترويع. إننا نعلم أن كل محاضرة أو كتاب أو مقال نقدمه هو بمثابة نداء لوعي الأمة وصرخة في وجه من يعتقدون أن السيطرة على العقول بالأكاذيب قد تنجح. فالتاريخ لا يرحم، والذاكرة الجمعية لا يمكن أن تُنسى. إن العراق الذي نؤمن به هو العراق الذي يُبنى على أسس من العدالة والمساواة والكرامة، وليس العراق الذي يُداس فيه الإنسان تحت أقدام المزايدات السياسية أو الطائفية.
٦- 🐸 أيها الأقزام، إن تهديدكم لن يُخيفني، فأنتم لا تملكون إلا الصراخ، ونحن نملك الإيمان العميق بأنّ الحق سيبقى يتوهج رغم محاولاتكم لطمسه، وإن ما تقترفونه من أفعال ستظل طيفًا مظلمًا في صفحات التاريخ، بينما سيظل العراق العزيز شامخًا، مستقلًا، سيادته محفوظة بقلوب أبنائه الذين لن يرضوا بغير الحقيقة والعدالة بديلاً. “
—————————————
📚ابرز الاصدارات التي نشرناها؛ {الامن المستدام وصناعة المستقبل، المرشد للقادة والقادة الاداريين، مقاربات في التنمية الادارية في العراق، معايير تقييم الاداء المؤسسي الحكومي، حكمة العقد الخامس، قيامة العراق ٣٦٠ْ (٣ أجزاء)، الأحدث في ادارة الدولة}, فضلاً عن مئات المقالات والمحاضرات والمشاركات.
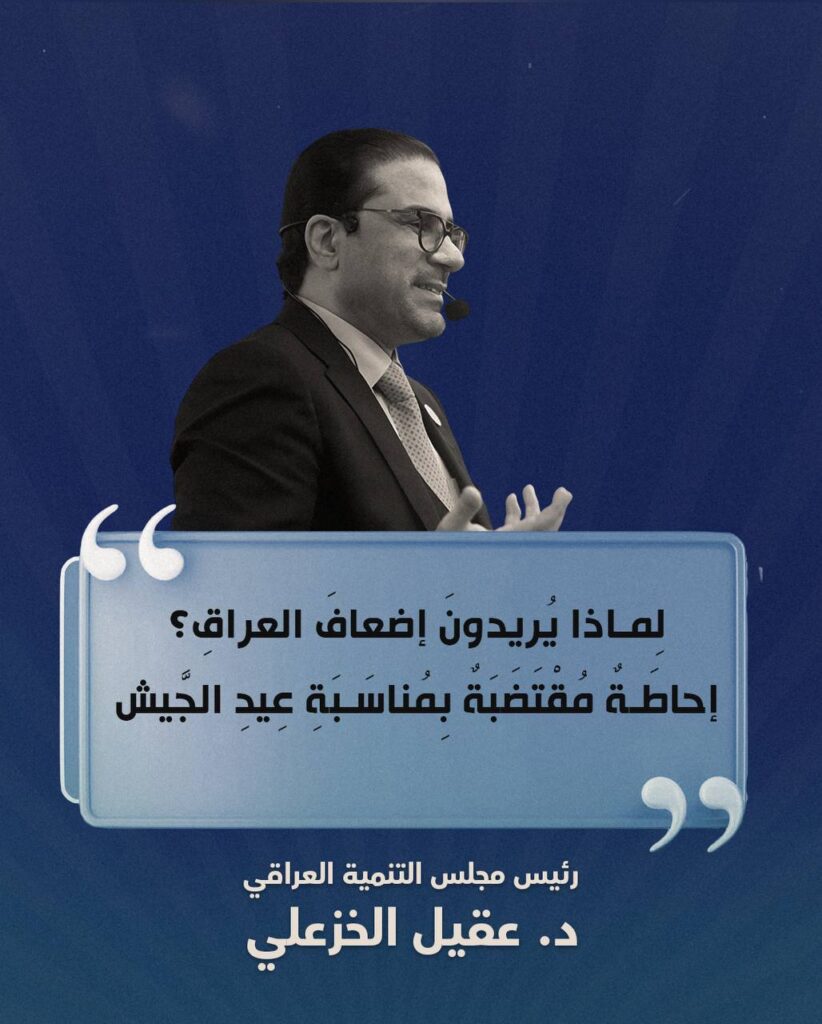
🇮🇶لِماذا يُريدونَ إضعافَ العراقِ؟🇮🇶
-إحاطَةٌ مُقْتَضَبَةٌ بِمُناسَبَةِ عِيدِ الجَّيش-
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️
“🇮🇶العِراقُ، هذا البلدُ العريقُ الذي يُعَدُّ مهدَ الحضاراتِ ومفترقَ الطُّرُقِ بينَ الشرقِ والغربِ، يشهدُ منذُ عقودٍ محاولاتٍ مُتكرِّرةً لتفكيكِهِ وإضعافِهِ وتقزيمِ دورِهِ التاريخيِّ والحضاريِّ. فما الذي يدفعُ القُوى الإقليميَّةَ والدوليَّةَ، إلى التَّكاتُفِ من أجلِ إضعافِهِ؟ للإجابةِ عن هذا السؤالِ، يجبُ التَّعمُّقُ في الأسبابِ الجيوسياسيَّةِ، والاقتصاديَّةِ، والاجتماعيَّةِ، والثقافيَّةِ، والعقائديَّةِ، والأيديولوجيَّةِ التي تُفسِّرُ هذا التَّوجُّهَ.
🗺️ 📜لَعنةُ الموقعِ المُمَيَّزِ 📜🗺️
منذُ فجرِ التاريخِ، كانَ العِراقُ مركزًا لحضاراتٍ إنسانيَّةٍ عظيمةٍ، مثلَ السومريَّةِ، والبابليةِ، والأكديَّةِ، ومسرحًا لصراعاتٍ كبرى بسببِ موقعِهِ الاستراتيجيِّ الذي يجعلُهُ بوابةً بينَ الشرقِ والغربِ.
👈🏼 هذا الموقعُ الفريدُ جعلَهُ هدفًا للطَّامعينَ منذَ العُصورِ القديمةِ وحتى اليومِ، فهو يربطُ آسيا بأوروبا، ويُعدُّ عقدةً حيويَّةً بينَ الشرقِ الأوسطِ والخليجِ العربيِّ، كما أنَّ نهرَي دِجلةَ والفُراتِ، اللذينَ جعلا من العِراقِ أرضًا خصبةً وزاخرةً بالمواردِ، حوَّلاهُ إلى مطمعٍ للقُوى الإقليميَّةِ والدوليَّةِ.
⚔️ في التاريخِ الحديثِ، خاصَّةً بعدَ انهيارِ الدولةِ العثمانيَّةِ، تحوَّلَ العِراقُ إلى مركزِ صراعٍ بينَ الاستعمارِ البريطانيِّ والقُوى المحلِّيَّةِ، لتثبيتِ النُّفوذِ والسيطرةِ على ثرواتِهِ، ومَثَّلَ الاحتلالُ الأمريكيُّ للعِراقِ عامَ 2003 تتويجًا لهذهِ الأطماعِ، حيثُ أُعيدَ تشكيلُ الدولةِ وفقَ حساباتِ القُوى الكُبرى، لضمانِ بقائِها ضعيفةً ومقسَّمةً وبؤرة للإستقطابِ المزمِن والتَّدَخّل المُستَمِر.
🧱💎حَجَرُ زاويةِ الشرقِ الأوسطِ💎🧱
العِراقُ هو مركزُ توازُنِ القُوى في الشرقِ الأوسطِ. قُوَّتُهُ أو ضَعفُهُ تؤثِّرُ مباشرةً على معادلاتِ المنطقةِ. ولذلكَ، ترى العديدُ من الدُّولِ الإقليميَّةِ، في العِراقِ إمَّا تهديدًا لمصالِحِها أو فُرصةً لتعزيزِ نُفوذِها، فدولة تعتبرُ العِراقَ امتدادًا لنُفوذِها العقائديِّ والسياسيِّ، وتسعى إلى ضمانِ بقائِهِ ضمنَ دائرةِ تأثيرِها المباشرِ، خاصَّةً في ظلِّ الارتباطِ المذهبيِّ بينَ البلدينِ. في المُقابِلِ، تخشى دُولٌ اخرى من أنَّ عِراقًا قويًّا ومستقلًّا قد يُعيدُ صياغةَ التَّوازناتِ الإقليميَّةِ، بما يُهدِّدُ مصالِحَها.
وعلى الصعيدِ الدوليِّ – وكما يُشير أغلب الباحثين- ، ترى الولاياتُ المتحدةُ في العِراقِ مسرحًا رئيسيًّا لاحتواءِ النُّفوذِ الإيرانيِّ، ومصدرًا للطَّاقةِ والنفوذ يُمكنُ أنْ يُعزِّزَ هيمنتَها على السُّوقِ العالميَّةِ.
أمَّا روسيا والصينُ، فتريانِ في العِراقِ فُرصةً لتوسيعِ نُفوذِهِما في الشرقِ الأوسطِ، مما يضعُهُ في قلبِ صراعٍ جيوسياسيٍّ بينَ القُوى الكُبرى.
🛢️⛽️🪨 لَعْنَةُ المَوارِد 🪨⛽️🛢️
يُعتبرُ العِراقُ هو واحدٌ من أغنى دولِ العالمِ بالمواردِ الطبيعيَّةِ، وخاصَّةً النِّفطِ، حيثُ يملِكُ ثاني أكبرَ احتياطيٍّ نفطيٍّ في العالمِ، وهذه الثرواتُ الهائلةُ جعلتْ منهُ مطمعًا دائمًا للقُوى الكُبرى، التي تسعى للسَّيطرةِ على قطاعِ الطَّاقةِ العراقيِّ لضمانِ تدفُّقِ الطَّاقةِ بما يخدمُ مصالِحَها.
كما أنَّ مواردَهُ المائيَّةَ والزراعيَّةَ تجعلهُ لاعبًا رئيسيًّا في الأمنِ الغذائيِّ والمائيِّ للمنطقةِ.
لكنْ، هذهِ الثرواتُ، بدلًا من أنْ تكونَ نعمةً، تحوَّلتْ إلى نقمةٍ بفعلِ التَّدخُّلاتِ الأجنبيَّةِ والصِّراعاتِ الداخليَّةِ التي تمنعُ استثمارَها بشكلٍ وطنيٍّ.
فالقُوى الإقليميَّةُ والدوليَّةُ تسعى لإبقاءِ العِراقِ في حالةِ ضَعفٍ اقتصاديٍّ يُجبِرُهُ على الاعتمادِ على المُساعداتِ والقُروضِ الدوليَّةِ، مما يُرسِّخُ التَّبعيَّةَ.
✂️✂️تفتيتُ النَّسيجِ الوطنيِّ✂️✂️
تاريخياً وراهناً ، مَثَّلَ استغلالُ التَّنوُّعِ الطَّائفيِّ والإثنيِّ في العِراقِ أحدُ الأسلحةِ الرئيسيَّةِ التي تُستَخدمُ لإضعافِهِ، فمنذُ عامِ 2003، استُخدِمَتِ الورقةُ الطَّائفيَّةُ لإثارةِ الانقساماتِ بينَ السُّنَّةِ والشِّيعةِ، وبينَ العَرَبِ والكُردِ، مما أدَّى إلى التأثير في النَّسيجِ الاجتماعيِّ وتعميقِ الفجوةِ بينَ مُكوِّناتِ الشَّعبِ. سَهَّلَت هذهِ الانقساماتُ التَّدخُّلاتِ الخارجيَّةَ مما اسهم في إضعاف القُدرةَ على بناءِ دولةٍ وطنيَّةٍ مُوحَّدةٍ وناجِزةٍ شامِلَة.
بدورِها استغلَّتْ القُوى الإقليميَّةُ،، هذهِ الانقساماتِ لتحقيقِ مصالِحَها. إيرانُ دعمتِ الفصائلَ الشِّيعيَّةَ، بينما ركَّزتْ تُركيا على تعزيزِ نُفوذِها بينَ الكُردِ والسُّنَّةِ.
الولاياتُ المتحدةُ، بدورِها، استفادتْ من هذهِ الانقساماتِ لإعادةِ تشكيلِ العِراقِ بما يخدمُ مصالِحَها الاستراتيجيَّةِ.
💪🏼🧠صِراعُ الأفكارِ والإرادات🧠💪🏼
تُعدُّ الصِّراعاتُ العقائديَّةُ والأيديولوجيَّةُ أحدَ العواملِ الأساسيَّةِ في استهدافِ العِراقِ، فاللوبياتِ الصهيونيّة والكيانُ الإسرائيليُّ يريانِ في العِراقِ مركزًا تاريخيًّا للحضارةِ الإسلاميَّةِ والعربيَّةِ، وقُوَّةً كامنةً قادرةً على تهديدِ مشروعِهِما في المنطقةِ، والكيانُ الإسرائيليُّ، على وجهِ الخصوصِ، يُدركُ أنَّ عِراقًا قويًّا ومستقلًّا قد يُعيدُ إحياءَ المشروعِ القوميِّ العربيِّ، ويُشكِّلُ تهديدًا استراتيجيًّا لأمنِهِ.
يعتمدُ المشروعُ الصُّهيونيُّ، كما يُظهرُهُ “مخطَّطُ ينون/يعنون”، على تفتيتِ الدُّولِ الكُبرى في المنطقةِ إلى كياناتٍ صغيرةٍ قائمةٍ على أُسُسٍ طائفيَّةٍ وإثنيَّةٍ.
لذلكَ، يُعتبَرُ تقسيمُ العِراقِ إلى دولةٍ شيعيَّةٍ، وأُخرى سُنِّيَّةٍ، وثالثةٍ كُرديَّةٍ هدفًا استراتيجيًّا لإسرائيلَ لضمانِ تفوُّقِها الإقليميِّ.
📺📱أدواتُ السَّيطرةِ والتَّشويهِ📱📺
لعبَ الإعلامُ دورًا كبيرًا في تشويهِ صورةِ العِراقِ دوليًّا، وتصديرِ صورةٍ نمطيَّةٍ تُظهِرُهُ كدولةٍ غارقةٍ في الفسادِ والطَّائفيَّةِ والعُنفِ، وقَد خَدَمَ هذا التَّشويهُ أهدافَ القُوى الكُبرى، لأنَّهُ يُسهِّلُ التَّدخُّلاتِ الدوليَّةَ ويُبرِّرُ السِّياساتِ العُدوانيَّةَ تجاهَهُ.
🇮🇶العِراقُ بينَ التَّحدِّياتِ والفُرَصِ🇮🇶
لَقَد باتَ واضِحاً أن إضعافُ العِراقِ ليسَ مُجرَّدَ صُدفةٍ، بلْ هو نتيجةُ تداخُلٍ مُعقَّدٍ لعواملَ تاريخيَّةٍ، وجغرافيَّةٍ، واقتصاديَّةٍ، وعقائديَّةٍ، وأيديولوجيَّةٍ. هذهِ القُوى تُدرِكُ أنَّ العِراقَ يمتلكُ المُقوِّماتِ ليكونَ قُوَّةً إقليميَّةً ودوليَّةً مُؤثِّرةً. لكنْ، في الوقتِ نفسِهِ، يبقى الأملُ معقودًا على شَعبِ العِراقِ، الذي أظهرَ عبرَ تاريخِهِ الطَّويلِ قُدرةً على تجاوزِ المِحَنِ. عِراقٌ قويٌّ ومُوحَّدٌ يُمكنُ أنْ يُعيدَ صياغةَ موازينِ القُوى في المنطقةِ، ويستعيدَ مكانتَهُ التَّاريخيَّةَ كمَهدٍ للحضاراتِ ورَكيزةٍ للاستقرارِ في الشَّرقِ الأوسطِ، وهَذا القَدَر لَنْ يَتم إلّا بإستجماعِنا لكل قوانا “الصّلبَة” و “النّاعِمَة”، خُصوصاً أننا في شرقِ أوسطٍ مُضطَربٍ وعالَمٍ مُتوَحِشٍ، ومشروعات الإنهاك والتقسيم والإذعان ستشهد مواسِمَ وافِرة، حيثُ لا رجاءَ إلّا بالتَّدخلات الإلهية المحكومة بالسُّنن الطبيعيّة !”
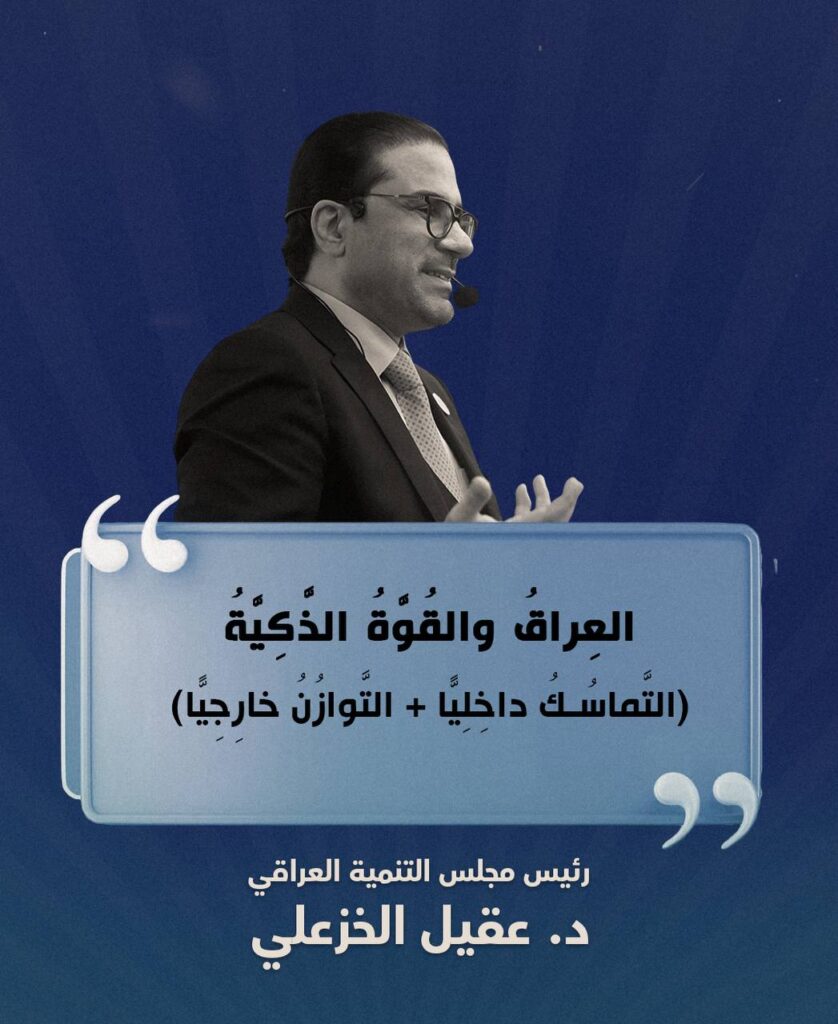
——🌴العِراقُ والقُوَّةُ الذَّكِيَّةُ🌴——— (التَّماسُكُ داخِلِيًّا + التَّوازُنُ خارِجِيًّا)
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾
“
١- 🌎 في عالمٍ يُسيطرُ عليهِ التَّغييرُ السَّريعُ والتَّعقيدُ المُتصاعِدُ في العلاقاتِ الدُّوليَّة، تبرزُ “🗡️القوّة الذكيّة💰” كأحدِ أهمِّ النماذجِ الاستراتيجية لإدارةِ الدول. القوّةُ الذكيّةُ ليستْ قوّةً مَحضةً عسكريةً أو ناعمةً دبلوماسيةً، بل هي – علاوةً على ذلك – مزيجٌ بينَ التَّماسُكِ الداخِليِّ القائمِ على الاستقرارِ والوحدةِ، والتَّوازُنِ الخارجيِّ القائمِ على الانفتاحِ والشَّراكةِ البنَّاءة.
يقولُ الفيلسوفُ فرنسيس بيكون: “القوّةُ الحقيقيّةُ لا تُقاسُ بما تملكُ، بل بقدرتِكَ على التَّكيُّفِ وتحقيقِ أهدافِكَ بذكاء.” وهذا ما يحتاجهُ العِراقُ ليُحقِّقَ دورًا استراتيجيًّا في محيطِهِ الإقليميِّ والدوليِّ، مستندًا إلى عناصرِ قوّتِهِ الذَّاتيّة والجَماعيّة.
٢- 🤝 التَّماسُكُ الدَّاخليُّ يُعَدُّ الرَّكيزةَ الأساسيّةَ لتحقيقِ القوّةِ الذَّكيّةِ. فَلا يُمكنُ لأيِّ دولةٍ أن تُمارسَ دورًا خارجيًّا فاعلًا دونَ أن تكونَ قويّةً من الدّاخل، وهو مايستدعي تعزيزُ الهُويّةِ الوطنيّةِ الجامعة، فالهُويّةُ الوطنيّةُ ليستْ شعارًا بل واقعًا يُجسِّدُ تلاحُمَ الشَّعبِ بِجميعِ مكوّناتِهِ. يقولُ غاندي: “الوحدةُ في التنوّعِ هي أساسُ القوّةِ الحقيقيّةِ.”،
والعِراقُ، بفسيفسائِهِ العِرقيةِ والطائفيةِ، يحتاجُ إلى مشروعٍ وطنيٍّ يُعزِّزُ الانتماءَ إلى الدولةِ فوقَ كُلِّ الولاءاتِ الفرعيّةِ.
٣. 💻إصلاحُ النظامِ التَّعليميّ، فالتعليمُ هو الأساسُ لبناءِ العُقولِ الواعيةِ والمجتمعِ المُتماسِكِ. يُمكنُ تطويرُ المناهجِ لِتُركِّزَ على قيمِ المواطنةِ، العدلِ،واقتصاديات المعرفة، وكما يقولُ نيلسون مانديلا: “التعليمُ هو السِّلاحُ الأقوى لتغييرِ العالم.”
٤. 🏦 تعزيزُ الاقتصادِ الداخليّ، فالاقتصادُ القويُّ هو عصبُ التَّماسُكِ الداخليِّ، والعِراقُ بحاجةٍ إلى تنويعِ مصادرِ الدَّخلِ، والاستثمارِ في قطاعاتِ الزِّراعةِ، الصِّناعةِ، والتِّكنولوجيا، وكما يقولُ آدم سميث: “اقتصادٌ قويٌّ هو الدولةُ القويّةُ.”
٥- 🎡 يُمثِّلُ التَّوازُنُ الخارجيُّ الجانبَ الآخرَ من معادلةِ القوّةِ الذكيّةِ. فالعِراقُ، بموقعِهِ الاستراتيجيِّ وثرواتِهِ الطَّبيعيّةِ، يحتاجُ إلى سياسةٍ خارجيّةٍ حكيمةٍ تُحقِّقُ مصالحَهُ وتُعزِّزُ مكانتَهُ، من خلال
بناءُ شراكاتٍ استراتيجيّةٍ، بالحفاظ على علاقاتٍ متوازِنةٍ مع القوى الإقليميّةِ والدوليّةِ، وأن يستثمرَ في بناءِ شراكاتٍ استراتيجيةٍ تُحقِّقُ المصالحَ المُشتركةَ.
يقولُ هنري كيسنجر: “الدبلوماسيّةُ هي فنُّ تحقيقِ المكاسبِ دونَ خلقِ أعداء.”
كما يتوجب على السياسةُ الخارجيّةُ للعِراقِ أن تعتمدَ على الحيادِ الإيجابيِّ، بحيثُ تُحافِظُ على مصالحِهِ دونَ الانحيازِ لطرفٍ على حسابِ آخر.
كما يقولُ ثيوسيديدس: “الأقوياءُ يفعلونَ ما يستطيعونَ، والأذكياءُ يُقرِّرونَ ما يجبُ أن يفعلوه.”
علاوةً على ما تقدّم ، فأنه يقتضي العمل على تعزيزُ المكانةِ الدولية، إذ يُمكِن للعِراقُ أن يكونَ جسرًا للتواصلِ بينَ الشرقِ والغربِ، وأن يُساهمَ في حلِّ الأزماتِ الإقليميّةِ والدوليّةِ• يقولُ كونفوشيوس: “من يُصلِحُ بيتَهُ يُصبِحُ مثالًا لِجيرانه.”
٦- 🧠 ان القوّةُ الذَّكيّةُ ليستْ خيارًا بل ضرورةٌ استراتيجيّةٌ لِنهوضِ العِراقِ، والتَّماسُكُ الداخليُّ هو أساسُ الاستقرارِ، والتَّوازُنُ الخارجيُّ هو مفتاحُ النُّفوذِ الإقليميِّ والدوليِّ.كما يقولُ وينستون تشرشل: “الدولةُ التي تُوازِنُ بينَ قوَّتِها الداخليّةِ وسياساتِها الخارجيّةِ، هي دولةٌ لا تُهزَم.”
٧- 🇮🇶 إنَّ بناءَ عِراقٍ قويٍّ ومرِنٍ يتطلَّبُ رؤيةً مُستدامةً وعملًا دؤوبًا. ومعًا، يمكنُ للعراقِ أن يُجسِّدَ نموذجًا رائدًا في القوّةِ الذَّكيّةِ التي تُحقِّقُ الأمنَ، الاستقرارَ، والازدهارَ لشعبِه، ومَن لا يَعي ذلك، فأنه يُديمُ أمَدَ جِراحَهُ النّازِفة🩸، فالغَباءُ مَهْلَكَةٌ!.”
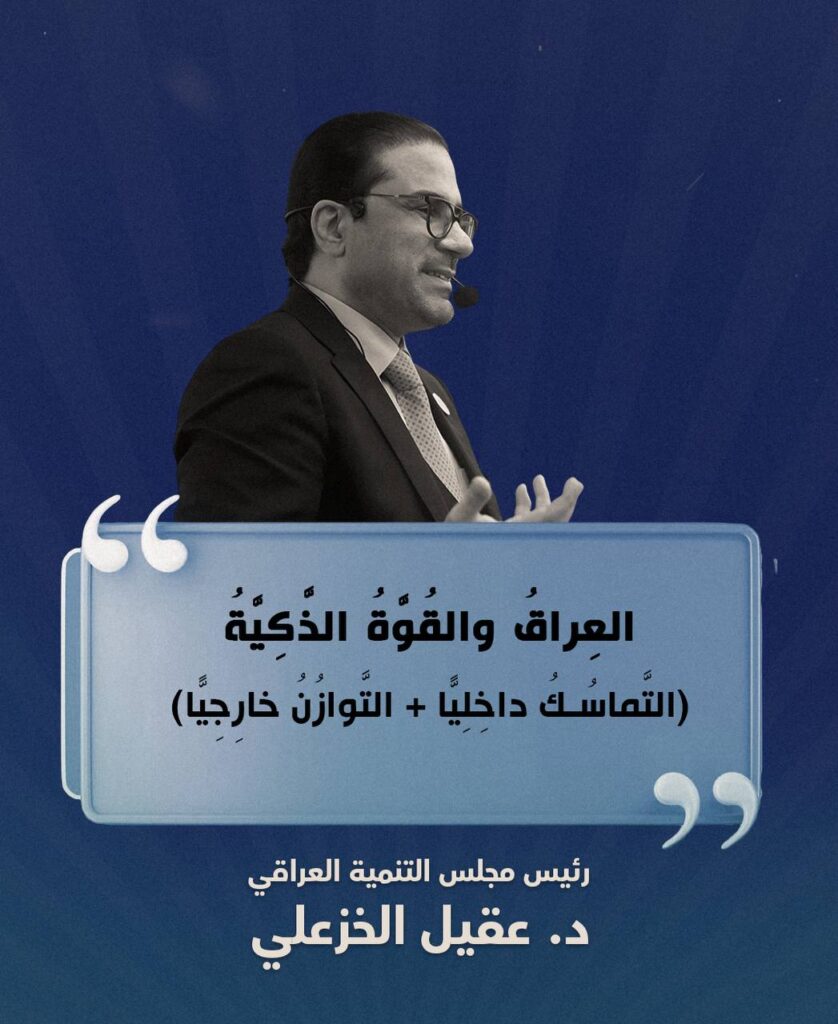
🔥🔥 *العَالَمُ والحَرائِقُ*؛ 🔥🔥
•••• مَنْ يُنْتِجُ مَنْ؟ ولِماذا؟ ••••••
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯🧯
١- في (عالم الطبيعة🌲)، تمتلك بعضُ الحرائق قوة استثنائية تُشبه السيف ذي الحدين، فهي تدمر وتُبيد، لكنها في الوقت نفسه تُمهّد لولادة جديدة، فالحرائق الطبيعية ليست فقط حدثًا عرضيًا ينشأ من خلال صواعق البرق⚡️ أو احتكاك الرياح الجافة بالأشجار🍂، بل هي عنصر أساسي في النظام البيئي الذي يستخدمها كوسيلة للتكيف والتجديد🌱.
اننا حين نتأمل الظاهرة من زاوية بيئية🌐، نجد أن بعض النظم الطبيعية تُشعل الحرائق بذاتها بشكل متعمد لتحقق أغراضًا تكيّفية تتعلق بالبقاء وتجديد الموارد♻️. لكن المثير هو كيف يمكن لهذه الظاهرة أن تعكس بُعدًا سياسيًا مشابهًا يحدث داخل العالم والدول⁉️.
———————-
٢- في الغابات الطبيعية🌳، ليست الحرائق دومًا دمارًا كارثيًا كما يتصورها البعض، بل هي عملية “تطهيرية💊” في كثير من الأحيان، فعلى سبيل المثال، (غابات الصنوبر🌲) في أمريكا الشمالية تعتمد على الحرائق لتحفيز انفتاح بذور الصنوبر من أقماعها الصلبة التي لا تنفتح إلا تحت تأثير الحرارة العالية، كما أن الغابة تُعيد بناء نفسها عبر الحريق، إذ تتخلص من (النبات الميت☠️) (والحشائش الجافة🍂) التي قد تُعطل نمو الأنواع الجديدة، وتفتح المجال (لجيل جديد🌱) أكثر مقاومة للتغيرات المناخية وللآفات. هذا التجديد، رغم أنه يأتي بثمن الفناء المؤقت، إلا أنه يضمن استمرارية النظام البيئي🔃.
——————
٣- ان ظاهرة الحرائق المُتَعمَدة🔥 يمكن فهمها عبر منظور أشمل حين تُطبق على السياسة والعلاقات الدولية، حيثُ يشهد العالم منذ عقود طويلة أحداثًا وأزمات قد تبدو وكأنها “حرائق سياسية”؛ حالات من (التوتر والصراع والاضطراب 🌋) التي تبدو وكأنها تدمّر أنظمة سياسية واجتماعية. لكنها، عند النظر إليها بتمعن، قد تكون جزءًا من دورة تجديدية شبيهة بالنظام البيئي. الأمثلة على ذلك عديدة، من الحروب الكبرى التي أعادت تشكيل النظام العالمي بعد الحربين العالميتين، إلى الثورات الاجتماعية التي أطاحت بأنظمة ديكتاتورية وخلقت مساحات جديدة للديمقراطية.
————————
٤- لقد مَثَّلَ (سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991🔴) أبرز الواهد التاريخية على الحرائق السياسيّة ،حيثُ كان الانهيار شاملاً ودمّر النظام القائم في الدول التابعة له، لكنه في الوقت نفسه فتح المجال لنظم سياسية واجتماعية جديدة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، و أعاد تشكيل الخريطة السياسية للعالم، وأنتج نظامًا عالميًا جديدًا أكثر تقبلاً للهيمنة الأمريكية في التسعينيات. لكن حتى في هذا التجديد، ظهرت تحديات وصراعات جديدة، وكأن النظام الدولي الجديد بدأ يتكدّس (بمخلفات سياسية واجتماعية🗑️ ) تحتاج بدورها إلى “حريق آخر” لتجديد نفسه.
———————
٥- ان الحرائق السياسية قد تكون أحيانًا متعمدة من قوى داخلية أو خارجية، فالقوى الكبرى، قد تُشعل “حرائق سياسية” في مناطق نفوذها لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى.فمثلاً الاخداث الجارية في الشرق الاوسط وبعض البلدان، على سبيل المثال، ليست فقط نزاعًا داخليًا، بل هي نتاج تداخلات إقليمية ودولية تُشبه في بعض وجوهها إشعال حريق في غابة لتغيير طبيعة المنطقة الجيوسياسية🗺️ ورغم الكوارث الإنسانية الهائلة، فإن التداعيات الجيوسياسية للحرب أعادت رسم علاقات القوى في الشرق الأوسط وأبرزت لاعبين جددًا على الساحة الدولية.
———————
٦- يكمن التشابه بين الحرائق الطبيعية والسياسية في (آليات عملها⚙️ وأهدافها النهائية🎯)، ففي كلتا الحالتين، هناك تدمير للنمط القائم وتحفيز لبداية جديدة. لكن، كما هو الحال في الغابات، قد تتحول الحرائق إلى (خطر مُستدام☢️ )إذا خرجت عن السيطرة، فالحروب الأهلية التي تطول دون حل، تُشبه حرائق الغابات التي لا تتوقف عن الانتشار، فتُدمّر المنظومة بأكملها دون فرصة للتجديد، وقد تأتي على ما جاوَرها، بل قد تمتد لمن أشعلها وأقتدحها وأذكى أوارها❗️.
——————
٧- رغم ذلك، هناك (درس مهم 👩🏫) من الطبيعة يمكن أن يُلهم السياسات الدولية: الحرائق الطبيعية الفعّالة (هي تلك التي تُدار بشكل ذكي وموجّه، بحيث تخدم الغابة بدلاً من أن تُبيدها)، و هذا يعني – في السياسة- ، أنه يجب أن تكون هناك إدارة واعية للأزمات والتوترات، تركز على تحويل (الكوارث🔥) إلى (فرص للتجديد🌿) بدلاً من السماح بانهيار كامل للنظام.
ان (التجربة الألمانية🇩🇪 ) بعد الحرب العالمية الثانية تُعد مثالاً يُحتذى، فلقد كان دمار ألمانيا الشامل نتيجة الحرب أشبه بحريق استهلك البلاد بأكملها، لكن الاستجابة السريعة والمخططة، مكنت البلاد من (النهوض مجددًا✊🏼 ) لتصبح واحدة من (القوى الاقتصادية الكبرى💶).
٨- ❓يبقى السؤال الأهم❓: من يُنتج من؟ هل العالم يُنتج الحرائق، أم أن الحرائق هي التي تُنتج العالم؟ الجواب، كما يبدو، هو كلاهما، فالعالم الطبيعي والسياسي ينتج الحرائق كوسيلة للبقاء والتجديد، والحرائق بدورها تعيد تشكيل العالم بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.
هذا التداخل الجدلي بين الإنتاج وإعادة الإنتاج هو ما يجعل النظامين البيئي والسياسي أكثر قدرة على البقاء رغم كل الكوارث التي تحيط بهما، ولكن مَنْ الذي يستطيعَ الجَزمَ مِنْ ان ما يُفتَعَل من حرائق إقليميّة ودوليّة ستكونُ لصالح الشعوب والكائناتِ والدّول، فالبعضُ -الغَبيّ استراتيجياً- ما زالَ يَحفُرُ قبره بِيَدِهِ، ويقدّحُ النيرانَ بشطَطِهِ، فلا هو برجل إطفاءٍ (فَيُلتَمس)، ولا مشروعَ بناءٍ (فَيُعتَمَد)، فأضحى مصداقا الآيةِ {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}(النحل76).!.” ———————-
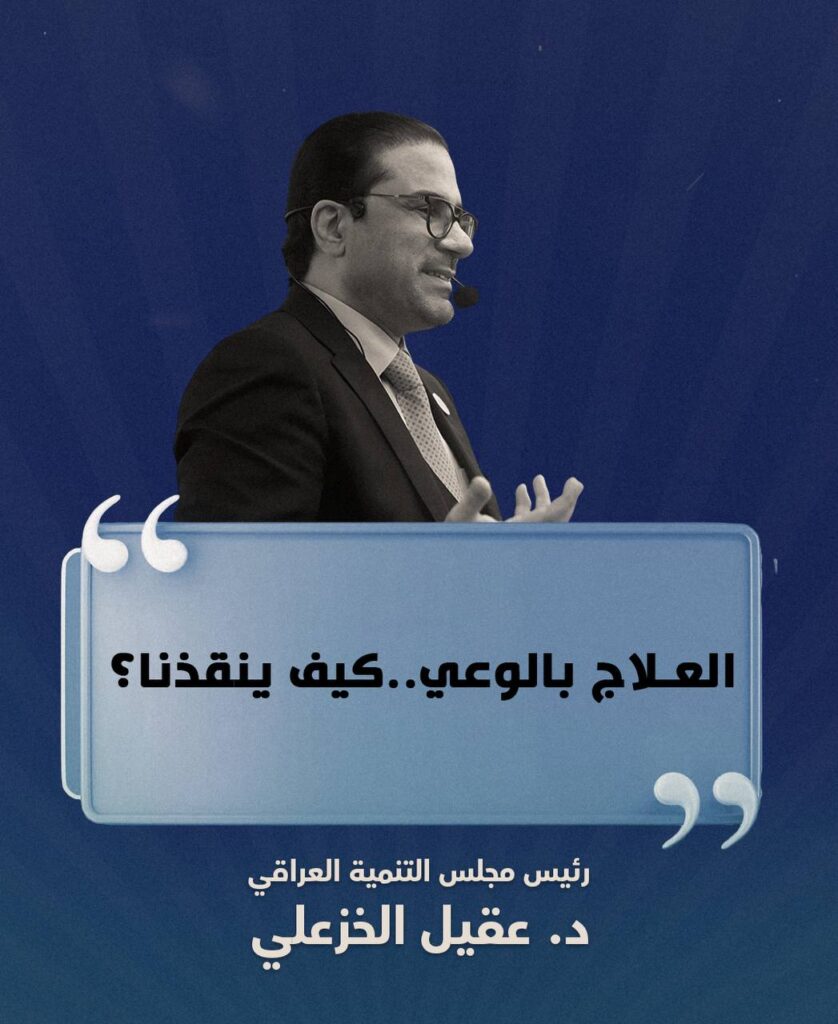
🩺العلاج بالوعي ..كيف ينقذنا؟🩺
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊
١- في عالمنا اليوم، الذي تسوده التفاهة والسطحيّة والسرعة وتشابك العلاقات والأفكار، يبرز (الوعي 💡) كركيزة أساسية لتحقيق التوازن في مواجهة الفوضى والتعقيد، فالوعي ليس مجرد إدراك سطحي أو حالة عقلية عابرة، بل هو منظومة متكاملة من الفهم والإدراك تشمل الذات، والآخرين، والطبيعة، والمجتمع، والعالم بأسره، وكما قال جان جاك روسو: “الوعي هو الحَكَم الذي يجعل الإنسان سيد أفعاله”، فكلما ارتفع وعينا، ازددنا سيطرة على مصيرنا.
٢-🧱الوعي بالذات هو (اللبنة الأولى) في بناء الشخصية الإنسانية، فعندما يبدأ الإنسان في فهم نفسه، دوافِعه، وأفكاره، ومشاعره، يصبح قادرًا على التصالح مع نفسه ومواجهة مخاوفه الداخلية، وهو ما يشكل القوة الحقيقية للتحرر من قيود الماضي وارتباكات الحاضر، وكما قال كارل يونغ: “لا يمكننا تغيير شيء حتى نقبله. الوعي هو القبول الأول”.
على سبيل المثال، قد يشعر الإنسان بالألم عند مواجهة حقيقة تعيق تطوره، كأن يدرك ضعفًا في شخصيته أو خطأً في سلوكياته، هذا الألم، على الرغم من شدته، هو البوابة للتغيير الجذري. فالوعي المؤلم يشبه جراحة دقيقة؛ (موجعة لكنها ضرورية للشفاء).
٣- 🔅عندما يتسع نطاق الوعي ليشمل الجماعة، تتحول القوى الفردية إلى طاقة تعاونية تسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر استقرارًا، إذ كان يرى ( غاندي) أن “التغيير الذي نريد أن نراه في العالم يبدأ من داخلنا”، وهذا ينطبق على المجتمعات أيضًا. فلنأخذ مثالًا من التاريخ؛ أثناء الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، استطاع نيلسون مانديلا أن يجعل من الوعي الجماعي أداة للتسامح والبناء، رغم الألم العميق الذي خلّفه النظام العنصري. لقد أدرك مانديلا أن “الوعي الجمعي بالمستقبل المشترك أقوى من ذكريات الألم”.
٤- 🎨يتيح الوعي المجتمعي أيضًا تفادي النزاعات القائمة على الجهل أو الخوف من الآخر. فمثلاً، عندما يتعلم مجتمع ما تقدير التنوع الثقافي والديني، يتحول الصراع إلى إثراء. يقول (ابن رشد): “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”، مشيرًا إلى ضرورة احترام التنوع الفكري لتحقيق السلام.
٥- 🇮🇶 اما على مستوى الدول، يُعد الوعي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وبناء أنظمة حكم رشيدة، فالقادة الذين يدركون أن السلطة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون امتيازًا شخصيًا، يستطيعون بناء دول مستقرة تتسم بالعدالة والمساواة إسترشاداً بما قاله أفلاطون: “المدينة العادلة هي تلك التي يحكمها الحكماء”. من الأمثلة المعاصرة، يمكن النظر إلى (الدول الإسكندنافية) التي نجحت في تحويل الوعي السياسي والاجتماعي إلى سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، مما جعلها نموذجًا للاستقرار والرفاهية، حيث أدركت هذه الدول أن الوعي بالمصلحة العامة يتطلب (توازنًا بين حقوق الفرد واحتياجات الجماعة).
٦-🌍في عصر العولمة، لم يعد الوعي محصورًا في حدود الفرد أو المجتمع، بل اتسع ليشمل الإنسانية جمعاء، وقد أشار ألبرت آينشتاين إلى هذا بقوله: “العالم مكان خطر، ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من يرون الشر ولا يفعلون شيئًا”.
على سبيل المثال، أزمة التغير المناخي هي من أبرز التحديات التي تتطلب وعيًا عالميًا مشتركًا، إذ أن دول العالم بدأت تدرك أن التعاون، وليس التنافس، هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة، كذلك، حملات القضاء على الفقر والأمراض تُظهر كيف يمكن للوعي الجماعي أن يصبح (أداة لإنقاذ البشرية).
٧-🎭قد يبدو الحديث عن “الوعي المؤلم” تناقضًا في ظاهره، لكنه في حقيقته دعوة شجاعة لمواجهة الحقائق، فالوعي المؤلم يفتح الأبواب لفهم أعمق للنفس والعالم، حتى لو كان ثمنه ألمًا مؤقتًا، وقد لَمّح (فريدريك نيتشه) لذلك بقوله: “ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى”، وهذا ينطبق على الألم الناتج عن مواجهة الحقيقة، ومثاله البارز من حياة فيكتور فرانكل، الطبيب النفسي الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية. فرانكل كتب في كتابه “الإنسان يبحث عن معنى” أن وعيه بمعاناة البشر من حوله لم يكن سهلًا، لكنه منحه القوة لإيجاد معنى حتى في أقسى الظروف.
٨-🎬في النهاية، يمكن القول إن الوعي ليس رفاهية، بل هو شرط أساسي لاستمرار الحياة الإنسانية بشكل متوازن ومستدام. ديكارت عبّر عن هذا المعنى ببساطة: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. التفكير هنا يشمل الوعي الذي يجعل الإنسان قادرًا على تحسين حياته وحياة الآخرين.
٩- 💉ان العلاج بالوعي المؤلم هو دعوة للتغيير والتحرر، فرصة لنقف أمام المرآة، نواجه ضعفنا وأخطائنا، ثم ننهض أقوى. وكما قال جلال الدين الرومي: “الجروح هي المكان الذي يدخل منه النور”، فإن ألم الوعي هو الطريق إلى نور الحكمة والتغيير، فمتى نعي اننا بحاجة لألم الوعي!.
🩺العلاج بالوعي ..كيف ينقذنا؟🩺
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊💊
١- في عالمنا اليوم، الذي تسوده التفاهة والسطحيّة والسرعة وتشابك العلاقات والأفكار، يبرز (الوعي 💡) كركيزة أساسية لتحقيق التوازن في مواجهة الفوضى والتعقيد، فالوعي ليس مجرد إدراك سطحي أو حالة عقلية عابرة، بل هو منظومة متكاملة من الفهم والإدراك تشمل الذات، والآخرين، والطبيعة، والمجتمع، والعالم بأسره، وكما قال جان جاك روسو: “الوعي هو الحَكَم الذي يجعل الإنسان سيد أفعاله”، فكلما ارتفع وعينا، ازددنا سيطرة على مصيرنا.
٢-🧱الوعي بالذات هو (اللبنة الأولى) في بناء الشخصية الإنسانية، فعندما يبدأ الإنسان في فهم نفسه، دوافِعه، وأفكاره، ومشاعره، يصبح قادرًا على التصالح مع نفسه ومواجهة مخاوفه الداخلية، وهو ما يشكل القوة الحقيقية للتحرر من قيود الماضي وارتباكات الحاضر، وكما قال كارل يونغ: “لا يمكننا تغيير شيء حتى نقبله. الوعي هو القبول الأول”.
على سبيل المثال، قد يشعر الإنسان بالألم عند مواجهة حقيقة تعيق تطوره، كأن يدرك ضعفًا في شخصيته أو خطأً في سلوكياته، هذا الألم، على الرغم من شدته، هو البوابة للتغيير الجذري. فالوعي المؤلم يشبه جراحة دقيقة؛ (موجعة لكنها ضرورية للشفاء).
٣- 🔅عندما يتسع نطاق الوعي ليشمل الجماعة، تتحول القوى الفردية إلى طاقة تعاونية تسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر استقرارًا، إذ كان يرى ( غاندي) أن “التغيير الذي نريد أن نراه في العالم يبدأ من داخلنا”، وهذا ينطبق على المجتمعات أيضًا. فلنأخذ مثالًا من التاريخ؛ أثناء الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، استطاع نيلسون مانديلا أن يجعل من الوعي الجماعي أداة للتسامح والبناء، رغم الألم العميق الذي خلّفه النظام العنصري. لقد أدرك مانديلا أن “الوعي الجمعي بالمستقبل المشترك أقوى من ذكريات الألم”.
٤- 🎨يتيح الوعي المجتمعي أيضًا تفادي النزاعات القائمة على الجهل أو الخوف من الآخر. فمثلاً، عندما يتعلم مجتمع ما تقدير التنوع الثقافي والديني، يتحول الصراع إلى إثراء. يقول (ابن رشد): “الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”، مشيرًا إلى ضرورة احترام التنوع الفكري لتحقيق السلام.
٥- 🇮🇶 اما على مستوى الدول، يُعد الوعي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وبناء أنظمة حكم رشيدة، فالقادة الذين يدركون أن السلطة مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون امتيازًا شخصيًا، يستطيعون بناء دول مستقرة تتسم بالعدالة والمساواة إسترشاداً بما قاله أفلاطون: “المدينة العادلة هي تلك التي يحكمها الحكماء”. من الأمثلة المعاصرة، يمكن النظر إلى (الدول الإسكندنافية) التي نجحت في تحويل الوعي السياسي والاجتماعي إلى سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، مما جعلها نموذجًا للاستقرار والرفاهية، حيث أدركت هذه الدول أن الوعي بالمصلحة العامة يتطلب (توازنًا بين حقوق الفرد واحتياجات الجماعة).
٦-🌍في عصر العولمة، لم يعد الوعي محصورًا في حدود الفرد أو المجتمع، بل اتسع ليشمل الإنسانية جمعاء، وقد أشار ألبرت آينشتاين إلى هذا بقوله: “العالم مكان خطر، ليس بسبب من يفعلون الشر، بل بسبب من يرون الشر ولا يفعلون شيئًا”.
على سبيل المثال، أزمة التغير المناخي هي من أبرز التحديات التي تتطلب وعيًا عالميًا مشتركًا، إذ أن دول العالم بدأت تدرك أن التعاون، وليس التنافس، هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة، كذلك، حملات القضاء على الفقر والأمراض تُظهر كيف يمكن للوعي الجماعي أن يصبح (أداة لإنقاذ البشرية).
٧-🎭قد يبدو الحديث عن “الوعي المؤلم” تناقضًا في ظاهره، لكنه في حقيقته دعوة شجاعة لمواجهة الحقائق، فالوعي المؤلم يفتح الأبواب لفهم أعمق للنفس والعالم، حتى لو كان ثمنه ألمًا مؤقتًا، وقد لَمّح (فريدريك نيتشه) لذلك بقوله: “ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى”، وهذا ينطبق على الألم الناتج عن مواجهة الحقيقة، ومثاله البارز من حياة فيكتور فرانكل، الطبيب النفسي الذي نجا من معسكرات الاعتقال النازية. فرانكل كتب في كتابه “الإنسان يبحث عن معنى” أن وعيه بمعاناة البشر من حوله لم يكن سهلًا، لكنه منحه القوة لإيجاد معنى حتى في أقسى الظروف.
٨-🎬في النهاية، يمكن القول إن الوعي ليس رفاهية، بل هو شرط أساسي لاستمرار الحياة الإنسانية بشكل متوازن ومستدام. ديكارت عبّر عن هذا المعنى ببساطة: “أنا أفكر، إذن أنا موجود”. التفكير هنا يشمل الوعي الذي يجعل الإنسان قادرًا على تحسين حياته وحياة الآخرين.
٩- 💉ان العلاج بالوعي المؤلم هو دعوة للتغيير والتحرر، فرصة لنقف أمام المرآة، نواجه ضعفنا وأخطائنا، ثم ننهض أقوى. وكما قال جلال الدين الرومي: “الجروح هي المكان الذي يدخل منه النور”، فإن ألم الوعي هو الطريق إلى نور الحكمة والتغيير، فمتى نعي اننا بحاجة لألم الوعي!.
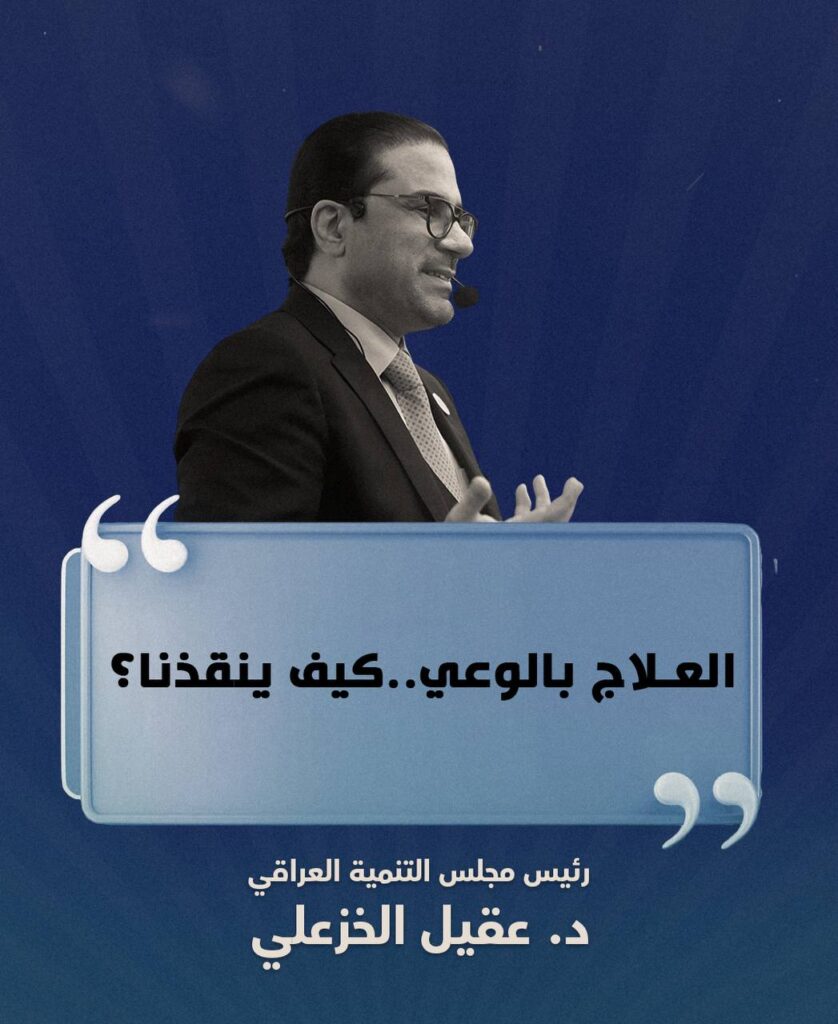
🕌🕌🕌 *الإمام عليّ* 🕌🕌🕌
— راهِنيّةُ الأزمَةِ وفوضويّةُ الأدعياءِ —
د.عقيل الخزعلي / رئيس مجلس التنميّة العراقي
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
” يئنُّ كَوكبُنا الأُمِ اليومَ تحتَ وطأةِ الأزماتِ المتشابكةِ والتهديداتِ التي تتحدّى الإنسانيّةَ على مختلفِ الأصعدةِ، وهنا ؛ تبرزُ مجدداً رمزيّةُ الشخصيّاتِ التاريخيّةِ في (المِخيّال النخبوي والعام) كمناراتٍ تهدي السائرينَ في دروبِ التَّصحيح، ومن بينِ هذهِ الشخصيّاتِ الفريدَةِ، يَتَجَلّى (الإمامُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ) كَصوَتٍ حيٍّ يتردّدُ في ذاكرةِ الإنسانيّةِ، لا بصفتهِ حاكماً أو قائداً فحسبَ، بل باعتبارهِ نموذجاً للفكرِ الذي يتجاوزُ الحدودَ الزمانيّةَ والمكانيّةَ، ليرسمَ معالمَ العدالةِ والحقِّ في مواجهةِ الظلمِ والادّعاءِ.
ورغمَ أنّ الإمامَ عاشَ قبلَ قرونٍ، إلّا أنّ صورتَهُ تتجدّدُ اليومَ كمرآةٍ فلسفيّةٍ تعكسُ التناقضاتِ العميقةَ التي نعيشُها؛ فهو (صوتُ العقلِ العادِلِ في زمنِ الجنونِ)، و(نداءُ الإنسانيّةِ الشّغوفِ في عصرِ الأزماتِ).
إنّ الإمامَ عليّاً، الذي عُرِفَ بتلكَ المصداقيّةِ الصارمةِ الممزوجةِ بالرحمةِ، يقفُ اليومَ شاهداً على طبيعةِ الظلمِ الذي لا يكتفي بمهاجمةِ العظماءِ من الخارجِ، بل يمتدُّ ليشوِّهَ صورتَهم من الداخلِ عبرَ الأدعياءِ الذينَ ينسبونَ أنفسَهم إليهم، فهؤلاءِ الأدعياءُ ليسوا مجرّدَ عابرينَ في التاريخِ، بل هم انعكاسٌ لصراعاتِ القوى التي نعيشُها اليومَ، حيثُ (يُستخدمُ الحقُّ لتحقيقِ الباطلِ)، و(تُستغلُّ القيمُ النبيلةُ لتبريرِ الانحرافاتِ الأخلاقيّةِ والسياسيّةِ). إنّ هذا التناقضَ يبدو أكثرَ وضوحاً في زمنِنا الراهنِ، حيثُ تُرفعُ شعاراتُ (العدلِ والاحتواء)، بينما تُمارَسُ (الهيمنةُ والإقصاءُ) تحتَ غطائِها.
اننا عندما نعودُ إلى إرثِ الإمامِ عليٍّ، نكتشفُ عُمقَ صرامتِهِ في التعاملِ مع الأزماتِ. لقد كانَ (الامام عليٌّ) يُدرِكُ أنّ (العدالةَ) ليست مجرّدَ كلمةٍ تُلقى في خطبةٍ، بل هي (فعلٌ يُمارَسُ بتأنٍّ ومسؤوليّةٍ، يتطلّبُ فهمَ السياقاتِ والمتغيّراتِ دونَ التفريطِ في القيمِ الجوهريّةِ). ومعَ ذلكَ، فإنَّ ما نشهدُهُ اليومَ من توظيفِ اسمِهِ وشعاراتِهِ من قِبَلِ الأدعياءِ يعكسُ أزمةً أخلاقيّةً وفكريّةً كبرى، إذ يتمُّ تقزيمُ إرثِهِ إلى أداةٍ للتنافسِ المذهبي أو السياسيِّ أو الاجتماعيِّ، ممّا يشوِّهُ جوهرَ رسالتِهِ وغاياتِهِ السّامِقة.
ففي العراقِ، الذي يُمثّلُ مسرحاً مركّباً للأزماتِ الراهنةِ، يمكننا أن نرى كيفَ يُستحضَرُ اسمُ (الإمامِ عليٍّ) في سياقاتٍ مختلفةٍ، أحياناً لإضفاءِ شرعيّةٍ على قراراتٍ تفتقرُ إلى الحكمةِ، وأحياناً أخرى كوسيلةٍ لتبريرِ صراعاتٍ لا تمتُّ بصلةٍ إلى مفهومِ العدالةِ الذي حملَهُ الإمامُ.
إنَّ هذهِ الظاهرةَ ليست مجرّدَ (إشكاليّةٍ) سياسيّةٍ أو اجتماعيّةٍ، بل هي امتدادٌ (للأزمةِ الحضاريّةِ) التي يعانيها الإنسانُ المعاصرُ، حيثُ يتمُّ تشويهُ الرموزِ الكبرى لتحويلِها إلى أدواتٍ في خدمةِ المصالحِ الضيّقةِ.
لقد واجَهَ (الإمامُ عليٌّ) الأدعياءَ بسلاحِ الفكرِ والكلمةِ، وكانَ يرى فيهم تجسيداً للظلمِ الذي لا يكتفي بالقمعِ المباشرِ، بل يمتدُّ لتقويضِ الأسسِ الفكريّةِ والأخلاقيّةِ للمجتمعِ. ولعلَّ أبرزَ مثالٍ على ذلكَ يتمثّلُ في موقفِهِ من (الخوارجِ)، الذينَ (رفعوا شعاراتِ الحقِّ لكنّهم انحرفوا عن جوهرِهِ)، فانتهى بهم الأمرُ أداةً للفرقةِ والاضطرابِ.
إنّ هذا النموذجَ يعيدُ نفسهُ اليومَ بأشكالٍ مختلفةٍ، حيثُ تتخذُ الشعاراتُ البرّاقةُ غطاءً للهيمنةِ الاقتصاديّةِ والسياسيّةِ، في عالمٍ يعاني من (تناقضاتِ العولمةِ وتكريسِ الاستقطابِ).
ما يحدثُ اليومَ في العراقِ والمنطقةِ الإقليميّةِ من أزماتٍ متشابكةٍ، سواءٌ في السياسةِ أو الاقتصادِ أو الأمنِ أو الثقافةِ، يضعُنا أمامَ تساؤلٍ فلسفيٍّ عميقٍ: كيفَ يمكننا استلهامُ الرموزِ الكبرى دونَ الوقوعِ في فَخِّ الأدعياءِ؟ الإجابةُ ليست سهلةً، لكنّها تبدأُ بفهمٍ حقيقيٍّ لإرثِ هذهِ الشخصيّاتِ، بعيداً عن القراءةِ الانتقائيّةِ التي تخدمُ المصالحَ الضيّقةَ.
إنَّ (الإمامَ عليّاً)، الذي كانَ يرى في (العدالةِ جوهرَ السياسةِ)، لم يكنْ ليقبلَ أن تتحوّلَ قِيمُهُ إلى مجرّدِ شعاراتٍ تُرفعُ دونَ التزامٍ حقيقيٍّ بتطبيقِها.
أما إذا نظرنا إلى المشهدِ الشَّرق أوسطي والعالميِّ، نرى أنّ الأزماتَ الراهنةَ تكشفُ عن فجوةٍ عميقةٍ بينَ القيمِ التي يتغنّى بها العالمُ الحديثُ وبينَ الممارساتِ الواقعيّةِ التي تُكرّسُ الظلمَ والاستغلالَ.
إنَّ الحديثَ عن الديمقراطيّةِ وحقوقِ الإنسانِ، في ظلِّ تفاقمِ الحروبِ والصراعاتِ وتزايدِ الفجوةِ بينَ الأغنياءِ والفقراءِ، يُشبهُ إلى حدٍّ كبيرٍ ما كانَ (الإمامُ عليٌّ) ينتقدُهُ في زمنِهِ من ادّعاءاتٍ خاليةٍ من المضمونِ، وفي هذا السياقِ، يُصبحُ الإمامُ عليٌّ رمزاً ليس فقط للعراقيّينَ أو المسلمينَ، بل للإنسانيّةِ جمعاءَ، كنموذجٍ للقيادةِ التي تجمعُ بينَ (المصداقيّةِ والشجاعةِ)، وبينَ (المبادئِ والعملِ).
إنَّ الإرثَ الذي تركَهُ الإمامُ عليٌّ ليس نصوصاً جامدةً تقبعُ في بطونِ الكتبِ، بل هو رؤيةٌ ديناميكيّةٌ تعكسُ طبيعةَ الإنسانِ في صراعِهِ مع نفسِهِ ومعَ العالمِ. وعليهِ، فإنَّ استعادةَ هذا الإرثِ تتطلّبُ منّا جهداً مضاعفاً لفهمِهِ في سياقِهِ الأصليِّ، ومن ثمَّ إعادةَ صياغتِهِ بما يتناسبُ معَ تحدّياتِ العصرِ، ففي عالمٍ يهيمنُ عليهِ الضجيجُ والظلم، تُصبحُ الحاجةُ إلى صوتِ الإمامِ عليٍّ أكثرَ إلحاحاً، لا كرمزٍ دينيٍّ فقط، بل كَرمزٍ إنسانيٍّ أدركَ (أنَّ العدالةَ ليست خياراً بل ضرورةً وجوديّةً).
وبالمُحَصِّلة، إنَّ الظلمَ الذي يطالُ الرموزَ الكبرى كالإمامِ عليٍّ ليس مجرّدَ تعدٍّ على شخصيّاتِهم، بل هو تعدٍّ على القيمِ التي يمثّلونَها، ولذا فإنَّ مسؤوليتَنا اليومَ تتجاوزُ الدفاعَ عنهم بالكلماتِ، إلى تجسيدِ قيمِهم الايجابية في أفعالِنا ومواقفِنا، وحينَ نتمكّنُ من ذلكَ، سنجدُ أنَّ صوتَ الإمامِ عليٍّ لا يزالُ يتردّدُ، لا في أروقةِ التاريخِ فقط، بل في كلِّ لحظةٍ نسعى فيها إلى تحقيقِ العدلِ وسطَ عالمٍ يعجُّ بالظَّلَمَةِ والقَتَلَةِ والأدعياءِ !
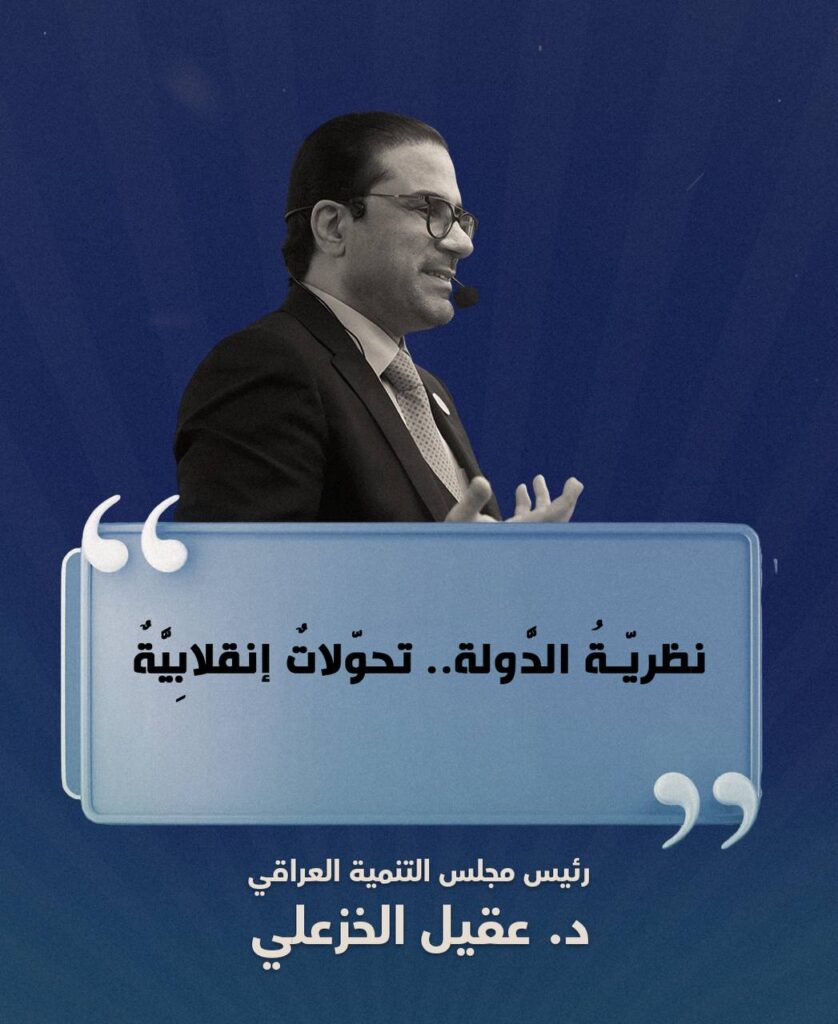
🔃 نظريّةُ الدَّولة.. تحوّلاتٌ إنقلابِيَّةٌ! 🔃
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️☄️
اليوم، يمرُّ العالمُ بتحوّلاتٍ جذريةٍ تُشبهُ الانفجاراتِ الكونيّةَ التي تُعيد تشكيلَ الفضاءاتِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ على نحوٍ غير مسبوقٍ، فما بين الثورةِ الرقميةِ التي دمجت العوالمَ الافتراضيةَ بالواقع، والأزماتِ البيئيةِ التي تجاوزت الحدودَ الجغرافيةَ، والصراعاتِ السياسيةِ التي تمزّج المحليَّ بالعالميِّ، أصبحَ مفهومُ الدولةِ التقليديِّ أمامَ ضرورةٍ ملحّةٍ لإعادةِ النظرِ في ركائزهِ وأبعادهِ وهياكلهِ، بما يتماشى مع متطلباتِ العصرِ ورؤى المستقبلِ. فلم تعُدِ الدولةُ، كما رسمها فقهاءُ القانونِ والسياسةِ في القرونِ الماضيةِ، تلك الكتلةَ المهيمنةَ ذاتَ الحدودِ المغلقةِ التي تدورُ في فلكِ السيادةِ المطلقةِ بمعناها الجامدِ، بل باتَ العالمُ اليومَ ينادي بمفهومِ (الدولةِ المرنةِ) التي تضعُ الإنسانَ وغايتهُ الكبرى في مركزِ الاهتمامِ.
لقد كان من أبرزِ ملامحِ هذه التحوّلاتِ أنّ الدولةَ أصبحت مضطرةً إلى مواجهةِ تغييراتٍ عميقةٍ في عناصرِ وجودِها الأساسيةِ. أولى هذه العناصرِ هي (الأرضُ)، التي لم تعُدْ مجردَ رقعةٍ جغرافيةٍ يتمُّ الدفاعُ عنها بالحدودِ والسيادةِ التقليديةِ، بل تحولت إلى مفهومٍ مرنٍ يشملُ الفضاءَ الرقميَّ، والبحارَ المفتوحةَ، والمواردَ المشتركةَ عالميًا، وعلى سبيل المثال، الفضاءُ الإلكترونيُّ باتَ ساحةً للصراعاتِ بين الدولِ، كما أنه منصةٌ للفرصِ التنمويةِ والاقتصاديةِ التي لا تُقيَّدُ بالجغرافيا. هنا، يتجلى السؤال: (كيف يمكنُ للدولةِ أن تحمي سيادتها في فضاءٍ بلا حدود؟).
أما العنصرُ الثاني هو (الشعبُ)، وهو ليس كيانًا ثابتًا ضمنَ حدودٍ جغرافيةٍ، بل (كيانٌ ديناميكيٌّ) يتمددُ عبرَ الهجرةِ، والعولمةِ، وتداخلِ الثقافاتِ، والشعوبُ اليومَ لم تعُد تكتفي بانتماءِ الهوياتِ الضيقةِ، بل باتت تبحثُ عن هوياتٍ أوسعَ قائمةٍ على (القيمِ المشتركةِ) مثلِ العدالةِ، والحريةِ، والتنميةِ المستدامةِ.
في هذا السياق، نجدُ أنّ دورَ الدولةِ لم يعُد قاصرًا على حمايةِ الحدودِ، بل باتَ منصبًا على حمايةِ حقوقِ الإنسانِ، وتطويرِ قدراتِه، وإشراكهِ في صنعِ القرارِ على كافةِ المستوياتِ.
أما (السلطةُ)، الركنُ الثالثُ للدولةِ، فقد تعرضتْ لتحولاتٍ عميقةٍ مع صعودِ مفاهيمِ (الحوكمةِ الذكيةِ، والديمقراطيةِ التشاركيةِ، والسياساتِ الشاملةِ) التي تهدفُ إلى تمكينِ المواطنِ بدلًا من تهميشهِ، وهذا التغييرُ يفرضُ على الدولِ التخلّي عن النموذجِ الهرميِّ التقليديِّ للسلطةِ لصالحِ نماذجَ أكثرَ شفافيةً، تعتمدُ على (الشراكةِ بين القطاعِ العامِّ والخاصِّ والمجتمعِ المدنيِّ)، وعلى سبيل المثال، قدّمت الدولُ الاسكندنافيةُ نماذجَ متطورةً للحكمِ التشاركيِّ الذي يدمجُ المواطنَ في صنعِ السياساتِ العامةِ، مما أدى إلى تعزيزِ الثقةِ بين الدولةِ والمجتمعِ.
الغايَةُ الكبرى للدولةِ هي (البوصلةُ) التي توجّهُ هذه التحوّلاتِ، فلم يعُدِ الأمنُ بمعناهِ العسكريِّ أو الاقتصاديِّ فقط هو الغايةَ القصوى، بل أصبحَ مفهومُ “جودةِ الحياةِ” مقياسًا حقيقيًا لنجاحِ الدولِ، والتي تعني أنْ تحققَ الدولةُ لشعبِها بيئةً صحيةً، وتعليمًا متقدمًا، وعدالةً اجتماعيةً، وحريةً فرديةً، وتكافؤَ فرصٍ.
من هنا تظهرُ أهميةُ إعادةِ تعريفِ وظائفِ الدولةِ لتشملَ مجالاتٍ جديدةً مثلَ (الأمنِ البيئيِّ، وحوكمةِ البياناتِ، وإدارةِ الابتكارِ).
إنّ هذه المراجعاتِ (الجذريّة) لمفهومِ الدولةِ تقتضي إعادةَ تشكيلِ الهياكلِ التقليديةِ، فبدلًا من الوزاراتِ التقليديةِ، تحتاجُ الدولةُ إلى مؤسساتٍ عابرةٍ للتخصصاتِ تتعاملُ مع القضايا المعقدةِ بشكلٍ تكامليٍّ، فإنّ قضايا مثلَ تغيّرِ المناخِ أو الأمنِ السيبرانيِّ تتطلبُ تعاونَ وزاراتِ البيئةِ، والدفاعِ، والتكنولوجياِ، بدلًا من أن تعملَ كلٌّ منها بمعزلٍ عن الأخرى.
من جهةٍ أخرى، فإنَّ الصراعاتِ الحاليةَ في الساحةِ الدوليةِ، مثلَ النزاعِ في أوكرانيا، أو التوتراتِ في الشرقِ الأوسطِ، تُظهرُ أنّ الدولةَ بحاجةٍ إلى هياكلَ أكثرَ مرونةً لمواكبةِ تغيّرِ طبيعةِ التحالفاتِ والصراعاتِ الدوليةِ.
تأسيساً على ما تقدّم، يمكنُ أنْ نخلُصَ إلى أنّ هذه التحوّلاتِ تجعلُ مفهومَ الدولةِ أكثرَ انسجامًا مع الطبيعةِ الديناميكيةِ للحياةِ البشريةِ، إذ أن الدولةُ ليست غايةً بحدِّ ذاتِها، بل هي (وسيلةٌ لتحقيقِ تطلعاتِ الإنسانِ نحوَ الأمنِ، والعدالةِ، والازدهارِ، وجودةِ الحياةِ)، وإذا كانت الدولةُ قد نشأتْ تاريخيًا كردِّ فعلٍ للتحدياتِ التي واجهتها المجتمعاتُ البشريةُ، فإنّها اليومَ مطالبةٌ (بالابتكارِ والانفتاحِ ) على كافةِ الحلولِ الممكنةِ، بعيدًا عن الأيديولوجياتِ المنغلقةِ التي قادتِ العالمَ سابقًا إلى الصراعاتِ والانقساماتِ.
وبالنتيجة؛ فإنّ نظريةَ الدولةِ اليومَ بحاجةٍ إلى مراجعاتٍ انقلابيةٍ جذريةٍ تتجاوزُ المفاهيمَ الجامدةَ التي تحكمتْ بها لعقودٍ. هذه المراجعاتُ لا تأتي فقط كضرورةٍ سياسيةٍ أو اقتصاديةٍ، بل (كضرورةٍ وجوديةٍ) لبقاءِ الإنسانِ نفسهِ في مواجهةِ تحدياتِ العصرِ، فالدولةُ التي لا تُلبي (تطلّعاتِ شعوبِها)، ولا تُواكبُ (متغيراتِ الزمنِ)، محكومٌ عليها (بالانهيارِ أو التآكلِ التدريجيِّ). لذلك، فإنَّ إعادةَ النظرِ في مفهومِ الدولةِ يجبُ أنْ يكونَ (مشروعًا عالميًا تشاركيًا) يُعيدُ صياغةَ العلاقةِ بين الإنسانِ والدولةِ، وبينَ الدولةِ والنظامِ العالميِّ برمّتهِ، وإلّا سيكونُ قانون التغيير والتبدّل القسري المؤلِم هو الفيصلُ الحاكِم !.
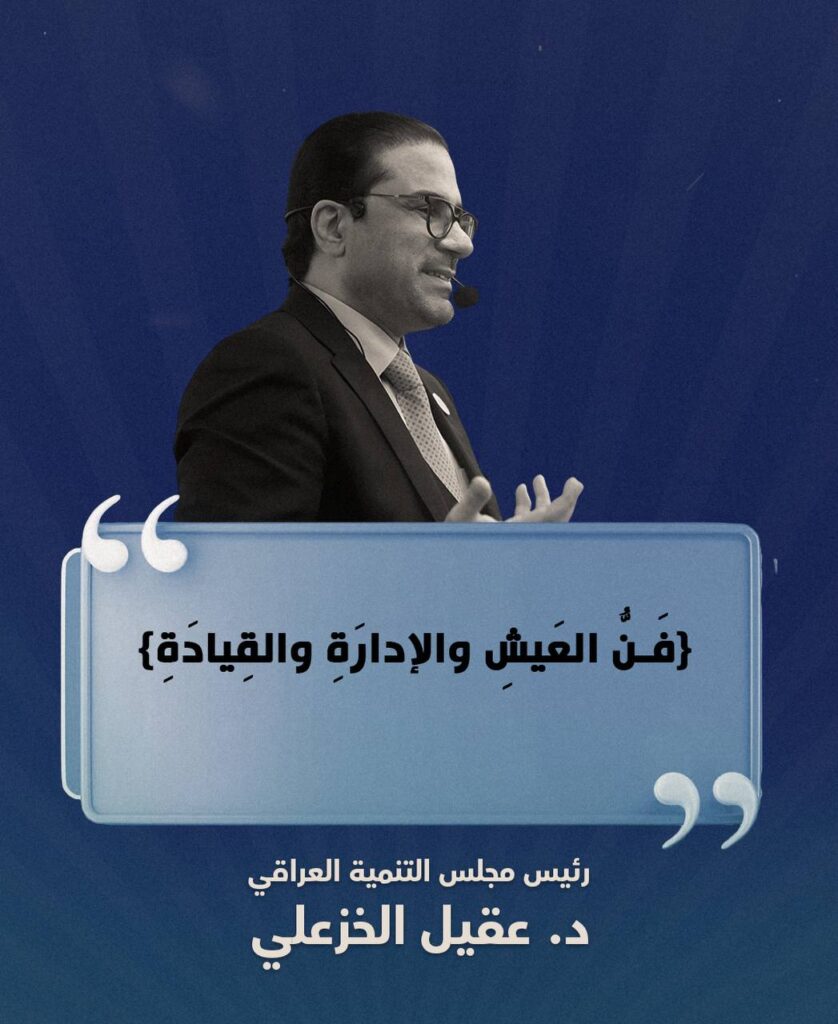
🚀🛸 عَصْرُ الڤوكا ( VUCA )🛸🚀
•••• {فَنُّ العَيشِ والإدارَةِ والقِيادَةِ} ••••••
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقيّ
➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿➿
” 📜قال سقراط: “الحياةُ غَيرُ المَدروسةِ لا تَستَحقُّ أن تُعاشَ.” هذهِ الحكمةُ العَميقةُ تُضيءُ لنا طريقَ الفهمِ في عَصرٍ مُتقَلِّبٍ وغيرِ مُؤكَّدٍ ومُعقَّدٍ وغامضٍ، حَيثُ يُعرَفُ عَصرُنا الحَاليُّ بِاسمِ “الڤوكا”. يُشتَقُّ هذا المُصطلَحُ من الحُروفِ الأولى لأربعةِ مُفرداتٍ باللغةِ الإنجليزيَّةِ: { التَّقَلُّبُ (Volatility)، وعَدَمُ اليَقينِ (Uncertainty)، والتَّعقيدُ (Complexity)، والغُموضُ (Ambiguity)}, إذ وُضِعَ هذا المُصطلَحُ لتوصيفِ بيئةٍ عالميَّةٍ دِينَامِيكِيَّةٍ مُتسارِعةِ التَّغَيُّرِ تَفرِضُ عَلى الأفرادِ والمُؤسَّساتِ والدُّوَلِ تَبَنّي استراتيجياتٍ استثنائيَّةٍ لمُواجَهَةِ تَحدِّيَاتها.
📡إنَّ طبيعةَ الحياةِ في عَصرِ الڤوكا تَرتَكِزُ على التَّغَيُّرِ المُستمِرِّ الذي يَخلُقُ واقِعًا يَختَصِرُ الزَّمنَ والمسافاتِ، فالتَّقَدُّمُ التِّكنولوجيُّ المُتسارِعُ – على سَبيلِ المِثالِ- فَرَضَ تَحوُّلاتٍ جَذريَّةً في مَفاهيمِ الحياةِ؛ كالانتِقالِ المُفاجئِ مِن العملِ التقليديِّ إلى العملِ عَن بُعدٍ خلالَ جَائِحةِ كورونا، ممَّا أجبَرَ المَلايينَ على اكتِسابِ مهاراتٍ رَقمِيَّةٍ جَديدةٍ، وفي هذا السِّياقِ، تَظهَرُ (المَرونةُ الذِّهنِيَّةُ) كواحدٍ مِن أهَمِّ المَهاراتِ اللازِمَةِ (لِلتَّكَيُّفِ)، حيثُ يَتطلَّبُ البقاءُ في هذا العَصرِ استعدادًا مُستَمِرًّا (لإعادةِ التَّعلُّمِ) وتَحديثِ (الكَفاءاتِ الشَّخصيَّةِ).
⚖️لا يَقتَصِرُ الأمرُ على التَّكَيُّفِ؛ بل إنَّ القُدرةَ على (إدارَةِ الذَّاتِ) تُمثِّلُ عُنصُرًا حاسِمًا في تحقيقِ (التَّوازُنِ)، فإدَارَةُ الوَقتِ، وتَحدِيدُ الأَولويَّاتِ، والتَّعلُّمُ المُستدامُ هي أدواتُ الحياةِ النَّاجِحةِ، وفي ضوءِ ذلكَ، تُصبحُ تَجارِبُ رُوَّادِ الأعمالِ الَّذينَ يُعيدُونَ تَشكيلَ مَساراتِهِم المِهنِيَّةِ نَموذَجًا مُلهِمًا.
🩸ورغمَ التَّحدِّياتِ، فإنَّ عَصرَ الڤوكا يَمنَحُنا (فُرصًا ذَهَبِيَّةً) لا تَتَكرَّرُ، فالتَّحوُّلُ الرَّقمِيُّ📱 يَفتَحُ آفاقًا جَديدةً، كما فَعَلَ معَ الشَّبابِ الذينَ أسَّسُوا مَشاريعَ نَاجِحَةً في مَجالاتِ التِّجارةِ الإلكترونيَّةِ والتَّعليمِ عَن بُعدٍ. يَكشِفُ لنا هذا العَصرُ (أنَّ الخَطرَ يَحمِلُ فِي طَيَّاتِهِ فُرَصَ الإبداعِ).
🗂️ تُمثِّلُ الإدارَةُ في عَصرِ الڤوكا العَصَبَ الرَّئيسيَّ (للمرونةِ التَّنظيميَّةِ)، حيثُ تواجهُ المُؤسَّساتُ (ضُغوطًا غيرَ مَسبُوقَةٍ)؛ مِن (التَّقَلُّبِ) في أَسواقِ المالِ، إلى (التَّعقيدِ ) في اتِّخاذِ القَراراتِ. مَثَلًا، تُجسِّدُ الحَربُ في أوكرانيا مِثالًا حَيًّا على التأثيراتِ المُتداخِلَةِ الَّتي تُعيقُ سَلاسِلَ التَّوريدِ العالَمِيَّةِ.
💪🏼يَكمُنُ الحَلُّ في (الإدارَةِ الرَّشيقَةِ)، التَّي تَسمَحُ لِلمُنظَّمَةِ بالتَّكَيُّفِ السَّريعِ مَعَ الظُّروفِ المُتغَيِّرَةِ. إنَّ تَبَنّي الشَّركاتِ للتِّكنولوجيا السَّحابيَّةِ كَوسيلةٍ لِخفضِ التَّكالِيفِ هُو نَموذجٌ يَستَحِقُّ الدِّراسَةَ، إلى جانِبِ ذَلِكَ، يَظْهَرُ (التَّفكيرُ المَنظُوميُّ) كأداةٍ لإدارَةِ التَّعقيدِ بِحيثُ يُراعَى في القَرارِ التَّأثيراتُ المُحتَمَلَةُ عَلى جَمِيعِ العَوامِلِ المُحيطَةِ.
🎖️وفي ظِلِّ عَصرٍ يَتَّسِمُ بالغُموضِ، تَتَطلبُ (القِيادَةُ) شَجاعةً استثنائيَّةً، فالقَائدُ النَّاجِحُ يَستَطِيعُ اتِّخاذَ قَراراتٍ حاسِمَةٍ حتى في أَوَجِّ عَدمِ اليَقينِ، وهذا يستدعي ذَكَاءً عاطِفِيًّا يُعينُهُ عَلى استِيعابِ احتِياجاتِ الفَريقِ وتحفيزِهِم، فالقَائدُ المُبدِعُ يَبنِي ثقافَةً تَشجِّعُ على الابتكارِ، حتَّى وإن بَدَتْ بَعضُ الأَفكارِ غَيرَ مَنطِقِيَّةٍ في البِدايَةِ.
🤝ولا يُمكنُ أَن نَغفَلَ أَهمِّيَّةَ التَّواصلِ الفَعَّالِ؛ فَهُو الأَداةُ التِّي يَنقُلُ بِها القائِدُ رُؤيَتَهُ بِوُضوحٍ ويَصنَعُ بَينَها وبينَ الفَريقِ جِسرًا يُلهِمُهُم للإنجازِ.
إنَّ فَنَّ (العَيشِ والإدارَةِ والقِيادَةِ) في عَصرِ الڤوكا لا يُمَثِّلُ تَكَيُّفاً مَعَ الظُّروفِ وفقط، بَل هُو (مَسيرَةٌ نَحوَ الابتكارِ والتَّميُّزِ)، ويَستَحِقُّ هذا العَصرُ أَن يُنظَرَ إليه (كفُرصَةٍ لِلتَّطوُّرِ)، فَمَن أَدرَكَ مَعناهُ واستَعدَّ لَهُ، بَنى مُستَقبلًا أَكثَرَ استدامةً☀️، ومَن جَهِلَهُ، انطَوى تَحتَ ظِلِّه🌘. “
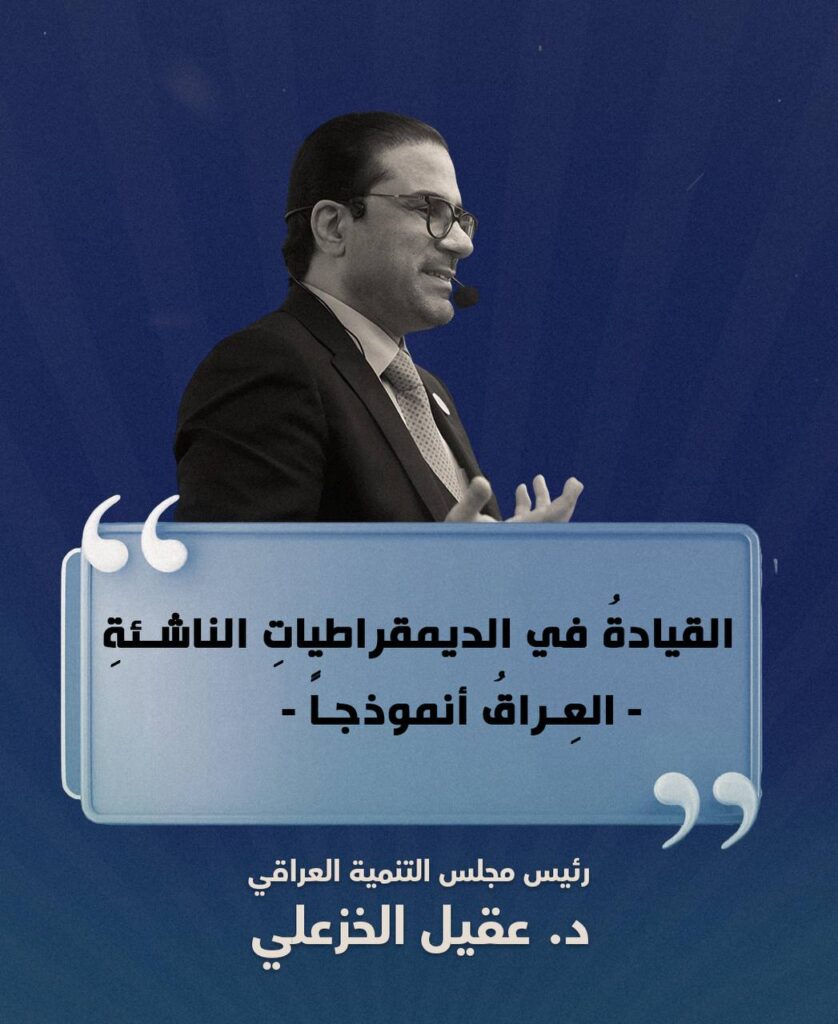
—(القيادةُ في الديمقراطياتِ الناشئةِ)—
🇮🇶- العِراقُ أنموذجاً -🇮🇶
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️
” ما زالت موضوعةُ (القيادةِ🏆) تُعَدُّ تحدّيًا مركزيًا أمامَ الدولِ التي تَسْعَى للخروجِ من صراعاتٍ طويلةٍ أو أنظمةٍ سلطويّةٍ نحوَ بناءِ أنظمةٍ ديمقراطيّةٍ حقيقيةٍ ومستقرة، والعراقُ، كبلدٍ يمتلكُ إرثًا حضاريًا وسياسيًا طويلًا، يقدّمُ أنموذجًا حيًّا يُجَسِّدُ معضلاتِ الديمقراطيةِ الناشئةِ وإمكاناتِها.
فمنذ سقوطِ النظامِ الدكتاتوري السابقِ عامَ ٢٠٠٣، دخلتِ البلادُ مرحلةً انتقاليةً حرجةً، تخلّلتْها تحدياتٌ هائلةٌ، ليسَ فقط على مستوى بناءِ الدولةِ، بل في إعادةِ تعريفِ العلاقةِ بينَ السلطةِ والشعبِ، وبينَ مكوناتِ المجتمعِ المتنوّعِ. وفي هذا السياقِ، تبرزُ القيادةُ كعاملٍ جوهريٍّ قد يُحَوِّلُ الأزماتِ إلى فرصٍ، أو يُبْقِيها عائقًا أمامَ التنميةِ والاستقرارِ.
⚓️ إنّ القيادةَ في العراقِ بعدَ عامِ ألفينِ وثلاثة كانتْ محمَّلةً بأثقالٍ تاريخيةٍ عميقةٍ؛ إذ ورثتْ البلادُ بنيةً سياسيةً متآكلةً، ومجتمعًا منهكًا من العقودِ السابقةِ من الصراعاتِ والحروبِ، ونظامًا اقتصاديًا يعتمدُ بشكلٍ شبهِ كاملٍ على النفطِ دونَ تنويعٍ يُذْكَر. علاوةً على ذلك، فإنَّ (انعدامَ الثقةِ) بينَ المواطنِ والدولةِ، (والفسادَ المؤسسيَّ) المستفحل، قد جعلا القيادةَ في موضعِ اختبارٍ دائمٍ.
وعلى الرغمِ من هذه التحدياتِ، فإنّ القيادةَ الفعّالةَ لا تزالُ هي المفتاحُ الذي يمكنُ من خلالهِ توجيهُ العراقِ نحوَ الاستقرارِ والتنميةِ.
🛟 لَم تَضحى (القيادة الفعّالة في الديمقراطياتِ الناشئةِ) مجردَ إدارةٍ للوقتِ أو المواردِ، بل هي (فنٌّ يجمعُ بينَ الفهمِ العميقِ للسياقاتِ التاريخيةِ والاجتماعيةِ، والقدرةِ على استشرافِ المستقبلِ)، من هنا ، وفي العراقِ الجديدِ يتوجب أن تكونَ رؤيةُ القياداتِ (جامعةً)، تتجاوزُ الانقساماتِ الطائفيةَ والعرقيةَ، لتُعيدَ بناءَ الهويةِ الوطنيةِ على أُسسٍ مشتركةٍ، لكونها – أي القيادة- أمْسَتِ الحَكَمُ بينَ الماضي والحاضرِ، وهي التي تُمسكُ بيدهِا مفاتيحَ الحاضرِ لتصنعَ (مستقبلًا) تتلاقى فيهِ (التطلعاتُ) المختلفةُ ضمنَ فَضاءٍ (مُوحّدٍ).
⚔️ لقد كانتْ تجربةُ العراقِ في مواجهةِ تنظيمِ (داع،شِ) الإرهابيِّ واحدةً من اللحظاتِ التي أظهرتْ الدورَ الحيويَّ (للقيادات الرسميّة والشعبيّة) في أوقاتِ الأزماتِ الكبرى، إذ حينها، تمكّنَتِ من توحيدِ الصفوفِ، مستفيدةً من الدعمِ الدوليِّ لتنسيقِ الجهودِ الوطنيةِ والعالميةِ، رُغمَ أنّ ما بَرَزَ بعدَ تلكَ الحربِ كانَ ضعفًا في التخطيطِ الاستراتيجيِّ، وهو ما يعكسُ غيابَ الرؤيةِ طويلةِ الأمدِ التي تحتاجها القيادةُ !.
💡يقتضي من (القياداتِ المُتَصَدية) أن تتحلى بالمرونةِ، فهي ليستْ قيادةً جامدةً تُصِرُّ على خططٍ لا تلائمُ الواقعَ المتغيّرَ، بل قيادةٌ واعيةٌ بأنَّ (الأزماتَ هي جزءٌ لا يتجزأُ من عمليةِ التحولِ)، وهذهِ المرونةُ تعني (القدرةَ على تعديلِ المسارِ دونَ التخلّي عن المبادئِ الجوهريةِ للدولةِ)، وتعني أيضًا القدرةَ على (اتخاذِ قراراتٍ صعبةٍ ولكنْ ضروريةٍ، حتى لو كانتْ غيرَ شعبيةٍ في اللحظةِ الراهنةِ).
🦠 كما ينبغي على القياداتِ أن تواجهَ معضلةَ (الفسادِ) بجديةٍ وإرادةٍ حقيقيةٍ؛ إذ (يُعَدُّ الفسادُ أحدَ أخطرِ التحدياتِ التي تُهدّدُ شرعيةَ أيِّ نظامٍ ديمقراطيٍّ ناشئٍ)، مما يستدعي بناءَ مؤسساتٍ رقابيةٍ أكثرُ استقلالاً وفاعلية، وتطبيقَ قوانينٍ صارمةٍ بحقِّ المتورطينَ، سواءٌ كانوا في مستوياتٍ عليا أو دنيا، كما أنَّ (الشفافيةَ) يجبُ أن تكونَ محورًا أساسيًا في سياساتِ القادةِ، لأنَّ (الثقةَ لا تُستعادُ إلا من خلالِ الصدقِ والمساءلةِ).
🏗️ وفي الوقتِ نفسهِ، لا يمكنُ فصلُ القيادةِ عن التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، فالعراقُ بحاجةٍ إلى قياداتٍ تمتلكُ رؤيةً لتقليلِ الاعتمادِ على النفطِ كمصدرٍ وحيدٍ للدخلِ، وتنويعِ الاقتصادِ من خلالِ الاستثمارِ في القطاعاتِ الزراعيةِ والصناعيةِ والسياحيةِ والماليّة والمصرفية والاقتصادات المعرفية والرقمية الذكية، بالإضافةً إلى ذلك، يجبُ أن تستثمرَ القيادةُ في بناءِ رأسِ المالِ البشريِّ، من خلالِ إصلاحِ النظامِ التعليميِّ ليكونَ (محركًا للإبداعِ والتطويرِ والاقتصاد والريادة والابتكار)، بدلًا من أن يظلَّ (حبيسًا لمناهجِ الماضي).
—(القيادةُ في الديمقراطياتِ الناشئةِ)—
🇮🇶- العِراقُ أنموذجاً -🇮🇶
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️🎖️
” ما زالت موضوعةُ (القيادةِ🏆) تُعَدُّ تحدّيًا مركزيًا أمامَ الدولِ التي تَسْعَى للخروجِ من صراعاتٍ طويلةٍ أو أنظمةٍ سلطويّةٍ نحوَ بناءِ أنظمةٍ ديمقراطيّةٍ حقيقيةٍ ومستقرة، والعراقُ، كبلدٍ يمتلكُ إرثًا حضاريًا وسياسيًا طويلًا، يقدّمُ أنموذجًا حيًّا يُجَسِّدُ معضلاتِ الديمقراطيةِ الناشئةِ وإمكاناتِها.
فمنذ سقوطِ النظامِ الدكتاتوري السابقِ عامَ ٢٠٠٣، دخلتِ البلادُ مرحلةً انتقاليةً حرجةً، تخلّلتْها تحدياتٌ هائلةٌ، ليسَ فقط على مستوى بناءِ الدولةِ، بل في إعادةِ تعريفِ العلاقةِ بينَ السلطةِ والشعبِ، وبينَ مكوناتِ المجتمعِ المتنوّعِ. وفي هذا السياقِ، تبرزُ القيادةُ كعاملٍ جوهريٍّ قد يُحَوِّلُ الأزماتِ إلى فرصٍ، أو يُبْقِيها عائقًا أمامَ التنميةِ والاستقرارِ.
⚓️ إنّ القيادةَ في العراقِ بعدَ عامِ ألفينِ وثلاثة كانتْ محمَّلةً بأثقالٍ تاريخيةٍ عميقةٍ؛ إذ ورثتْ البلادُ بنيةً سياسيةً متآكلةً، ومجتمعًا منهكًا من العقودِ السابقةِ من الصراعاتِ والحروبِ، ونظامًا اقتصاديًا يعتمدُ بشكلٍ شبهِ كاملٍ على النفطِ دونَ تنويعٍ يُذْكَر. علاوةً على ذلك، فإنَّ (انعدامَ الثقةِ) بينَ المواطنِ والدولةِ، (والفسادَ المؤسسيَّ) المستفحل، قد جعلا القيادةَ في موضعِ اختبارٍ دائمٍ.
وعلى الرغمِ من هذه التحدياتِ، فإنّ القيادةَ الفعّالةَ لا تزالُ هي المفتاحُ الذي يمكنُ من خلالهِ توجيهُ العراقِ نحوَ الاستقرارِ والتنميةِ.
🛟 لَم تَضحى (القيادة الفعّالة في الديمقراطياتِ الناشئةِ) مجردَ إدارةٍ للوقتِ أو المواردِ، بل هي (فنٌّ يجمعُ بينَ الفهمِ العميقِ للسياقاتِ التاريخيةِ والاجتماعيةِ، والقدرةِ على استشرافِ المستقبلِ)، من هنا ، وفي العراقِ الجديدِ يتوجب أن تكونَ رؤيةُ القياداتِ (جامعةً)، تتجاوزُ الانقساماتِ الطائفيةَ والعرقيةَ، لتُعيدَ بناءَ الهويةِ الوطنيةِ على أُسسٍ مشتركةٍ، لكونها – أي القيادة- أمْسَتِ الحَكَمُ بينَ الماضي والحاضرِ، وهي التي تُمسكُ بيدهِا مفاتيحَ الحاضرِ لتصنعَ (مستقبلًا) تتلاقى فيهِ (التطلعاتُ) المختلفةُ ضمنَ فَضاءٍ (مُوحّدٍ).
⚔️ لقد كانتْ تجربةُ العراقِ في مواجهةِ تنظيمِ (داع،شِ) الإرهابيِّ واحدةً من اللحظاتِ التي أظهرتْ الدورَ الحيويَّ (للقيادات الرسميّة والشعبيّة) في أوقاتِ الأزماتِ الكبرى، إذ حينها، تمكّنَتِ من توحيدِ الصفوفِ، مستفيدةً من الدعمِ الدوليِّ لتنسيقِ الجهودِ الوطنيةِ والعالميةِ، رُغمَ أنّ ما بَرَزَ بعدَ تلكَ الحربِ كانَ ضعفًا في التخطيطِ الاستراتيجيِّ، وهو ما يعكسُ غيابَ الرؤيةِ طويلةِ الأمدِ التي تحتاجها القيادةُ !.
💡يقتضي من (القياداتِ المُتَصَدية) أن تتحلى بالمرونةِ، فهي ليستْ قيادةً جامدةً تُصِرُّ على خططٍ لا تلائمُ الواقعَ المتغيّرَ، بل قيادةٌ واعيةٌ بأنَّ (الأزماتَ هي جزءٌ لا يتجزأُ من عمليةِ التحولِ)، وهذهِ المرونةُ تعني (القدرةَ على تعديلِ المسارِ دونَ التخلّي عن المبادئِ الجوهريةِ للدولةِ)، وتعني أيضًا القدرةَ على (اتخاذِ قراراتٍ صعبةٍ ولكنْ ضروريةٍ، حتى لو كانتْ غيرَ شعبيةٍ في اللحظةِ الراهنةِ).
🦠 كما ينبغي على القياداتِ أن تواجهَ معضلةَ (الفسادِ) بجديةٍ وإرادةٍ حقيقيةٍ؛ إذ (يُعَدُّ الفسادُ أحدَ أخطرِ التحدياتِ التي تُهدّدُ شرعيةَ أيِّ نظامٍ ديمقراطيٍّ ناشئٍ)، مما يستدعي بناءَ مؤسساتٍ رقابيةٍ أكثرُ استقلالاً وفاعلية، وتطبيقَ قوانينٍ صارمةٍ بحقِّ المتورطينَ، سواءٌ كانوا في مستوياتٍ عليا أو دنيا، كما أنَّ (الشفافيةَ) يجبُ أن تكونَ محورًا أساسيًا في سياساتِ القادةِ، لأنَّ (الثقةَ لا تُستعادُ إلا من خلالِ الصدقِ والمساءلةِ).
🏗️ وفي الوقتِ نفسهِ، لا يمكنُ فصلُ القيادةِ عن التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، فالعراقُ بحاجةٍ إلى قياداتٍ تمتلكُ رؤيةً لتقليلِ الاعتمادِ على النفطِ كمصدرٍ وحيدٍ للدخلِ، وتنويعِ الاقتصادِ من خلالِ الاستثمارِ في القطاعاتِ الزراعيةِ والصناعيةِ والسياحيةِ والماليّة والمصرفية والاقتصادات المعرفية والرقمية الذكية، بالإضافةً إلى ذلك، يجبُ أن تستثمرَ القيادةُ في بناءِ رأسِ المالِ البشريِّ، من خلالِ إصلاحِ النظامِ التعليميِّ ليكونَ (محركًا للإبداعِ والتطويرِ والاقتصاد والريادة والابتكار)، بدلًا من أن يظلَّ (حبيسًا لمناهجِ الماضي).
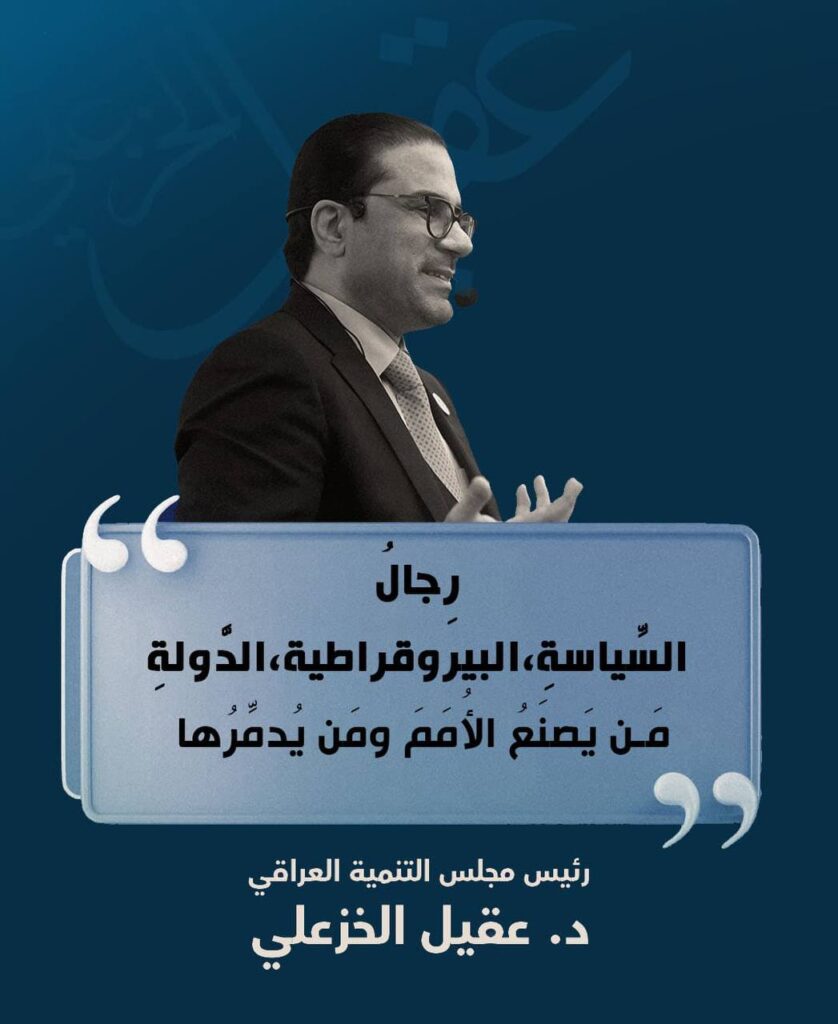
🛡️رِجالُ (السِّياسةِ،البيروقراطية،الدَّولةِ)🛡️
-——( مَن يَصنَعُ الأُمَمَ ومَن يُدمِّرُها؟)——-
د.عقيل الخزعلي
رئيس مجلس التنميّة العراقي
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
“ إنَّ السِّياسةَ بلا مبدإٍ ضربٌ من العَبَثِ، والمبدَأ بلا سِياسةٍ ضربٌ مِنَ الخُرَافَةِ ” بهذه الحكمةِ البليغةِ لمونتسكيو، يُفتَتَحُ الحديثُ عن الصِّنفِ الأندرِ والأكثرِ تأثيرًا في تاريخِ الأُممِ، وهو القائدُ الحقيقيُّ الَّذي يَصنَعُ التاريخَ بدلًا من أنْ تَصنعَهُ الأحداثُ، ففي عالمٍ يَمتلئُ بالسِّياسيِّينَ الذينَ يُتقنونَ فنَّ المناورةِ والتَّكتيكِ، والسُّلطويِّينَ الذينَ يُديرونَ الأجهزةَ الحكوميَّةَ بالقوانينِ والانضباطِ، تَبقى الحاجةُ ماسَّةً إلى رِجالِ الدَّولةِ، أولئكَ الذينَ يَملكونَ الرُّؤيةَ والقدرةَ على بناءِ الحاضرِ والمستقبلِ معًا، فلا يَتصرَّفونَ وفقَ مصلحةٍ آنِيَّةٍ ولا يَغرقونَ في حساباتِ الاستقرارِ العابرِ، بل يُخطِّطونَ (لمشاريعِ نَهضةٍ) تمتدُّ عبرَ العقودِ والأجيالِ.
يَحكمُ (رِجالُ السِّياسةِ) بفنونِ الإقناعِ، يُتقنونَ اللُّعبةَ الانتخابيَّةَ، يَعرفونَ متى يُغيِّرونَ مواقفَهم، وكيفَ يُناورونَ داخلَ الأحزابِ والكتلِ السِّياسيَّةِ، يُقدِّمونَ وعودًا يُدركونَ أنَّها قد لا تَتحقَّقُ، لكنَّهم يُجيدونَ تسويقَها لجمهورٍ يَبحثُ عن مَنْ يُمثِّلهُ في (صراعِ المصالحِ)، وهنا؛ يكونُ السِّياسيُّ البارعُ ليسَ بالضَّرورةِ مَن يَملكُ رؤيةً استراتيجيَّةً، بل مَن يَملكُ القدرةَ على (التَّكيُّفِ) مع الظُّروفِ المتغيِّرةِ، و(استغلالِ ) المشاعرِ العامَّةِ لكسبِ الأصواتِ والنُّفوذِ.
في الدُّولِ ذاتِ الأنظمةِ التَّعدُّديَّةِ، يُصبحُ (رجلُ السِّياسةِ) عُنصرًا ضروريًّا لتوجيهِ الدَّفَّةِ بينَ المصالحِ المتضاربةِ، لكنَّهُ حينَ يَتحوَّلُ إلى (انتهازيٍّ) يَسعى إلى البقاءِ في المشهدِ بغضِّ النَّظرِ عن العواقبِ، فإنَّهُ (يُدمِّرُ) الاستقرارَ ويَجعلُ الدَّولةَ (أسيرةَ) صراعاتٍ داخليَّةٍ لا تَنتهي.
أما (رِجالُ السُّلطةِ/البيروقراطيّة) فَهُمُ على النَّقيضِ من ذلكَ، لا يُلقونَ بالًا للمُناوراتِ السِّياسيَّةِ، ولا يَهتمُّونَ بكسبِ ودِّ الجماهيرِ أو بِنَسْجِ التَّحالُفاتِ الانتخابيَّةِ، بل يَنشغلونَ (بإدارةِ) المؤسَّساتِ وأجهزةِ الحُكمِ، مُؤمنينَ بأنَّ الاستقرارَ لا يُمكنُ تحقيقُهُ إلَّا (بالانضباطِ والالتزامِ بالقوانينِ والأنظمةِ)، و(يَفرضونَ القواعدَ بصلابةٍ، يَمنعونَ الفوضى، يُديرونَ المواردَ بفعاليَّةٍ)، لكنَّهُم قد يَميلونَ إلى (الجمودِ) حينَ تَتطلَّبُ المرحلةُ إصلاحاتٍ جوهريَّةً أو تحوُّلاتٍ كبرى، وهو ما يَرفَعُ منسوبَ الخَسائِر.
في الأنظمةِ السُّلطويَّةِ، يَمتلكُ هؤلاءِ القُوَّةَ الكافيةَ لإبقاءِ الدَّولةِ في مسارٍ مُحدَّدٍ، لكنَّهم قد يُضحُّونَ (بالحُريَّةِ) في سبيلِ (الأمنِ)، وقد يُحوِّلونَ القانونَ من (أداةِ حُكمٍ) إلى (سلاحٍ ) لمُحاصرةِ المُعارضينَ وإسكاتِ الأصواتِ المُغايرةِ. حينَ يُدارُ البلدُ بمنطقِ (السُّلطةِ/البيروقراطيّة) فقط، يَصبحُ التَّقدُّمُ مُستحيلًا، لأنَّ (الإدارةَ) وحدَها لا تَكفي لِبِناءِ حضارةٍ أو تشكيلِ رؤيةٍ تُنيرُ المستقبلَ.
أن التَّاريخَ لم يَصنعْهُ (السِّياسيُّونَ) وحدَهم، ولم يَحمِهُ رجالُ (السُّلطةِ) فقط، بل سَطَّرهُ (رجالُ الدَّولةِ) الذينَ يَجمعونَ بينَ {الحِكمةِ والقُوَّةِ}، بينَ {الفِكرِ والإدارةِ}، بينَ {الاستراتيجيَّةِ والمَرحليَّةِ}. هؤلاءِ هُم الذينَ يَملكونَ نَظرةً شاملةً للمجتمعِ، يَعرفونَ أنَّ [بناءَ الأُممِ] لا يَحدثُ في دَورةٍ انتخابيَّةٍ، ولا في عقدٍ واحدٍ، بل هو <عمليَّةٌ مُعقَّدةٌ> تَحتاجُ إلى رُؤيةٍ مُتماسكةٍ وإرادةٍ سياسيَّةٍ صلبةٍ لا تَخضعُ لِلضُّغوطِ العابرةِ, فرجلُ الدَّولةِ لا يَخشى تَغييرَ القَوانينِ أو إِجراءَ الإصلاحاتِ الجَذريَّةِ إذا كانتْ ضَروريَّةً، ولا يُساومُ على مَصلحةِ الأُمَّةِ في سَبيلِ نَجاحِهِ الشَّخصيِّ، ويُفكِّرُ في (كيفيَّةِ تَحقيقِ النُّموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ)، و(كيفيَّةِ تَطويرِ التعليمِ والصِّناعةِ والتِّكنولوجيا)، و(كيفيَّةِ بناءِ نظامٍ سياسيٍّ يُراعي التَّوازُنَ بينَ السُّلطةِ والشَّعبِ)، (كيفيَّةِ إِبقاءِ البلادِ مستقلَّةً عن التَّجاذُباتِ الدَّوليَّةِ)، و(كيفيَّةِ إِدارةِ المواردِ بحيثُ لا تَكونُ الأُمَّةُ عُرضةً للأزماتِ المُفاجِئةِ)، إنَّهُ [القائدُ الذي يُنشئُ دَولةً تَعيشُ بَعدَ رَحيلهِ، لا نظامًا يَنهارُ معَ غيابِهِ].
لَقَد وَلَجَ العالَمُ في زمنٍ تُواجِهُ فيهِ الأُممُ تَحدِّيَاتٍ غيرَ مَسبوقةٍ، مِن أَزمَاتٍ (اقتصاديَّةٍ) عَالميَّةٍ إلى تَحوُّلاتٍ (تِكنولوجيَّةٍ) جَذريَّةٍ إلى نِزاعاتٍ (سياسيَّةٍ) تَشتدُّ فَصولُها، مما يُحَتِّمُ الدُّولُ احتياجَها الى أَكثَرَ مِن مُجرَّدِ مُنافِسِينَ سِياسيِّينَ أو مُديرينَ لِلشَّأنِ العَامِّ، بل إلى رِجالِ دَولةٍ حقيقيِّينَ يَستطيعونَ وَضعَ مَسَاراتٍ واضِحةٍ لِلنهضةِ والاستِقرارِ وَالبَقاءِ.
إنَّ البُلدانَ الَّتي يَحكُمُها مَحضُ (سِياسيِّينَ) تَظلُّ تَتأرجَحُ بينَ نِزاعاتِ الأحزابِ وَالصِّراعاتِ الدَّاخليَّةِ، وتُصبِحُ هَشَّةً أَمامَ الأَزماتِ، وَالبُلدانَ الَّتي يَتحكَّمُ فيها (رِجالُ السُّلطةِ/البيروقراطيّة) وحدَهم، تَفقِدُ مَرونَتَها وَتَتحوَّلُ إلى أَنظِمَةٍ جامِدَةٍ تَنهارُ مَعَ أوَّلِ اهتِزازٍ كَبيرٍ، وَحَدها الدُّوَلُ الَّتي تَقودُها [رِجالُ الدَّولةِ] هِيَ القادِرَةُ على صُنعِ المُستَقبَلِ وَضَمانِ الاسْتِمرارِ.
إنَّ {المُستَقبَلَ} لا يَنتَظِرُ المُناوِرينَ وَلا الإِداريِّينَ فَقط، بَل يَنحَنِي أَمامَ مَن يَعرِفُ كَيفَ يَكسبُ (اللُّعبَةَ السِّياسيَّةَ وَالإِداريَّةَ) لصالِحِ شَعبِهِ ، وَفي نَفسِ الوَقتِ يَصنَعُ نِظامًا يَستَمِرُّ وَيَتَطَوَّرُ بَعدَهُ، “فَقليلٌ دائِمٌ خيرٌ مِن كَثيرٍ مُنقَطِع.
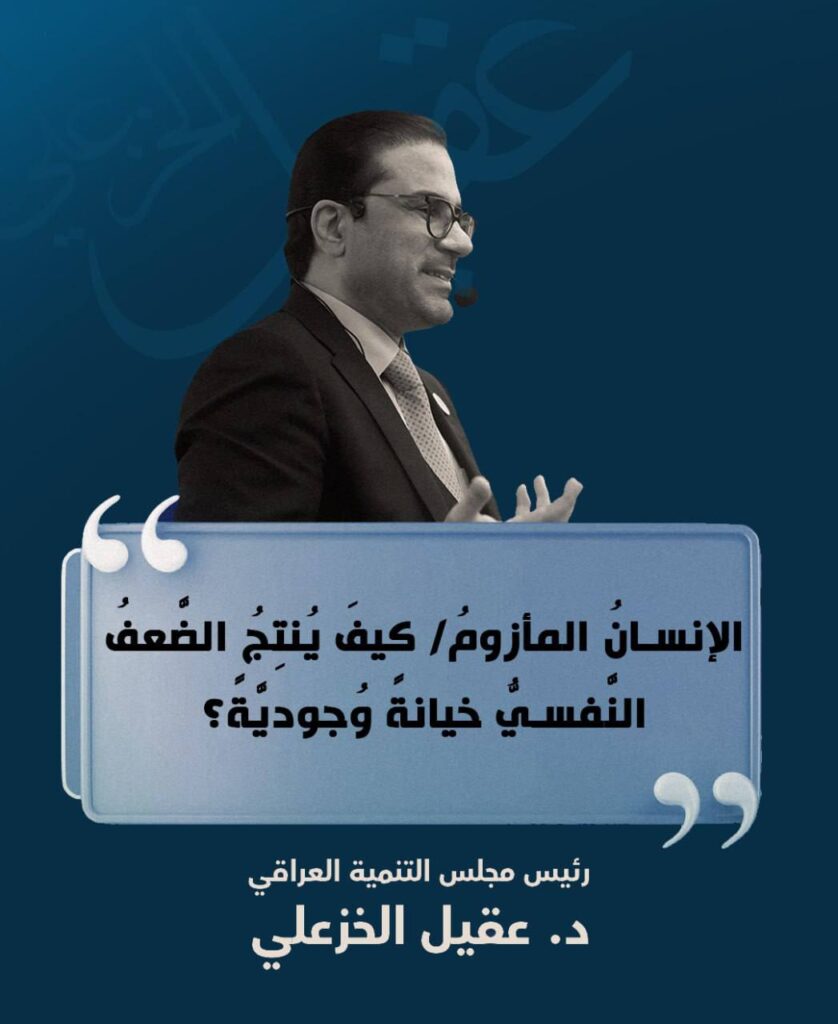
🪐في لَيلَةِ اصطفافِ الكَواكِب السّبعة🪐
-————( الإنسانُ المأزوم )—————-
كيفَ يُنتِجُ الضَّعفُ النَّفسيُّ خيانةً وُجوديَّةً؟
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
” في مَسرحِ الحياةِ، حيثُ تتقاطعُ المصائرُ وتتشابكَ الإراداتُ، يَتَسَلَّلُ بعضُهُم بينَنا (كأشباحٍ مُعتِمةٍ)، يَزحَفونَ على الحوافِّ الرَّخوةِ للمجتمعاتِ، (يَقتاتونَ على التَّشوُّهاتِ النَّفسيَّةِ التي تَستعمِرُ أرواحَهُم)، يَرفعونَ راياتِ؛ (الحِقدِ والغِلِّ والحَسَدِ والكَراهِيَةِ)، ويتَّخِذونَ مِن نجاحِ الآخرينَ إعلانًا لهزيمَتِهِم، فيَتَحَوَّلونَ إلى (مَعَاوِلَ هَدمٍ) صامِتَةٍ، تَسعى لتَقويضِ كلِّ بِنَاءٍ، وكَبحِ كلِّ انطِلاقَةٍ، وتَشويهِ كلِّ جَمالٍ.
في قَلبِ هذه الشَّخصيَّاتِ المأزومَةِ، لا يَنبِضُ إنسانٌ، بل (آلةُ خِيانةٍ وُجوديَّةٍ)، (تَبتَلِعُ النُّورَ وتُعيدُ بَثَّهُ ظلامًا)، (تُحَوِّلُ الإنجازَ إلى تَهديدٍ)، (وتَغزِلُ حولَهُ شِبَاكًا مِن الافتراءِ والتَّشويهِ والتَّآمُرِ)، كأنَّ الحياةَ ليست ساحةَ بِنَاءٍ، بل مَيدانَ صِراعٍ بينَ العَدَمِ والوُجودِ، بينَ الرُّكودِ والتَّقدُّمِ، بينَ مَن يُريدونَ أن يكونوا ومَن يَرفُضونَ أن يكونَ أحدٌ سِواهُم.
هؤلاءِ ليسوا مُجَرَّدَ أفرادٍ يُعانونَ اضطراباتٍ شَخصيَّةً، بل هُم (انعِكاسٌ لِشُرُوخٍ عَميقَةٍ في بُنيَةِ المُجتمعِ ذاتِهِ).
إنَّهُم (أبناءُ الخَوفِ)، (أبناءُ الأزماتِ)، (أبناءُ العُصورِ التي تَنكَمِشُ فيها الإنسانيَّةُ) تحتَ وَطأَةِ الانهياراتِ الكُبرى، فيَصيرُ (الحِقدُ رَديدفًا للبَقاءِ)، و(الكَراهِيَةُ وَقودًا للحَرَكَةِ)، و(العِداءُ للنَّجاحِ استراتيجيَّةً لِلدِّفاعِ عن الذَّاتِ المُترَهِّلَةِ) أمامَ سَطوَةِ المُتَغَيِّراتِ.
في العِراقِ، في المِنطَقَةِ، في العالَمِ، حيثُ تَجتاحُ الأزماتُ الوُجودَ الإنسانيَّ كما العَواصِفُ العاتِيَةُ، (تَتضَخَّمُ) هذه الظَّواهِرُ، (تَتناسَخُ)، (تَتَحَوَّلُ) إلى تيَّارٍ خَفِيٍّ (يُفشِلُ الدُّوَلَ كما يُفشِلُ الأفرادَ)، (يُبَدِّدُ الطَّاقَاتِ كما يُبَدِّدُ الحَضاراتِ)، (يُحَوِّلُ الفَضاءَ العامَّ إلى ساحةٍ مِن الاشتباهِ المُتَبادَلِ)، حيثُ لا مَكانَ للثِّقَةِ، ولا مِساحَةَ للنَّوايا الصَّافِيَةِ، ولا قُدرَةَ على البِنَاءِ وسطَ الرُّكامِ الذي يُخَلِّفُهُ الطَّاعُونُ النَّفسيُّ الجَماعيُّ.
ليسَ غَريبًا أن تَكُونَ هذه الظَّواهِرُ مُتفَشِّيَةً في بِيئاتٍ مَأزومَةٍ، حيثُ تَنسَحِبُ المؤسساتُ الرسميّةُ والاجتماعيّةُ عن دَورِها، ويَتهَشَّمُ العَقدُ الاجتِماعِيُّ، ويُصبِحُ الإنسانُ (رُقعَةً على رُقعَةٍ في لَوحَةِ فَوضَى هائِلَةٍ).
في تِلكَ البِيئاتِ، يَفقِدُ النَّاسُ الأملَ في أن يكونوا جُزءًا مِن (مَشروعٍ جَامِعٍ)، فَتَتَفَتَّتُ إراداتُهُم إلى (مَعَارِكِ صَغيرَةٍ)، كلٌّ يَسعى لإقصاءِ الآخَرِ، كلٌّ يَرى في (نَجاحِ الآخَرِ إعلانًا عن مَوتِهِ)، وفي السِّياسةِ، يَتَحَوَّلُ هؤلاءِ إلى أدواتٍ لِلهَدمِ، (لا يَملِكونَ مَشروعًا إلَّا إسقاطَ مَشاريعِ الآخَرينَ)، (يَتَّخِذونَ مِن الكَراهِيَةِ مَنصَّةً لِلتَحشيد)، و(مِن التَّخوِينِ سِلاحًا لِلشَّرعِيَّةِ)، و(مِن الفَوضَى مَلاذًا ضدَّ انكِشافِ خَوائِهِم).
في الإعلامِ، (يَملَؤونَ الفَضاءَ بالأكاذِيبِ)، (يُسَلِّحونَ الكَلِماتِ بالخِداعِ)، يُعيدونَ تَشكِيلَ الواقِعِ وَفقَ (مَقاساتِهِم الضَّيِّقَةِ)، (يَرمُونَ كلَّ جَميلٍ بالحِجارَةِ)، و(يَزرَعونَ في العُقولِ بُذورَ الشَّكِّ)، حتَّى (يُصبِحَ الصِّدقُ تُهمَةً)، و(النَّجاحُ فَضيحَةً)، و(الوَطَنُ مُجرَّدَ شِعارٍ يُستَعمَلُ وَقودًا لِلمَعَارِكِ الشَّخصيَّةِ).
وفي بيئاتِ العَملِ، يَتَحَوَّلونَ إلى (سُمُومٍ تَسري في شَّرَايينِ المؤسساتِ)، (يُحبِطونَ المُبادَراتِ)، (يُجهِضونَ الأفكارَ)، (يُعرقِلونَ التَّطَوُّرَ)، (يَنشُرونَ الإحبَاطَ)، حتَّى يُصبِحَ (الجُمودُ هو المِعيَارُ)، و(الوَسِيلَةُ الوَحِيدَةُ لِلنَّجاةِ هي التَّحَوُّلُ إلى كائِنٍ يُشبِهُهُم)، كائِنٍ (يَكرَهُ)، (يُوشِي)، (يُهاجِمُ)، (يَطعَنُ)، فَقَطْ لِيُحافِظَ على مَوقِعِهِ في (مُستَنقَعِ الرُّكودِ).
إنَّ مُقاوَمَةَ هؤلاءِ لا تَكونُ بِالهُروبِ مِنهُم، ولا بِمُهادَنَتِهِم، بل (بِالتَّصَدِّي الحازِمِ لَهُم)، (بِالحِفاظِ على وَهَجِ النَّجاحِ رَغمَ مُحاوَلاتِهِم لإطفائِهِ)، (بِإعادةِ تَشكِيلِ بِيئاتٍ تَرفُضُ أن تَكونَ حَواضِنَ لَهُم)، (بِتَأسِيسِ مَناخاتٍ حيثُ يكونُ النَّجاحُ مِعيارًا، لا تُهمَةً)، (حيثُ تكونُ النَّزاهَةُ مِيزَةً، لا ضَعفًا)، (حيثُ تكونُ الكَفاءَةُ ضَمانًا لِلتَّقَدُّمِ، لا دافِعًا لِلإقصاءِ).
حينَ يُحاصَرونَ بِفَراغِهِم، حينَ لا يَجِدونَ نَجاحًا يُشَوِّهونَهُ، ولا مَشروعًا يُعرقِلونَهُ، ولا كِيانًا يُحَطِّمونَهُ، سَيُدرِكونَ أنَّهُم (لَم يَخُونُوا أحَدًا بِقَدرِ ما خانُوا أنفُسَهُم)، وأنَّ التَّاريخَ لَم يَكُنْ يَومًا ساحةً لِلَّذينَ يُعارِضونَ التَّغييرَ، بل لِلَّذينَ يَصنَعُونَهُ، حتَّى لو اضطُرُّوا لِخَوضِ الحَربِ ضِدَّ الظِّلالِ.
مُستَمِرونَ بمحاربَتِهِم ومنَ الله العَون.
🤲🏼 *بُورِكَت لياليكم وايامكم* 🤲🏼
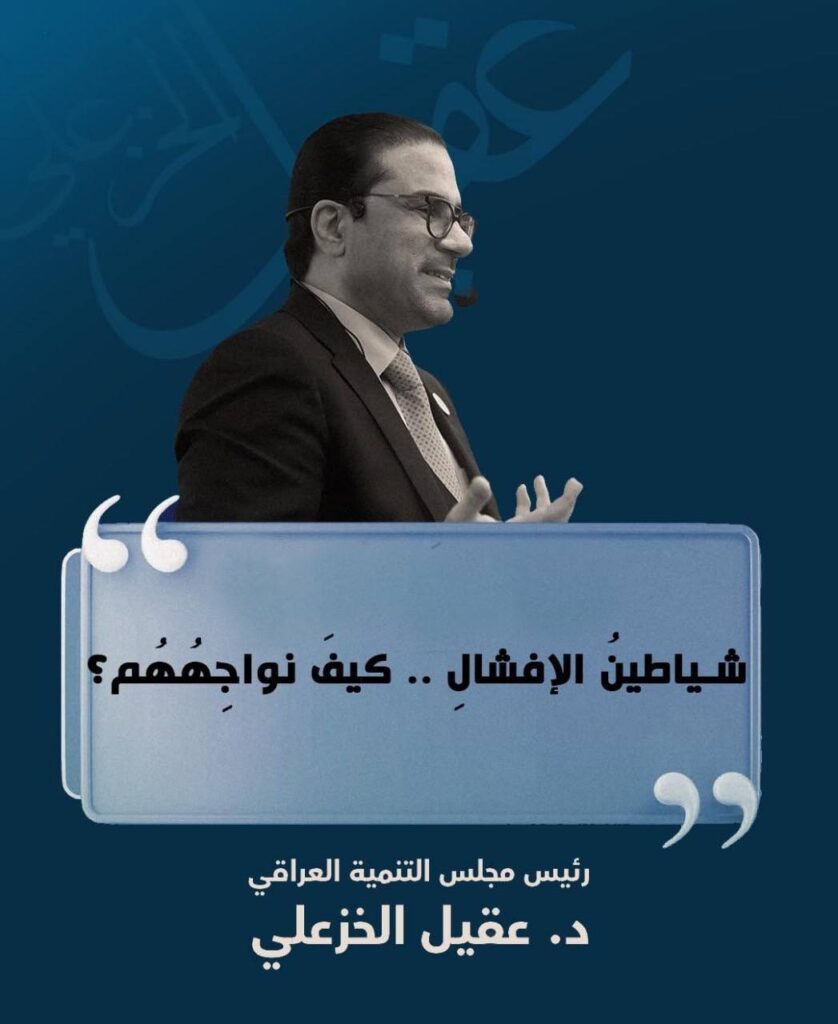
😈شياطينُ الإفشالِ ..كَيفَ نواجُههم؟😈
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️
“إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ ”
[فاطر:٦]
“ العَقَبَاتُ هي تِلكَ الأَشْيَاءُ المُخِيفَةُ الَّتِي تَرَاهَا عِندَمَا تَرْفَعُ عَيْنَيْكَ عَنْ هَدَفِكَ.”
– هِنْرِي فُورْدُ
⁉️ هَلْ تَسَاءَلْتَ يَوْمًا لِمَاذَا يَفْشَلُ البَعْضُ فِي تَحْقِيقِ أَحْلَامِهِمْ، رَغْمَ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ القُدُرَاتِ الكَافِيَةَ؟ وَلِمَاذَا يَتَأَخَّرُ البَعْضُ عَنْ بُلُوغِ أَهْدَافِهِمْ، رَغْمَ وُضُوحِ الطَّرِيقِ أَمَامَهُمْ؟
⬅️ تَكْمُنُ الإجابةُ في أَنَّ الفَشَلَ لَيْسَ مُجَرَّدَ حَدَثٍ، بَلْ هُوَ نَتَاجُ اِسْتِرَاتِيجِيَّاتٍ خَفِيَّةٍ تَعْمَلُ فِي الظِّلِّ، تُضْعِفُ العَزِيمَةَ وَتُشَتِّتُ التَّرْكِيزَ. وَلَوْ كَانَ لِهَذِهِ الاِسْتِرَاتِيجِيَّاتِ عَقْلٌ مُدَبِّرٌ، لَكَانَ “شَيْطَانُ الإِفْشَالِ” هُوَ النَّفْسُ الأمّارةُ بالسوءِ والعَقْلَ الإبليسيِّ الَّذِي (يَنْسِجُ هَذِهِ المَكَائِدَ، يُحْبِطُ الهِمَمَ، وَيَمْنَعُ الإِنْسَانَ مِنَ التَّحْلِيقِ نَحْوَ النَّجَاحِ).
🔬 دَعُونَا نَكْشِفُ عَنْ هَذِهِ الأَسَالِيبِ الشَّيْطَانِيَّةِ، ثُمَّ نَضَعُ لَهَا الحُلُولَ الَّتِي تُحَرِّرُنَا مِنْهَا، حَتَّى نَعُودَ إِلَى طَرِيقِ الإِنْجَازِ بِقُوَّةٍ وَثَبَاتٍ.
〰️〰️〰️الأساليب الشيطانية〰️〰️〰️
🩸١.التَّشْوِيشُ عَلَى الأَهْدَافِ وَالطُّمُوحِ🩸
🎲🎲🎲 (مَتَاهَةُ الضَّيَاعِ )🎲🎲🎲
“إِذَا لَمْ تَعْرِفْ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ، فَكُلُّ الطُّرُقِ سَتُوصِلُكَ إِلَى اللَّاشَيْءِ.” — لُوِيسْ كَارُولْ
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
—————————
يَبْدَأُ بِبَعْثَرَةِ أَفْكَارِكَ، وَيَجْعَلُكَ تَتَسَاءَلُ: “هَلْ هَذَا الهَدَفُ يَسْتَحِقُّ الجُهْدَ؟ هَلْ هُوَ مُنَاسِبٌ لِي؟ هَلْ سَأَنْدَمُ لَاحِقًا؟” ثُمَّ يُغْرِيكَ بِأَهْدَافٍ بَدِيلَةٍ بِلَا مَعْنًى، تَبْدُو مُغْرِيَةً وَلَكِنَّهَا لَا تُؤَدِّي إِلَى أَيِّ مَكَانٍ، فَتَسْتَهْلِكُ وَقْتَكَ وَطَاقَتَكَ، وَتَنْتَهِي فِي نَفْسِ النُّقْطَةِ الَّتِي بَدَأْتَ مِنْهَا.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————-
اُكْتُبْ أَهْدَافَكَ بِوُضُوحٍ، ثُمَّ اِسْأَلْ نَفْسَكَ: هَلْ هَذَا الهَدَفُ يَعْكِسُ شَغَفِي الحَقِيقِيَّ؟ هَلْ يُقَرِّبُنِي مِنْ مُسْتَقْبَلِي المِثَالِيِّ؟ لَا تَدَعْ الضَّبَابَ يَحْجُبُ رُؤْيَتَكَ، رَكِّزْ عَلَى الطَّرِيقِ، وَخُذْ خُطْوَةً يَوْمِيَّةً نَحْوَ هَدَفِكَ، حَتَّى وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً. النَّجَاحُ لَا يَأْتِي لِمَنْ يَنْتَظِرُ وُضُوحَ الرُّؤْيَةِ، بَلْ لِمَنْ يَسِيرُ بِثَبَاتٍ رَغْمَ الضَّبَابِ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٢.إِضْعَافُ الثِّقَةِ بِالنَّفْسِ🩸
💔💔💔 مِرْآةٌ مَكْسُورَةٌ 💔💔💔
“الشَّخْصُ الوَحِيدُ الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يُحَطِّمَكَ هُوَ نَفْسُكَ، عِنْدَمَا تَسْمَحُ لِلْخَوْفِ أَنْ يُهَمْسَ فِي أُذُنِكَ.” — رَالْفُ وَالْدُو إِيمِرْسُونَ
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
————————
يُذَكِّرُكَ بِإِخْفَاقَاتِكَ المَاضِيَةِ، وَيَجْعَلُهَا تَبْدُو كَأَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ هُوِيَّتِكَ، وَلَيْسَتْ مُجَرَّدَ مَرَاحِلَ تَعَلُّمٍ. ثُمَّ يُقَارِنُ نَجَاحَاتِكَ بِإِنْجَازَاتِ الآخَرِينَ، لِيَجْعَلَكَ تَشْعُرُ بِأَنَّ مَا حَقَّقْتَهُ لَا قِيمَةَ لَهُ، وَكَأَنَّكَ تُلَاحِقُ وَهْمًا.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
—————————
أَعِدْ كِتَابَةَ قِصَّتِكَ بِنَفْسِكَ! اِجْمَعْ إِنْجَازَاتِكَ، حَتَّى لَوْ كَانَتْ بَسِيطَةً، وَدَوِّنْهَا أَمَامَكَ. ذَكِّرْ نَفْسَكَ بِأَنَّ الإِخْفَاقَ لَيْسَ حُكْمًا نِهَائِيًّا، بَلْ مَرْحَلَةً مِنْ رِحْلَتِكَ نَحْوَ النَّجَاحِ. لَا تَسْمَحْ لِأَيِّ صَوْتٍ دَاخِلِيٍّ أَنْ يُقَلِّلَ مِنْ قِيمَتِكَ، فَأَنْتَ أَقْوَى مِمَّا تَظُنُّ، وَأَكْثَرُ قُدْرَةً مِمَّا تَتَخَيَّلُ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٣. زَرْعُ الكَسَلِ وَالتَّسْوِيفِ🩸
😴😴😴حِينَ يُصْبِحُ الغَدُ وَهْمًا😴😴😴
“التَّسْوِيفُ هُوَ مَقْبَرَةُ النَّجَاحِ.”
— دِينِيسْ وِيتْلِي
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
————————-
يَقُولُ لَكَ: “اِسْتَرِحْ قَلِيلًا، لَا بَأْسَ بِالتَّأْجِيلِ، غَدًا سَيَكُونُ الوَقْتُ أَفْضَلَ!” وَهَكَذَا، يُصْبِحُ الغَدُ سَرَابًا لَا يَأْتِي أَبَدًا، وَتَضِيعُ الأَيَّامُ بَيْنَ حُجَجٍ وَاهِيَةٍ، حَتَّى تَجِدَ نَفْسَكَ عَالِقًا فِي نَفْسِ المَكَانِ، بَيْنَمَا يَتَحَرَّكُ الآخَرُونَ نَحْوَ أَهْدَافِهِمْ.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————-
اِبْدَأِ الآنَ، لَا غَدًا! ضَعْ قَاعِدَةً: “خَمْسُ دَقَائِقَ فَقَطْ”، وَابْدَأْ أَيَّ مَهَمَّةٍ بِخَمْسِ دَقَائِقَ، سَتَجِدْ أَنَّكَ قَدْ أَنْجَزْتَ أَكْثَرَ مِمَّا كُنْتَ تَتَوَقَّعُ. النَّجَاحُ لَيْسَ فِي انْتِظَارِ اللَّحْظَةِ المُثْلَى، بَلْ فِي صُنْعِهَا بِيَدَيْكَ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
٤. 🩸خَلْقُ المَخَاوِفِ وَالعَوَائِقِ النَّفْسِيَّةِ🩸
💈💈💈 السُّجُونُ غَيْرُ المَرْئِيَّةِ 💈💈💈
“الشَّجَاعَةُ لَيْسَتْ غِيَابَ الخَوْفِ، بَلْ القُدْرَةُ عَلَى المُضِيِّ قُدُمًا رَغْمَ وُجُودِهِ.”
— نِيلْسُونْ مَانْدِيلَا
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
—————————
يَزْرَعُ فِيكَ الخَوْفَ مِنَ الفَشَلِ، وَيَجْعَلُهُ يَبْدُو كَأَنَّهُ كَارِثَةٌ لَا تُحْتَمَلُ، ثُمَّ يُخَوِّفُكَ مِنَ النَّجَاحِ نَفْسِهِ! يُخْبِرُكَ أَنَّ تَحْقِيقَ أَهْدَافِكَ سَيُثْقِلُكَ بِالمَسْؤُولِيَّاتِ، وَأَنَّ الأَفْضَلَ لَكَ أَنْ تَبْقَى حَيْثُ أَنْتَ، بِلَا مُخَاطَرَةٍ.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————
اِفْعَلْ مَا تَخَافُ مِنْهُ، وَسَتَجِدْ أَنَّ الخَوْفَ يَتَلَاشَى. تَذَكَّرْ أَنَّ كُلَّ إِنْجَازٍ عَظِيمٍ بَدَأَ بِخُطْوَةٍ خَائِفَةٍ، لَكِنْ صَاحِبُهَا لَمْ يَتَرَاجَعْ. الشَّجَاعَةُ لَيْسَتْ انْعِدَامَ الخَوْفِ، بَلْ رَفْضُ الاِسْتِسْلَامِ لَهُ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٥. تَشْتِيتُ التَّرْكِيزِ🩸
🕺🕺🕺 رَقْصَةٌ فِي العَدَمِ 🕺🕺🕺
“التَّرْكِيزُ هُوَ القُوَّةُ العُظْمَى الَّتِي تُحَدِّدُ الفَرْقَ بَيْنَ النَّجَاحِ وَالضِّيَاعِ.”
— بُرُوسْ لِي
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
————————-
يَمْلَأُ حَيَاتَكَ بِالمُلْهِيَاتِ، يُغْرِقُكَ فِي وَسَائِلِ التَّوَاصُلِ، وَالأَخْبَارِ، وَالمُحَادَثَاتِ الفَارِغَةِ، حَتَّى لَا تَجِدَ وَقْتًا لِلأَشْيَاءِ الَّتِي تَهُمُّكَ حَقًّا.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————-
حَارِبِ الفَوْضَى بِالوُضُوحِ! ضَعْ قَائِمَةً بِأَهَمِّ ثَلَاثِ مَهَامِّ يَوْمِيَّةٍ، وَلَا تَنْشَغِلْ بِشَيْءٍ آخَرَ حَتَّى تُنْجِزَهَا. رَكِّزْ عَلَى مَا يَبْنِي مُسْتَقْبَلَكَ، وَدَعِ البَاقِي لِلْوَقْتِ الضَّائِعِ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٦.إِثَارَةُ الخِلَافَاتِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ🩸
☹️☹️☹️ الوِحْدَةُ القَاتِلَةُ ☹️☹️☹️
“الأَصْدِقَاءُ هُمُ العَائِلَةُ الَّتِي نَخْتَارُهَا لِأَنْفُسِنَا.” — إِدْنَا بُوشَانَانْ
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
—————————
يُفْسِدُ عِلَاقَاتِكَ، وَيَزْرَعُ الشُّكُوكَ وَسُوءَ الفَهْمِ، وَيَجْعَلُكَ تَعْتَقِدُ أَنَّ الجَمِيعَ ضِدَّكَ، فَيُبْعِدُكَ عَنِ الدَّاعِمِينَ الحَقِيقِيِّينَ لَكَ.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————-
كُنْ أَنْتَ صَانِعَ السَّلَامِ فِي عِلَاقَاتِكَ، وَلَا تَقَعْ فِي فَخِّ الظُّنُونِ. تَوَاصَلْ، وَافْهَمْ، وَاِحْتَفِظْ بِأَصْدِقَائِكَ الحَقِيقِيِّينَ بِقُرْبِكَ، لِأَنَّهُمْ الحِصْنُ الَّذِي يَحْمِيكَ مِنَ الإِحْبَاطِ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٧. اِسْتِنْزَافُ الطَّاقَةِ🩸
🏃🏃🏃 سِبَاقٌ بِلَا خَطِّ نِهَايَةٍ 🏃♂️🏃♂️🏃♂️
“لَا يُمْكِنُ لِلشَّمْعَةِ أَنْ تُضِيءَ إِنِ اسْتُهْلِكَتْ نَفْسُهَا بِالكَامِلِ.” — بُوذَا
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
—————————
يَدْفَعُكَ لِلغَرَقِ فِي التَّفَاصِيلِ غَيْرِ المُهِمَّةِ، وَيَجْعَلُكَ تَعْمَلُ بِلَا رَاحَةٍ، حَتَّى تَفْقِدَ الحَافِزَ وَتَنْهَارَ.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————
كُنْ ذَكِيًّا فِي إِدَارَةِ طَاقَتِكَ، فَلَا تَعْمَلْ بِجُهْدٍ فَقَطْ، بَلْ بِذَكَاءٍ. خُذْ فَتَرَاتِ رَاحَةٍ، وَرَكِّزْ عَلَى المَهَامِّ الأَكْثَرِ تَأْثِيرًا، وَلَيْسَ الأَكْثَرَ اِسْتِهْلَاكًا لِوَقْتِكَ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٨. إِضْعَافُ القِيَمِ وَالأَخْلَاقِ🩸
🛝🛝🛝 المَزَالِقُ الخَفِيَّةُ 🛝🛝🛝
“النَّزَاهَةُ هِيَ أَنْ تَفْعَلَ الشَّيْءَ الصَّحِيحَ حَتَّى عِنْدَمَا لَا يُرَاقِبُكَ أَحَدٌ.” — سِي. إِس. لُوِيسْ
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
—————————
يَجْعَلُكَ تَعْتَقِدُ أَنَّ الطُّرُقَ المُخْتَصَرَةَ هِيَ الأَسْرَعُ، وَلَكِنَّ الحَقِيقَةَ أَنَّهَا الأَكْثَرُ خُطُورَةً.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————-
تَمَسَّكْ بِمَبَادِئِكَ، لِأَنَّ النَّجَاحَ الحَقِيقِيَّ لَا يُبْنَى بِالغِشِّ، بَلْ بِالمُثَابَرَةِ وَالصِّدْقِ.
➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰➰
🩸٩. خَلْقُ شُعُورٍ بِالعَجْزِ🩸
⛓️⛓️⛓️⛓️ القَيْدُ النَّفْسِيُّ ⛓️⛓️⛓️⛓️
“أَنْتَ أَقْوَى مِمَّا تَعْتَقِدُ، وَأَكْثَرُ قُدْرَةً مِمَّا تَظُنُّ.” — رُوِيزْ وِيلْسُونْ
😈حِيلَةُ الشَّيْطَانِ
—————————
يُقْنِعُكَ بِأَنَّكَ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ مُشْكِلَاتِكَ أَكْبَرُ مِمَّا يُمْكِنُكَ تَحَمُّلُهُ، وَأَنَّ النَّجَاحَ مُسْتَحِيلٌ.
👼كَيْفَ تُوَاجِهُهُ؟
————————-
اِنْهَضْ، وَقَاوِمْ، وَوَاجِهْ، وَتَذَكَّرْ: كُلُّ عَائِقٍ يُمْكِنُ تَجَاوُزُهُ، وَكُلُّ حُلْمٍ يُمْكِنُ تَحْقِيقُهُ بِالإِرَادَةِ وَالعَمَلِ.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🤺حَصيلةُ فن المواجَهة🤺
———————-———————————-
⛓️💥 حَطِّمْ قَيْدَ الفَشَلِ، وَاصْنَعْ نَجَاحَكَ بِنَفْسِكَ! ، فالفَشَلُ لَيْسَ قَدَرًا، بَلْ مُجَرَّدُ عَثْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ.
كُنْ أَنْتَ القَائِدَ، وَلَا تُعْطِ “شَيْطَانَ الإِفْشَالِ” فُرْصَةً لِلسَّيْطَرَةِ، فالنَّجَاحُ يَنْتَظِرُ مَنْ يَسْعَى إِلَيْهِ، فَهَلْ سَتَبْدَأُ رِحْلَتَكَ اليَوْمَ؟
نعم، كُلّي أمل.💗
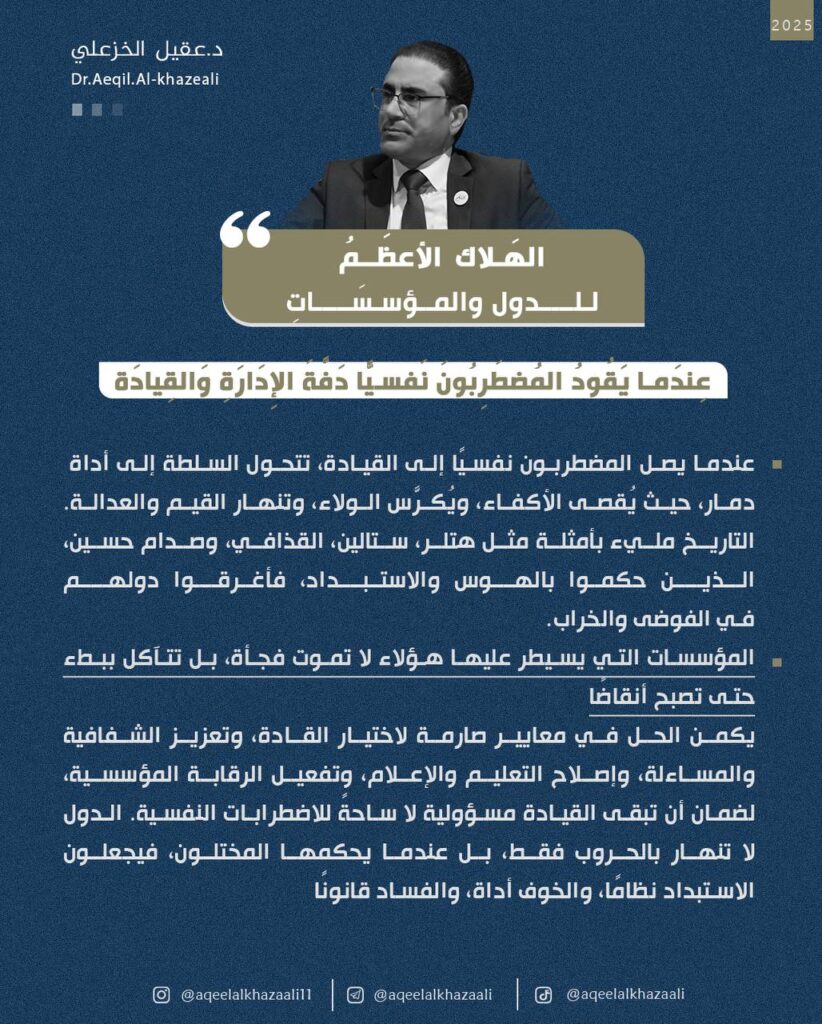
🌋الهَلاكُ الأعظَمُ لِلدُّوَلِ وَالمُؤَسَّسَاتِ🌋
(عِندَما يَقُودُ المُخْتَلُّون دَفَّةَ الإِدَارَةِ وَالقِيادَةِ)
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
“حين يُمنَح الجاهل أو المضطرب قوةً وسلطةً، يصبح الخطر أعظم مما لو بقي عدوًا خارج الأسوار.”. – أفلاطون
” فِي العُمقِ المُظلِمِ مِن التَّاريخِ، حِينَ يَسقُطُ (العَقلُ فِي مَتَاهَةِ الأوهَامِ)، وَيَنفَصِلُ (الإِدراكُ عَن مَسَارِ الوَاقِعِ)، تَبدأُ المَسَارِحُ الكُبرَى لِلكَارِثَةِ، فَمَا مِن هَلاكٍ أفظَعَ مِن دُوَلٍ وَمُؤَسَّسَاتٍ تَسقُطُ فِي يَدِ المُضطَرِبِينَ نَفسيًّا، أُولَئِكَ الذِينَ يَلبَسُونَ أَثوَابَ القِيادَةِ وَيَحمِلُونَ ألقَابَ السُّلطةِ، وَهُم فِي دَاخِلِهِم (مَضَاغِطُ خَرَابٍ وَحُطَامُ إِنسَانٍ).
فِي هَذِهِ الدُّوَلِ، فِي تِلكَ المُؤَسَّسَاتِ، تَستَحِيلُ (الإِدَارَةُ) مَعرِضًا لِلأمرَاضِ النَّفسيَّةِ المُقَنَّعَةِ، وَيَتَحَوَّلُ (الكُرسِيُّ) مِن أَدَاةٍ لِلتَّقدُّمِ وَالإِنجَازِ إِلَى (مِحفَظَةٍ لِلتَّعقِيدَاتِ الشَّخصيَّةِ وَالعُقَدِ المُزمنَةِ)، فالمُضطَرِبُ نَفسيًّا لَا يَفهَمُ القِيادَةَ إِلَّا (كَمُنتَجٍ لِرَغَبَاتِهِ العَاجِزَةِ)، وَهُوَ يَعرِفُ بِحِسِّهِ المُشوَّهِ أَنَّهُ فَارِغٌ، فَيُحَاوِلُ مَلءَ فَرَاغِهِ بِسُلطَةٍ تُعَوِّضُ مَا فَقَدَهُ فِي طُفُولتِهِ المُعتَلَّةِ، وَحَيَاتِهِ المُهَشَّمَةِ.
الشَّواهِدُ مُتَكاثِرَةٌ، فمثالُها؛ (أدولف هتلر) في ألمانيا كان يعاني من جُنُونِ العَظَمَةِ واضطراباتٍ نَفْسِيَّةٍ عَمِيقَةٍ. (جوزيف ستالين) في الاتحاد السوفيتي اشتهر بجُنُونِ العَظَمَةِ والشكِّ المَرَضِيِّ الذي دفعه إلى ارتكابِ حملاتِ تطهيرٍ دمويَّةٍ. (معمر القذافي) في ليبيا أظهر جُنُونَ العَظَمَةِ واضطراباتِ الشخصيةِ بشكلٍ واضحٍ طوالَ فترةِ حكمِهِ. (نيكولاي تشاوشيسكو) في رومانيا كان يعاني من جُنُونِ العَظَمَةِ وعدَمِ تقبُّلِ النَّقدِ، مما قادَ إلى نهايتِهِ المأساويةِ. (بول بوت) في كمبوديا كان نموذجًا لاضطراباتٍ نَفْسِيَّةٍ مُمِيتَةٍ تَجلَّتْ في التَّطهيرِ العِرْقِيِّ. (صدام حسين) في العراق تَمَيَّزَ بجُنُونِ العَظَمَةِ والسُّلُوكِ القمعيِّ الذي دمَّرَ بلادَهُ. (روبرت موغابي) في زيمبابوي عانى من جُنُونِ العَظَمَةِ والتشبُّثِ المَرَضِيِّ بالسُّلطةِ. (عيدي أمين) في أوغندا اشتهر بجُنُونِ العَظَمَةِ والعُدْوَانِيَّةِ المَرَضِيَّةِ التي تسبَّبَتْ في مآسٍ إنسانيةٍ جسيمةٍ. وما زالت الشَّواهِدُ تتناسَلُ !.
أما فِي المُؤَسَّسَاتِ المَأزُومَةِ، يُصبِحُ المُضطَرِبُ (قَاعِدَةً)، وَيُصبِحُ السَّوِيُّ (استِثنَاءً)، لِأَنَّ المَعايِيرَ تَنقَلِبُ، وَالمُوازِينَ تَتَحَرَّفُ، وَالقَدرَةَ الحَقِيقِيَّةَ تُصبِحُ خَطرًا يُجِبُ اسْتِئصَالُهُ.
يُؤمِنُ المُضطَرِبُ نَفسيًّا بِقَانُونٍ وَاحِدٍ: «لَا تَجعَلِ الكِبَارَ يَكبُرُونَ أَكثَرَ، وَاجعَلِ العُظَمَاءَ يَبدُونَ ضِعَافًا.» هَذَا هُوَ دَأبُهُ، وَهَذِهِ هِيَ مَهمَّتُهُ المُقدَّسَةُ فِي الحُكمِ وَالإِدَارَةِ.
(لَا يَكُونُ الإِنجَازُ فِي دَولَةٍ تَقُودُهَا العُقَدُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ التَّحَلُّلُ)، (لَا يَكُونُ التَّطَوُّرُ وَإِنَّمَا يَكُونُ النَّكسَةُ)، (لَا تَكُونُ العَدَالَةُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الجَورُ الَّذِي يَرتَدُّ إِلَى قَلبِ الوَطَنِ وَيَقتُلُهُ ببطءٍ)، فالمُضطَرِبُ نَفسيًّا، الَّذِي يَحتَلُّ القِيادَةَ، يَجمَعُ فِي رُوحِهِ كُلَّ مَا هُوَ تَدمِيرِيٌّ، وَيَكُونُ (مُنزَلِقًا دَائِمًا) بَينَ حُبِّ التَّملُّكِ وَالخَوفِ مِن فُقدَانِهِ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى القِيادَةِ، أَطلَقَ هَوَسَهُ، وَأَشعَلَ جَحِيمًا لَا يَنطَفِئُ، وَزَرَعَ فِي أَوصَالِ الدَّولَةِ وَالمُؤَسَّسَةِ فِيرُوسَ الفَسَادِ، وَأَنتَجَ سُلْطَةً مِن نُسَخِهِ المُشوَّهَةِ، فَإِذَا الجَمِيعُ صُورَةٌ لَهُ، وَإِذَا الجَمِيعُ فِيهِم مَسٌّ مِن خَبَلِهِ.
إِنَّ (أَعظَمَ مَأسَاةٍ) فِي التَّارِيخِ لَيسَتِ الحُرُوبُ، وَلَا الأَوبِئَةُ، وَلَا الكَوَارِثُ الطَّبِيعِيَّةُ، وَإِنَّمَا هِيَ (وُصُولُ المُضطَرِبِينَ نَفسيًّا إِلَى الحُكمِ وَالإِدَارَةِ)، عِندَئِذٍ، (يَنتَهِي العَقلُ وَيَبدأُ العَبَثُ)، (يَختَفِي التَّخطيطُ وَيَتَسَيَّدُ الهَوَى)، (يُصبِحُ الحِقْدُ هُوَ المِعيَارُ)، وَ(يَصِيرُ النَّجَاحُ مُؤَامَرَةً)، وَ(تُصبِحُ العُظَمَةُ جُرمًا يَتَوجَّبُ قَمعُهُ)، وَيُدرِكُ المَرءُ عِندَئِذٍ أَنَّ (الدَّولَةَ تَحطُمُ نَفسَهَا)، وَ(المُؤَسَّسَةَ تَنهَارُ مِن دَاخِلِهَا)، وَالقِيادَةَ تُصبِحُ مُجرَّدَ سِلاحٍ فِي يَدِ مُضطَرِبٍ (يُحَارِبُ كُلَّ مَا لَا يَفقَهُهُ)، وَ(يَهدِمُ كُلَّ مَا لَا يَستَطِيعُ بِنَاءَهُ).
فَمَا الحَلُّ؟ هَل يُمكِنُ مَنحُ القِيادَةِ لِمَن يُحارِبُونَ العَظَمَةَ، وَيَخَافُونَ مِن القُوَّةِ، وَيَقتُلُونَ المُبدِعِينَ؟، الحَلُّ فِي (العَزلِ القَطِعِيِّ لِهَذِهِ النَّمَاذِجِ)، وفِي (بِنَاءِ مَوانِعَ نَفسيَّةٍ وَقِيمِيَّةٍ تَجعَلُ القِيادَةَ لِأَهلِهَا)، وَتُبعِدُهَا عَن أَصحَابِ العُقَدِ وَالاضطِرَابَاتِ. فَإِنَّهُ مَا مِن جَحِيمٍ أَسوأُ مِن حُكمِ مَن يَمتَلِكُونَ الحُكمَ وَيَخَافُونَهُ فِي الوَقتِ نَفسِهِ.
وَلَكِن، (إِذَا وَقَعَتِ الدَّولَةُ وَالمُؤَسَّسَةُ فِي فَخِّ المُضطَرِبِينَ)، فَإِنَّهَا لَا تَمُوتُ مَرَّةً وَاحِدَةً، بَل تَتَآكَلُ كَمَا يَتَآكَلُ جَسَدُ مَن أَصَابَهُ الوَبَاءُ، حَتَّى لَا يَبقَى إِلَّا خَيَالُ دَولَةٍ، وَأَطلالُ مُؤَسَّسَةٍ، وَقَائِدٌ يَعتَلِي مَنصَّتَهُ، وَهُوَ أَعظَمُ عُنصُرِ تَدمِيرٍ فِيهَا.
ضمانُ عَدَمِ صُعُودِ المُضطَرِبِينَ نَفسيًّا لِمَواقِعِ القِيادَةِ وَالإِدَارَةِ
كُلُّ الدّول والمؤسساتِ مَدْعُوّةٌ لِضَمانِ عَدَمِ وُصُولِ المُضطَرِبِينَ نَفسيًّا إلى مَواقِعِ القِيادَةِ وَالإِدَارَةِ، إذ يَتَعَيَّنُ تَأسِيسُ مَنظُومَةٍ شَامِلَةٍ تُعالِجُ المَسأَلَةَ مِن جُذُورِهَا، بَدءًا مِن تَشخِيصِ المُشكلاتِ فِي بِنْيَةِ المُجتَمَعِ وَآلِيَّاتِه، وَمُرُورًا بِبِنَاءِ مَعايِيرٍ دَقِيقَةٍ لِاختِيَارِ القِيادَاتِ، وَوُصُولًا إِلَى تَطوِيرِ مَنظُومَةِ القِيمِ الَّتِي تَتحَكَّمُ فِي السُّلُوكِ السِّياسِيِّ وَالإِدارِيِّ.
أَوَّلًا/بِنَاءُ مَعايِيرِ صَارِمَةٍ لِاختِيَارِ القِيادَاتِ
—————————————————
1. إِخضَاعُ المُرشَّحِينَ لِلفَحصِ النَّفسيِّ وَالسُّلُوكِيِّ، فيستدعي العملُ أَن تَكُونَ هُنَاكَ لَجَانٌ مُختَصَّةٌ تُقَيِّمُ الصِّحَّةَ النَّفسيَّةَ وَالثَّباتَ العَاطِفِيَّ لِلمُرشَّحِينَ، مَعَ تَركِيزٍ عَلَى مَعَالِمِ السَّوِيَّةِ النَّفسيَّةِ، وَالتَّوازُنِ النَّفسِيِّ، وَالقُدرَةِ عَلَى اتِّخاذِ القَرَارِ بِوَعيٍ وَرَاشِد.
2. وَضعُ مَعايِيرَ قِيَمِيَّةٍ وَأَخلَاقِيَّةٍ دَقِيقَةٍ، إذ
يُشَتَرَطُ أَن يَتَّسِمَ المُرشَّحُونَ بِالنَّزَاهَةِ، وَالاستِقَامَةِ، وَالإِيمَانِ بِمَصَالحِ الجَمَاعَةِ فَوقَ المَصَالحِ الشَّخصيَّةِ. يَتِمُّ ذَلِكَ عَبرَ مُتابَعَةِ تَارِيخِهِم وَرَصدِ سُلُوكِيَّاتِهِم فِي الحَيَاةِ الشَّخصيَّةِ وَالعَامَّةِ.
3. التَّأكُّدُ مِن الكَفاءَةِ الفَنِّيَّةِ وَالإِدَارِيَّةِ،
فالقِيادَةُ لَا تَنبَثِقُ مِن الشُّهرةِ أو السُّلطةِ، بَل تَنبَثِقُ مِن الكَفاءَةِ. يُفَرَضُ على المُرشَّحِينَ اجتِيَازُ اختِبَارَاتٍ فَنِّيَّةٍ تُقَيِّمُ القُدرَةَ عَلَى التَّخطِيطِ، وَإِدرَاكِ المُشكلاتِ، وَوَضعِ الحُلُولِ الإِبداعِيَّةِ.
ثَانِيًا/تَعزِيزُ الشَّفَافِيَّةِ وَالحَوكَمَةِ
——————————————
1. إِرسَاءُ قَواعِدَ لِلمُساءَلَةِ، بحيث يَكُونَ القَائِدُ مُلزَمًا بِتَقدِيمِ تَقَارِيرَ دَورِيَّةٍ عَن أَعمَالِهِ، مَعَ ضَمَانِ إِتاحَةِ هَذِهِ التَّقَارِيرِ لِلجُمهُورِ وَالمُؤَسَّسَاتِ الرَّقَابِيَّةِ.
2. إِشراكُ الجُمهُورِ فِي عَمَليَّةِ صُنعِ القَرَارِ،
فَعِندَ تَطوِيرِ الآلِيَّاتِ الدِّيمُقراطِيَّةِ، يُصبِحُ صَعبًا عَلَى المُضطَرِبِينَ النَّفسيِّينَ أَن يَصِلُوا إِلَى مَواقِعِ السُّلطةِ، إِذ يَكُونُ القَرَارُ بِيَدِ جُمهُورٍ وَاعٍ وَمُطَّلِعٍ.
ثَالِثًا/ تَربيَةُ الأَجيَالِ عَلَى القِيمِ الصَّحِيحَةِ
—————————————————-
1. إِصلَاحُ النِّظَامِ التَّعلِيمِيِّ، فالتَّعليمُ هُوَ أَساسُ تَشكِيلِ العُقُولِ، وَإِذا تَمَّ غَرْسُ قِيمِ النَّزَاهَةِ، وَالاحترَامِ، وَالتَّعدُّدِيَّةِ، فِي النُّشُوءِ، يُصبِحُ صَعبًا عَلَى العُقَدِ النَّفسيَّةِ أَن تَتَسَلَّلَ إِلَى سُلُوكِ الأَجيَالِ.
2. تَعزِيزُ القِيَمِ العَامَّةِ فِي الوَسَائِلِ الإِعلَامِيَّةِ، فالإِعلَامُ أَدَاةٌ فَاعِلَةٌ فِي تَشكِيلِ الرَّأيِ العَامِّ، ويَجِبُ استِثمَارُهُ فِي تَوعِيَةِ الشَّعبِ بِخُطُورَةِ القِيادَةِ السَّيِّئَةِ، وَتَروِيجِ مَعايِيرَ لِلقِيادَةِ الصَّالِحَةِ.
رَابِعًا/تَفعيلُ الرَّقَابَةِ المُؤَسَّسِيَّةِ من خلال:
——————————————————
1. إِنشَاءُ هَيئَاتٍ مُستَقِلَّةٍ لِلفَحصِ وَالمُرَاقَبَةِ،لِضَمانِ أَن يَمرَّ المُرشَّحُونَ لِلقِيادَةِ بِفِلترٍ دَقِيقٍ يَكشِفُ عَن أَيِّ اضطرَابَاتٍ نَفسيَّةٍ أَو سُلُوكِيَّاتٍ تُهدِّدُ المَصلَحَةَ العَامَّةِ.
2. إِقرَارُ قَوَانِينِ صارِمَةٍ تُحَارِبُ الفَسَادَ وَتُجرِّمُ سُوءَ استِخدَامِ السُّلطةِ، بحيث تَكوُنُ هَذِهِ القَوَانِينُ ضَامِنًا لِمَنَعِ المُضطَرِبِينَ مِن استِغلالِ مَنَاصِبِهِم.
خَامِسًا/تَفعِيلُ الثَّقَافَةِ النَّقدِيَّةِ فِي المُجتَمَعِ
——————————————————-
تَشجِيعُ المَسَاءَلةِ الشَّعبِيَّةِ، وإِعطَاءُ المُواطِنِينَ فُرصَةً لِتَقيِيمِ أَداءِ القِيادَاتِ، مَعَ إِيجَادِ مَنَصَّاتٍ تُحَفِّزُ المُجتَمَعَ عَلَى إِبدَاءِ آرَائِهِ.
وبالمُحَصّلةِ، فأنهُ لَا تُبنَى الدُّوَلُ وَالمُؤَسَّسَاتُ بِالسُّلطةِ فَقط، بَل بِالقِيَمِ وَالإِنسَانِيَّةِ وَالعَدَالَةِ الَّتِي تَجعلُ القِيادَةَ مَسؤُولِيَّةً، لَا مَنصِبًا.
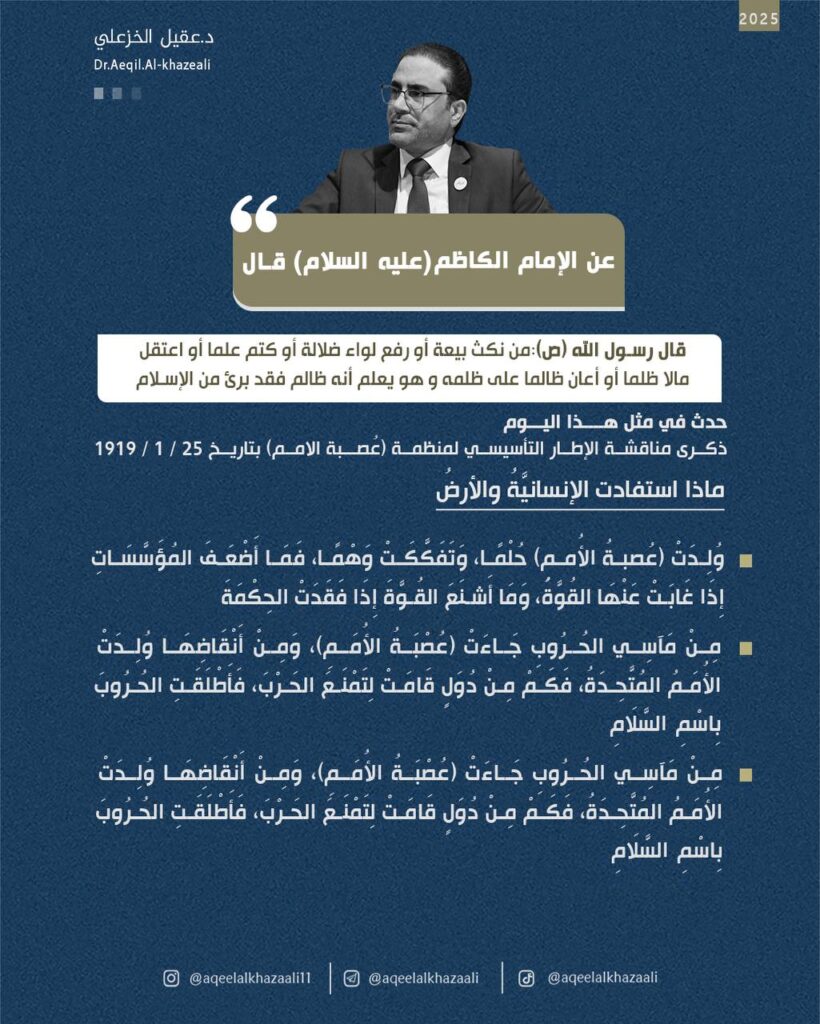
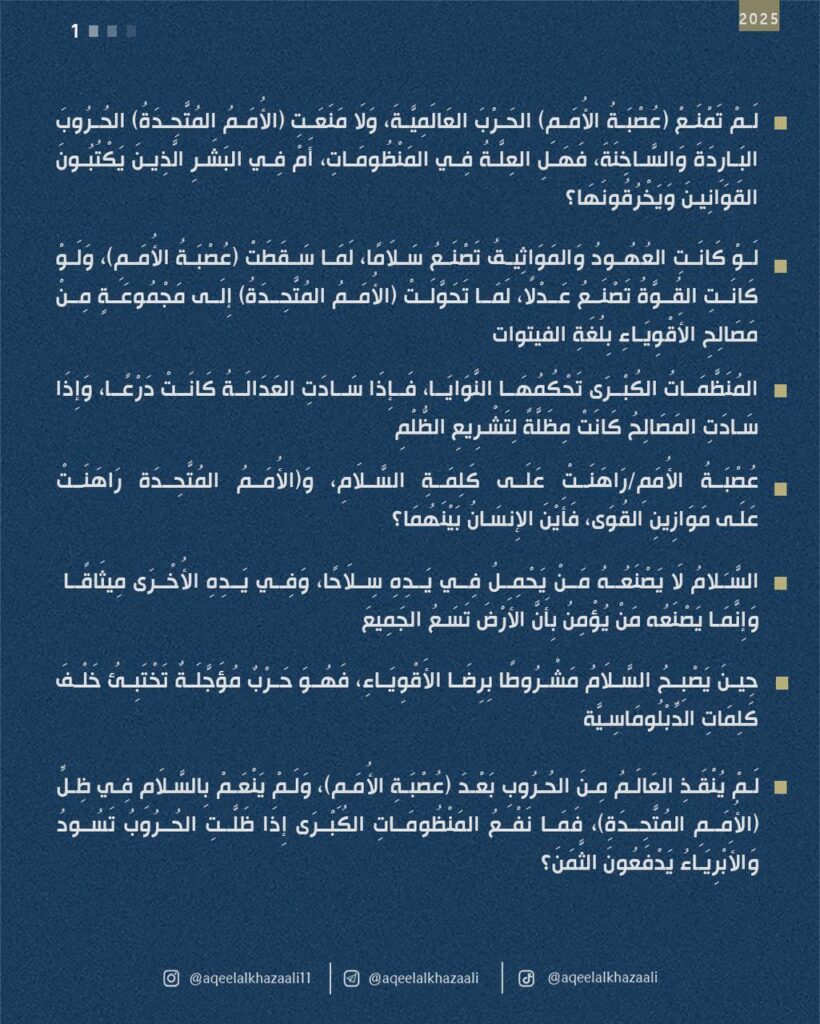
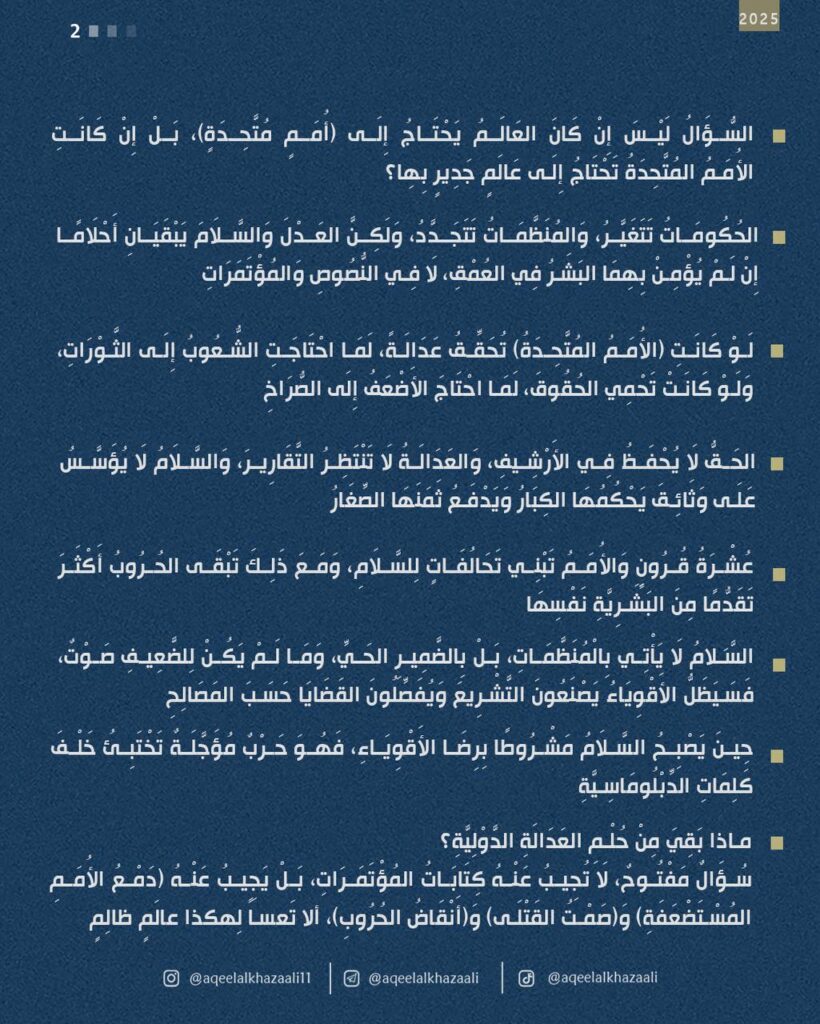
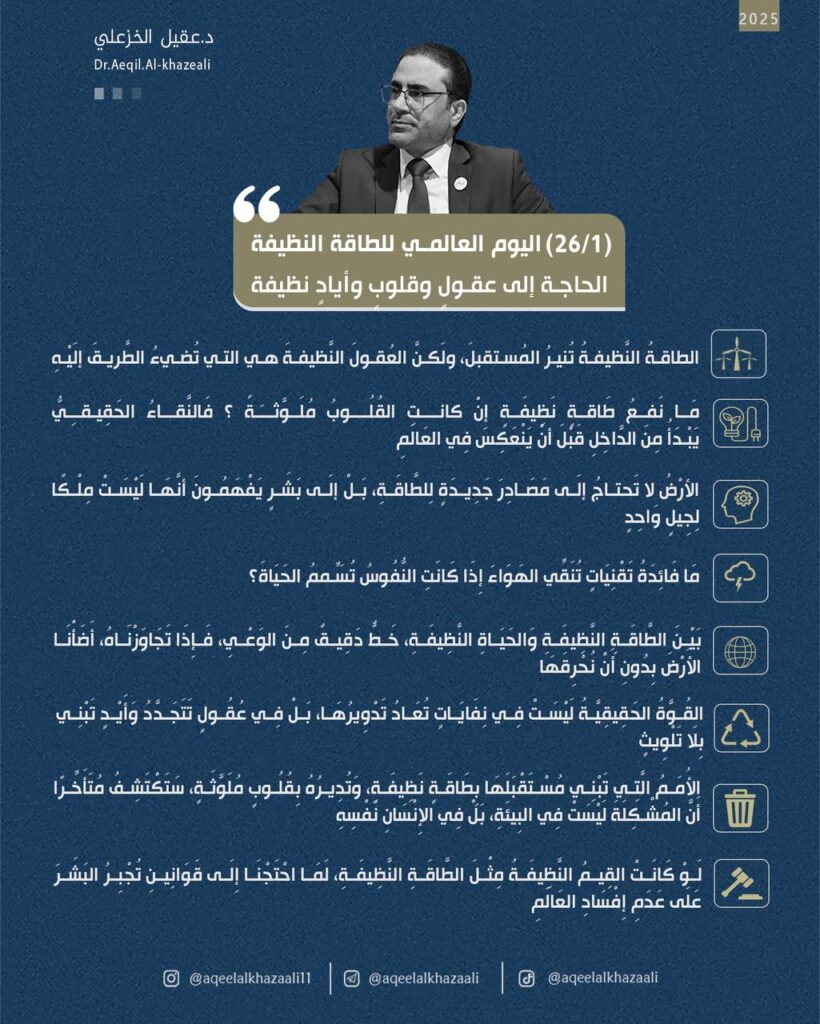
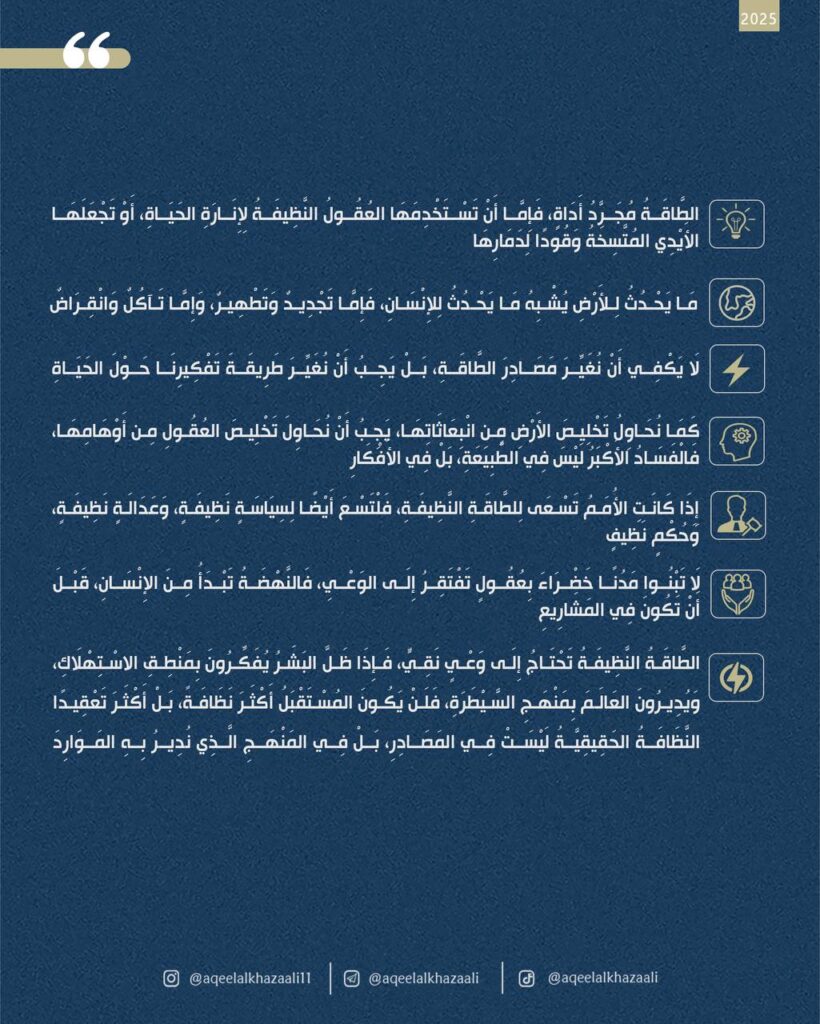
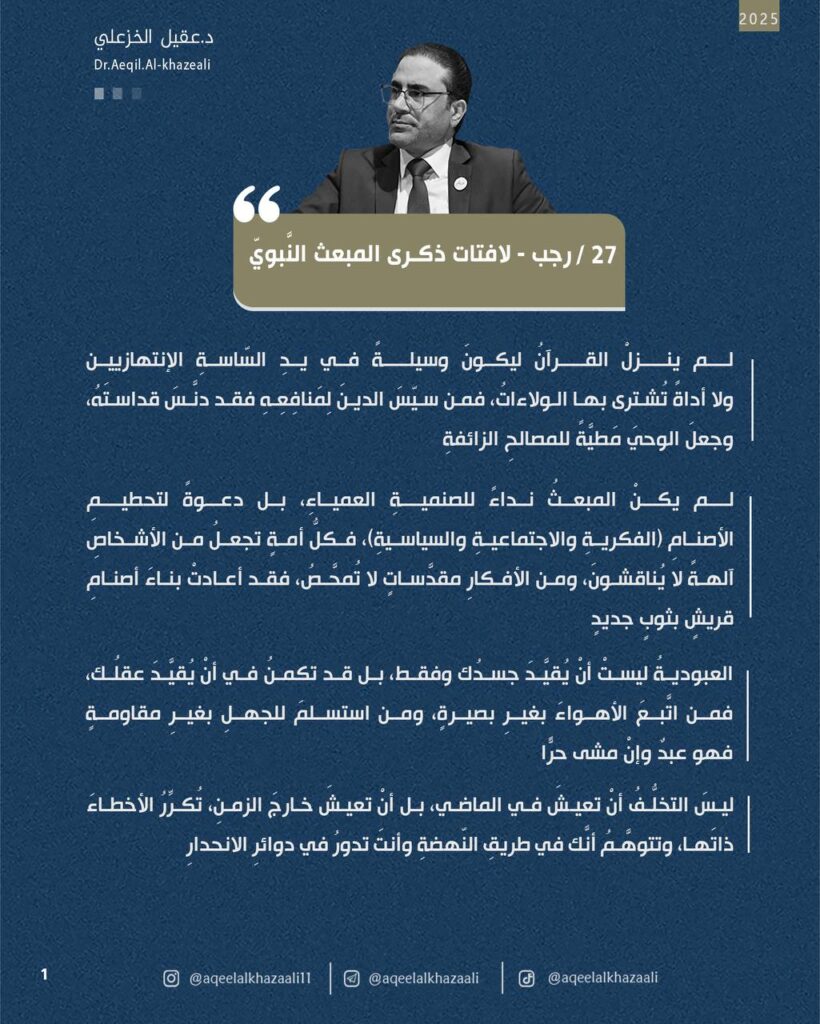
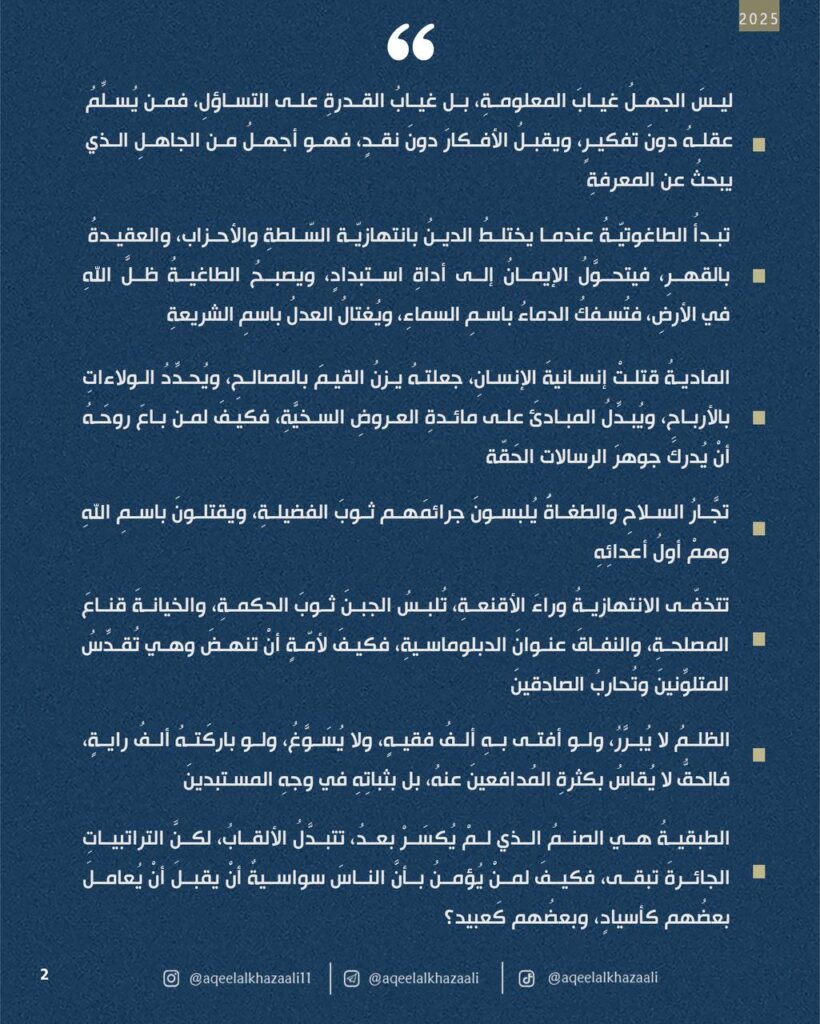
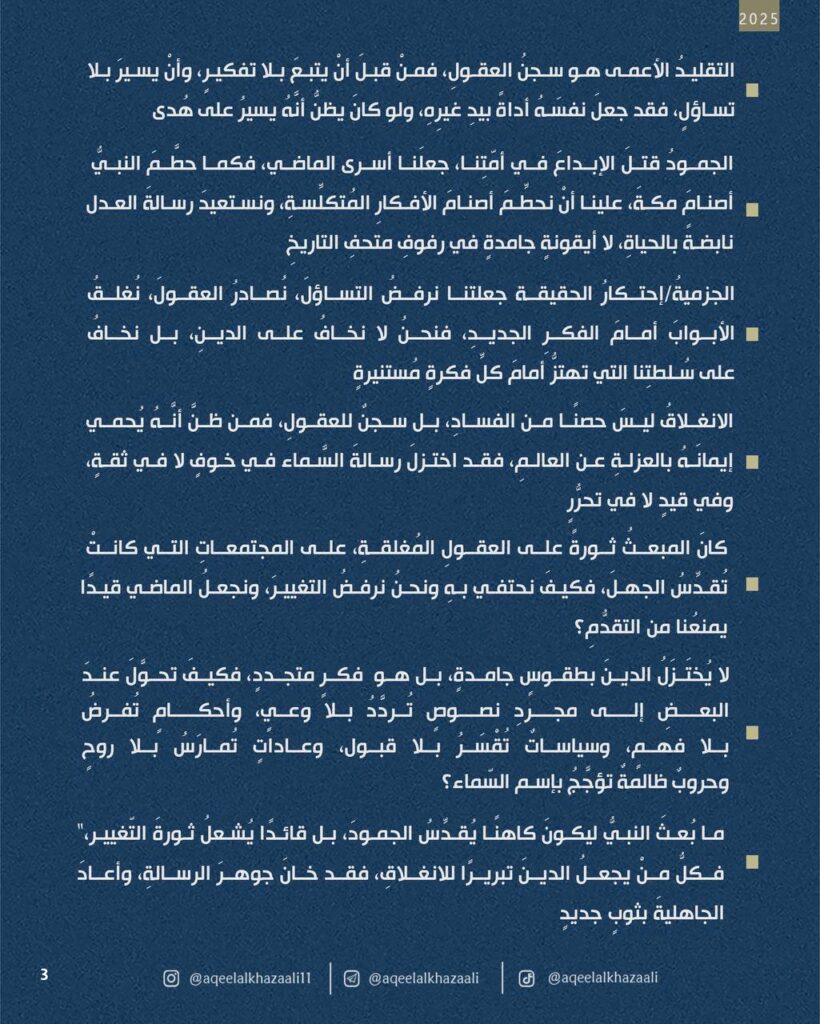
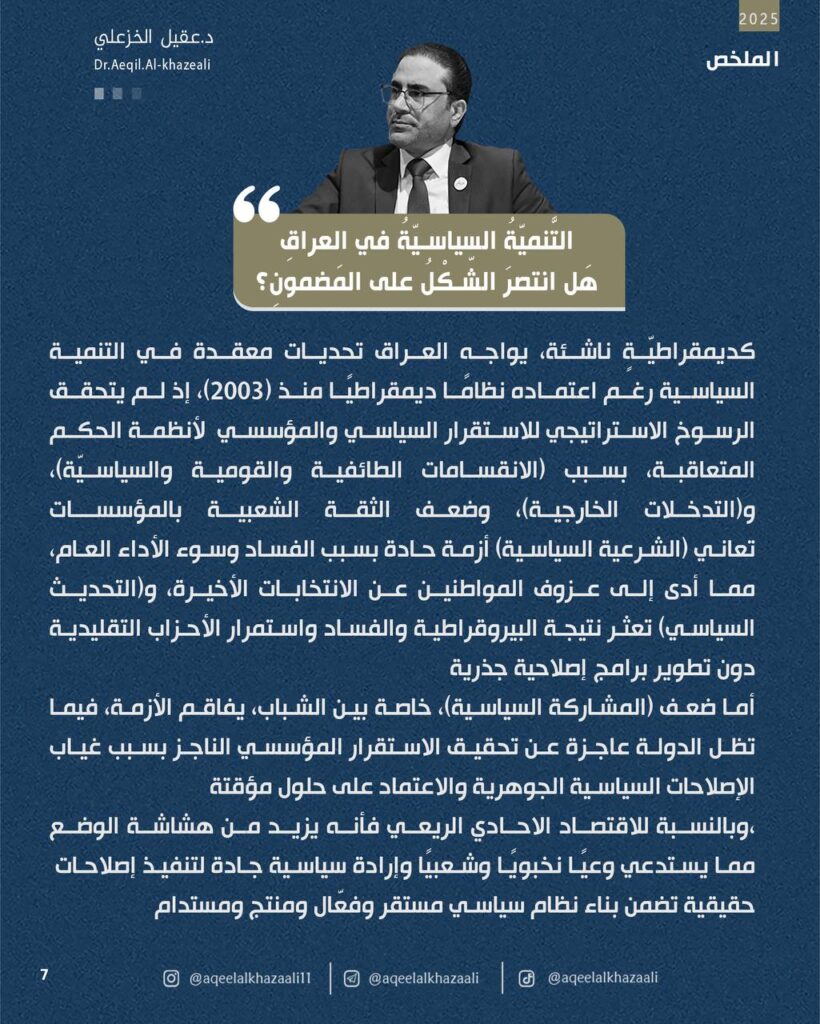
🌱🌱التَّنميّةُ السياسيّةُ في العراقِ🌱🌱
—-{هَل انتصرَ الشّكْلُ على المَضمونِ؟}——
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقي
⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️⚙️
” يمرُّ العراقُ بمرحلةٍ معقدةٍ من تطوّرهِ السياسيّ، حيثُ يتشابكُ التغييرُ السياسيُّ مع تحدياتِ التنميةِ والاستقرارِ، فمنذُ العامِ (ألفينِ وثلاثةٍ)، شَهدَ تحوّلاتٍ عميقةً في نظامِهِ السياسيِّ، ورغمَ اعتمادِهِ على نظامٍ ديمقراطيٍّ وانتخابيٍّ، إلّا أنّ الدولةَ لا تزالُ تواجهُ عقباتٍ تحولُ دونَ تحقيقِ التنميةِ السياسيةِ الحقيقيةِ.
إنَّ مفهومَ التنميةِ السياسيةِ – بحسب أعمال لوسيان باي وصامويل هنتنغتون – يرتبطُ بمراحلَ متعددةٍ تبدأُ (بالتوحيدِ السياسيِّ)، ثمَّ تحقيقِ (الشرعيةِ)، وصولًا إلى (التحديثِ السياسيِّ)، ثُمَّ (المشاركةِ السياسيةِ)، وأخيرًا (الاستقرارِ المؤسسيِّ) الذي الهدفُ النهائيُّ لأيِّ دولةٍ تسعى إلى ترسيخِ نظامٍ سياسيٍّ فعّالٍ ومستدامٍ.
وتأسيسا على ذلك ، وحيث ان العراقُ يواجهُ تحدياتٍ كبيرةً في هذهِ المراحلِ المختلفةِ، فقد جعل منه واقعاً في حالةٍ من (عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ والمؤسسيِّ المستمرِّ)، حسب التصنيف اعلاه.
ان الدولةِ العراقيةِ الحديثةِ منذُ تأسيسِها في العامِ (١٩٢١)، كانَ (التوحيدُ السياسيُّ) أحدَ أبرزِ التحدياتِ التي واجهتْها الحكوماتُ المتعاقبةُ، فالعراقُ يتميّزُ بتنوّعٍ (قوميٍّ وطائفيٍّ ودينيٍّ)، وهذا التنوّعُ لم يكنْ دائمًا عنصرَ قوةٍ، بل أصبحَ في كثيرٍ من الأحيانِ سببًا (للصراعاتِ والانقساماتِ). وبعدَ العامِ (٢٠٠٣)، إذ بان الإحتلال الأمريكي، تفاقمتْ هذهِ التحدياتُ مع انهيارِ الدولةِ المركزيّةِ، ممّا أدّى إلى صعودِ قوىً سياسيةٍ جديدةٍ تستندُ أغلبها إلى الهُوياتِ (الطائفيةِ) و(العِرقيةِ) بدلاً من (الهويةِ الوطنيةِ الجامعةِ)، فضلاً عن ان التدخّلات الخارجية زادتْ من تعقيدِ المشهدِ السياسيِّ، حيثُ تحوّلتِ البلادُ إلى ساحةٍ لصراعاتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، كما أنَّ العلاقةَ بينَ الحكومةِ الإتحاديّة وإقليمِ كردستانَ بقيتْ متوتّرةً ومتذبذبة، ممّا يزيدُ من تعقيدِ عمليةِ بناءِ دولةٍ موحّدةٍ ذاتِ مؤسساتٍ قويةٍ رصينةٍ ومُستدامةٍ.
فيما يخصُّ (الشرعيةُ السياسيةُ) فانها تُعَدُّ أحدَ أهمِّ العناصرِ التي تُحدِّدُ استقرارَ أيِّ نظامٍ سياسيٍّ. في العراقِ، ما تزالُ هذهِ الشرعيةُ تواجهُ اختبارًا مستمرًّا، فَرُغمَ إجراءِ انتخاباتٍ دوريةٍ واعتمادِ (دستورٍ جديدٍ) عامَ (٢٠٠٥)، إلّا أنَّ النظامَ السياسيَّ يُعاني من (أزمةِ ثقةٍ) حادّةٍ، فالشعبُ ينظرُ إلى (مؤسساتِهِ السياسيةِ) على أنَّها غيرُ قادرةٍ على تلبيةِ احتياجاتِهِ، كما أنَّ ضعفَ الأداءِ في (اغلب المؤسسات الحزبيّة ودوائر القطّاعِ العامِ ومؤشرات الفسادِ) جعل المواطنينَ يفقدونَ الأملَ في قدرةِ النظامِ على تحقيقِ الإصلاحاتِ الجّذريّة المطلوبةِ، وهو مما تسبب في ان الانتخابات الأخيرة شهدتْ انخفاضًا كبيرًا في نسبةِ المشاركةِ، ممّا يعكسُ حالةً من (الإحباطِ الشعبيِّ) تجاهَ الطبقةِ السياسيةِ المُتَصَدِّرَة للمشهد.
علاوةً على ذلكَ، فإنَّ (التدخلاتِ الخارجيةَ) و(التجاذباتِ الحزبيةَ) تُعيقُ تشكيلَ حكوماتٍ مستقرةٍ، ممّا يزيدُ من ضعفِ (الشرعيةِ السياسيةِ) ويؤدّي إلى أزماتٍ متكرّرةٍ تؤثرُ على مسارِ التنميةِ.
لقد سعى العراقُ منذُ العامِ (٢٠٠٣) إلى (تحديثِ نظامِهِ السياسيِّ)، لكنَّ التحديثَ السياسيَّ لم يُحقِّقِ النجاحَ المطلوبَ بسببِ ضعفِ المؤسساتِ الإداريةِ والسياسيةِ، فالبيروقراطيةُ الحكوميةُ تُعاني من ترهّلٍ كبيرٍ، والفسادُ يزيدُ من تعقيدِ العمليةِ الإداريةِ، على الرغم من ان الحكومة الحالية قد قامت بمشاريع مهمة وبتسريع انجاز المُتلكىء المتراكم منها.
وفيما يتعلّق بالأحزابُ السياسيةُ التي تسيطرُ على المشهدِ السياسيِّ، فأنها بحاجة الى تقديمِ برامجَ سياسيةٍ واضحةٍ تهدفُ إلى تحقيقِ التنميةِ والاستقرارِ.
هذا الوضعُ يجعلُ عمليةَ تحديثِ النظامِ السياسيِّ بطيئةً، حيثُ ما تزالُ سُلطات الدولة تعتمدُ على أساليبَ تقليديةٍ في الحُكمِ، دونَ القدرةِ على تنفيذِ إصلاحاتٍ جوهريةٍ من شأنِها تحسينُ الأداءِ السياسيِّ والإداريِّ.
وفي جانب (المشاركةُ السياسيةُ) التي تُعَدُّ من (أهمِّ) مظاهرِ التنميةِ السياسيةِ، فأنها تُعاني من ضعفٍ واضحٍ، فعزوفُ المواطنينَ عنِ الانتخاباتِ هو مؤشّرٌ خطيرٌ على تراجعِ الثقةِ في العمليةِ الديمقراطيةِ، إذ تُسيطرُ الأحزابُ السياسيةُ التقليديةُ على المشهدِ السياسيِّ، ممّا يجعلُ من الصعبِ بروزُ أحزابٍ جديدةٍ ذاتِ توجهاتٍ إصلاحيةٍ حقيقيةٍ، علاوةً على ان المجتمع المدنيّ
– بأغلب فعالياته- ما يزالُ دورُهُ محدودًا، رغمَ أنه كانَ من المفترضِ أنْ يلعبَ دورًا رئيسيًا في تعزيزِ الديمقراطيةِ.
لقد كشفَت الحراكات الشعبيّة وخصوصاً ما برزَ في ( تشرين ١/ ٢٠١٩ ) عن (عمقِ الأزمةِ السياسيةِ)، والذي تسبب في حصول ارتدادات خطيرة.
من جانبٍ آخر، فقد أسفرت الانتخاباتُ الأخيرة لمجالس المحافظات ان الشبابُ العراقيُّ -الذي يُشكّلُ غالبيةَ السكانِ- لا يجدُ في النظامِ السياسيِّ الحاليِّ مساحةً حقيقيةً للمشاركةِ الفعالةِ المُجدِيّة، ممّا يزيدُ من حالةِ الإحباطِ وعدمِ الرغبةِ في الانخراطِ في العمليةِ السياسيةِ. هذا الوضعُ يجعلُ الدّولة في مأزقٍ سياسيٍّ، حيثُ تتراجعُ المشاركةُ الشعبيةُ، بينما تستمرُّ النُّخَبُ السياسيةُ التقليديةُ في السيطرةِ دونَ إحداثِ تغييراتٍ حقيقيةٍ في بُنيةِ النظامِ السياسيِّ.
من البداهة بمكان، ان الهدف النهائيّ لأيِّ نظامٍ سياسيٍّ هو تحقيقُ (الاستقرارِ المؤسسيِّ)، وهو ما لم يتمكّنِ العراقُ من الوصولِ إليهِ حتى الآنَ، فالأنظمة السياسيّة العراقيةُ المتعاقبةُ لم تستطعْ بناءَ مؤسساتٍ قويةٍ راسِخَةٍ قادرةٍ على تحمّلِ الأزماتِ، حيثُ لا تزالُ الدولةُ تعتمدُ على الحلولِ المؤقتةِ بدلاً من الإصلاحاتِ الجذريةِ البنيوية الاستراتيجية، مما جعل التغييراتُ الحكوميةُ المتكرّرةُ تُؤدّي إلى حالةٍ من (عدمِ الاستقرارِ السياسيِّ)،وصعوبةِ تنفيذُ (سياساتٍ طويلةِ الأمدِ) تضمنُ تحقيقَ التنميةِ المستدامةِ.
من بُعدٍ آخر، فما تزالُ الدولةُ تُمارسُ جُهوداً مُضنيّة لإنفاذ قدرتها على فرضِ سيادتِها (الداخلية والخارجيّة) الكاملة من كافة النواحي لاسباب سياسية واقتصادية واقليمية ودولية . وبالنسبة الاقتصادُ العراقيُّ، الذي يعتمدُ بشكلٍ أساسيٍّ على النفطِ، يجعلُهُ عرضةً (للتقلّباتِ) الاقتصاديةِ، وهو ما يؤثّرُ على (الاستقرارِ الماليِّ) للدولةِ ويزيدُ من الضغوطِ الاجتماعيةِ والاقتصاديةِ والخارجيّة.
إنَّ عدم قيام الأنظمة المتلاحقة باجراء إصلاحاتٍ هيكليةٍ حقيقيةٍ في مختلفِ القطاعاتِ جعل العراقَ في حالةٍ من الجمودِ السياسيِّ والاقتصاديِّ، حيثُ سادَ التعاملُ مع الأزماتِ بشكلٍ مؤقتٍ دونَ وضعِ استراتيجياتٍ طويلةِ الأمدِ.
يتبيّن مما تَقَدّم، ان العراق ما يزال بحاجة الى جهودٍ بنيوية حثيثة ومنضبطة لتحقيقِ التنميةِ السياسيةِ الكاملةِ، حيثُ لا تزالُ البلادُ (عالقةً) بينَ محاولاتِ (التوحيدِ السياسيِّ)، و(الأزماتِ المتوالدة) التي تهدّدُ الشرعيةَ السياسيةَ، فضلاً عن التحدياتِ التي تواجهُ (تحديثَ مؤسساتِ الدولةِ)، و(ضعفِ المشاركةِ السياسيةِ)، و(عدمِ القدرةِ على تحقيقِ الانسجام المؤسسيِّ)، والتي جعلت العراقَ في وضعٍ صعبٍ، حيثُ تحتاجُ البلادُ إلى إصلاحاتٍ جذريةٍ لضمانِ بناءِ نظامٍ سياسيٍّ مستقرٍّ وفعّالٍ، وهو ما يستوجب استيلاد (وعي نخبوي وشعبي، وارادة توّاقة، ومشاريع جادّة، وحوكمة عادلة ورشادة مستدامة)، فالمراهنةُ على العَفويّاتِ لن يصنعَ تميّزاً ولا إقتداراً، وقد يُودِي بالقليلِ المتبقي !.
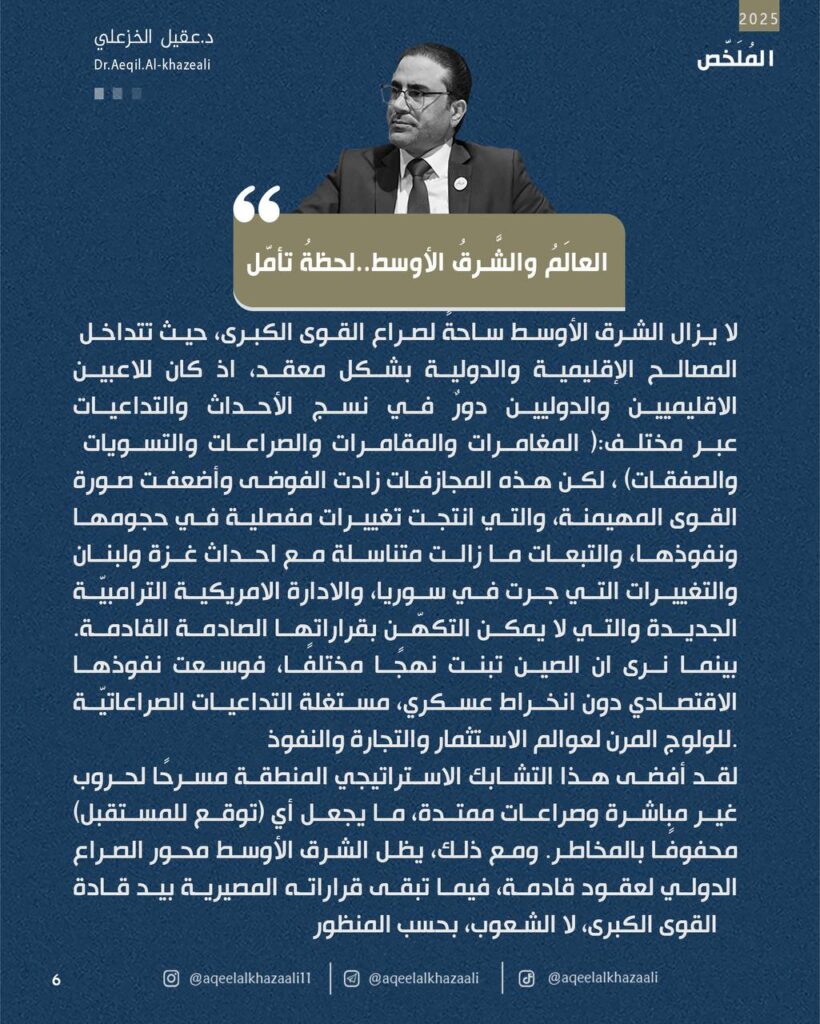
{العالَمُ والشَّرقُ الأوسط..لحظةُ تأمّل}
د.عقيل الخزعلي/ رئيس مجلس التنميّة
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
لا تزالُ منطقةُ الشَّرقِ الأوسطِ تمثِّلُ ساحةً لصراعِ القوى الكبرى، حيثُ تتداخلُ العواملُ الإقليميةُ والدوليةُ لتصنعَ معادلاتٍ معقَّدةً تحكمُ مسارَ الأحداثِ وتحكمُ على اللاعبينَ الأساسيينَ فيها بالسَّيرِ فوقَ حبلٍ مشدودٍ بينَ (الاستراتيجيةِ والمخاطرةِ)، فمنذُ بدايةِ القرنِ الحادي والعشرينَ، مرَّتِ المنطقةُ بمراحلَ من (التَّحوُّلِ العميقِ ) نتيجةَ التَّدخُّلاتِ الخارجيةِ والاصطفافاتِ الإقليميةِ المتجدِّدةِ، وكانَ أبرزُ مَن أثَّرَ في هذا المسارِ ثلاثُ قوى رئيسةٌ: الولاياتُ المتَّحدةُ الأمريكيَّةُ التي تمسَّكتْ بدورِ (القوَّةِ المهيمنةِ) رغمَ الانتكاساتِ، (وإيرانُ) التي أوجدتْ نفوذًا متناميًا، (والصِّينُ) التي استفادتْ من كلِّ اضطرابٍ دوليٍّ لبناءِ نفوذٍ (اقتصاديٍّ وجيوسياسيٍّ) عابرٍ للقارَّاتِ، فضلاً عن قوى مهمة اخرى مثل تركيا و السعودية. لذا ، تأتي محاولات استجلاءَ طبيعةِ هذه التَّشابُكاتِ، وتحليلَ تداعياتِها، ورصدَ المآلاتِ المستقبليَّةِ بناءً على أحدثِ المعطياتِ والدِّراساتِ الأكاديميَّةِ.
انطلقتِ (الولاياتُ المتَّحدةُ) في مطلعِ القرنِ الحادي والعشرينَ برؤيةٍ حالِمةٍ لفرضِ (نظامٍ عالميٍّ جديدٍ) يُعيدُ تشكيلَ المنطقةِ وفقَ مصالحِها، فكانَ الغزوُ الأمريكيُّ (لأفغانستانَ) عامَ ٢٠٠١ تحتَ شعارِ “الحربِ على الإرهابِ” ثمَّ الغزوُ الأكثرُ إشكاليَّةً (للعراقِ ) عامَ ٢٠٠٣، واللَّذانِ شكَّلا نقطتَيْ (تحوُّلٍ استراتيجيَّتَيْنِ ) في سياساتِ واشنطنَ تجاهَ الشَّرقِ الأوسطِ. إلَّا أنَّ هاتَيْنِ (المغامرتَيْنِ)، بدلاً من تحقيقِ الاستقرارِ الذي وعدتْ بهِ الإداراتُ الأمريكيَّةُ المتعاقبةُ، أفضتا إلى واقعٍ معقَّدٍ سقطتْ فيهِ المنطقة في مستنقعِ الطائفيَّةِ والاحترابِ الدَّاخليِّ، فيما تحوَّلتْ أفغانستانُ إلى نموذجٍ كلاسيكيٍّ لفشلِ الدَّولةِ وانهيارِ مشروعِها السِّياسيِّ المدعومِ غربيًّا، وهو ما تجلَّى في عودةِ “طالبانَ” للحُكمِ بعدَ عشرينَ عامًا من القتالِ المستمرِّ ضدَّ القوَّاتِ الأمريكيَّةِ وقوَّاتِ النَّاتو، و لم تقتصرْ هذه النَّتائجُ المُخيِّبةُ على الأبعادِ المحلِّيَّةِ لكلٍّ من العراقِ وأفغانستانَ، بل امتدَّ تأثيرُها إلى المشهدِ الجيوسياسيِّ العالميِّ حيثُ أدَّتْ إلى (تقويضِ) صورةِ الولاياتِ المتَّحدةِ كقوَّةٍ لا تُقهرُ، وفتحتِ البابَ أمامَ قوىً أخرى لملءِ الفراغِ الاستراتيجيِّ الذي خلَّفتهُ واشنطنُ في المنطقةِ.
في المقابلِ، استغلَّتْ قوى اخرى هذه الفوضى ووسَّعتْ نفوذَها بشكلٍ كبيرٍ، حيثُ اعتمدتْ سياسةً قائمةً على دعمِ حلفاءَ محليِّينَ وقُوى غيرِ حكوميَّةٍ تُشارِكُها الرُّؤيةَ والأهدافَ، اذ منحتْ هذه الاستراتيجيَّةُ عُمقًا جيوسياسياً كبيرًا مكَّنَها من التأثيرِ في المشهدِ الإقليميِّ. ومع أنَّ هذه السِّياسةَ كانتْ مُكلفةً اقتصاديًّا وسياسيًّا لهذ القوى، إلَّا أنَّها حقَّقتْ عائدًا استراتيجيًّا واضحًا، وهو ما بدا جليًّا في اتِّساعِ دوائرِ نفوذِها، وقدرتِها على التأثيرِ في الأحداثِ الإقليميَّةِ.
أمَّا (الصِّينُ)، فقدِ التزمتْ نهجًا مُغايرًا تمامًا، إذ لم تنخرطْ في (مغامراتٍ عسكريَّةٍ)، ولم تحاولْ فرضَ نفوذِها (بالقوَّةِ الخشنةِ)، وإنَّما اعتمدتْ على (القوَّةِ النَّاعمةِ)، وأبرزُ أدواتِها: (الاقتصادُ والتِّجارةُ والتَّنميةُ المستدامةُ)، ففي الوقتِ الذي كانتِ الولاياتُ المتَّحدةُ (تنزفُ) مواردَها في حروبِ الشَّرقِ الأوسطِ، كانتِ الصِّينُ (تستثمرُ) في مشروعاتِ البُنيةِ التَّحتيَّةِ حولَ العالمِ عبرَ “مبادرةِ الحزامِ والطَّريقِ”، وتمدُّ نفوذَها تدريجيًّا من آسيا إلى إفريقيا وأوروبا. ومن خلالِ تعزيزِ علاقاتِها التِّجاريَّةِ معَ دولِ (الخليجِ العربيِّ وإيرانَ وإسرائيلَ) في آنٍ واحدٍ، بذلك، نجحتْ الصِّينُ في بناءِ منظومةِ (تحالفاتٍ اقتصاديَّةٍ مُتشابكةٍ) تجعلُ من الصَّعبِ على واشنطنَ فرضَ عقوباتٍ مُشدَّدةٍ على أيٍّ من شركاءِ بكينَ دونَ أنْ تضرَّ مصالحَها الاستراتيجيَّةَ الخاصَّةَ. وهكذا، تحوَّلتِ الصِّينُ إلى قوَّةٍ لا يُمكنُ تجاهلُها في سياساتِ الشَّرقِ الأوسطِ، رغمَ أنَّها لمْ تُطلقْ رصاصةً واحدةً في أيِّ صراعٍ إقليميٍّ.
ومعَ اشتدادِ حدَّةِ التَّنافسِ بينَ هذه القوى، أصبحَ مستقبلُ الشَّرقِ الأوسطِ أكثرَ تعقيدًا، حيثُ تتداخلُ المصالحُ الإقليميَّةُ والدوليَّةُ بشكلٍ يجعلُ من المنطقةِ مسرحًا لحروبٍ غيرِ مُباشرةٍ، وساحاتٍ لصراعاتٍ طويلةِ الأمدِ، هذا التَّشابُكُ الاستراتيجيُّ يجعلُ أيَّ توقُّعٍ لمآلاتِ الأوضاعِ مُغامرةً في حدِّ ذاتِها، إلَّا أنَّ الثَّابتَ الوحيدَ هو أنَّ الشَّرقَ الأوسطَ سيظلُّ في (قلبِ معادلاتِ الصِّراعِ الدَّوليِّ) لعقودٍ قادمةٍ، وسيبقى ساحةَ اختبارٍ مُستمرٍّ لقدرةِ القوى العالميَّةِ على إدارةِ اشتباكاتِها دونَ الانزلاقِ إلى مواجهاتٍ شاملةٍ تُعيدُ تشكيلَ النِّظامِ الدَّوليِّ برُمَّتِهِ، فهل مِن جُرعَةِ وعيٍّ استراتيجيٍّ يرسُمُ أملاً واقعياً حقيقياً، والإجابةُ – مع الأسف – لا تمتلكها الشعوب، بل قادة التَّهوّر وتُجّارُ الحروب، إلا أن ” يقضي الله أمراً كانَ مفعولاً” !.
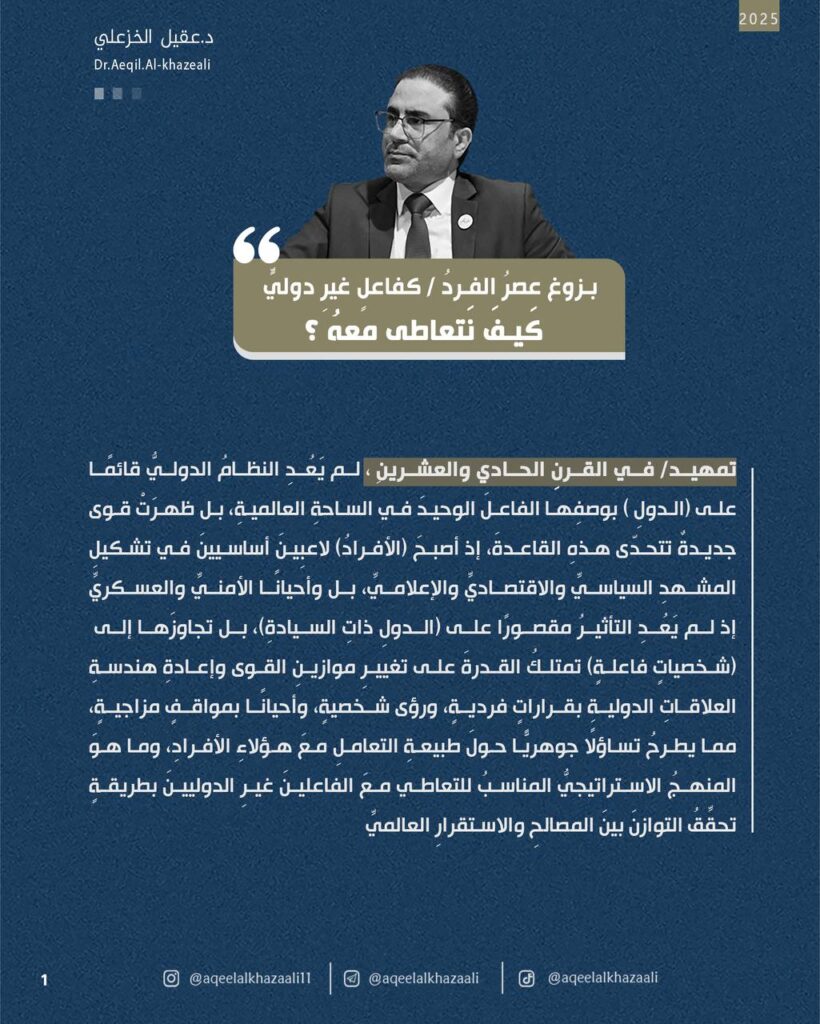
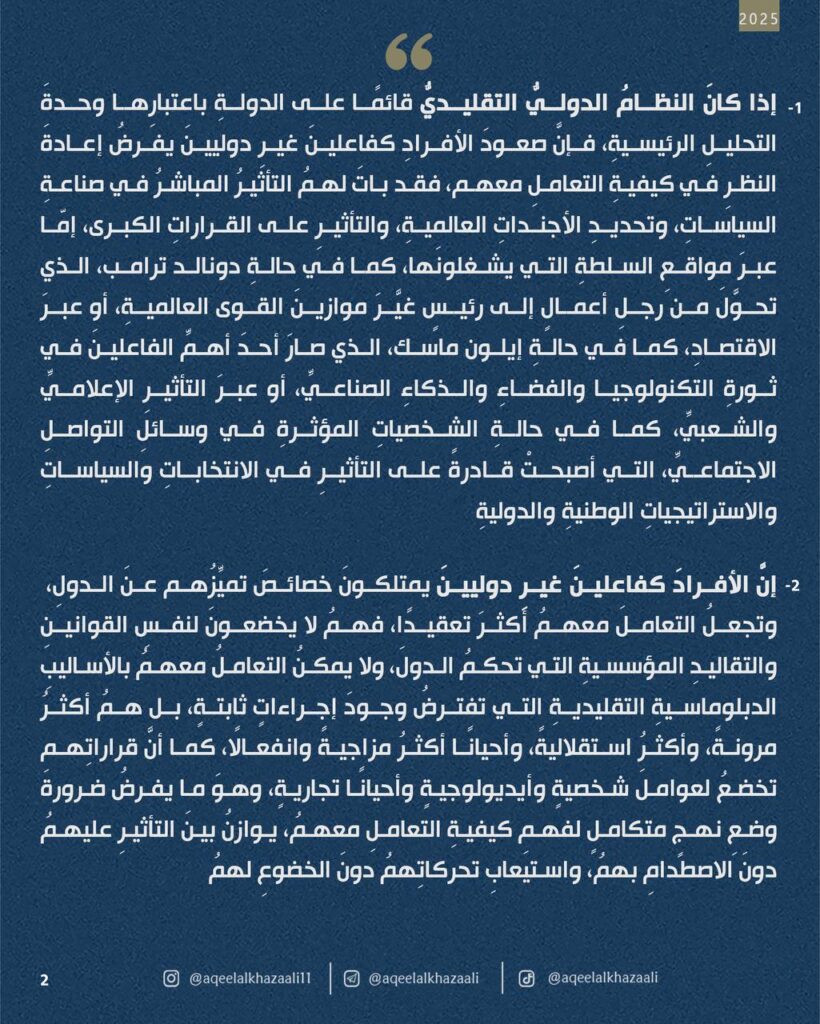
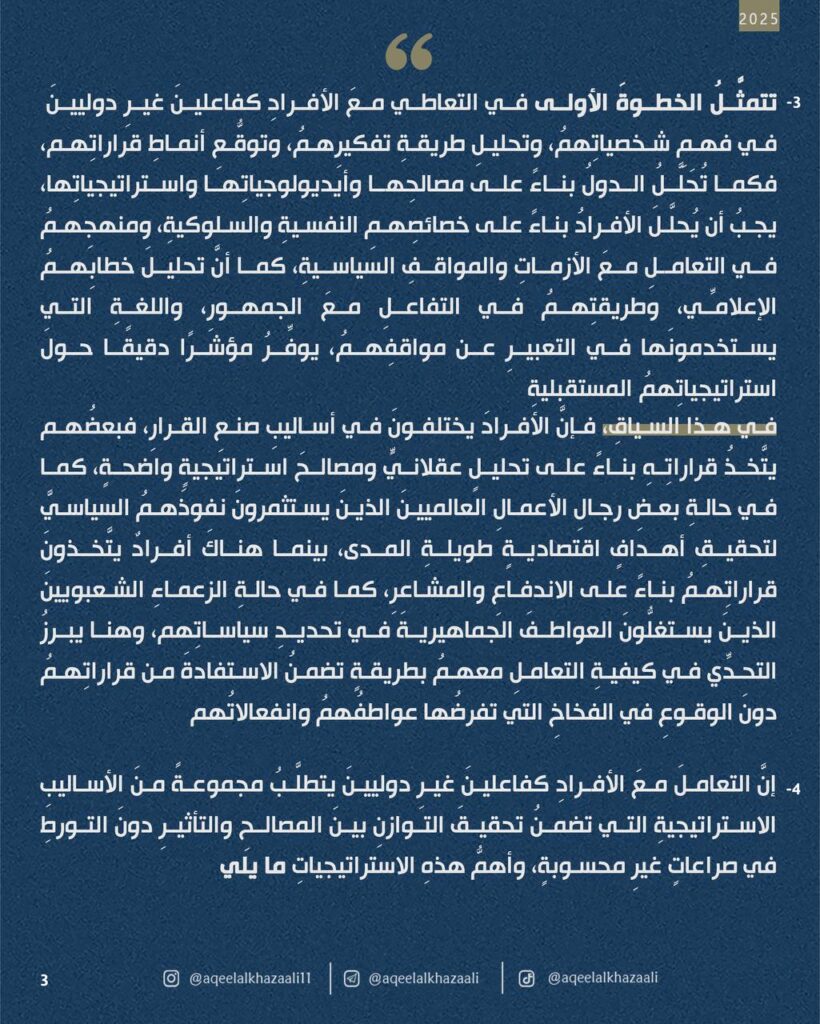
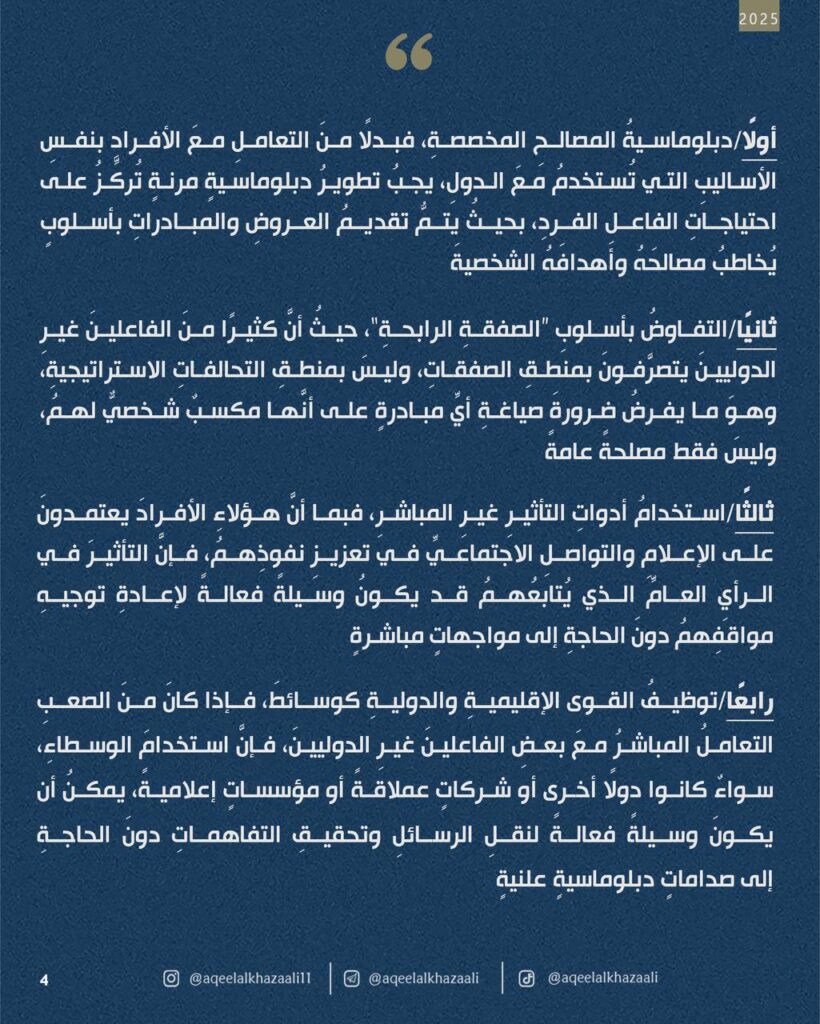
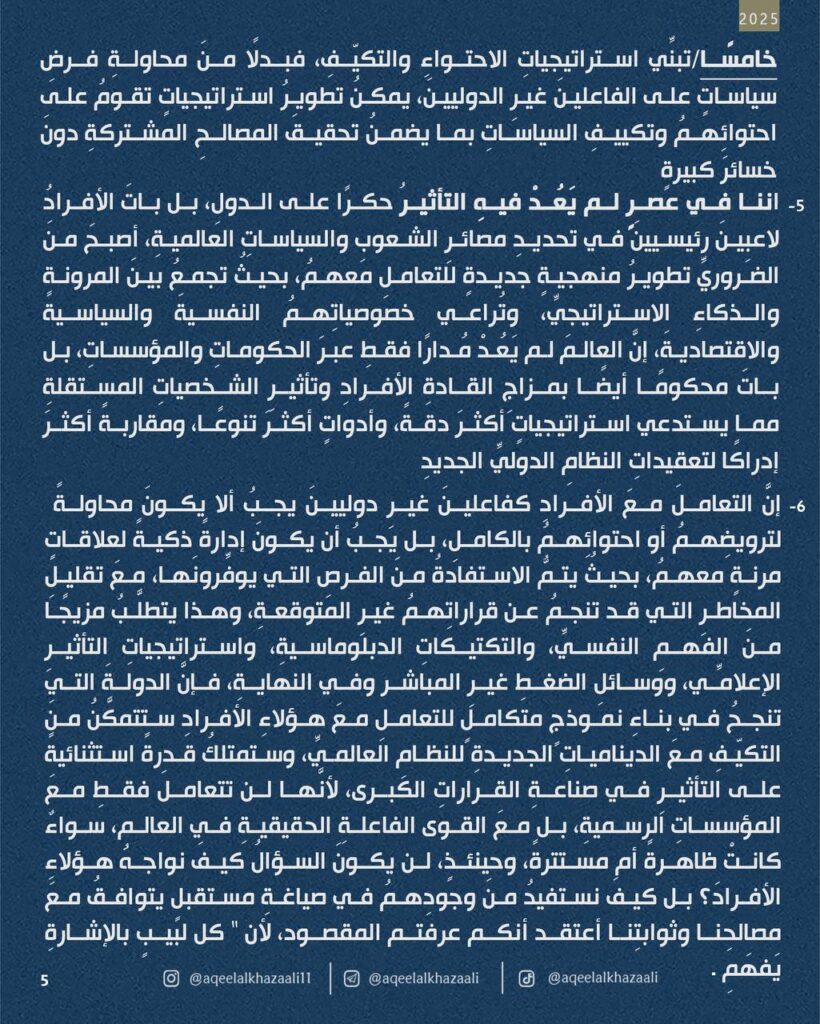
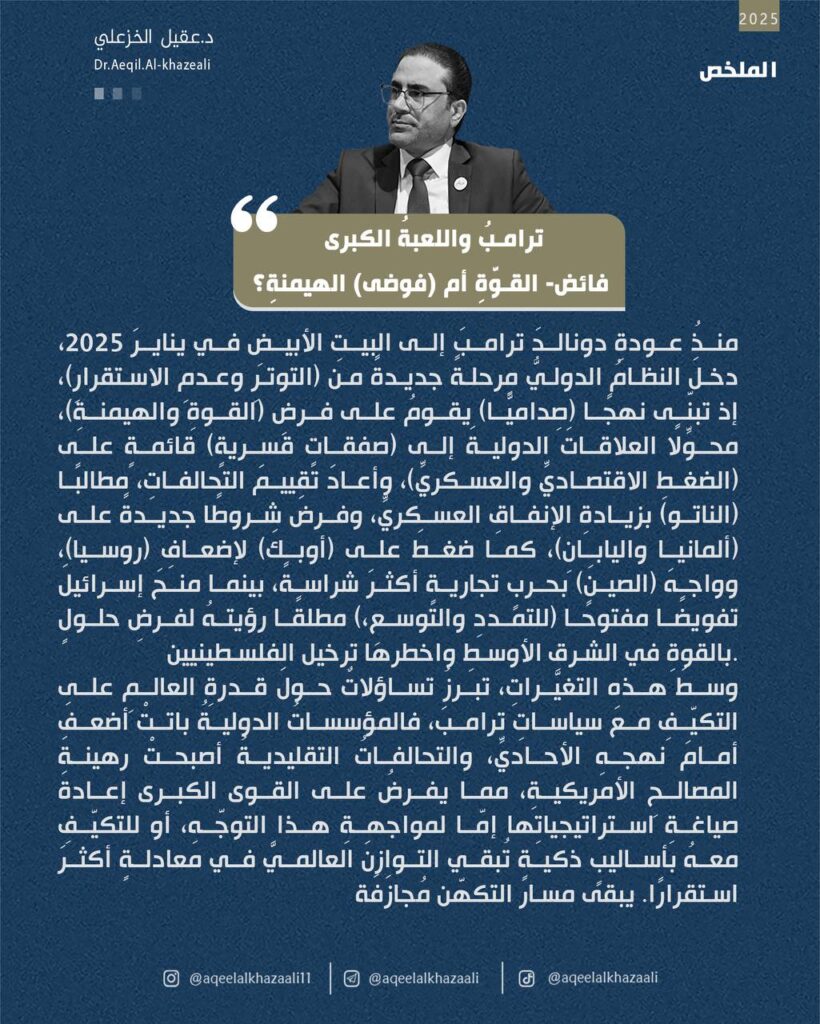
“ترامبُ واللعبةُ الكبرى..
(فائض) القوّةِ أم (فوضى) الهيمنةِ؟ “
+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
*تمهيد* / منذُ عودةِ دونالدَ ترامبَ إلى البيتِ الأبيضِ في العشرينَ من ينايرَ عامَ ألفينِ وخمسةٍ وعشرينَ، شهدَ النظامُ الدوليُّ موجةً منَ (التوتراتِ المتصاعدةِ)، إذ جاءَ ترامبُ (مُدَجَّجًا) برؤًى جديدةٍ تتجاوزُ كلَّ ما هوَ مألوفٌ، متحرِّرًا منْ قيودِ الأعرافِ السياسيةِ والدبلوماسيةِ، مُتَبَنِّيًا (نهجًا صِدامِيًّا) يسعى من خلالِهِ إلى إعادةِ تشكيلِ العالَمِ وَفْقَ (تَصَوُّراتِهِ الخاصَّةِ)، فلمْ يكدْ يجلسُ في المكتبِ البيضاويِّ حتّى بدأَ بإصدارِ قراراتٍ تَعكِسُ نهجَهُ الذي يقومُ على (القوَّةِ وَالهَيْمَنَةِ)، مُحَوِّلًا العَلاقاتِ الدوليَّةَ مِنْ (تَوَازُناتٍ دقيقةٍ إلى مَعادلاتٍ قَسْرِيَّةٍ) قائمةٍ على (فَرْضِ الأمرِ الواقعِ)، فالتحالُفاتُ التي بُنِيَتْ على مدى عقودٍ أصبحتْ رهينةَ (نَزْعَةِ التَّفاوُضِ القَسْرِيِّ)، وَالالتزاماتُ الدوليَّةُ تَحَوَّلَتْ إلى (أوراقِ ضغطٍ) تُستَخدَمُ متى شاءَ، مِمّا يجعلُ العالَمَ أمامَ مرحلةٍ جديدةٍ لا يَحكمُها القانونُ بقدرِ ما تُسَيْطِرُ عليها (الصَّفقاتُ وَالمَصالِحُ الذّاتيَّةُ)، وهو ما يستدعي الوقوف عند هذه الانعطافة التي سيكون لها العديد من التداعيات والارتدادات في الداخل الامريكي وخارجه.
١- لمْ تَكُنْ سياساتُ ترامبَ يَومًا انعكاسًا لمجردِ توجُّهاتٍ إداريَّةٍ داخليَّةٍ، بلْ شَكَّلَتْ تَحَوُّلًا جَوْهَرِيًّا في الطَّريقةِ التي تَنْظُرُ بها النزعة الجمهوريّة إلى مَوقِعِها في العالَمِ، فَهُوَ لا يَرى الحُلفاءَ (شُرَكَاءَ مُتَكافِئِينَ)، بلْ يَعْتَبِرُهم (مُسْتَفِيدِينَ) عليهِ أنْ يَفْرِضَ عليهم (شُروطًا جديدةً) لِلِاسْتِمرارِ تَحْتَ المِظَلَّةِ الأمريكيَّةِ، وَمنذُ لَحظاتِهِ الأولى في الحُكْمِ بدأَ بإعادةِ النَّظَرِ في التِزَاماتِ الوِلاياتِ المُتَّحِدَةِ تجاهَ (النَّاتُو)، فَطالَبَ الدُّوَلَ الأعضاءَ بزيادةِ إِنْفاقِها العَسْكَرِيِّ وَفَرَضَ على (أَلْمانيا وَاليابانِ ) دَفْعَ تَكاليفَ إضافِيَّةٍ مُقابِلَ بَقاءِ القُوّاتِ الأمريكيَّةِ على أَراضِيهِما، وَلمْ تَكُنْ (كَنْدا) بِمَنْأًى عنْ طُموحاتِهِ، إذْ أَشارَ إلى ضَرُورةِ تَعْزيزِ السَّيطَرَةِ الأمريكيَّةِ على مَواردِها، كما لَمْ يُخْفِ رَغْبَتَهُ في إعادةِ تَعْريفِ العَلاقَةِ معَ (مُنَظَّمَةِ أُوبِكْ)، ضاغطًا باتِّجاهِ رَفْعِ مَعدَّلاتِ الإنتاجِ النَّفْطِيِّ بهدفِ إِضْعافِ (الاقتصادِ الرُّوسيِّ)، وَهوَ ما يَعْكِسُ أَنَّ استراتيجيَّتَهُ ليستْ مُجَرَّدَ سياساتٍ فَرْدِيَّةٍ، بلْ جُزءٌ مِنْ رُؤْيَةٍ أَشْمَلَ لإعادةِ (هَنْدَسَةِ التَّوازُناتِ الدُّوَلِيَّةِ( بِما يَخْدِمُ التَّفَوُّقَ الأمريكيَّ المُطْلَقَ.
٢- على الجانبِ الآخَرِ، كانتْ (الصينُ وَرُوسيا) في صُلْبِ المُواجَهَةِ، فَترامبُ الذي طالما اعتَبَرَ بَكِين الخَطَرَ الاقتصاديَّ الأَكْبَرَ بدأَ حَمْلَةَ ضُغُوطٍ اقتصاديَّةٍ غيرِ مَسْبُوقَةٍ لِإجْبارِها على زيادةِ وَارِداتِها منَ الوِلاياتِ المُتَّحِدَةِ، مُهَدِّدًا بِفَرْضِ تَعْرِيفاتٍ جُمْرُكِيَّةٍ جَديدةٍ إِذا لَمْ تَمْتَثِلْ، وَلمْ يَكُنْ مَوْقِفُهُ مِنْ مُوسْكُو أَقَلَّ حِدَّةً، إذْ سَعى إلى عَزْلِها اقتصاديًّا وَعَسْكَرِيًّا مِنْ خِلالِ حُزْمَةِ عُقُوباتٍ تَسْتَهْدِفُ الصِّناعاتِ الدِّفاعِيَّةَ وَالطَّاقةَ، فَضْلًا عنْ تَعْزيزِ الحُضُورِ العَسْكَرِيِّ الأمريكيِّ في (أُورُوبَّا الشَّرْقِيَّةِ) لِرَدْعِ أيِّ تَحَرُّكاتٍ رُوسيَّةٍ قَدْ تُهَدِّدُ مَصالِحَ واشنطنَ، وَفي (الشَّرْقِ الأَوْسَطِ) أَعَادَ تَأْكِيدَ دَعْمِهِ غَيرِ المَشْرُوطِ لإِسْرَائِيلَ، مَانِحًا تَلَّ أَبِيبَ الضَّوءَ الأَخْضَرَ (لِلتَّوَسُّعِ وَالتَّمَدُّدِ)، وَطَرَحَ مُجَدَّدًا فِكْرَةَ إعادةِ تَوْطِينِ الفِلِسْطِينِيِّينَ خارِجَ أَرْضِهِمْ، في رُؤْيَةٍ تَسْعَى إلى فَرْضِ (حَلٍّ بِالقُوَّةِ) بَدَلًا مِنَ التَّفاوُضِ، وَكَأَنَّ التَّاريخَ يُعِيدُ نَفْسَهُ وَلكنْ هَذِهِ المَرَّةَ بِمَنْطِقٍ أَمْرِيكِيٍّ أَكْثَرَ راديكاليةً وَوُضُوحًا.
٣- وَسَطَ هَذِهِ التَّغَيُّراتِ المُتَسارِعَةِ، تَبْرُزُ تَساؤُلاتٌ حَوْلَ مَدَى قُدْرَةِ العالَمِ على (التَّكَيُّفِ) معَ نَهْجِ ترامبَ الجَديدِ، فَالمُؤَسَّساتُ الدُّوَلِيَّةُ التي لَطالَما شَكَّلَتْ إِطارًا ناظِمًا لِلْعَلاقاتِ بَيْنَ الدُّوَلِ تَبْدُو اليَوْمَ أَكْثَرَ ضُعْفًا أَمامَ سِياساتٍ قائِمَةٍ على (الابْتِزازِ وَالضَّغْطِ)، وَالتَّحالُفاتُ التَّقْلِيدِيَّةُ لَمْ تَعُدْ تَضْمَنُ حِمايَةَ أَصْحابِها، بَلْ باتَتْ (مَشْرُوطَةً) بِالامتِثالِ لِلمَطالِبِ الأَمْرِيكِيَّةِ، وَهوَ ما يَطْرَحُ (سِينارْيُوهَيْنِ مُتَناقِضَيْنِ)؛ فَإِمّا {أَنْ تُعيدَ الدُّوَلُ الكُبْرى صِياغَةَ استراتيجِيَّاتِها لِمُواجَهَةِ هَذا التَّوَجُّهِ الأُحادِيِّ}، وَإِمّا {أَنْ تَجِدَ نَفْسَها مُجْبَرَةً على التَّكَيُّفِ مَعَ المَعادِلاتِ الجَديدَةِ}، وَبَيْنَ هَذَيْنِ السِّينارْيُوهَيْنِ، يَبْقَى السُّؤالُ الأَهَمُّ: هَلْ يُدْرِكُ العالَمُ أَنَّ مُواجَهَةَ ترامبَ لا تَكُونُ بِمُقاوَمَتِهِ فَقَطْ، بَلْ بِفَهْمِ مَنْطِقِهِ وَالتَّعامُلِ مَعَهُ بِأَساليبِهِ، دُونَ أَنْ يَفْقِدَ جَوْهَرَ القِيَمِ وَالمَصالِحِ التي تَحْكُمُ عَلاقاتِهِ؟، وان هناك خيرات ذكيّة (داخلية امريكياً) و(خارجيّة؛احادية او ثنائية او جماعية)، فلكلِّ “قفلٍ مُفتاح” كما في المأثور.
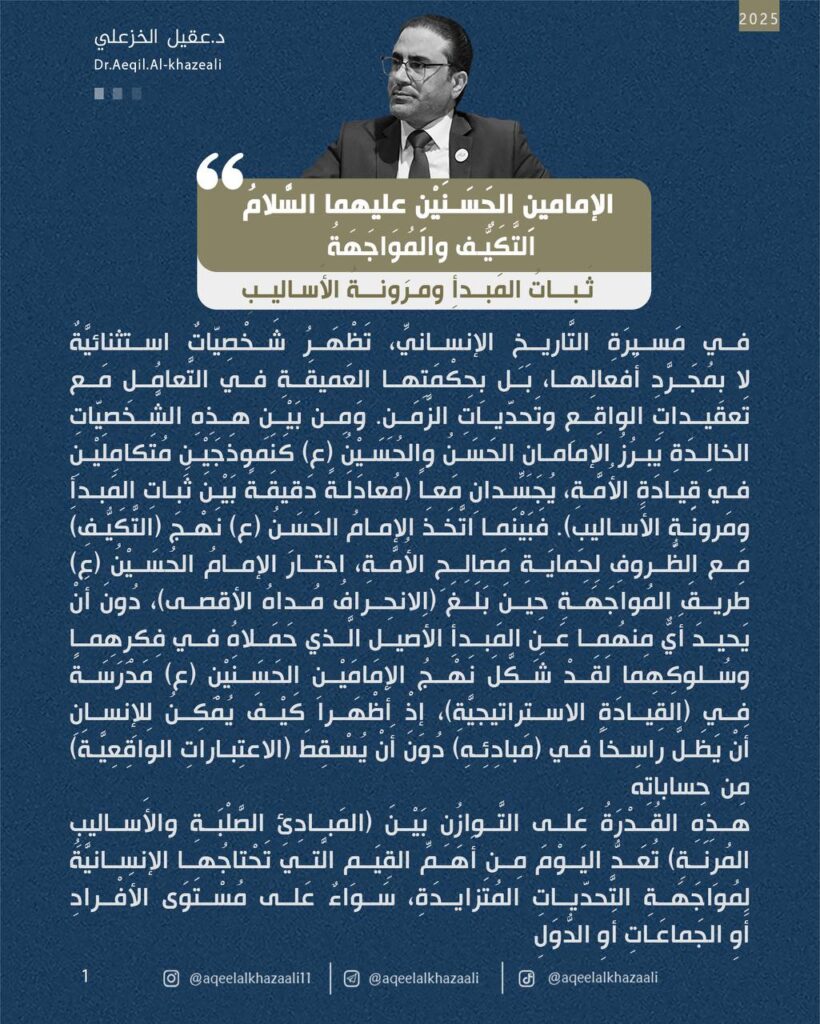
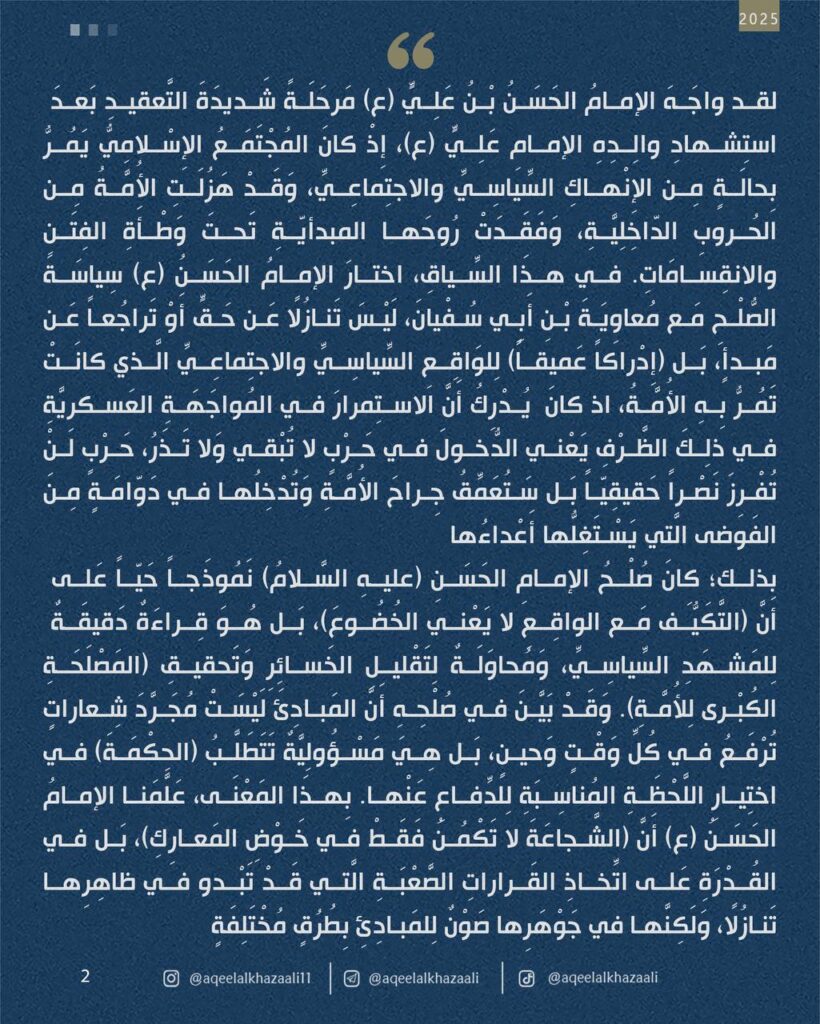
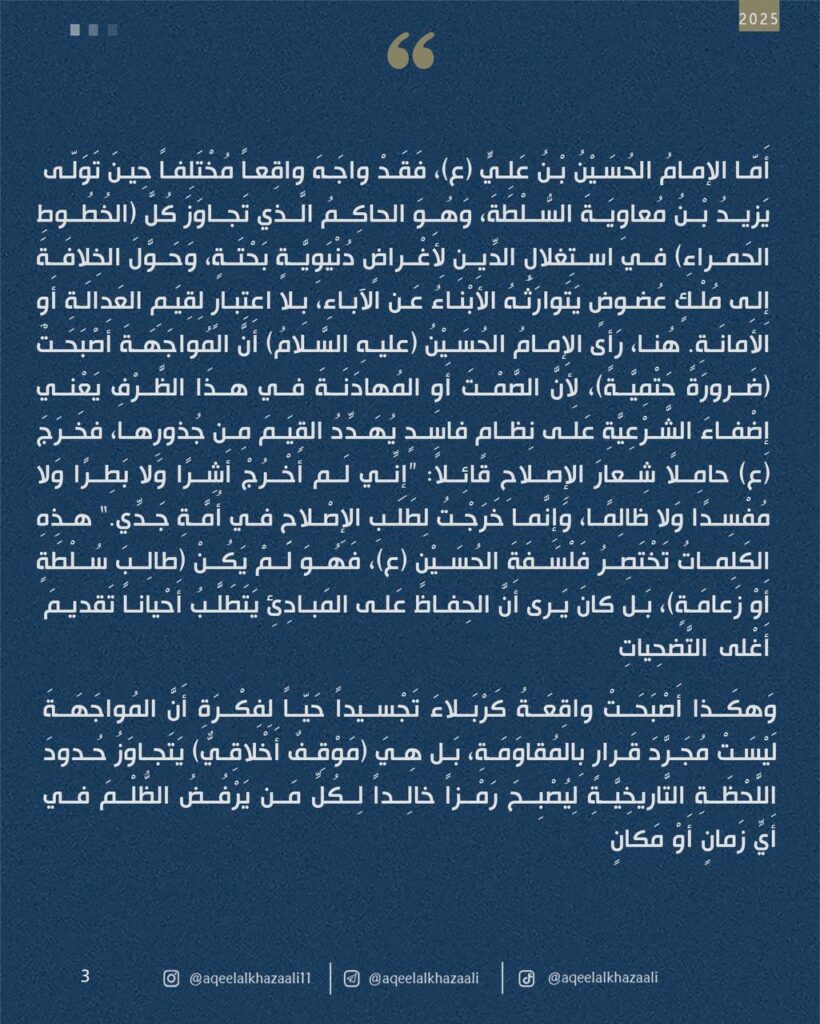
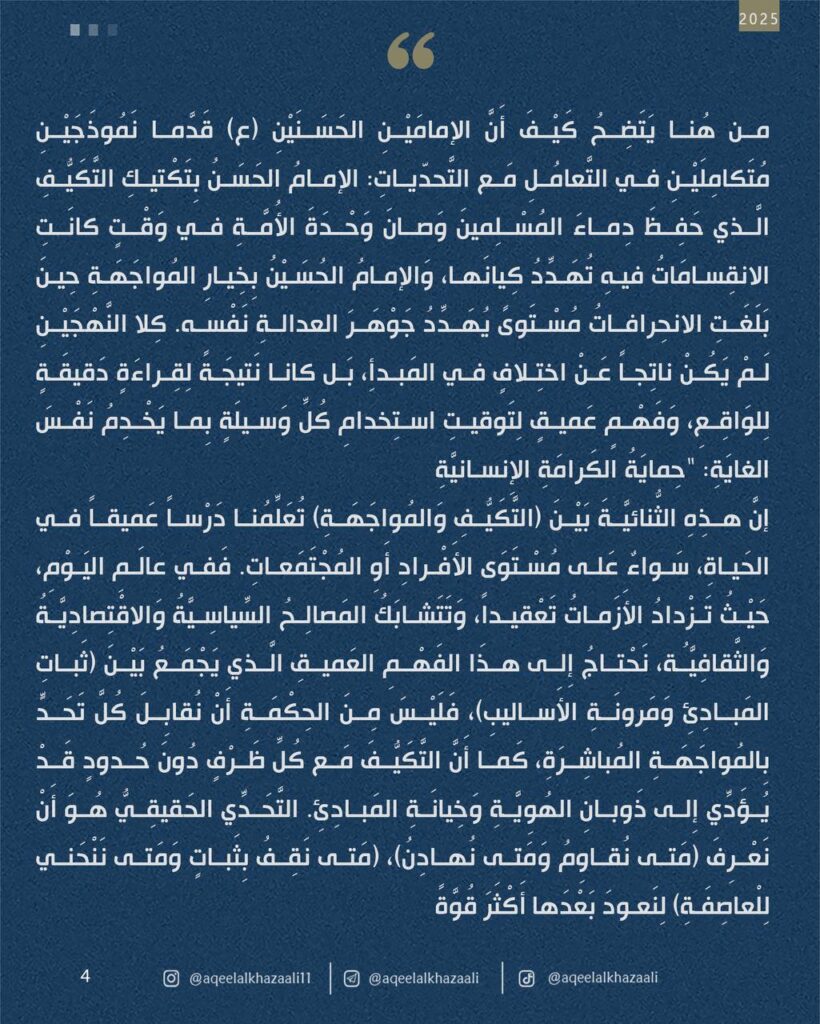
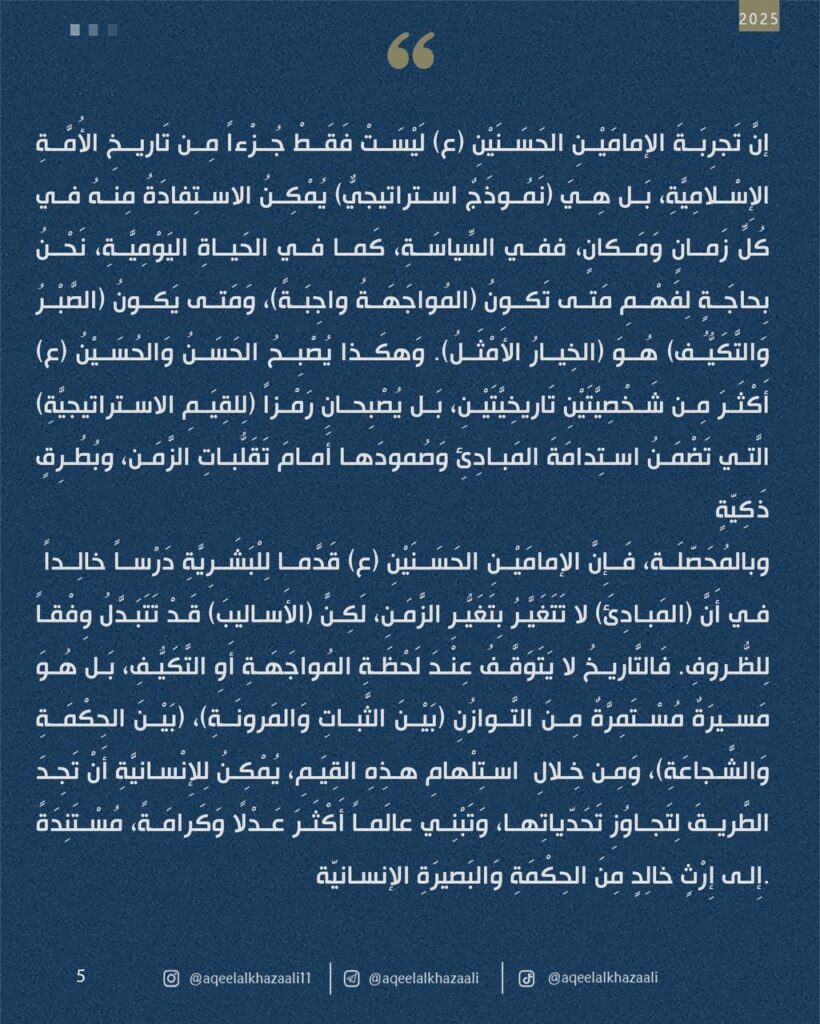
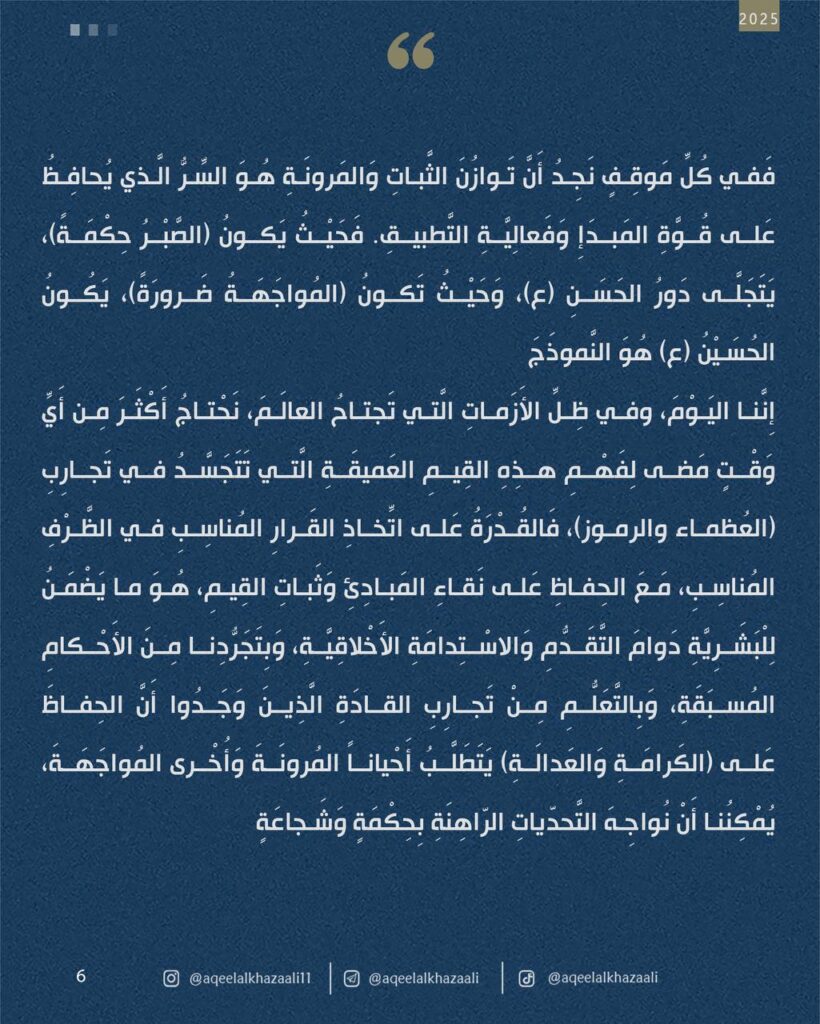
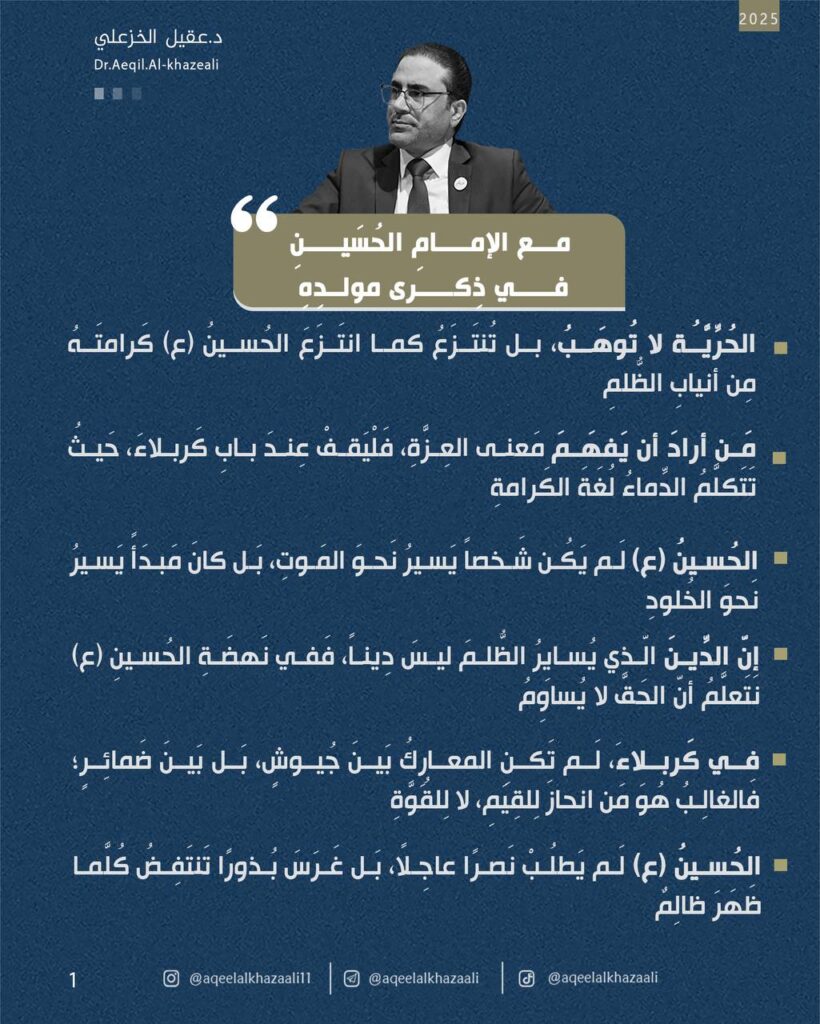
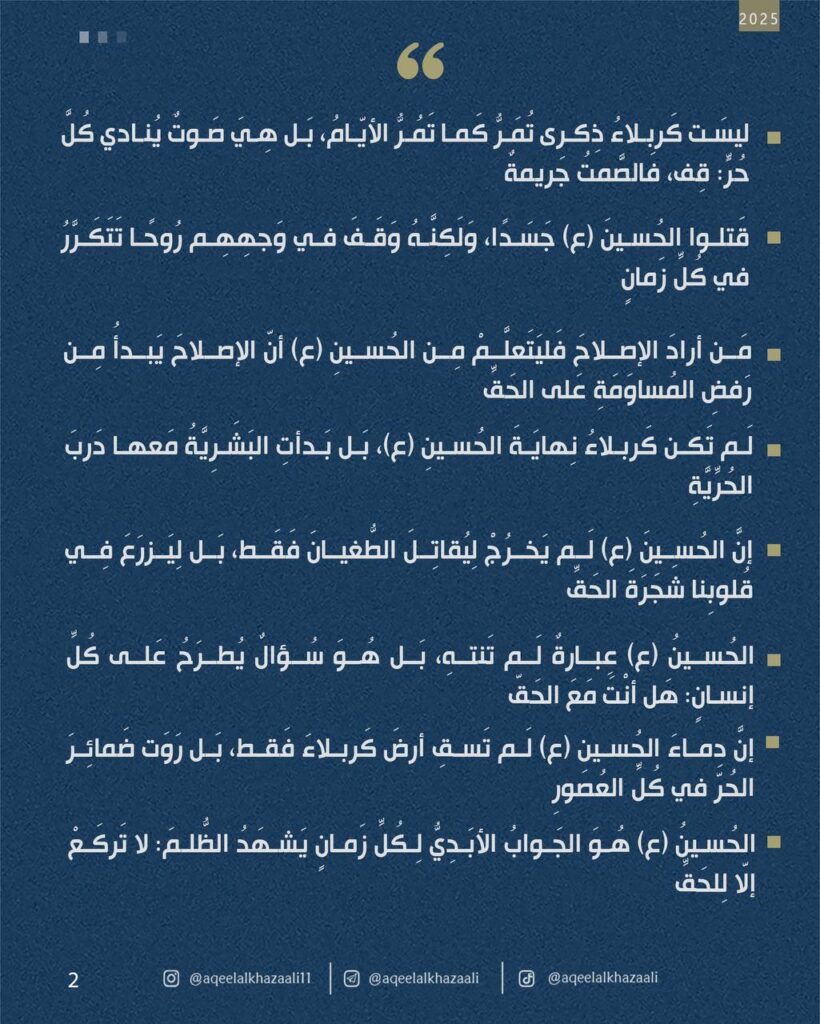
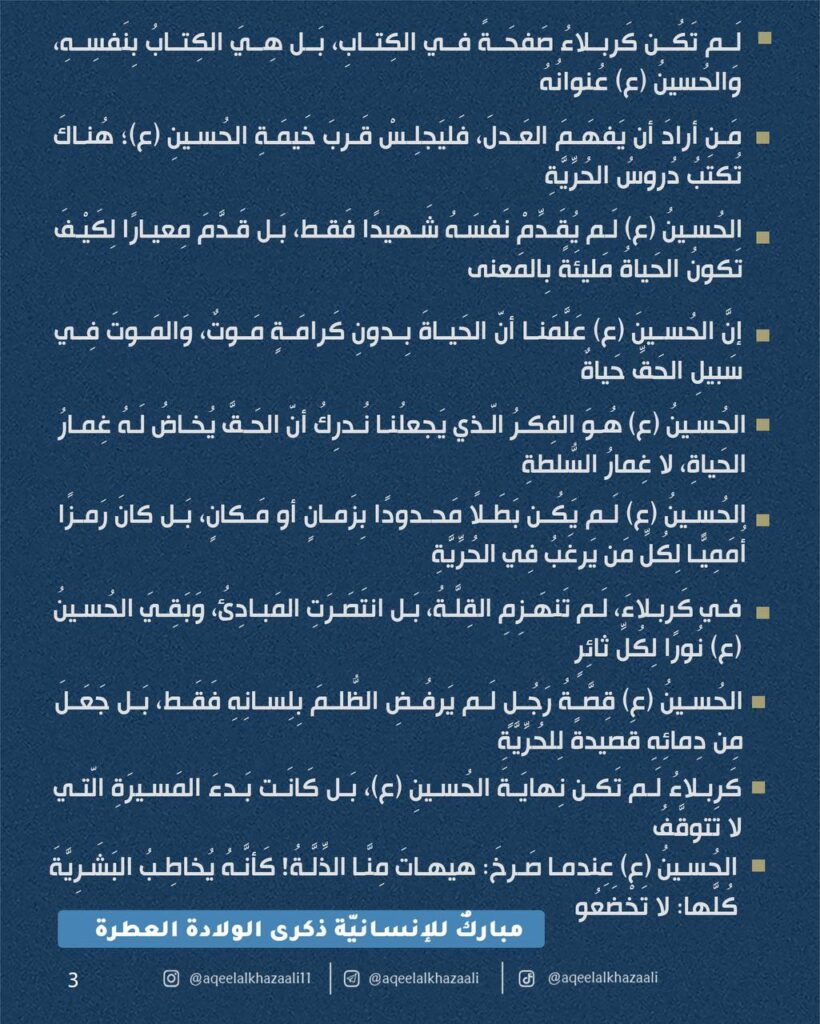
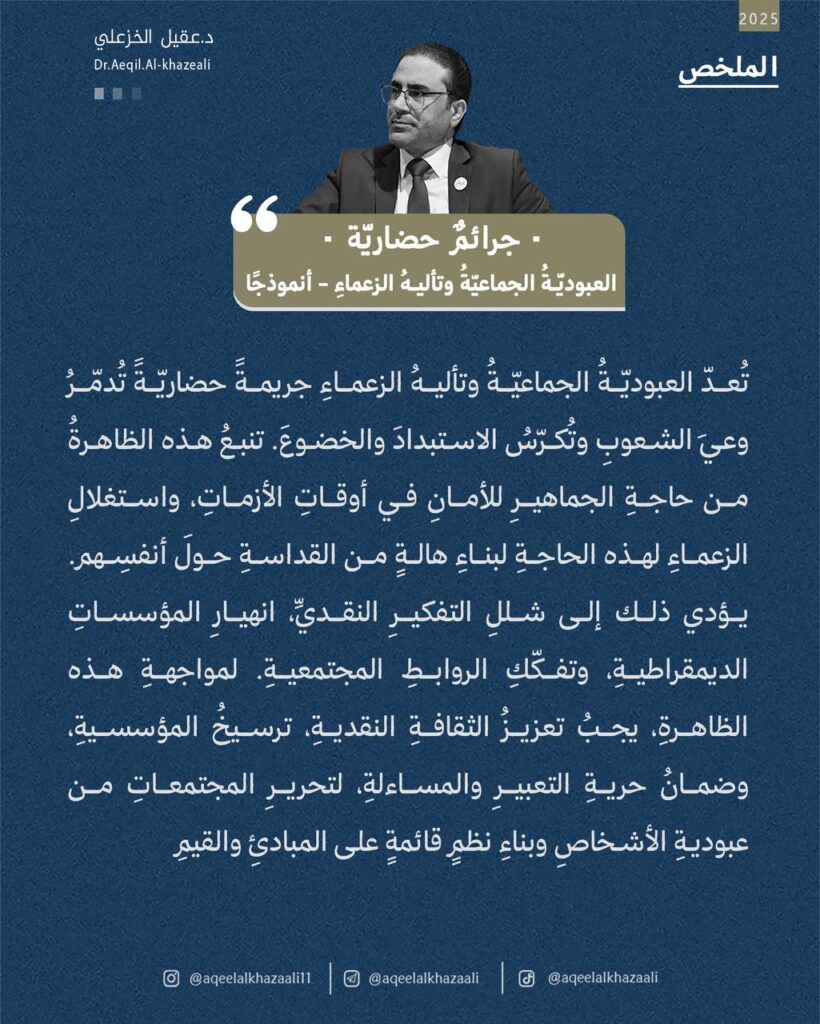
🔪🔪🔪 *جرائمٌ حضاريّةٌ* 🔪🔪🔪
– العبوديّةُ الجماعيّةُ وتأليهُ الزعماءِ (أنموذجًا) –
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقيّ
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
في مسيرةِ البشريةِ الطويلةِ، تتجلّى (جرائمُ حضاريّةٌ) ليست أقلَّ فتكًا من الحروبِ والنزاعاتِ، بل لعلَّها الأخطرُ لأنها (تنخرُ في وعيِ الإنسانِ ) وتُعيدُ تشكيلَ ثقافتِهِ وهويتِهِ بما يُقيّدُ حريتَهُ من الداخلِ قبلَ الخارجِ. ومن بينِ هذه الجرائمِ، تبرزُ (العبوديّةُ الجماعيّةُ) و(تأليهُ الزعماءِ) كأنموذجٍ صارخٍ على قدرةِ الأنظمةِ والأفكارِ على (استعبادِ الشعوبِ) نفسيًّا وفكريًّا، فيتحوّلُ القائدُ إلى (صنمٍ) تُنحَتُ ملامحُهُ في ذاكرةِ الجماهيرِ وتُسطَّرُ أقوالُهُ كأنها (نصوصٌ مقدّسةٌ)، بينما تتلاشى إرادةُ الأفرادِ تحت وطأةِ الطاعةِ المطلقةِ والخضوعِ غيرِ المشروطِ.
مِنَ البَداهَةِ بمكان، فأن ظاهرةُ العبوديّةِ الجماعيّةِ لا تنبعُ فقط من (قسوةِ) الزعيمِ أو طغيانِهِ، بل أيضًا من (استعدادِ) الجماهيرِ النفسيِّ والاجتماعيِّ لتقديمِ ولاءِهم الكاملِ بلا مساءلةٍ أو نقدٍ، ففي لحظاتِ الأزماتِ والانهياراتِ، حين تتشظّى الثقةُ بالمؤسساتِ وتتلاشى القدرةُ على مواجهةِ (المجهولِ)، يبحثُ الناسُ عن (رمزٍ يتّكئون عليهِ)، شخصٍ يبدو وكأنّهُ يحملُ (حلولًا) سحريةً لكلِّ معضلةٍ ويمنحُهم (الأمانَ) وسطَ الفوضى. هذه الحاجةُ النفسيةُ (للتشبثِ) بشخصيةٍ قويةٍ تدفعُ الجماعاتِ إلى تأليهِ الزعيمِ، حيثُ يُنظرُ إليهِ (ككائنٍ استثنائيٍّ) لا يُخطئُ ولا يُساءَلُ، بل يُقدَّسُ ويُمجَّدُ وكأنّهُ فوق البشرِ.
من جهةِ الزعيمِ، فإنّ تأليهَهُ لا يحدثُ من فراغٍ. بعضُ (القادةِ) يُدركونَ تمامًا هذه الحاجةَ الجماعيةَ ويستغلّونَها لصالحِهم، فيُغذّونَ (أسطورةَ العظمةِ) من خلالِ الخطاباتِ الرنانةِ، والظهورِ الإعلاميِّ المُنمّقِ، وصناعةِ صورةِ القائدِ (المُخلِّصِ) الذي لا يُضاهى، والزعيمُ الذي يتذوّقُ طعمَ (التقديسِ) يصبحُ (مدمنًا) عليهِ، فيُحيطُ نفسهُ بدائرةٍ من (المصفّقينَ والمُطبلينَ) الذين (يُكرّسونَ) هذه الصورةَ المثاليةَ، (ويُقصونَ) كلَّ من يجرؤُ على النقدِ أو المعارضةِ، عندها ينمو الشعورُ (بالعظمةِ) حتى يصلَ إلى حدِّ (الجنونِ)، حيثُ يرى الزعيمُ نفسَهُ ليس فقط كقائدٍ، بل كمصدرِ إلهامٍ روحيٍّ وأخلاقيٍّ.
على الجانبِ الآخرِ، الجماهيرُ التي تُؤلّهُ زعماءَها ليست دائمًا (ضحيةً ساذجةً)، بل تشاركُ أحيانًا في هذه الجريمةِ الحضاريّةِ عن (وعيٍ أو غيرِ وعيٍ)، ففي كثيرٍ من الأحيانِ، يكونُ تأليهُ الزعيمِ نوعًا من (الهروبِ) من المسؤوليةِ الفرديةِ والجماعيةِ، حيثُ يُفضّلُ الناسُ تسليمَ زمامِ الأمورِ لشخصٍ واحدٍ يتخذُ القراراتِ بالنيابةِ عنهم، فيتحررونَ من (عِبءِ) التفكيرِ النقديِّ والمشاركةِ الفاعلةِ في الشأنِ العامِّ. هذا النمطُ من (العبوديّةِ الطوعيةِ) يعكسُ (أزمةً) في الثقافةِ المجتمعيةِ، حيثُ يُقدَّمُ (الولاءُ الأعمى كفضيلةٍ)، بينما يُعتبرُ (النقدُ) والخروجُ عن الصفِّ نوعًا من (الخيانةِ).
تتجلّى مظاهرُ العبوديّةِ الجماعيّةِ وتأليهُ الزعماءِ في صورٍ متعددةٍ، تبدأُ من (تمجيدِ) الخطابِ الشخصيِّ وتحويلِ أقوالِ الزعيمِ إلى (شعاراتٍ تُدرَّسُ وتُردَّدُ) كأنها (نصوصٌ مقدسةٌ)، ولا تنتهي عند رفعِ الصورِ والتماثيلِ في الأماكنِ العامةِ والخاصةِ، حيثُ تصبحُ ملامحُ القائدِ جزءًا لا يتجزأُ من الحياةِ اليوميةِ للجماهيرِ. هذه المظاهرُ تشملُ أيضًا (قمعَ) أيِّ محاولةٍ لانتقادِ الزعيمِ، حيثُ (تُجرَّمُ المعارضةُ) ويُوصمُ المعارضونَ (بالعمالةِ أو الخيانةِ)، كما تُصبحُ الدولةُ أو المؤسسة بأكملِها انعكاسًا لشخصِ الزعيمِ، فتُختزلُ دوائرُها وسياساتُها في إرادتِهِ وأهوائِهِ.
تمتدُّ أمثلةُ هذه الجريمةِ الحضاريّةِ عبرَ التاريخِ والجغرافيا، في ألمانيا النازيةِ، تحوّل (أدولف هتلر) إلى رمزٍ للعظمةِ الألمانيةِ واستغلَّ الأزماتِ الاقتصاديةَ والاجتماعيةَ ليُشيّدَ نظامًا قائمًا على تمجيدِ شخصهِ وإبادةِ كلِّ من يعارضُهُ. وفي (الاتحادِ السوفيتيِّ)، بنى (جوزيف ستالين) دولةً استبداديةً قمعيةً حولَ شخصيتِهِ، حيثُ أصبحَ النقدُ جريمةً تُعاقَبُ بالإعدامِ أو النفيِ. وفي العالمِ العربيِّ، نجدُ نماذجَ مشابهةً مثل (معمر القذافي) في ليبيا (وصدام حسين) في العراق، حيثُ تحولتْ شخصياتُهم إلى أيقوناتٍ تُمارَسُ حولها طقوسُ الولاءِ والتمجيدِ، ما أدّى إلى تدميرِ النسيجِ الاجتماعيِّ والسياسيِّ في بلدانِهم، والمُشكِلَةُ لَمْ تنتهي عندَ هذه الزَعاماتِ، بل ما زالت (الظاهرةُ ولودة) لتشمل طيفاً واسعاً من (رجال دين، ومفكرين، وسياسيين، وزعماء مافيا…إلخ) في الوقت الراهن، وقد تمتد للمستقبل القريب !.
ان التداعيات المترتبة على هذه العبوديّةِ الجماعيّةِ وتأليهِ الزعماءِ (كارثيةٌ) على جميعِ الأصعدةِ، فعلى (المستوى السياسيِّ)، تُؤدّي هذه الظاهرةُ إلى انهيارِ المؤسساتِ الديمقراطيةِ واستبدالِها بنظامٍ استبداديٍّ يُحكَمُ بإرادةِ فردٍ واحدٍ. وعلى (المستوى الاجتماعيِّ)، تؤدي إلى شللِ التفكيرِ النقديِّ وتفككِ الروابطِ المجتمعيةِ، حيثُ (يُصبحُ الولاءُ للأشخاصِ فوقَ الولاءِ للمبادئِ والقيمِ !). أما على (المستوى الاقتصاديِّ)، فتؤدي السياساتُ الفرديةُ غيرُ المدروسةِ إلى أزماتٍ خانقةٍ نتيجةَ غيابِ التخطيطِ المؤسسيِّ والاستنادِ إلى قراراتٍ شخصيةٍ غيرِ خاضعةٍ (للمساءلةِ). وعلى (المستوى الثقافيِّ)، تُكرّسُ هذه الظاهرةُ ثقافةَ (الخضوعِ والجمودِ)، ما يُعيقُ (الابتكارَ والتقدمَ الحضاريَّ).
تقتضي معالجةُ هذه الجريمةِ الحضاريّةِ وعيًا جماعيًّا (يعترفُ) بخطورةِ تأليهِ الأفرادِ ويُدركُ أهميةَ بناءِ مؤسساتٍ قويةٍ ومستقلةٍ تُؤطّرُ العملَ السياسيَّ والإجتماعي والثّقافي ضمنَ قواعدَ واضحةٍ من (الشفافيةِ والمساءلةِ). يبدأُ (الحلُّ) من إصلاحِ النظامِ التعليميِّ والإعلاميِّ، حيثُ يتمُّ تشجيعُ (التفكيرِ النقديِّ) وفتحُ المجالِ للنقاشِ الحرِّ وتعددِ الآراءِ. كما يتطلبُ الأمرُ (تعزيزَ) الثقافةِ الديمقراطيةِ التي تقومُ على احترامِ التنوعِ وتقبّلِ الاختلافِ، وضمانِ حقوقِ الأفرادِ في التعبيرِ عن آرائِهم دون خوفٍ أو تهديدٍ، كما أنه لا بدَّ من ترسيخِ فكرةِ (أنّ الولاءَ يجبُ أن يكونَ للمبادئِ والقيمِ وليس للأشخاصِ)، وأنّ الزعماءَ مهما بلغوا من قوةٍ أو تأثيرٍ، هم بشرٌ معرضونَ للخطأِ ويجبُ أن يخضعوا للمساءلةِ مثلَ أيِّ فردٍ آخرَ.
في نهايةِ المطافِ، فإنّ العبوديّةَ الجماعيّةَ وتأليهَ الزعماءِ لا تُعَبّر عن مجرّدَ ظاهرةٍ سياسيةٍ أو اجتماعيةٍ، بل تعكسُ جريمةً حضاريّةً تُقوّضُ أسسَ (الحريةِ والكرامةِ الإنسانيةِ)، وان (تحريرُ العقولِ ) من هذه العبوديّةِ هو الخطوةُ الأولى نحو بناءِ مجتمعاتٍ أكثرَ عدلًا وإنسانيةً، مجتمعاتٍ (تُكرّمُ العقلَ) و(تُقدّرُ الاختلافَ) و(تحتفي بالحريةِ) كقيمةٍ أساسيةٍ لا يمكنُ التنازلُ عنها، وخصوصاً في بلداننا الناميّة المسكونة بِعُقَدِ (العبوديّةِ والتأليهِ) المُفْزِعَة.
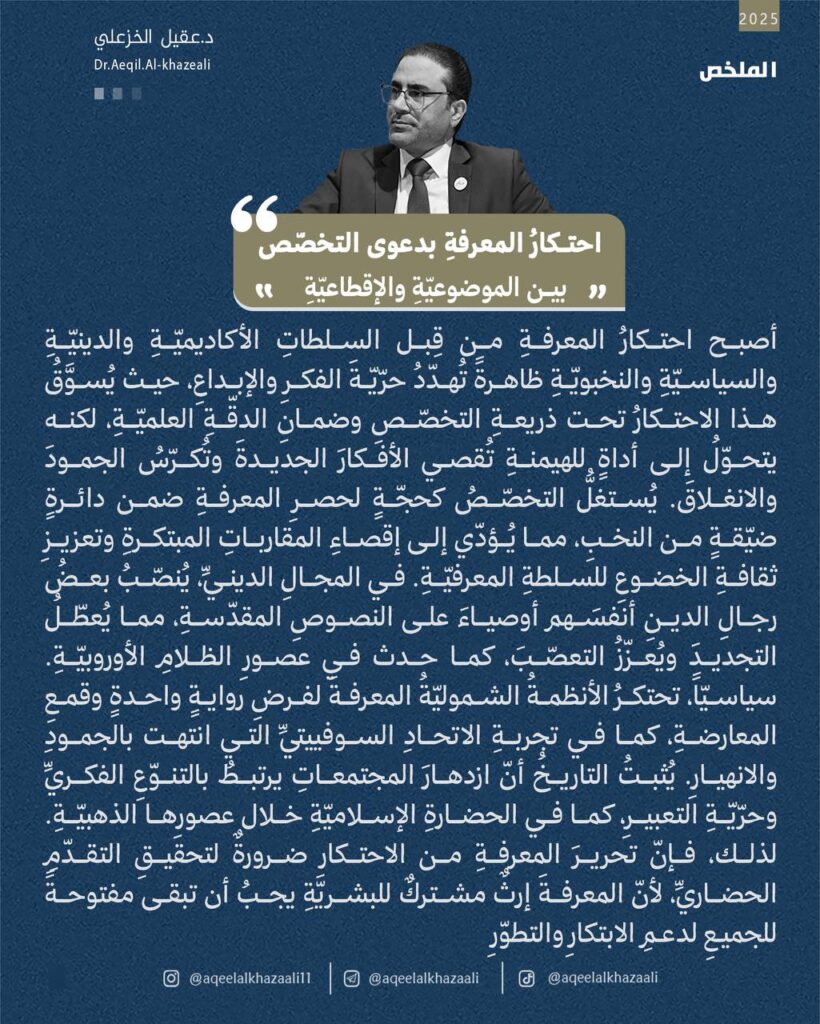
“احتكارُ المعرفةِ بدعوى التخصّص”
– بين الموضوعيّةِ والإقطاعيّةِ –
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة العراقيّ
⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️
“حيثما وُجدت المعرفة، وُجدت السلطة؛ فالتحكم في المعرفة هو التحكم في مصير العقول.”
أصبَحَ (احتكارُ المعرفةِ) من قِبَلِ السلطاتِ المختلفةِ – سواء كانت أكاديميّةً أو دينيّةً أو سياسيّةً أو نخبويّةً أو مؤسّسيّةً – في عالمٍ يزخرُ بالتنوّعِ الفكريِّ وتعدّدِ الرؤى، (مجازفةً خطيرةً) تُهدّدُ جوهرَ التقدّمِ الإنسانيِّ وتُقيّدُ (حرّيّةَ) الفكرِ والإبداعِ. هذا الاحتكارُ، الذي غالباً ما يُسوَّقُ تحتَ ذريعةِ (التخصّصِ) وضمانِ (الدقّةِ) العلميّةِ، لا يتوقّفُ عندَ تنظيمِ تدفّقِ المعرفةِ أو حمايةِ مصداقيّتها، بل يتحوّلُ إلى أداةٍ (للهيمنةِ والسيطرةِ) تُقصي الأصواتَ المختلفةَ وتمنعُ الأفكارَ الجديدةَ من التسرّبِ إلى (فضاءِ النقاشِ العامِّ)، إذ أنهُ وتحتَ قناعِ الموضوعيّةِ، تُرسَّخُ (إقطاعيّةٌ معرفيّةٌ) تُغلقُ الأبوابَ أمامَ كلِّ محاولةٍ للتجدّدِ والتحديثِ، وتُكرِّسُ (الجمودَ والانغلاقَ)، ما يُفضي إلى بيئةٍ خانقةٍ (تقتلُ) روحَ الابتكارِ وتُقيِّدُ مساراتِ التطوّرِ.
في هذا السياقِ، يُقدَّمُ التخصّصُ كحجّةٍ قويّةٍ تبرّرُ هذا (الاحتكارَ)، حيثُ يُفترَضُ أنّ الفهمَ العميقَ لأيِّ موضوعٍ يتطلّبُ سنواتٍ من الدراسةِ الأكاديميّةِ الصارمةِ، ولا يحقُّ لغيرِ المختصّينَ الخوضُ في هذهِ المواضيعِ أو مناقشتُها. إلا أنّ هذا الطرحَ يُخفي وراءَهُ (نزعةً إقصائيّةً) تهدفُ إلى حصرِ المعرفةِ ضمنَ (دائرةٍ ضيّقةٍ) من النخبِ التي تملكُ سلطةَ (تحديدِ) ما هو صحيحٌ وما هو خاطئٌ، (وتُقصي) في الوقتِ ذاتهِ أيَّ مقاربةٍ بديلةٍ أو وجهةِ نظرٍ غير مألوفةٍ. هذهِ الديناميكيّةُ لا تُؤدّي فقط إلى تهميشِ الأفكارِ الجديدةِ، بل تُرسِّخُ أيضاً ثقافةً من (الخضوعِ للسلطةِ المعرفيّةِ النسبيّة)، حيثُ يُنظَرُ إلى أيِّ تشكيكٍ أو نقدٍ على أنّه (تهديدٌ) يُقوِّضُ أسسَ النظامِ القائمِ.
في المجالِ الدينيِّ، يُصبحُ هذا الاحتكارُ أكثرَ وضوحاً وأكثرَ خطورةً، حيثُ يُنصِّبُ بعضُ رجالُ الدينِ أنفسَهم أوصياءَ على النصوصِ المقدّسةِ وحاملي مفاتيحِ الحقيقةِ المطلقةِ. تحتَ مسمّى الدفاعِ عن (العقيدةِ والثوابتِ)، تُمنَعُ أيُّ محاولةٍ لإعادةِ قراءةِ النصوصِ أو تفسيرِها بعيونٍ معاصرةٍ تتلاءمُ مع تحوّلاتِ الزمانِ والمكان، وفق مَنظرِ حَيويّة النص ككائِنٍ (ثابِتٍ) في هيكلِهِ (ومُتحرِكٍ) في معانيهِ. هذا (الجمودُ الفكريُّ) لا يُؤدّي فقط إلى تعطيلِ مساراتِ التجديدِ الدينيِّ، بل يُعزِّزُ أيضاً (التعصّبَ والانغلاقَ)، ويخلقُ بيئةً (يُقصى) فيها كلُّ مَن يجرؤُ على التفكيرِ خارجَ الأطرِ التقليديّةِ. ومن الأمثلةِ البارزةِ على ذلكَ، ما شهدتْهُ أوروبا في العصورِ الوسطى، حينَ احتكرتِ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ تفسيرَ النصوصِ الدينيّةِ ومنعتْ أيَّ محاولةٍ لتحدّي سلطتِها، ما أدّى إلى ما يُعرَفُ (بعصورِ الظلامِ)، حيثُ تراجعتِ العلومُ وتجمّدَ الفكرُ في ظلِّ سيطرةِ الجمودِ الدينيِّ.
وفي المجالِ السياسيِّ، يتجلّى الاحتكارُ المعرفيُّ في صورهِ (الأشدِّ قمعاً)، حيثُ تُسيطِرُ الأنظمةُ الشموليّةُ على وسائلِ الإعلامِ والتعليمِ والمؤسّساتِ الثقافيّةِ، لتفرضَ (روايةً واحدةً) تُقصي الرواياتِ البديلةَ وتُجرِّمُ المعارضةَ الفكريّةَ والسياسيّةَ. هذا النمطُ من الاحتكارِ لا يُؤدّي فقط إلى (تهميشِ) الكفاءاتِ والأصواتِ المعارضةِ، بل يُفضي أيضاً إلى خلقِ مجتمعاتٍ (أحاديّةِ الفكرِ) تُفتقَدُ فيها روحُ النقدِ والمساءلةِ، وتُسيطِرُ عليها ثقافةُ (التبعيّةِ والخضوعِ ) للسلطةِ، فالاتحادُ السوفييتيُّ، على سبيلِ المثالِ، كان نموذجاً صارخاً لهذا النوعِ من (الاحتكارِ)، حيثُ احتكرَ الحزبُ الشيوعيُّ التفسيرَ الوحيدَ للفكرِ الماركسيِّ، وأقصى كلَّ محاولةٍ لتقديمِ مقارباتٍ جديدةٍ أو نقديّةٍ للفكرِ الاشتراكيِّ، ما أدّى في نهايةِ المطافِ إلى (انهيارِ النظامِ) تحتَ وطأةِ (الجمودِ) الفكريِّ (والعجزِ) عن مواكبةِ تحوّلاتِ العصرِ.
إنّ (أخطرَ) ما في احتكارِ المعرفةِ هو أنّهُ لا يُؤدّي فقط إلى تهميشِ الأفكارِ الجديدةِ، بل يُفضي أيضاً إلى خلقِ بيئةٍ من (الجزميةِ والانغلاقِ ) تُمنَعُ فيها حرّيّةُ التعبيرِ ويُقصى فيها كلُّ مَن يجرؤُ على الاختلافِ. هذهِ البيئةُ تُنتِجُ أفراداً غيرَ قادرينَ على (التفكيرِ النقديِّ) أو (الابتكارِ)، وتُحوِّلُ المجتمعاتِ إلى (كياناتٍ راكدةٍ) تعيشُ في ظلِّ أفكارٍ موروثةٍ لا تقبلُ التغييرَ أو التطويرَ. ومع مرورِ الوقتِ، تتحوّلُ هذهِ المجتمعاتُ إلى (كياناتٍ هشّةٍ) غيرِ قادرةٍ على مواجهةِ التحدّياتِ المعاصرةِ، فتفقدُ قدرتَها على المنافسةِ في مجالاتِ العلومِ والتكنولوجيا والثقافةِ، وتُصبِحُ عُرضةً (للتخلّفِ والانهيارِ).
يُعلّمُنا (التاريخُ) أنّ المجتمعاتِ التي ازدهرتْ وتقدّمتْ كانت تلكَ التي احتضنتِ (التنوّعَ الفكريَّ) وشجّعتْ على (حرّيّةِ التعبيرِ والنقاشِ البنّاء)، فالحضارةُ الإسلاميّةُ في عصورِها (الذهبيّةِ) لم تصلْ إلى قمّةِ إبداعِها إلّا حينَ انفتحتْ على التراثِ اليونانيِّ والهنديِّ والفارسيِّ، وسمحتْ بتلاقحِ الأفكارِ من مختلفِ الثقافاتِ، ما أدّى إلى ازدهارِ العلومِ والفنونِ والفلسفةِ. أمّا حينَ سادَ (الجمودُ والانغلاقُ)، فقد بدأتِ الحضارةُ في التراجعِ وفقدانِ مكانتِها بينَ الأممِ. وفي العصرِ الحديثِ، يُمكنُ رؤيةُ أمثلةٍ مشابهةٍ في الدولِ التي احتكرتِ السلطةُ فيها المعرفةَ ومنعتْ حرّيّةَ التعبيرِ، حيثُ عانتْ هذهِ الدولُ من التخلّفِ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ، وفشلتْ في مواكبةِ التطوّراتِ العالميّةِ.
لذلكَ، يُعتَبَرُ (تحريرُ المعرفةِ) من احتكارِ السلطاتِ المختلفةِ ليس فقط ضرورةً أخلاقيّةً وإنسانيّةً، بل هو شرطٌ أساسيٌّ لتحقيقِ (التقدّمِ الحضاريِّ والازدهارِ الإنسانيِّ)، فالمعرفةُ ليست ملكاً للنخبِ الأكاديميّةِ أو الدينيّةِ أو السياسيّةِ، بل هي (إرثٌ مشتركٌ) للبشريّةِ جمعاء، ويجبُ أن تبقى مفتوحةً أمامَ الجميعِ، تُغذّيها النقاشاتُ الحرّةُ والمقارباتُ المتنوّعةُ.
اننا حينَ نُطلِقُ (سراحَ الفكرِ) من قيودِ الاحتكارِ، نُعيدُ للعالمِ حيويّتَهُ ونفتحُ الأبوابَ أمامَ عصورٍ جديدةٍ من الابتكارِ والتجدّدِ، ونُمهّدُ الطريقَ لمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً وإنسانيّةً، خصوصاً وان عالَم اليوم هو عَصرُ الإنفتاح المعرفي والإتاحة الرقميّة والإقلاع الذَّكي، والذي سيلفِظُ كُل من لم يستطع التكيّف والاستدامة ضمن القواعد الجديدة التي يرسمها التطوّر الفاني !.
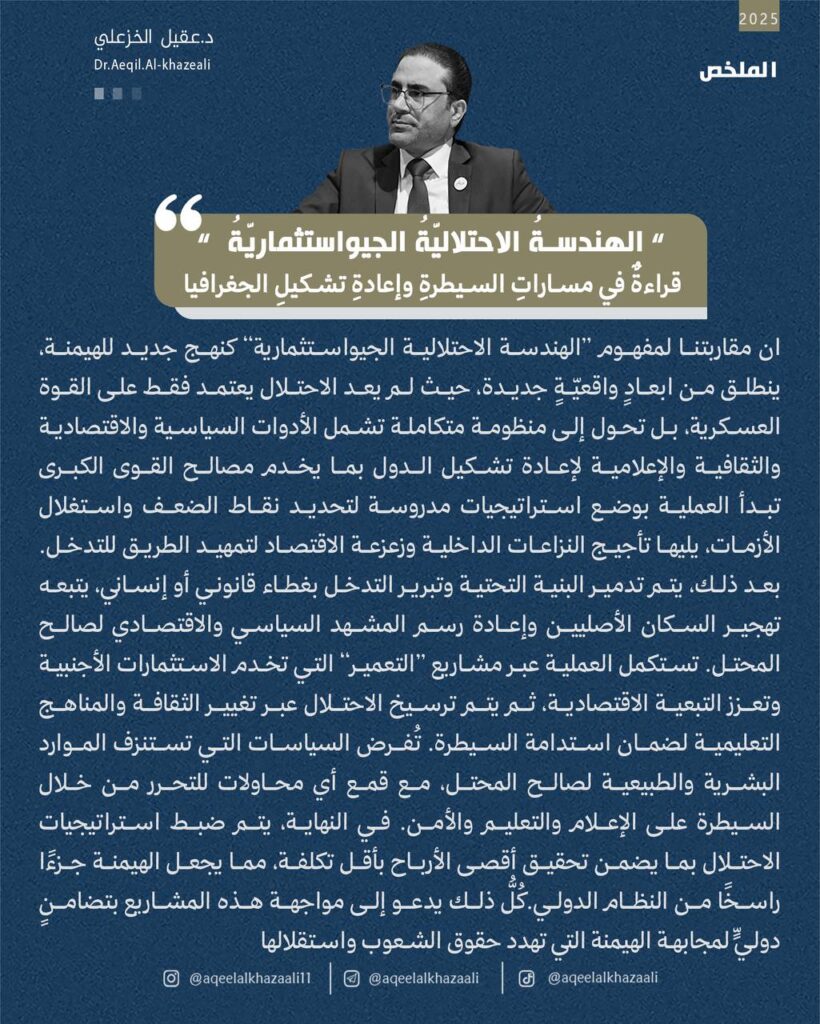
“الهندسةُ الاحتلاليّةُ الجيواستثماريّةُ”
-قراءةٌ في مساراتِ السيطرةِ وإعادةِ تشكيلِ الجغرافيا-
د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة
📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐📐
على إيقاعِ (سُنّةِ التَّغييرِ) المُستمِرِ، يَمضي الوقتُ؛ ومَعَهُ تتشكَّلُ معالمُ عالَمٍ مُتَغيّرٍ وفقاً لمصالحِ (القوى الكبرى) واستراتيجياتِها الخفيَّةِ، إذ لم يَعُدِ (الاحتلالُ) مجرَّدَ عمليةٍ عسكريةٍ تُمارَسُ بالوسائلِ التقليديَّةِ، بل تحوَّلَ إلى منظومةٍ أكثرَ تعقيدًا وشموليةً، يُكنُنا تَعريفُها بـ (الهندسةِ الاحتلاليَّةِ الجيواستثماريَّةِ)، حيثُ تتداخلُ الأدواتُ السياسيَّةُ والعسكريَّةُ والاقتصاديَّةُ والثقافيَّةُ في (شبكةٍ محكمةٍ) لإعادةِ تشكيلِ الجغرافيا والاقتصادِ بما يخدمُ مصالحَ القوى الكُبرى، فتتحوَّلُ (نَزْعَةُ السيطرة) من احتلالٍ مباشرٍ إلى مشروعٍ طويلِ الأمدِ يُعيدُ (هندسةَ) المشهدِ السياسيِّ والاجتماعيِّ والاقتصاديِّ للدولِ المُستهدفةِ.
تبدأُ هذهِ الهندسةُ بمراحلَ دقيقةٍ ومتسلسلةٍ تضمنُ استمرارَ (الهيمنةِ وتكريسَ الاحتلالِ ) بأقلِّ تكلفةٍ وأعلى فاعليَّةٍ، حيثُ تمرُّ العمليةُ بأطوارٍ متعاقبةٍ، تبدأُ (بالتفكيرِ) وتنتهي بالتسعيرِ، في حلقةٍ مغلقةٍ تجعلُ من الهيمنةِ واقعًا دائمًا يصعبُ الفكاكُ منهُ، إلا لِمَن أتقنَ لُعبةِ المناورة البراغماتية.
تبدأُ (المرحلةُ الأولى بــ “التفكيرِ”)، إذ تُصاغُ الرؤيةُ الاستراتيجيَّةُ بعنايةٍ فائقةٍ، حيثُ تُحلَّلُ البيئاتُ الجغرافيَّةُ والسياسيَّةُ والاقتصاديَّةُ لتحديدِ نقاطِ الضعفِ والفرصِ المتاحةِ (للتوغُّلِ والهيمنةِ)، وتُعدُّ مراكزُ الأبحاثِ وصنَّاعُ القرارِ الخططَ اللازمةَ لتوظيفِ الأدواتِ المختلفةِ، سواءً عبرَ (التدخُّلِ ) المباشرِ أو (النفوذِ) غيرِ المباشرِ باستخدامِ الاقتصادِ والثقافةِ كوسائلَ للسيطرةِ. وبعدَ هذهِ المرحلةِ الفكريةِ، تبدأُ (مرحلةُ التحضيرِ)، حيثُ تُجهَّزُ الأدواتُ اللازمةُ للتنفيذِ، سواءً من خلالِ (تأجيجِ ) النزاعاتِ الداخليَّةِ، أو (خلقِ ) بيئةٍ اقتصاديَّةٍ هشَّةٍ تُسَهِّلُ التدخُّلَ لاحقًا، أو عبرَ (تعزيزِ ) الانقساماتِ الاجتماعيَّةِ والسياسيَّةِ داخلَ الدولةِ المستهدفةِ، ويتمُّ ذلك باستخدامِ (الإعلامِ، والمنظَّماتِ الدوليَّةِ، والشركاتِ متعددةِ الجنسياتِ) لتشكيلِ واقعٍ يسمحُ بفرضِ النفوذِ تدريجيًّا.
تتقدَّمُ العمليةُ بعدَ التحضيرِ إلى (مرحلةِ التفجيرِ)، حيثُ تُفتعلُ الأزماتُ أو تُستَغلُّ النزاعاتُ القائمةُ لتبريرِ التدخُّلِ، إذ يتمُّ (خلقُ( صراعاتٍ داخليَّةٍ أو (دعمُ) حركاتٍ انفصاليَّةٍ لتفتيتِ الدولةِ المستهدفةِ من الداخلِ، وقد يتخذُ هذا التفجيرُ طابعًا (عسكريًّا) كما في الحروبِ والانقلاباتِ، أو طابعًا (معنويًّا/مَرِناً) كما في الحروبِ الإعلاميَّةِ وحملاتِ التضليلِ. ويُفضي هذا التفجيرُ إلى (مرحلةِ التدميرِ)، حيثُ تُدمَّرُ البنى التحتيَّةُ والمؤسَّساتُ الحكوميَّةُ لتُضعفَ الدولةُ المستهدفةُ وتصبحَ غيرَ قادرةٍ على إدارةِ شؤونِها، فتُمهَّدُ الطريقُ لتدخُّلِ القوى الكبرى بحجَّةِ إعادةِ الاستقرارِ
بعدَ إحداثِ هذا الدمارِ، تبدأُ (مرحلةُ التبريرِ)، حيثُ تُشرعنُ القوى الكبرى لاستحواذها على الأرض والمُقَدّرات؛ عبرَ استخدامِ غطاءٍ قانونيٍّ أو إنسانيٍّ، فتُقدَّمُ تسويغاً يُشرعنُ فقط للحرب، بل لشرعنةِ العمليَّاتِ التحذيريّة للواقع الاحتلالي الجديد ، على أنَّها جهودٌ (لحمايةِ) حقوقِ الإنسانِ أو لمكافحةِ الإرهابِ أو (لإعادةِ) بناءِ الدولةِ، وتُستغلُّ بعضُ المنظَّماتِ الدوليَّةِ (لتضفي الشرعيَّةَ) على هذهِ التدخُّلاتِ، بينما (يُضلَّلُ الرأيُ العامُّ العالميُّ) لتقبُّلِ هذه السياساتِ وكأنَّها (ضروريَّةٌ ومشروعةٌ). يتبعُ التبريرَ مباشرةً (مرحلةُ التهجيرِ)، حيثُ يُعادُ تشكيلُ الخريطةِ الديموغرافيَّةِ من خلالِ تهجيرِ السكانِ الأصليِّينَ، كما حدث ويحدثُ في فلسطينَ، أو في مناطقَ أخرى تشهدُ صراعاتٍ إثنيَّةً وطائفيَّةً، إذ يتمُّ (تفريغُ الأرضِ) من أهلِها لصالحِ قوى جديدةٍ تخدمُ مصالحَ القوى المحتلَّةِ.
معَ تفريغِ الأرضِ من معارضي الاحتلالِ، تبدأُ (مرحلةُ التغييرِ)، حيثُ يُعادُ رسمُ الخريطةِ السياسيَّةِ للدولةِ المُحتلَّةِ وفقًا لمصالحِ القوى المسيطرةِ، فيُعادُ صياغةُ كُلِّ الأُطر والأصعدة لتتماشى مع أهدافِ الاحتلالِ، وتُعيَّنُ نُخبٌ سياسيَّةٌ واقتصاديَّةٌ مواليةٌ لضمانِ (استدامةِ السيطرةِ)، وبعدَ ذلك، تُطلقُ (مرحلةُ التعميرِ)، حيثُ يُعادُ بناءُ البنيةِ التحتيَّةِ والمؤسَّساتِ ولكن بما يخدمُ أجنداتِ القوى الكبرى، فتُفتحُ الأسواقُ للشركاتِ متعددةِ الجنسياتِ وتُمنحُ الامتيازاتُ للمستثمرينَ الأجانبِ، فيتحوَّلُ التعميرُ إلى أداةٍ لتعزيزِ الهيمنةِ وليس لإعادةِ الإعمارِ الحقيقيِّ.
تلي هذه المرحلةُ عمليةُ (التثميرِ)، حيثُ تُستثمرُ المواردُ الطبيعيَّةُ والبشريَّةُ بأقصى طاقةٍ لتعظيمِ الأرباحِ لصالحِ القوى المحتلَّةِ، فتتحوَّلُ الدولُ المُحتلَّةُ إلى (مصادرَ دائمةٍ) للثرواتِ والموادِّ الخامِّ والعوائد الجيوسياسية والحيواستثمارية، وتُفرضُ سياساتٌ اقتصاديَّةٌ تُكرِّسُ التبعيَّةَ الاقتصاديَّةَ وتجعلُ من الهيمنةِ أمرًا مستدامًا. ومعَ مرورِ الوقتِ، تصلُ العمليةُ إلى (مرحلةِ التجذيرِ)، حيثُ يُكرَّسُ الاحتلالُ كواقعٍ دائمٍ من خلالِ الاستيطانِ وتغييرِ المناهجِ التعليميَّةِ والثقافةِ والهويَّةِ الوطنيَّةِ للسكانِ، ليُصبحَ الاحتلالُ جزءًا لا يتجزأُ من الواقعِ السياسيِّ والاجتماعيِّ للدولةِ.
بعدَ التجذيرِ، تبدأُ القوى الكبرى (بمرحلةِ التسخيرِ)، حيثُ يتمُّ استغلالُ السكانِ والمواردِ لخدمةِ الاقتصادِ الاستعماريِّ، ويُوظَّفُ السكانُ الأصليُّونَ كأداةٍ إنتاجيَّةٍ لخدمةِ النظامِ الجيواستثماريِّ الجديدِ، سواءً عبرَ العملِ في شركاتِ القوى المحتلَّةِ أو عبرَ فرضِ سياساتٍ اقتصاديَّةٍ تُكبّلُ أيَّ محاولةٍ للتحرُّرِ. ولضمانِ استمراريَّةِ هذا النظامِ، تُنفَّذُ (مرحلةُ التسكيرِ)، حيثُ تُغلَقُ جميعُ المنافذِ أمامَ المقاومةِ أو التغييرِ، من خلالِ القمعِ العسكريِّ، والسيطرةِ على الإعلامِ، والتعليمِ، والثقافةِ، مما يُخنقُ أيَّ محاولةٍ للتحرُّرِ أو الاستقلالِ.
وفي المرحلةِ الأخيرةِ، تأتي (عمليَّةُ التسعيرِ)، حيثُ تُحدَّدُ تكلفةُ الاحتلالِ والهيمنةِ وتُقَيَّمُ الفوائدُ الاقتصاديَّةُ والسياسيَّةُ الناتجةُ عنهُ، ويُعادُ ضبطُ إيقاعِ السيطرةِ بحيثُ تضمنُ القوى الكبرى تحقيقَ أقصى قدرٍ من الأرباحِ بأقلِّ تكلفةٍ ممكنةٍ وفقَ نظامٍ محكمٍ يُكرِّسُ الهيمنةَ كجزءٍ من بنيةِ النظامِ الدوليِّ. وهكذا تتحوَّلُ (الهندسةُ الاحتلاليَّةُ الجيواستثماريَّةُ) إلى منظومةٍ شاملةٍ تُعيدُ تشكيلَ العالمِ وفقًا لمصالحِ (القوى الكبرى)، حيثُ تتداخلُ أدواتُ (العسكرةِ والاستثمارِ) لإعادةِ تشكيلِ الجغرافيا والسياسةِ والاقتصادِ بطريقةٍ تضمنُ استمرارَ السيطرةِ وتُضعفُ إمكانيَّاتِ التحرُّرِ والاستقلالِ، لتبقى الشعوبُ والدولُ عالقةً في دائرةِ الهيمنةِ دونَ القدرةِ على كسرِ هذا الحصارِ المعقَّدِ، وَهوَ ما يَنبَغي إستيلادِ تَضامنٍ دولِيٍّ للوقوفِ بِوَجْهِ هَكَذا مَشروعاتٍ ناسِفةٍ لمنظومات الحقوق والحُريّاتِ والأمن والسلم الدوليين !.
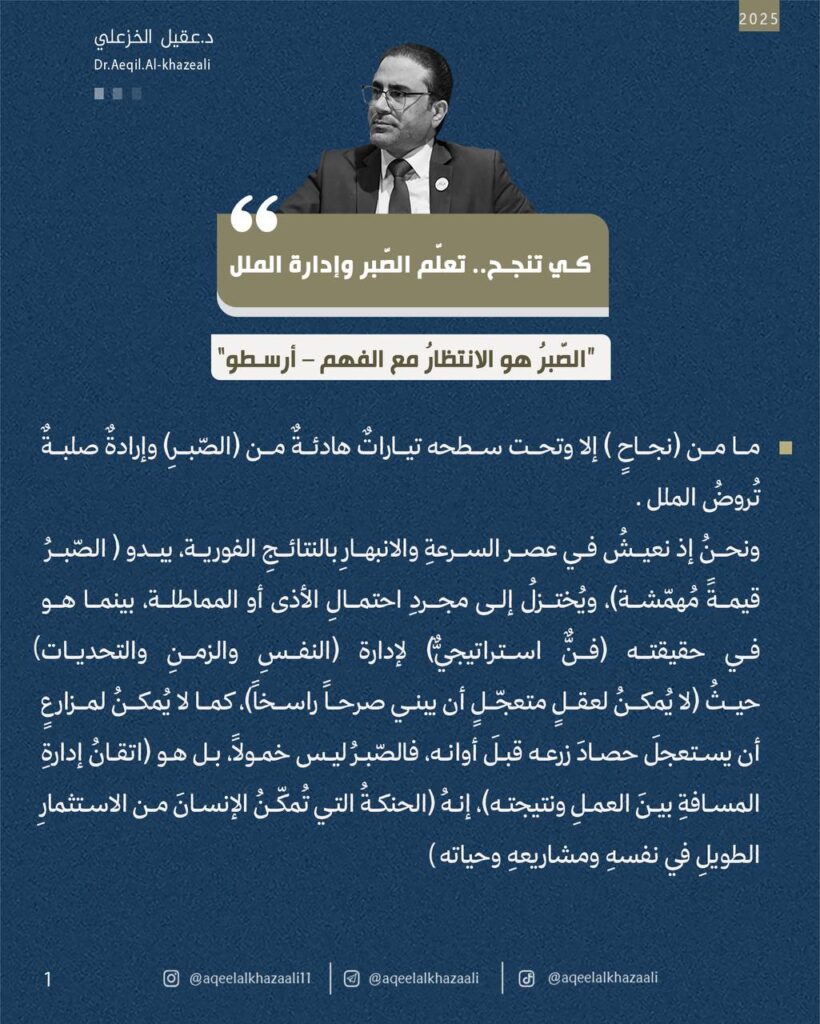
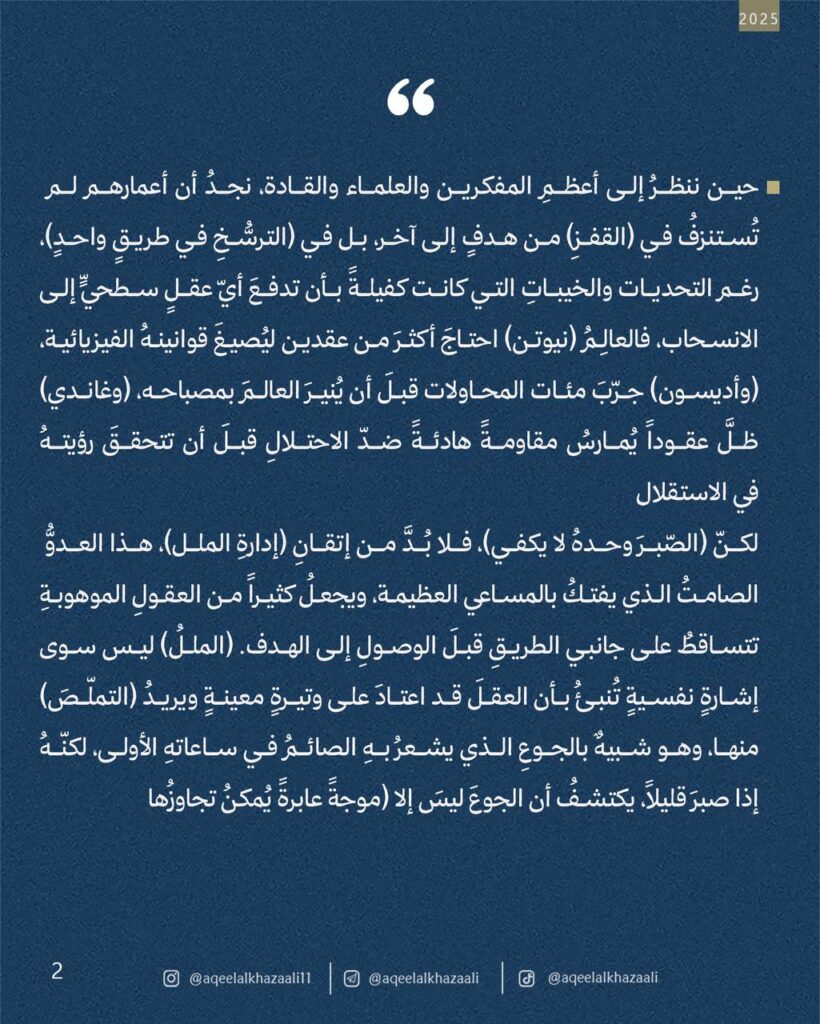
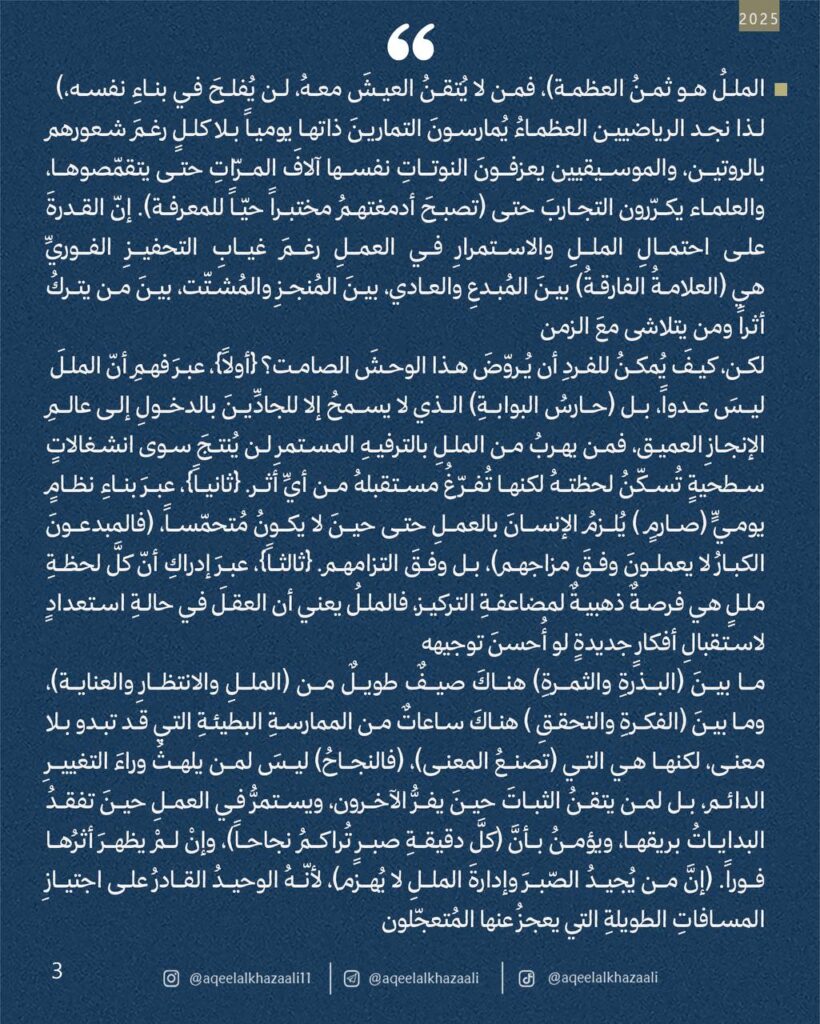
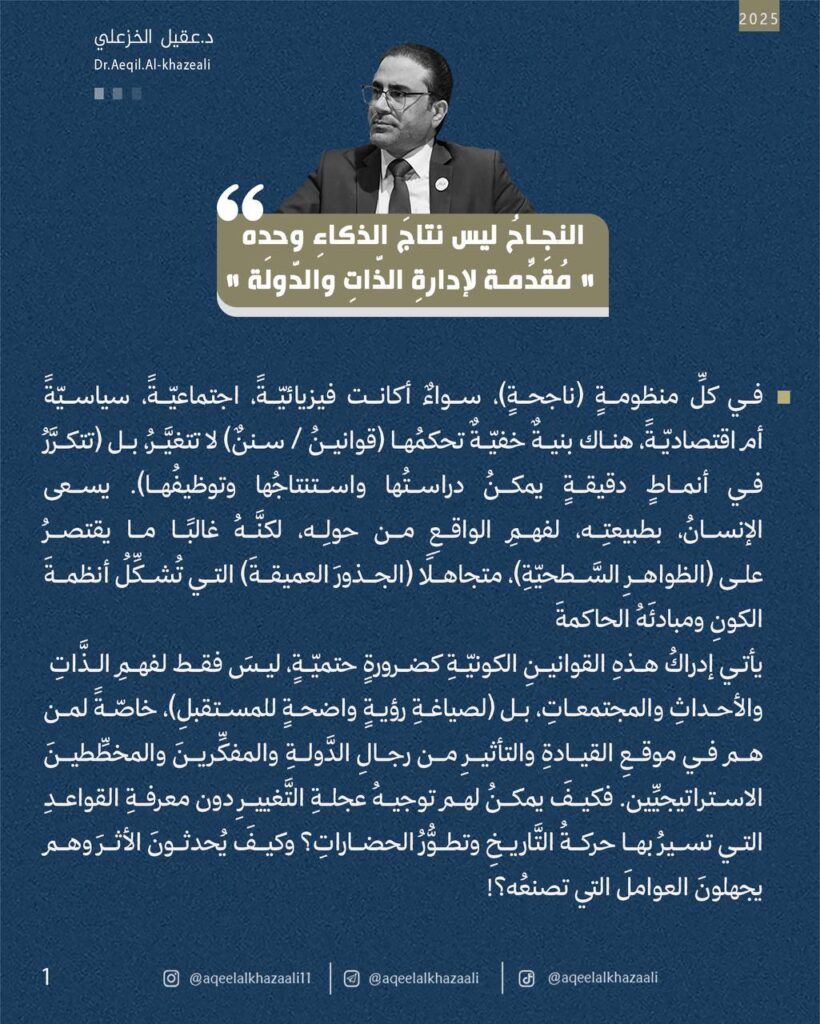
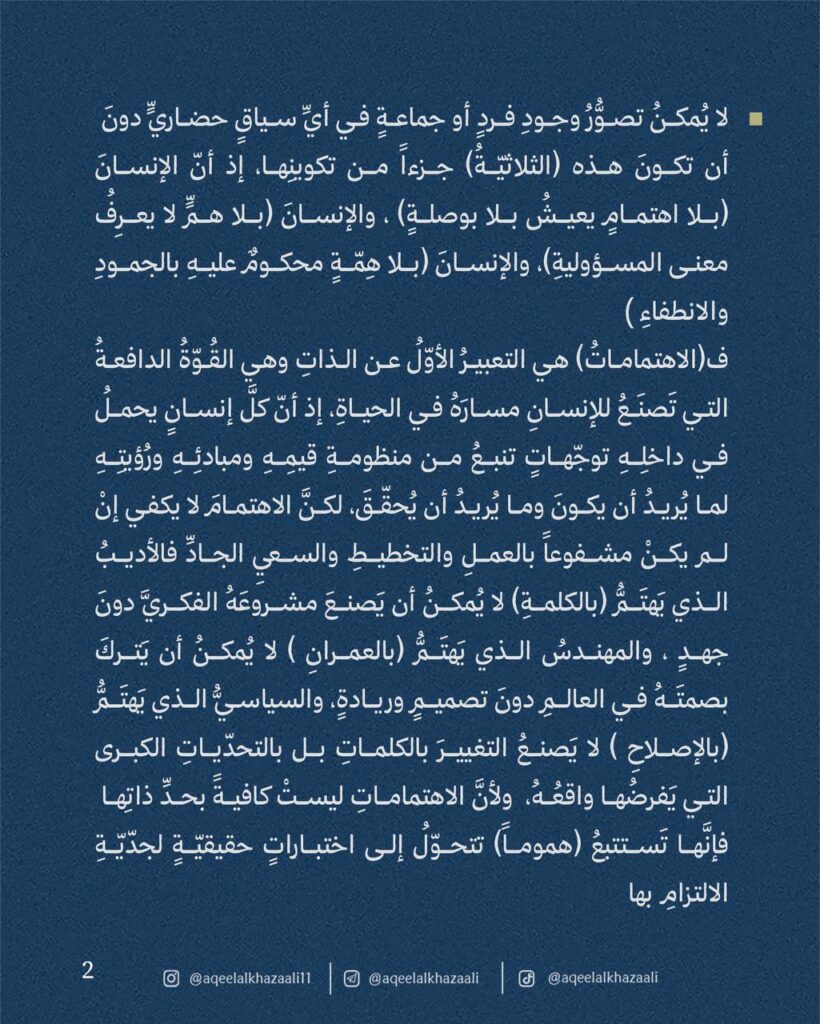
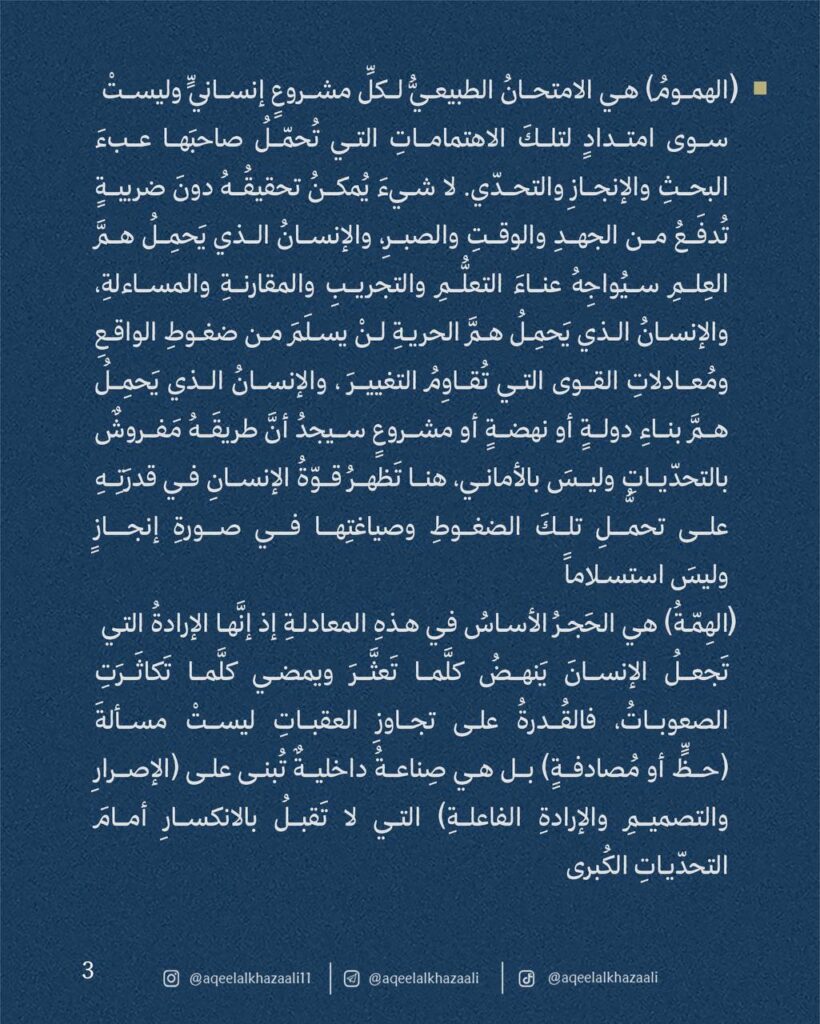
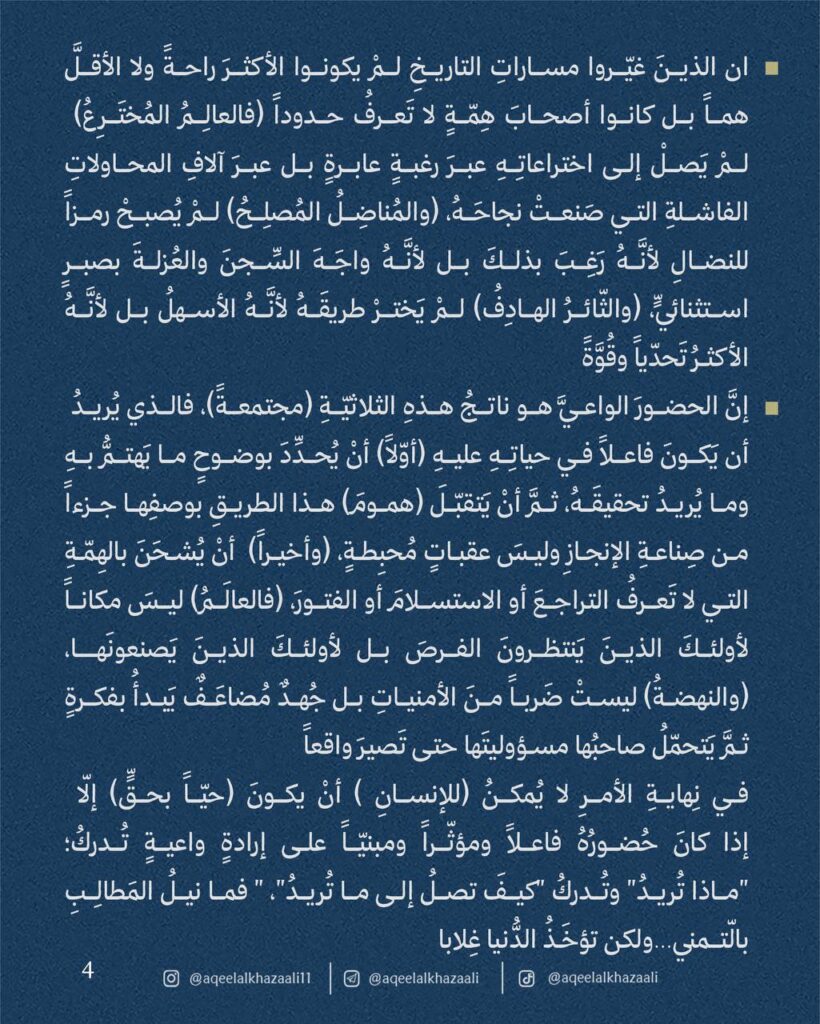
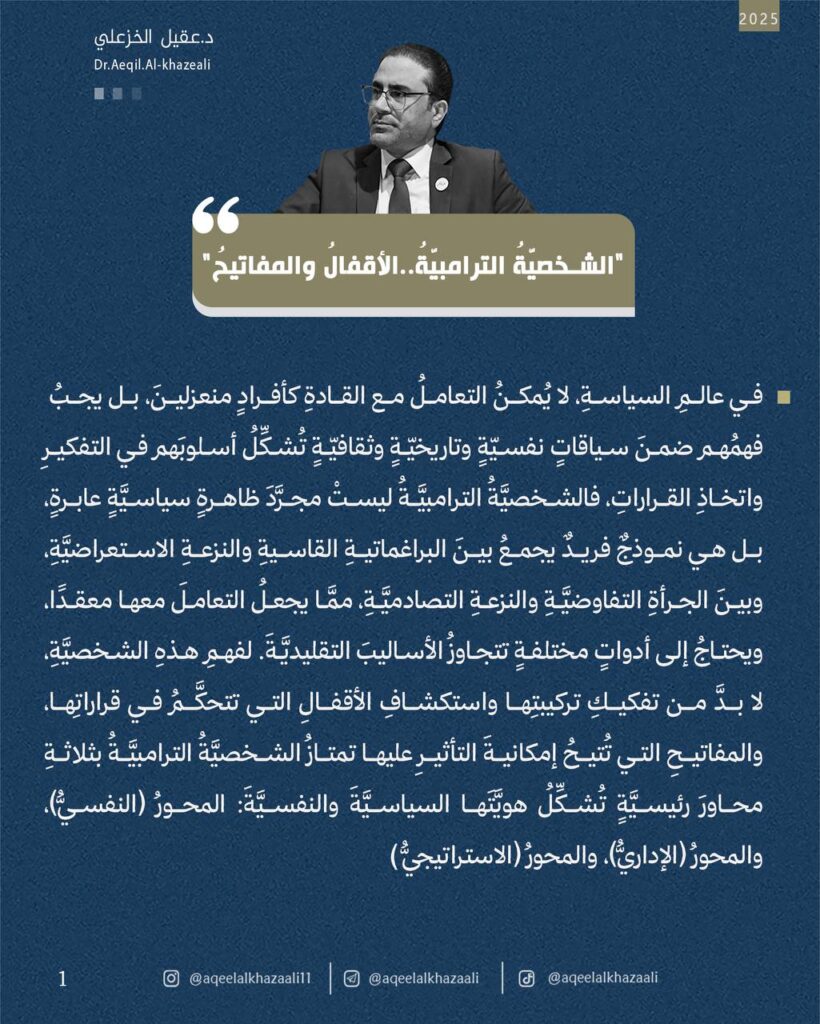
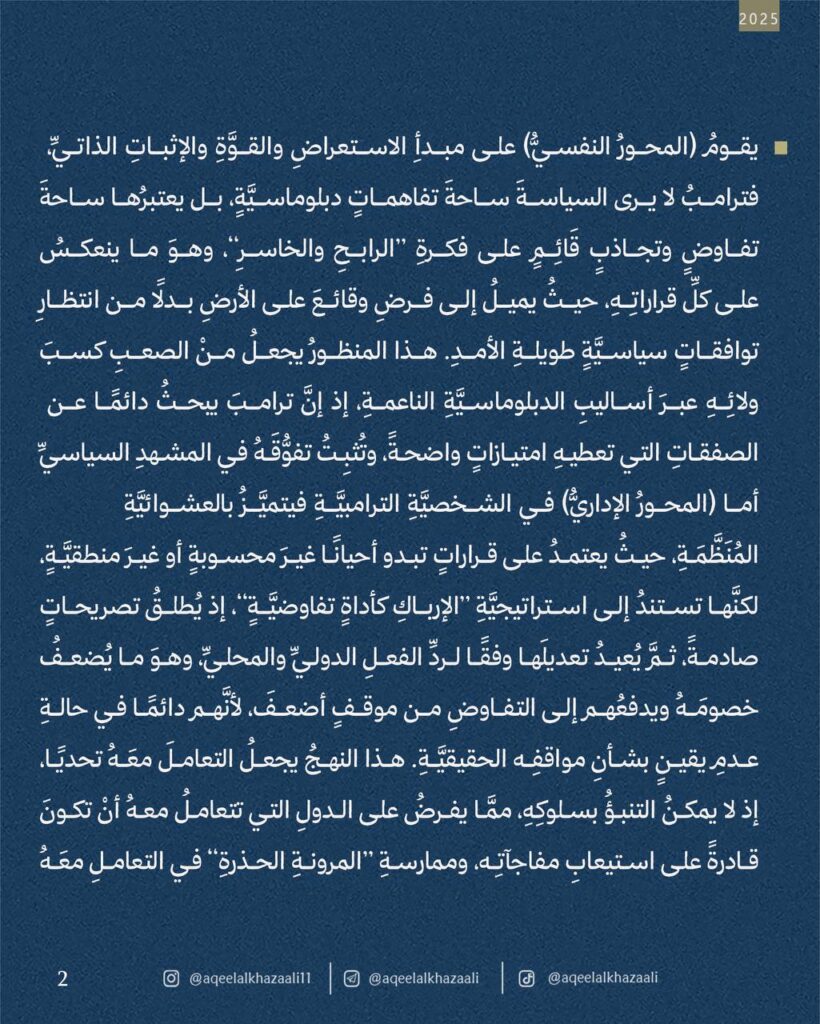
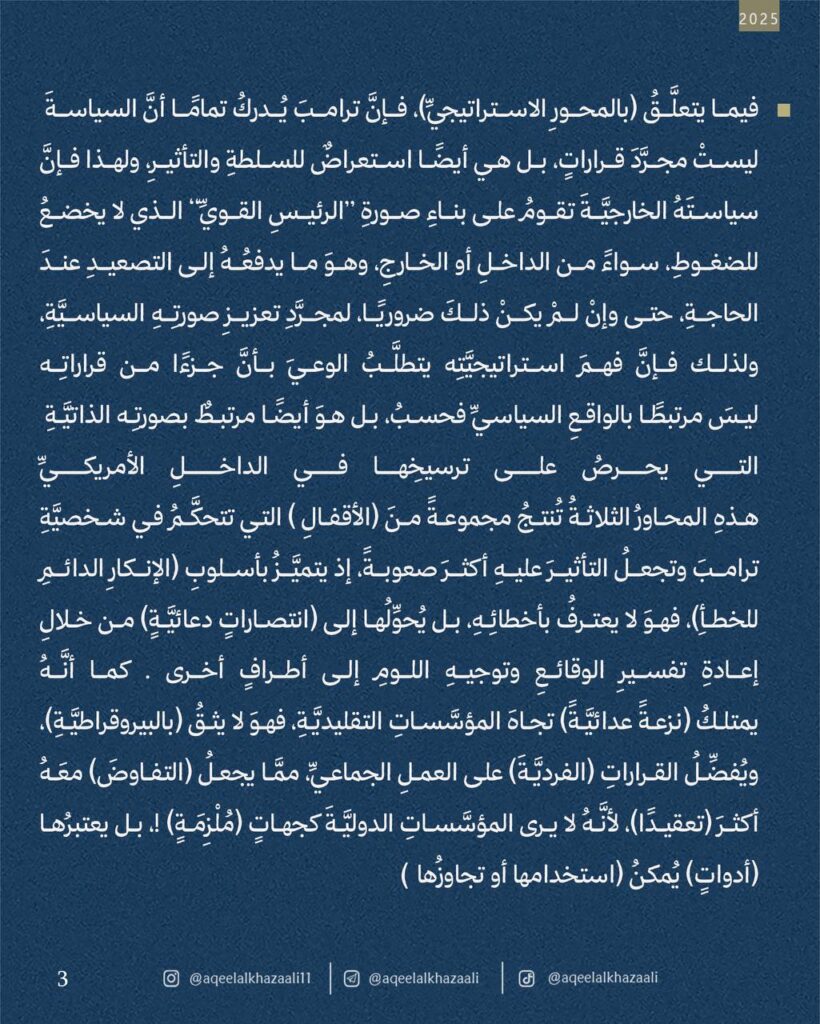
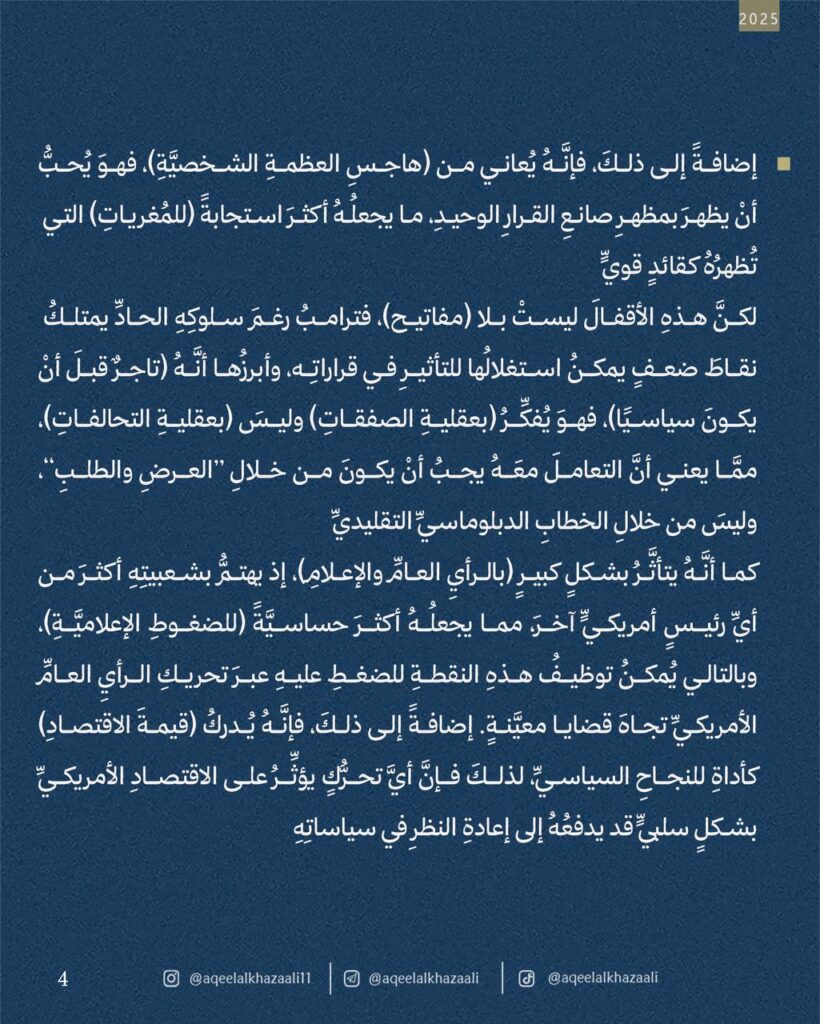
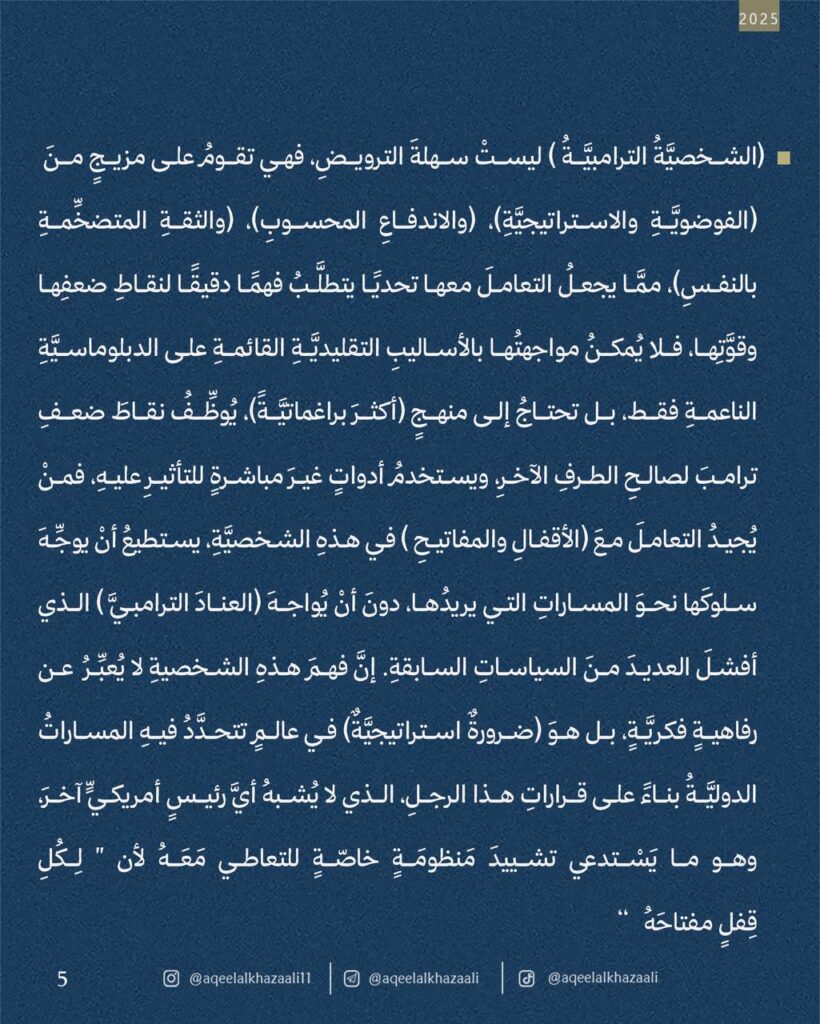
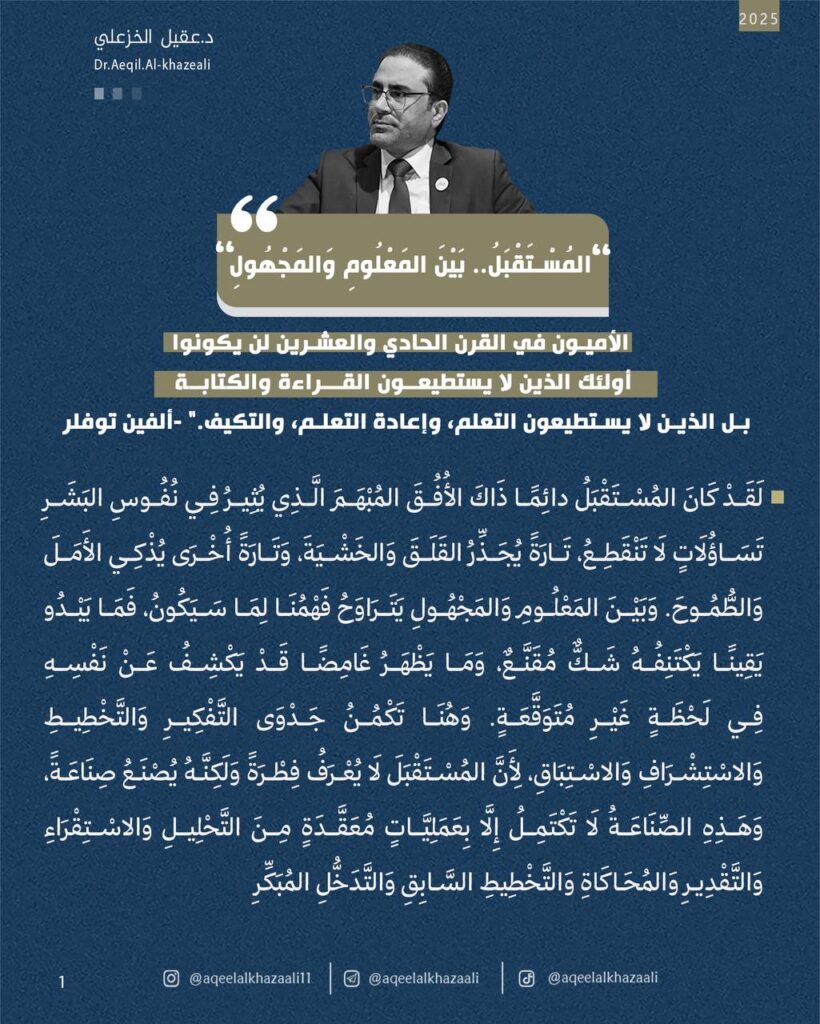
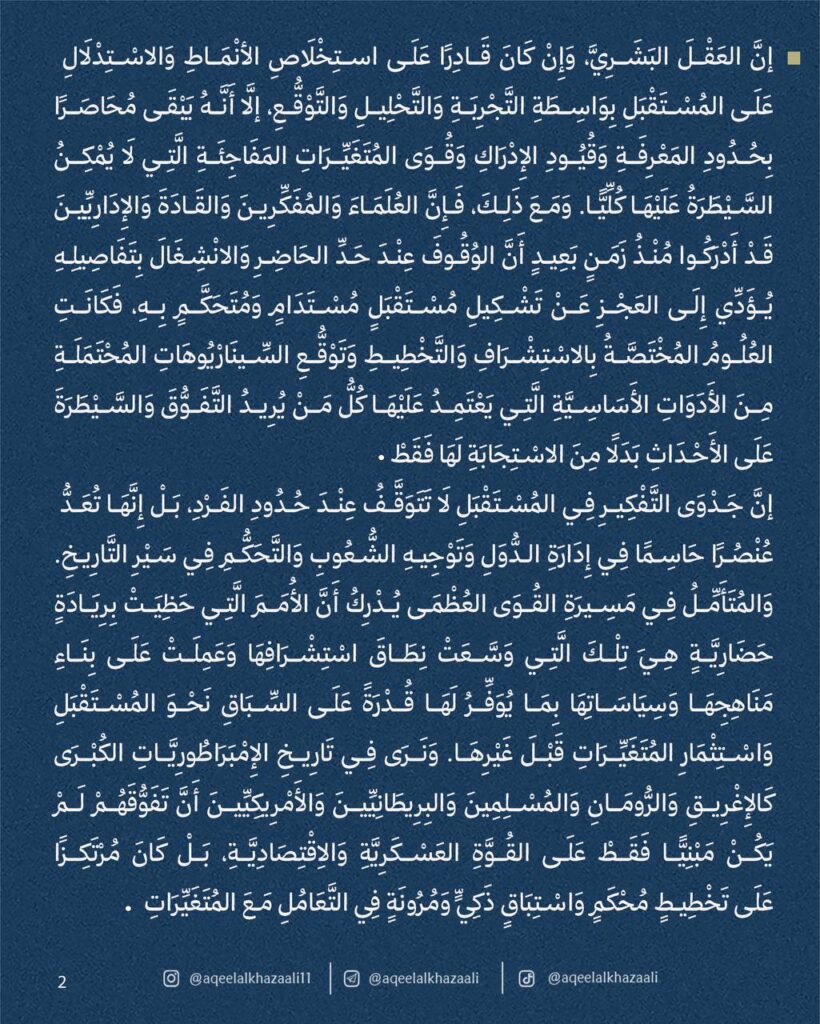
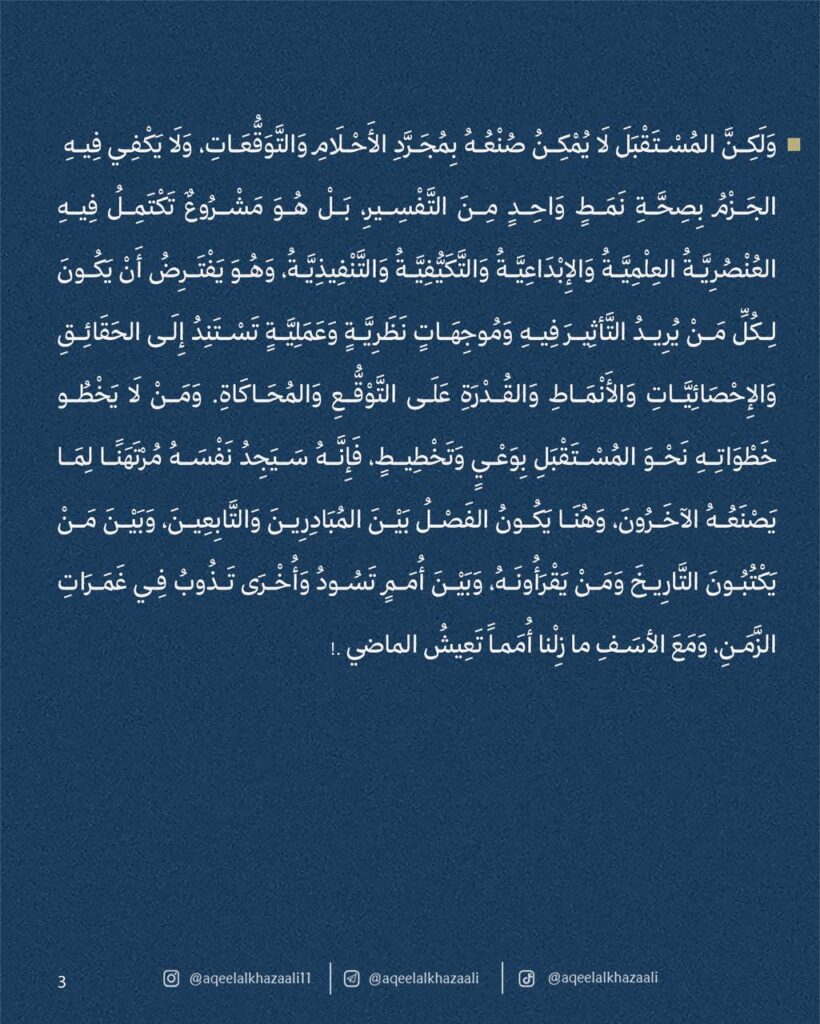
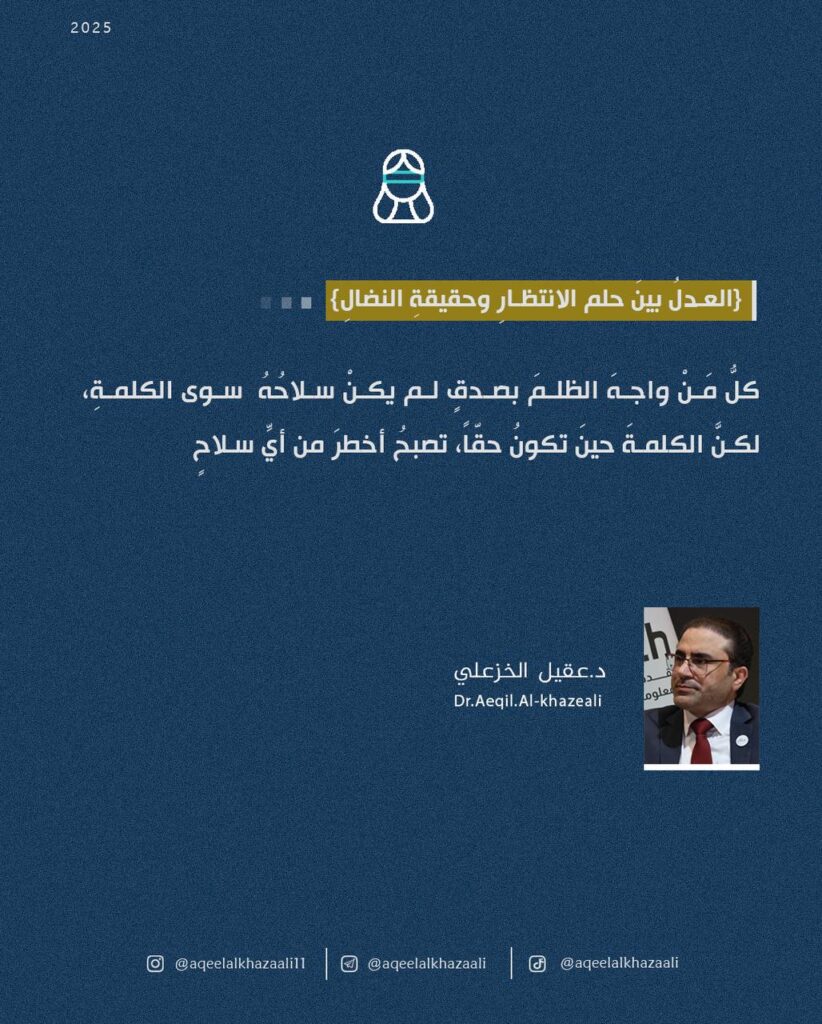
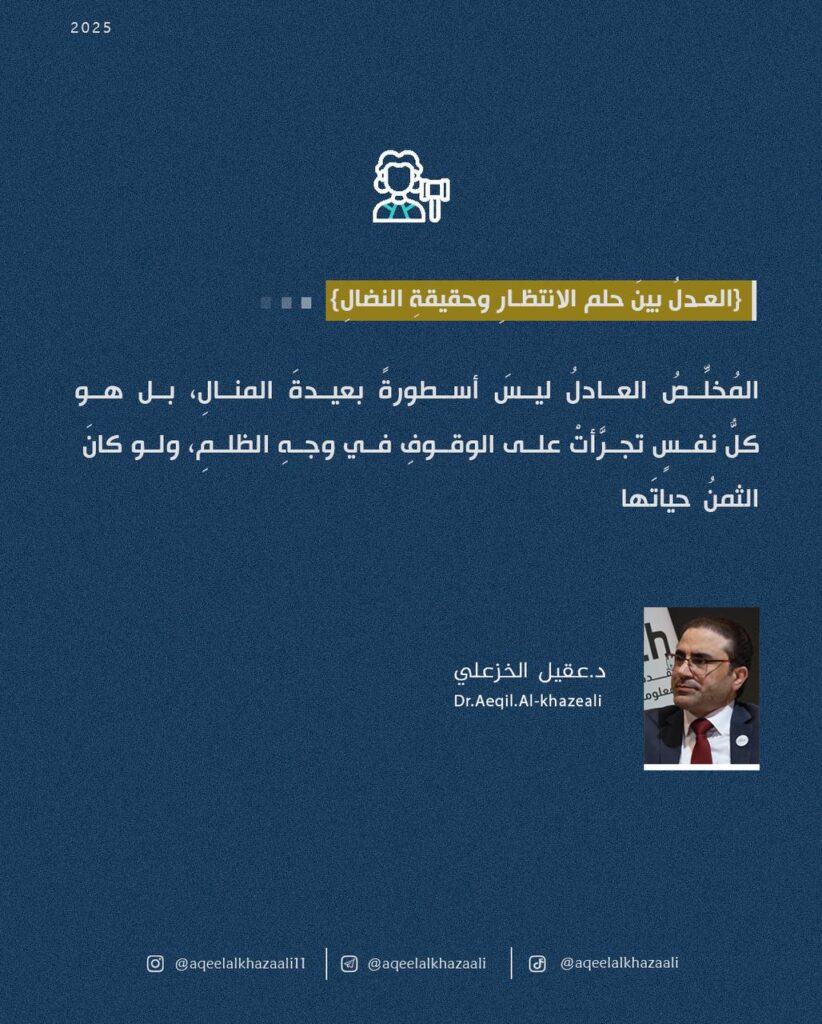
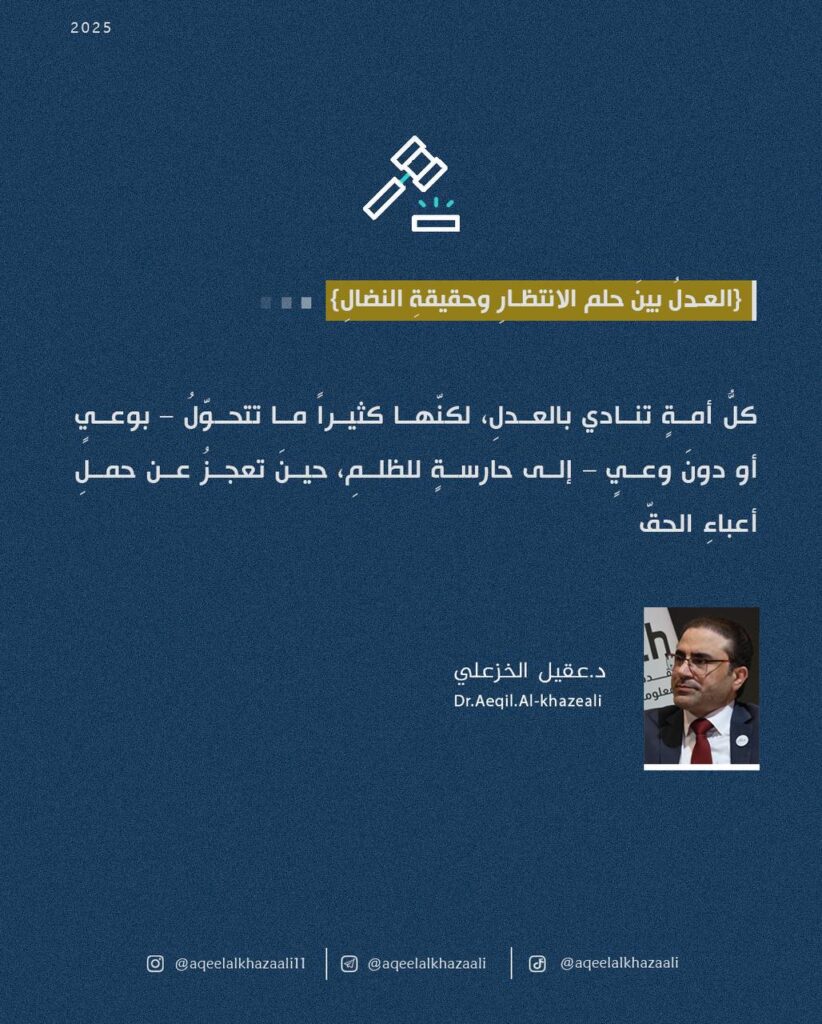
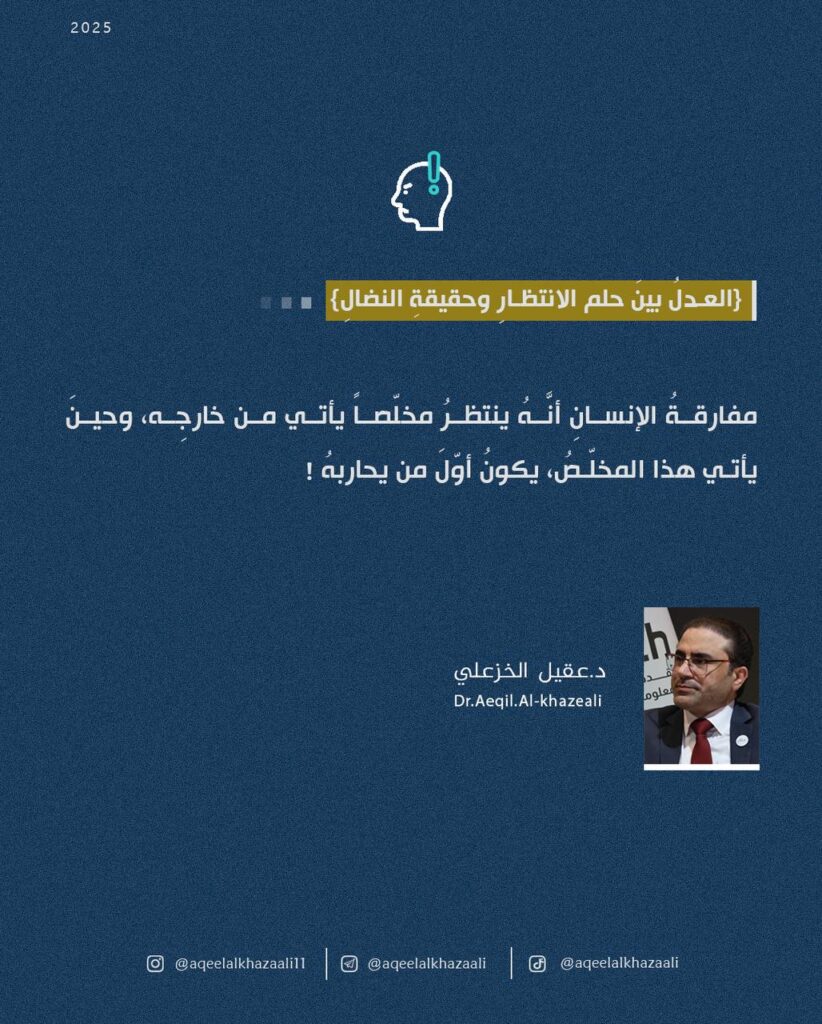
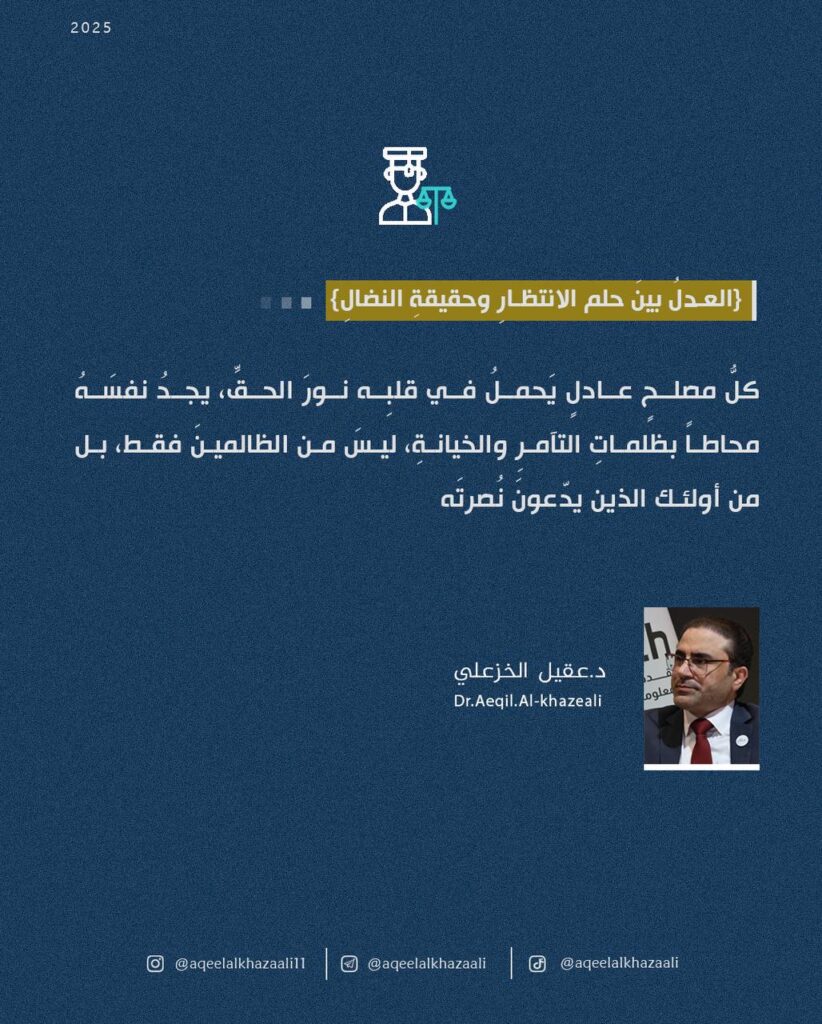
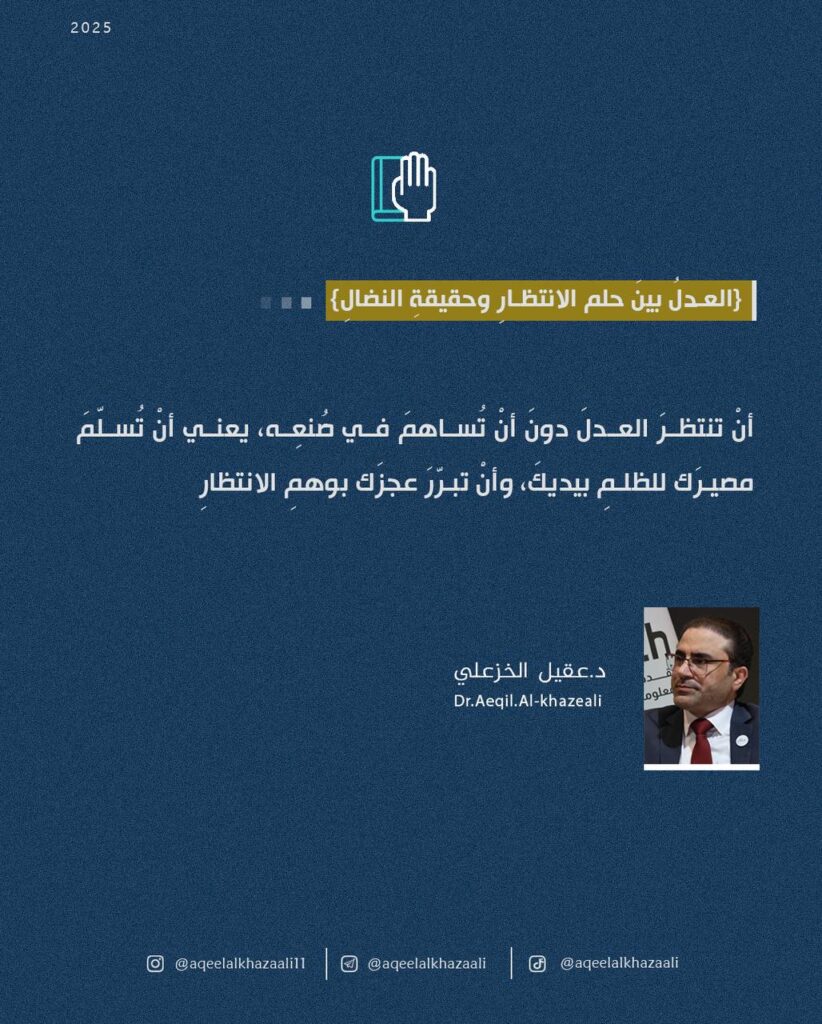
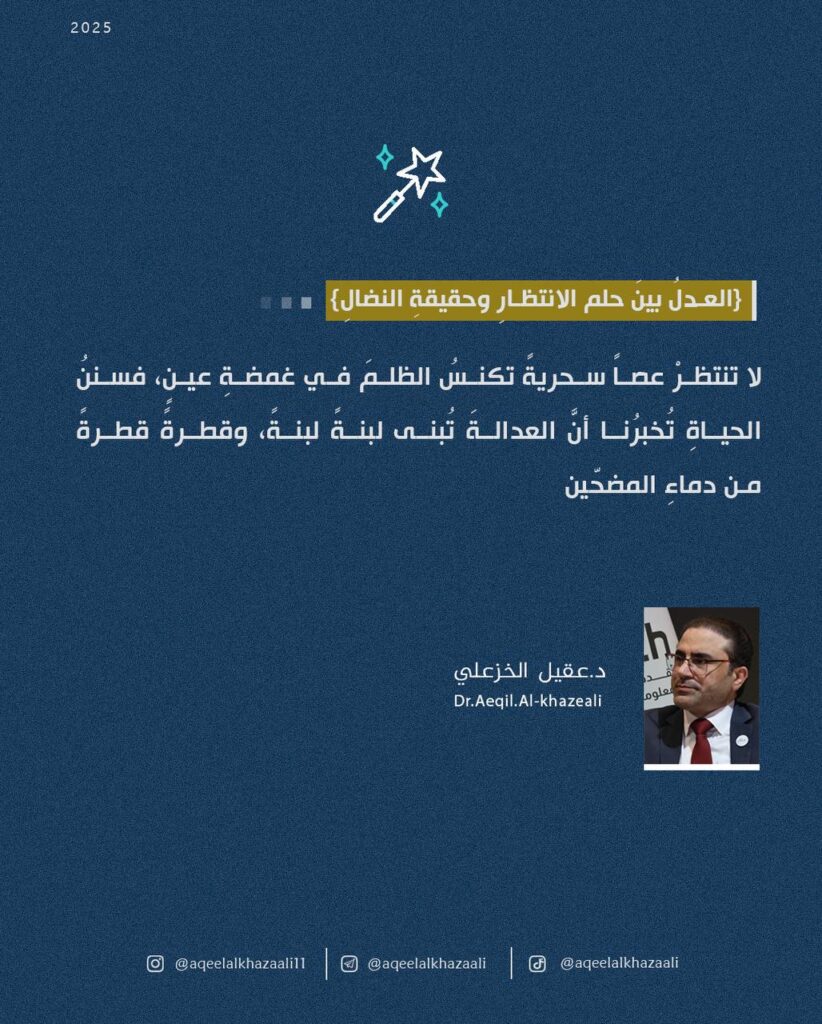
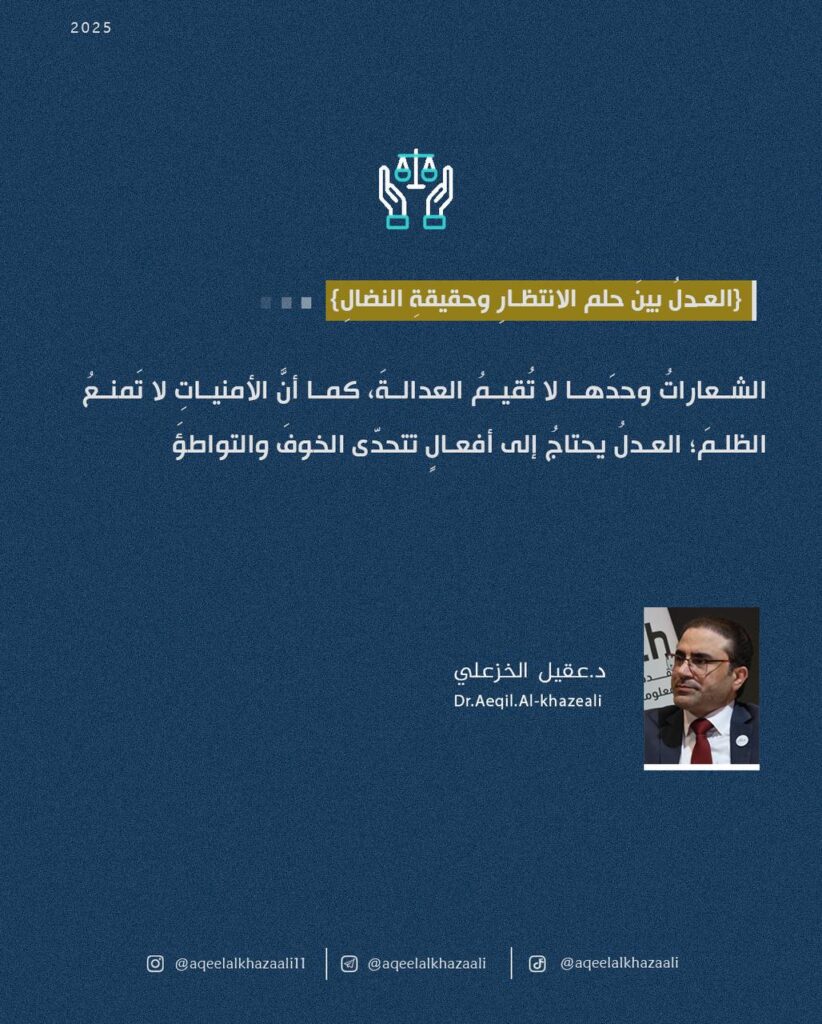
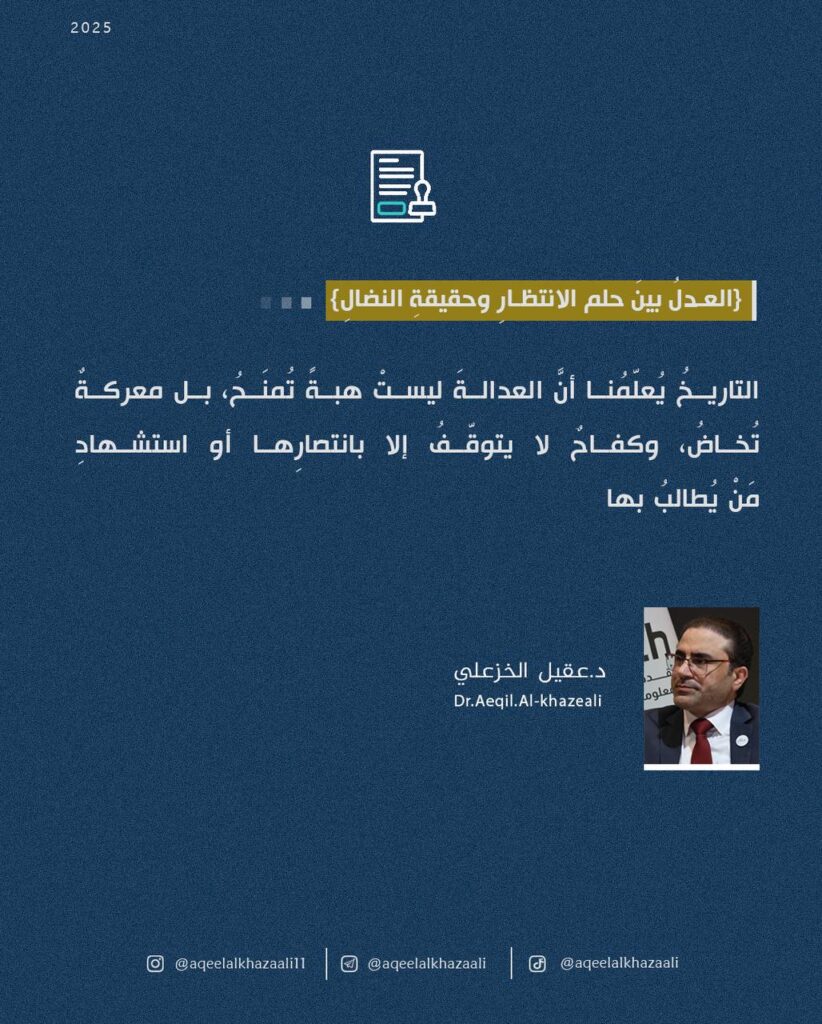
🌕🌕🌕 *سلام و محبّة* 🌕🌕🌕
﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾
[ القصص: 5]
==========================
{العدلُ بينَ حلم الانتظارِ وحقيقةِ النضالِ}
🖋️د.عقيل الخزعلي/رئيس مجلس التنميّة
1. 💭 العدلُ ليسَ حلماً معلّقاً في فضاءِ التمنّي، بل جهادٌ يوميٌّ تُرويهِ التضحياتُ وتُثبّتُهُ الإراداتُ الصادقةُ.
2. 🔄 كلُّ أمةٍ تنادي بالعدلِ، لكنّها كثيراً ما تتحوّلُ – بوعيٍ أو دونَ وعيٍ – إلى حارسةٍ للظلمِ، حينَ تعجزُ عن حملِ أعباءِ الحقِّ.
3. 💪🏼 ليسَ العدلُ فكرةً مؤجَّلةً إلى غدٍ مجهولٍ، بل هو فعلٌ مُلحٌّ يولدُ في كلِّ لحظةٍ من رحمِ الشجاعةِ والإصرارِ.
4. 😳 مفارقةُ الإنسانِ أنَّهُ ينتظرُ مخلّصاً يأتي من خارجِه، وحينَ يأتي هذا المخلّصُ، يكونُ أوّلَ من يحاربهُ!
5. 🪧 الشعاراتُ وحدَها لا تُقيمُ العدالةَ، كما أنَّ الأمنياتِ لا تَمنعُ الظلمَ؛ العدلُ يحتاجُ إلى أفعالٍ تتحدّى الخوفَ والتواطؤَ.
6. 🔪 كلُّ مصلحٍ عادلٍ يَحملُ في قلبِه نورَ الحقِّ، يجدُ نفسَهُ محاطاً بظلماتِ التآمرِ والخيانةِ، ليسَ من الظالمينَ فقط، بل من أولئك الذين يدّعونَ نُصرتَه.
7. 💡المُخلِّصُ العادلُ ليسَ أسطورةً بعيدةَ المنالِ، بل هو كلُّ نفسٍ تجرَّأتْ على الوقوفِ في وجهِ الظلمِ، ولو كانَ الثمنُ حياتَها.
8. 📜 التاريخُ يُعلّمُنا أنَّ العدالةَ ليستْ هبةً تُمنَحُ، بل معركةٌ تُخاضُ، وكفاحٌ لا يتوقّفُ إلا بانتصارِها أو استشهادِ مَنْ يُطالبُ بها.
9. 🪞العدلُ مرآةٌ تُرعبُ أصحابَ المصالحِ، لذا يُحاربونَ حاملَها بوحشيّةٍ، لأنّهُ يفضحُ قُبحَهم ويُهدّدُ امتيازاتِهم.
10. 📢 كلُّ مَنْ واجهَ الظلمَ بصدقٍ لم يكنْ سلاحُهُ سوى الكلمةِ، لكنَّ الكلمةَ حينَ تكونُ حقّاً، تصبحُ أخطرَ من أيِّ سلاحٍ.
11. 🅿️ أنْ تنتظرَ العدلَ دونَ أنْ تُساهمَ في صُنعِه، يعني أنْ تُسلّمَ مصيرَك للظلمِ بيديكَ، وأنْ تبرّرَ عجزَك بوهمِ الانتظارِ.
12. 👷 العدلُ ليسَ شعاراً يُرفعُ، بل مسؤوليةٌ تُحمَلُ، وواجبٌ يُؤدَّى، ووعيٌ لا ينكسرُ أمامَ الترهيبِ أو الإغراءِ.
13. 🦠 ما أشدَّ مرارةَ أنْ تُحاربَ وأنتَ تطلبُ حقَّ الآخرينَ، وما أعمقَ مأساتَنا حينَ يكونُ مَنْ نُناضلُ من أجلِهم، همْ أولُ أعدائِنا!
14. 🪄 لا تنتظرْ عصاً سحريةً تكنسُ الظلمَ في غمضةِ عينٍ، فسننُ الحياةِ تُخبرُنا أنَّ العدالةَ تُبنى لبنةً لبنةً، وقطرةً قطرةً من دماءِ المضحّين.
15. ❤️🔥 من يطمحُ للعدلِ عليهِ أنْ يُوقظَ قلبَهُ من وَهْمِ الراحةِ، ويشحذَ عقلَهُ برفضِ الاستكانةِ، ويُهيِّئَ ساعدَهُ لحملِ أثقالِ المسؤوليةِ.
16. 🌱 العدلُ ليسَ هديّةً من السماءِ، بل ولادةٌ مؤلمةٌ لا تتمُّ إلا برفضِ الظلمِ، مهما كانَ الثمنُ، وبالعملِ الدؤوبِ، مهما طالَ الطريقُ.
17. 😡 حينَ يَظهرُ العادلُ في زمنِ الخنوعِ، يتحوَّلُ إلى عدوٍّ لمن ارتضَوا العيشَ في ظلِّ الطغيانِ، لأنَّهُ يُزعزعُ راحتَهم المزيّفةَ.
18. ⚙️ كلُّ نظامٍ قائمٍ على الظلمِ، ليسَ مجرّدَ قانونٍ ظالمٍ، بل شبكةُ مصالحَ وتقاليدَ وعاداتٍ عشّشتْ في النفوسِ، حتى صارتْ سجناً لها.
19. 🎁 من يخشى العدالةَ، هو من تعوَّدَ على امتيازاتِ الظلمِ، ومن يُحاربُ العادلَ، هو مَنْ يرى في العدلِ تهديداً لمكاسبِه، لا نصراً لقيمِه.
20. 🩸 العادلُ الحقيقيُّ ليسَ من يرفعُ الصوتَ عالياً، بل من يمضي في طريقِ الحقِّ، ولو كانَ وحيداً، ولو كانَ مثقلاً بجراحِ الخذلانِ.
21. 🧪 العدلُ امتحانٌ عسيرٌ؛ ليسَ لأنَّ الظلمَ قويٌّ، بل لأنَّ كثيراً من القلوبِ ضعيفةٌ، تخشى أنْ تدفعَ ثمنَ مواقفِها.
22. 🔭 انتظارُ العدالةِ دونَ سعيٍّ لتحقيقِها، يُحوِّلُ الشعوبَ إلى متفرّجينَ في مسرحِ الظلمِ، مكتفينَ بالتصفيقِ حينَ يُقتلُ العادلُ، ثمَّ البكاءِ عليهِ بعدَ فواتِ الأوانِ.
23. ⚰️ منْ أرادَ العدلَ حقّاً، عليهِ أنْ يَحملَ كَفَنَهُ، ويَمضي في دربِ التّحدي، مُستعدّاً للنفيِّ والعزلِ والتنكيلِ، لأنَّ طريقَ العدلِ مُعبّدٌ بالأشواكِ لا بالزهورِ.
24. ✊🏼 العدلُ لا يأتي من فراغٍ، ولا يتحقّقُ بالانتظارِ السلبيّ؛ بل هو ثمرةُ قلوبٍ لا تعرفُ الخوفَ، وعقولٍ لا تقبلُ الاستبدادَ، وسواعدَ لا تهابُ التعبَ.
25. 🎭 منْ يرفعُ شعاراتِ العدالةِ بلسانِهِ ويخذلُ العادلينَ بفعلِهِ، ليسَ فقط مُنافقاً، بل شريكٌ صامتٌ في جَريمَةِ بقاءِ الظلمِ.
🤲🏼 اللهم لا تجعل هذه العبارات صدى كلماتٍ عابرةٍ، بل دعوةٌ للتأمّلِ والعملِ، لتكونَ العدالةُ واقعاً، لا أمنيةً، ومسؤوليةً مشتركةً، لا شعاراً فارغاً.🤲🏼
🎂مباركٌ يومُكم وجمعاتكم🎂
د.عقيل الخزعلي
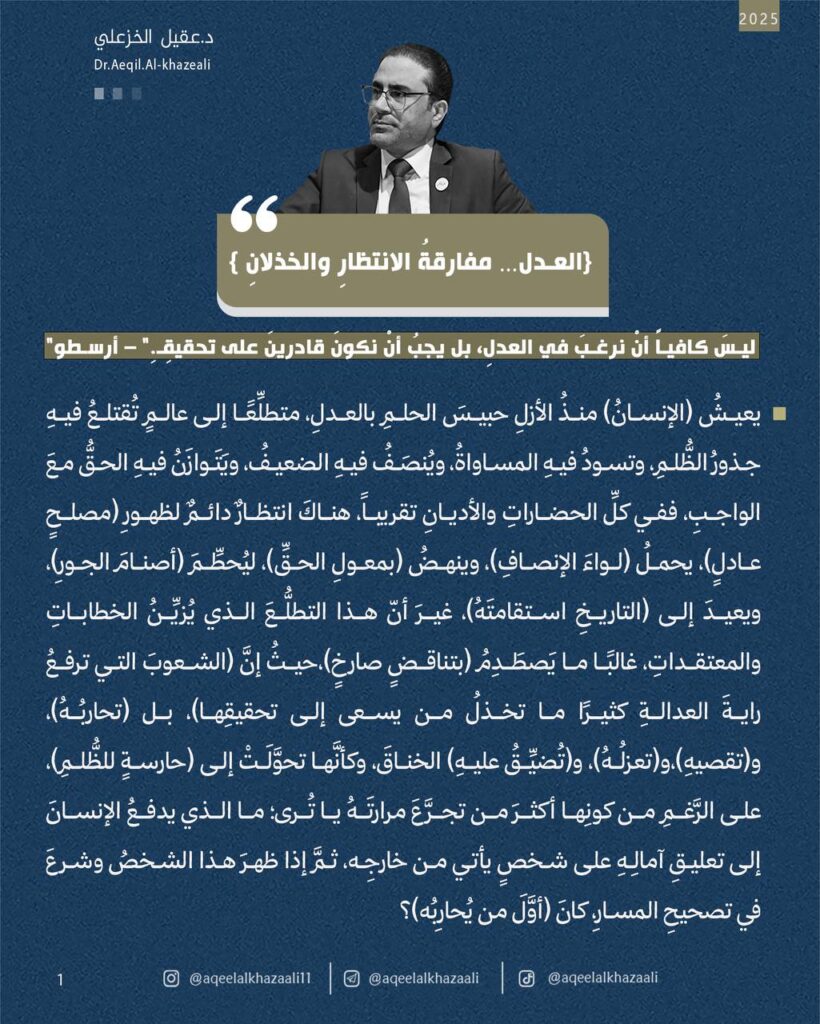
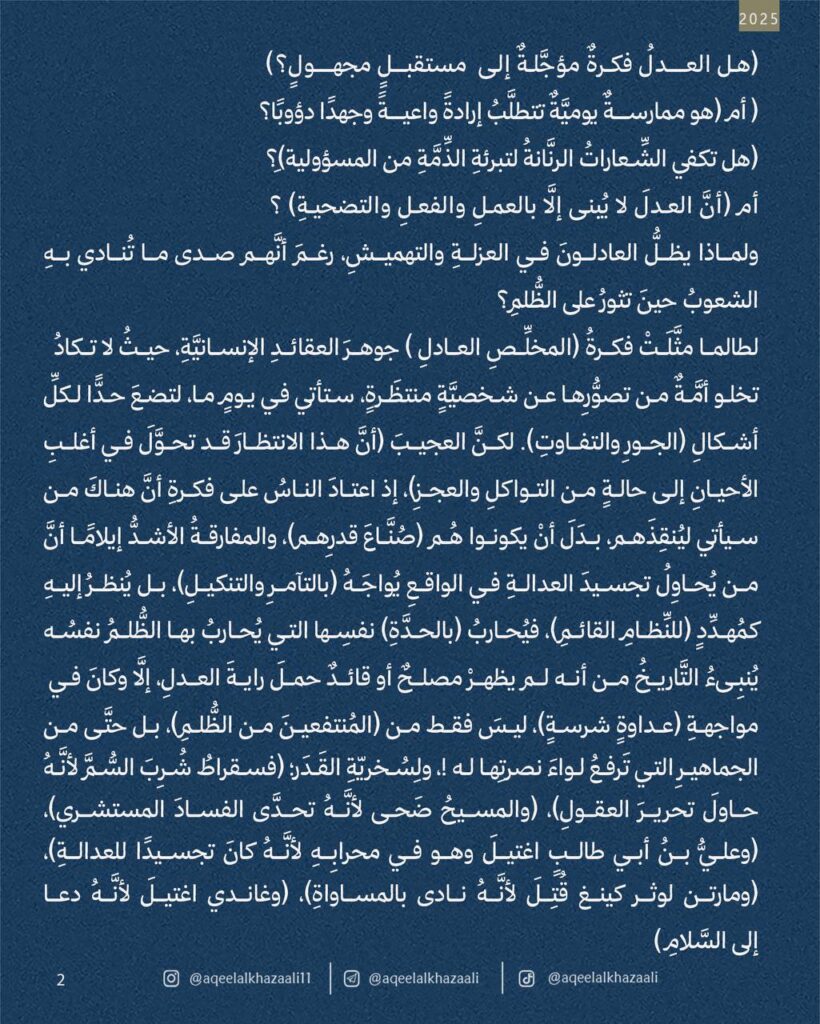
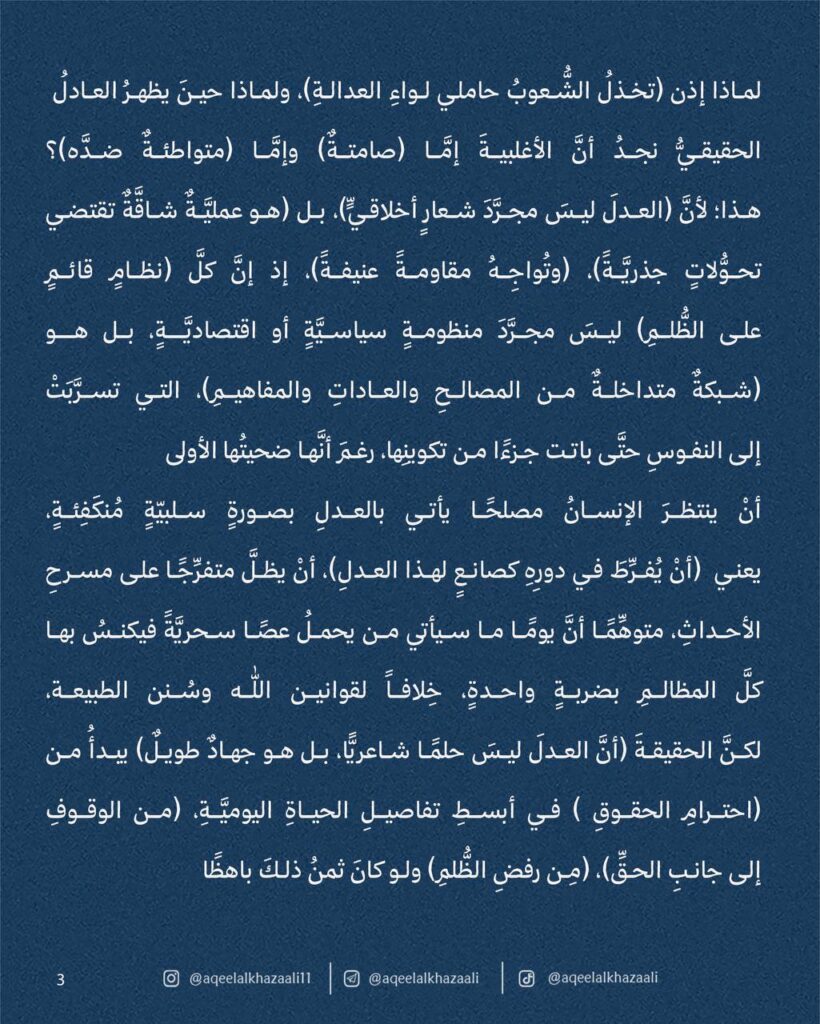
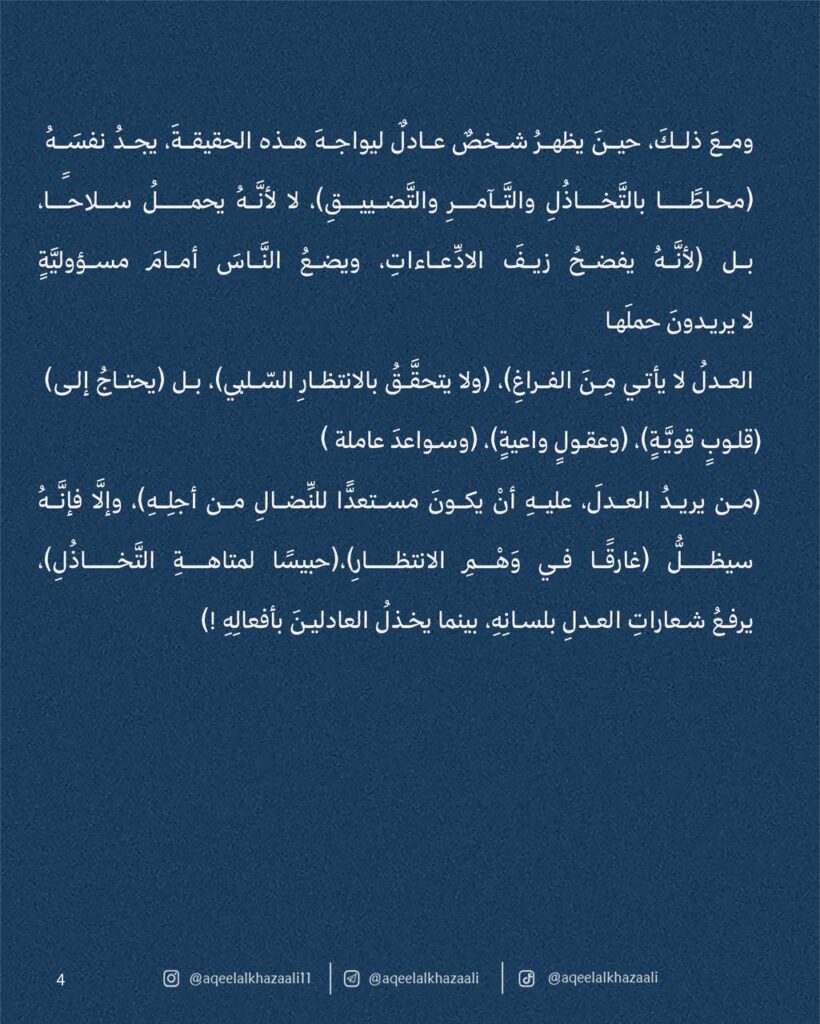
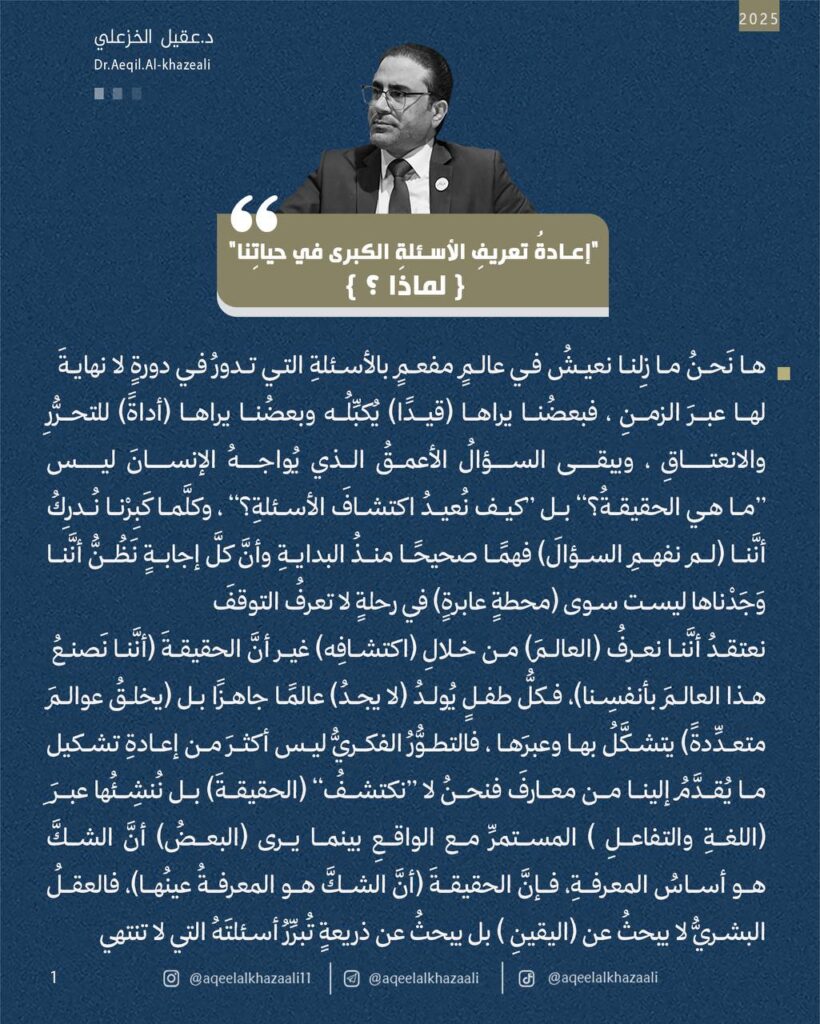
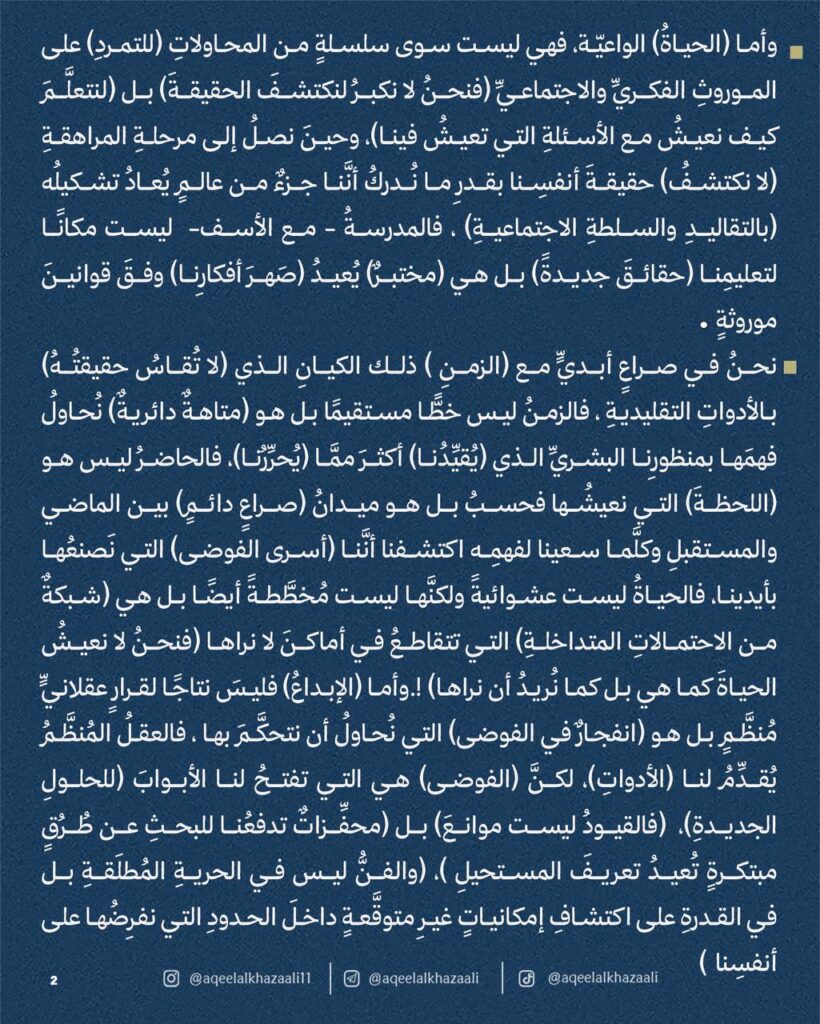
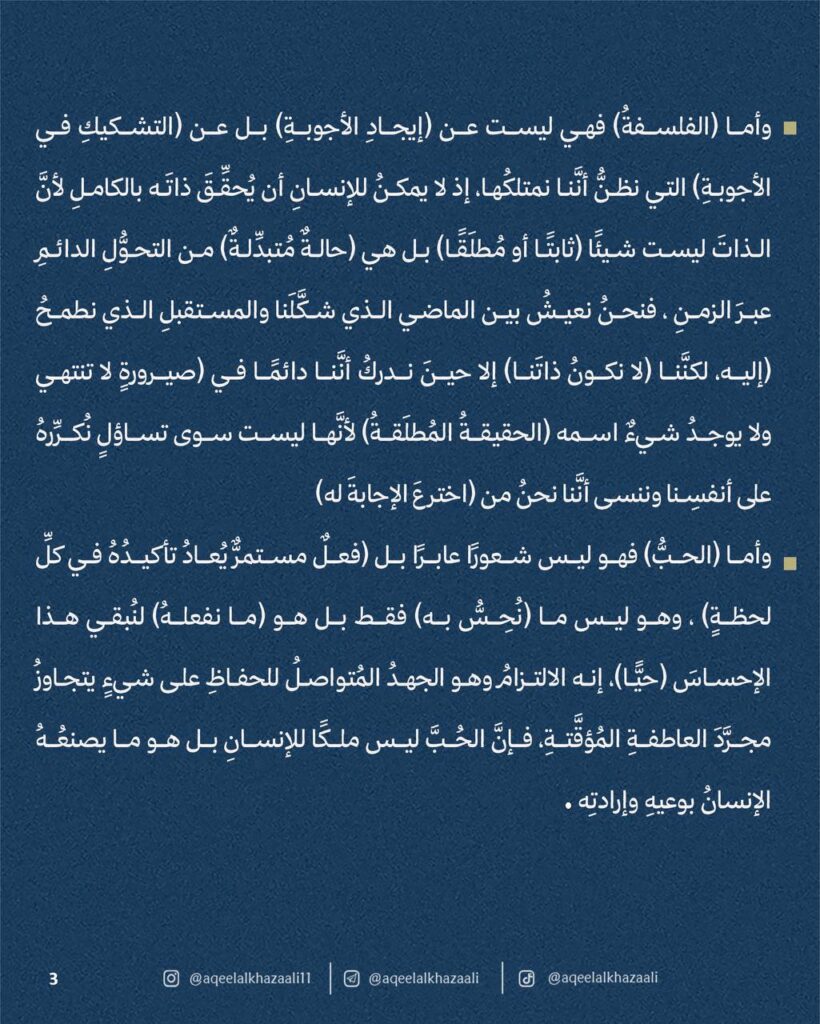
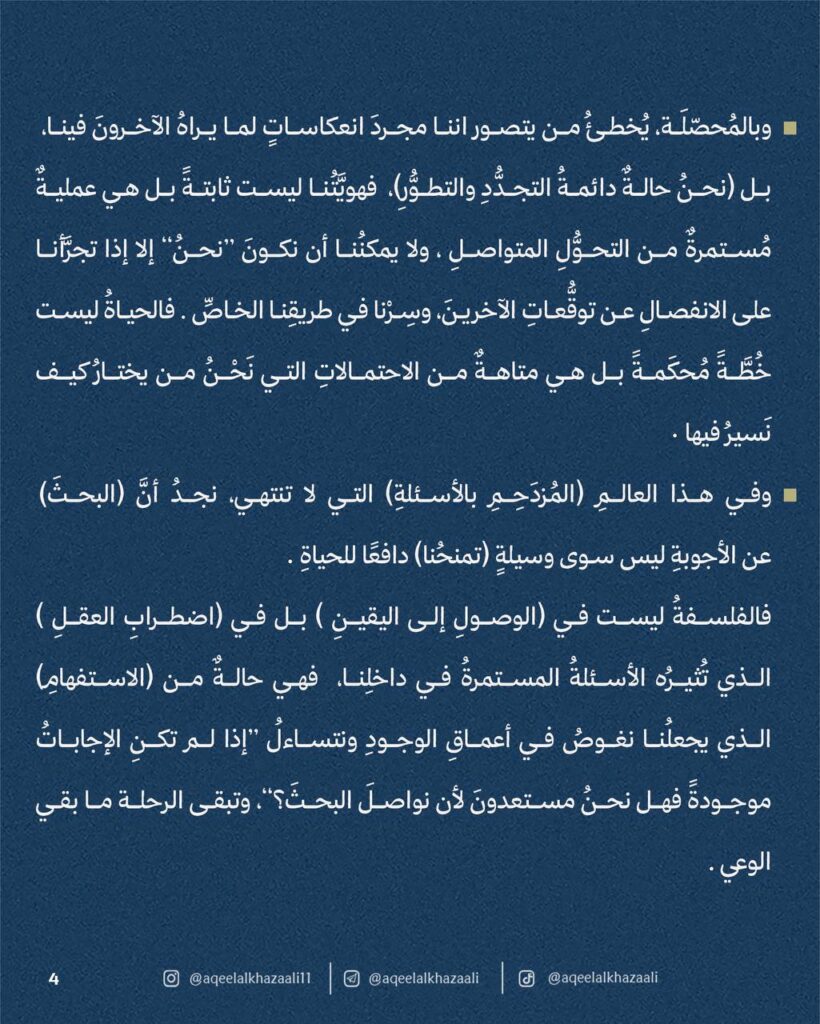
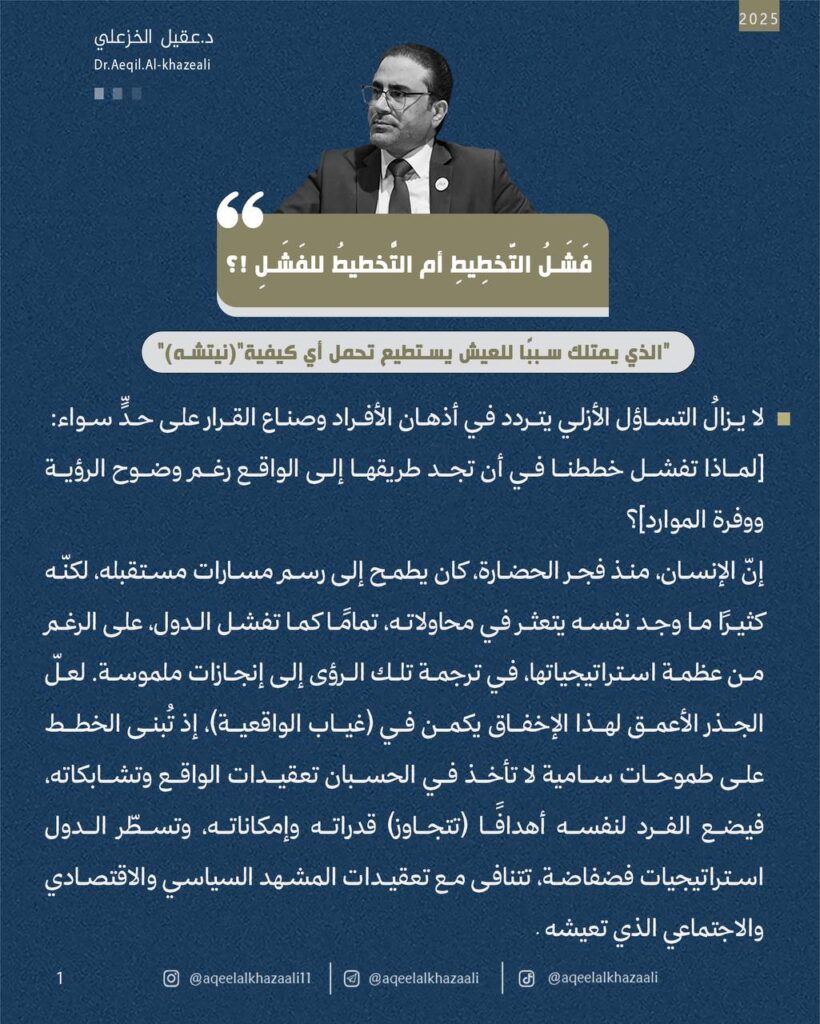
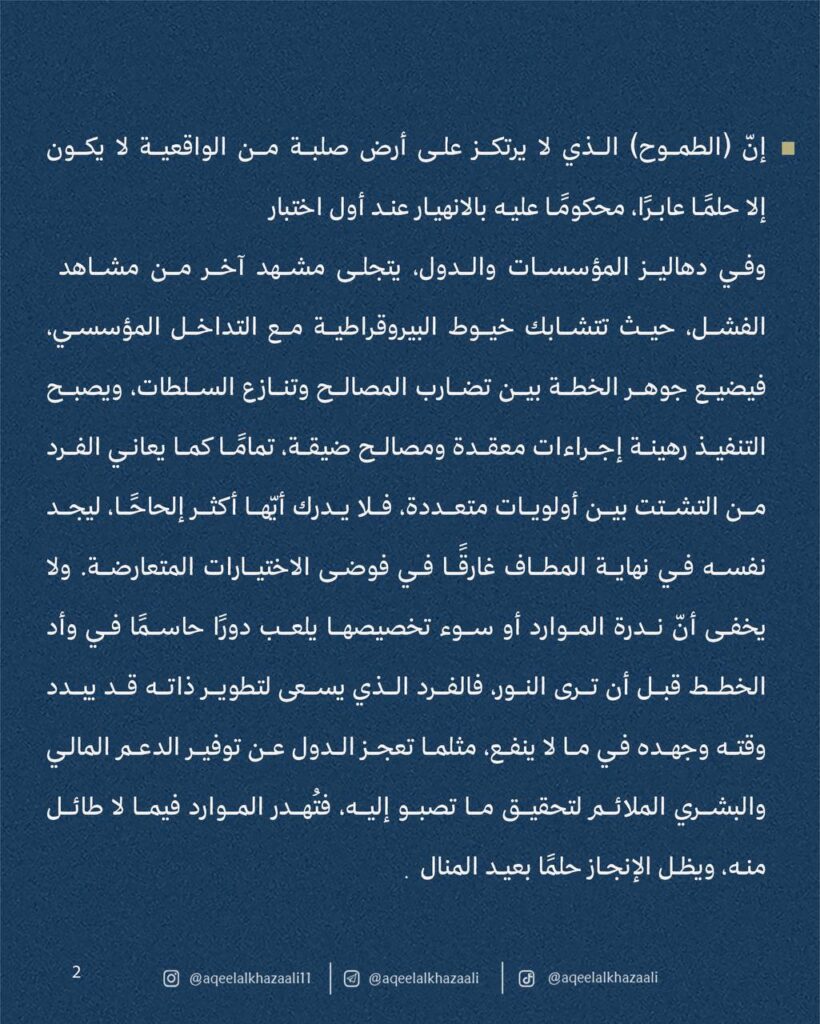
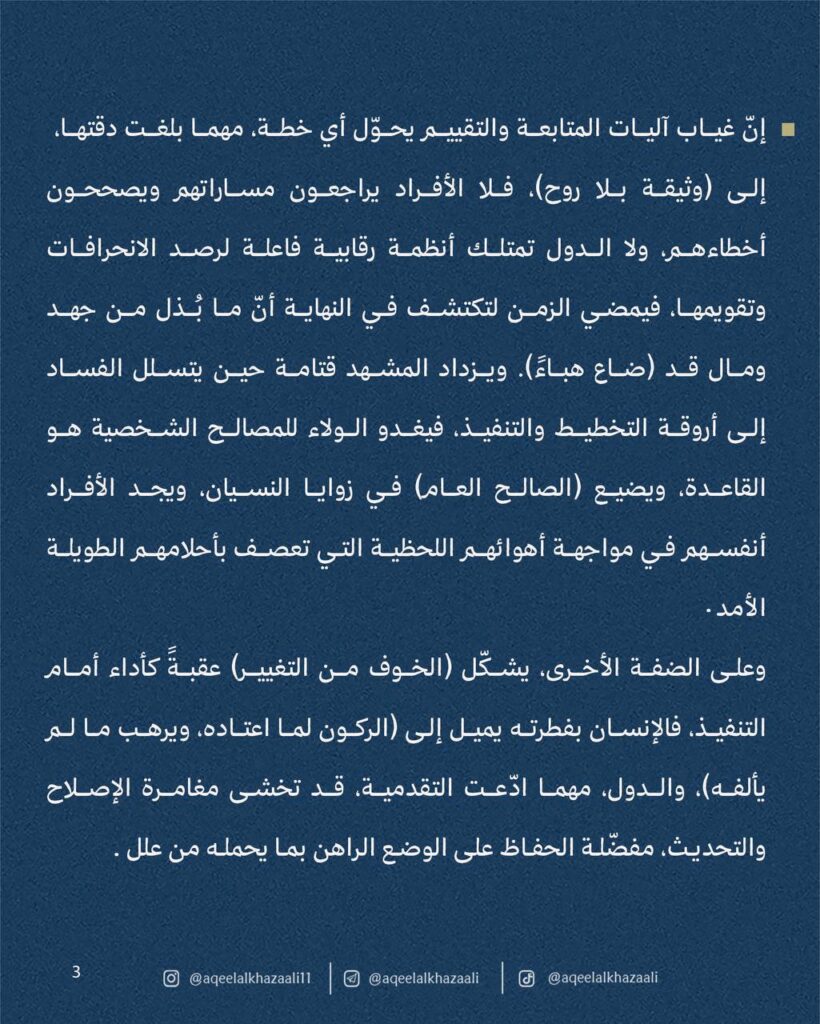
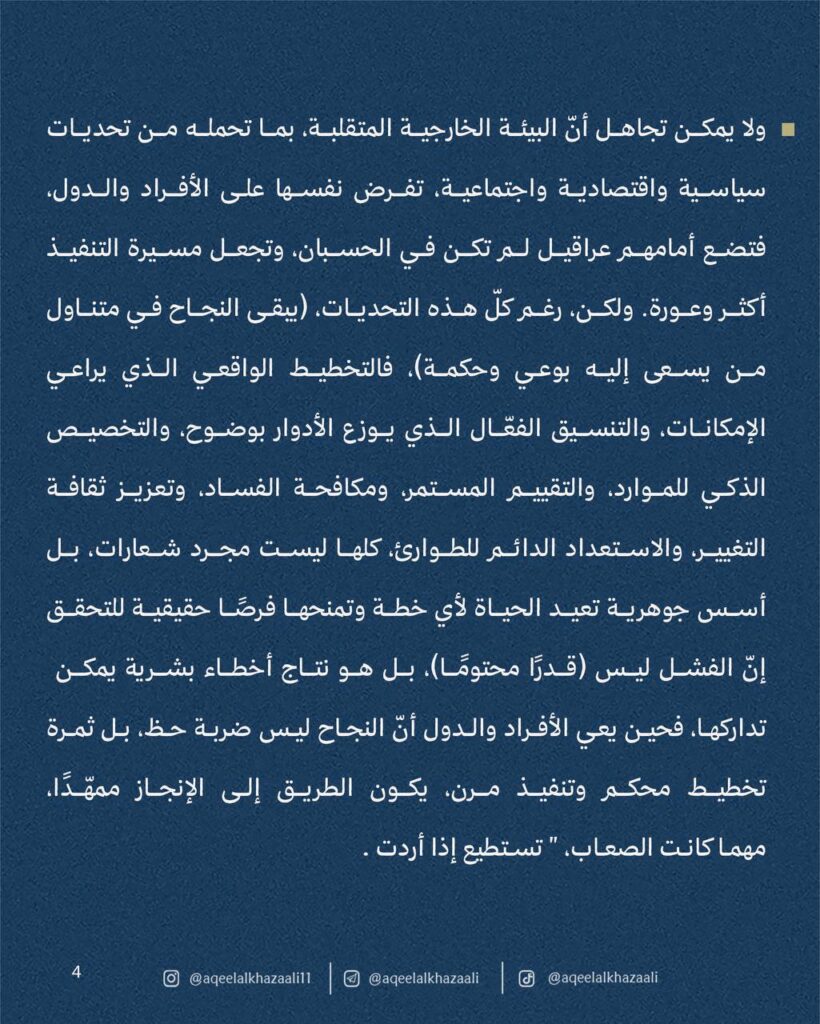
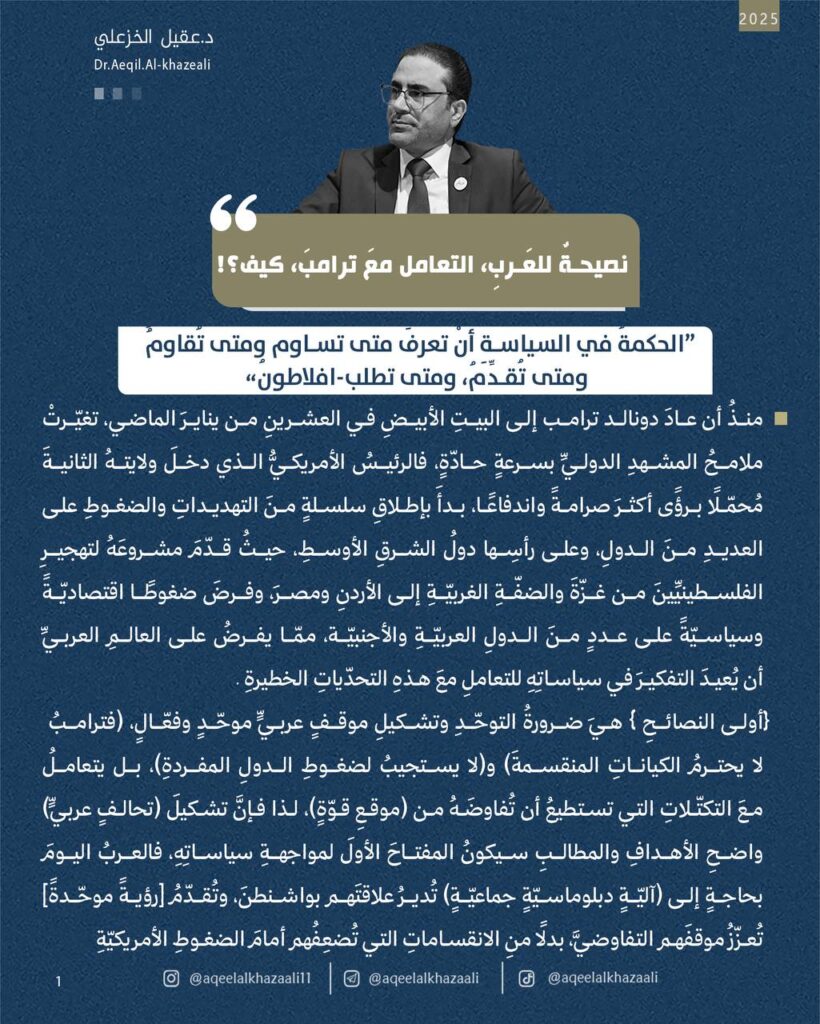
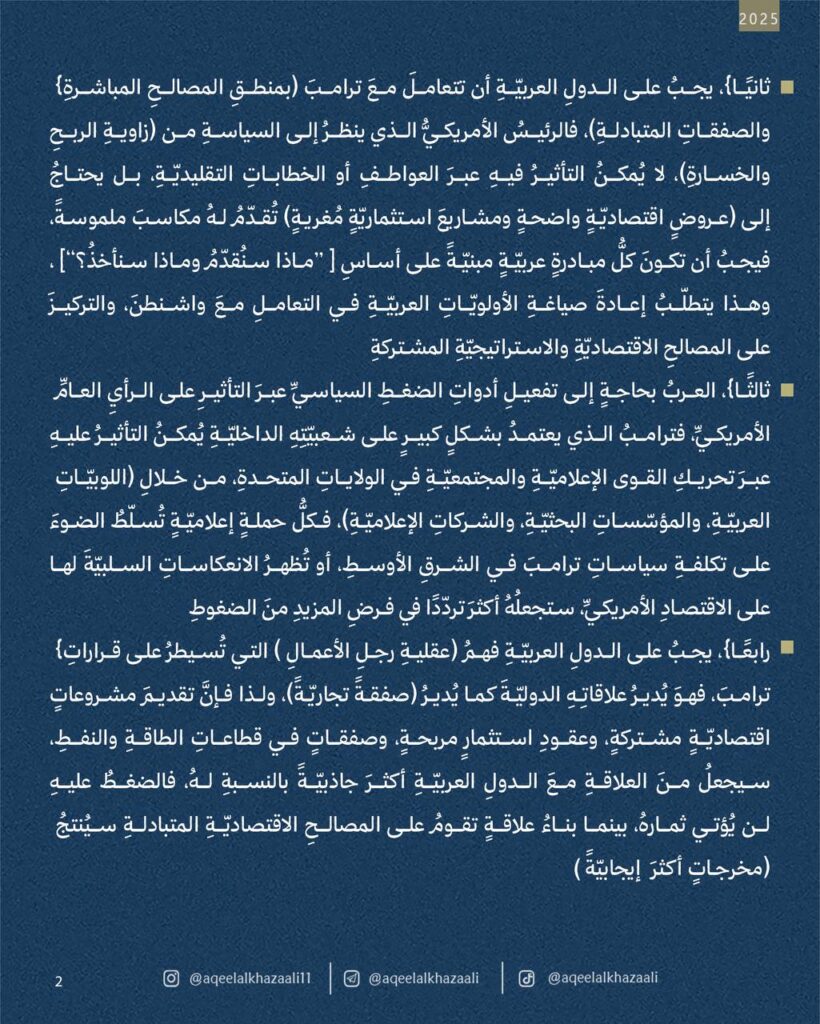
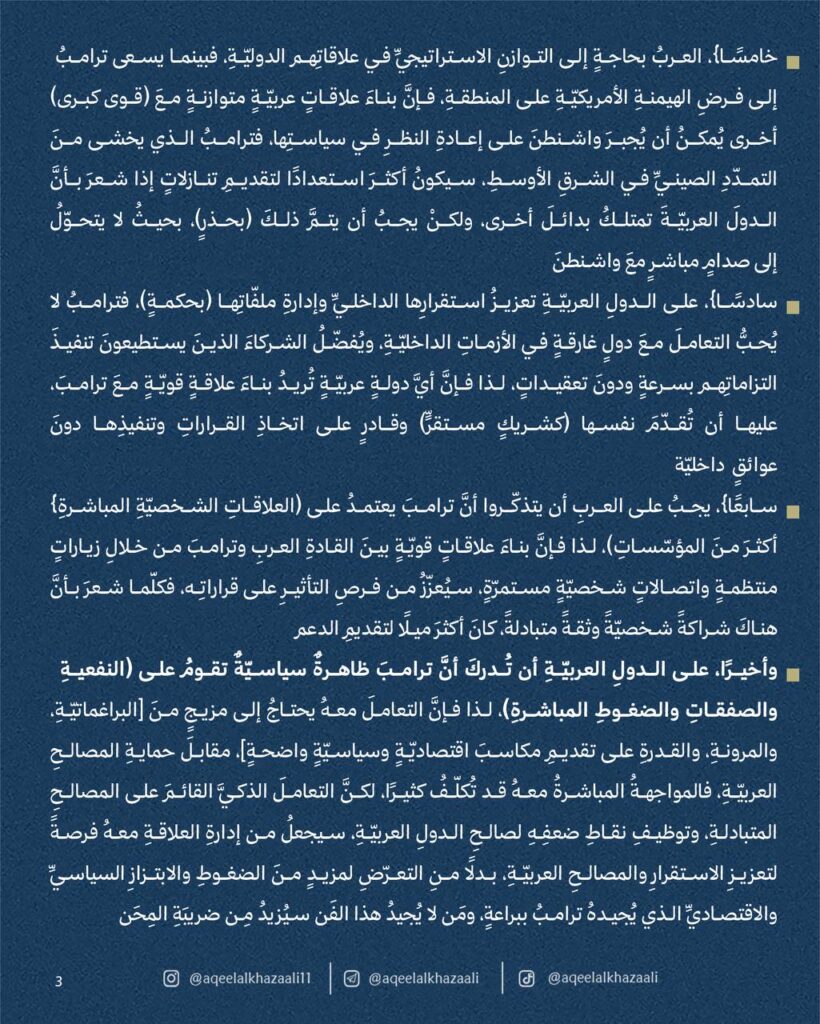
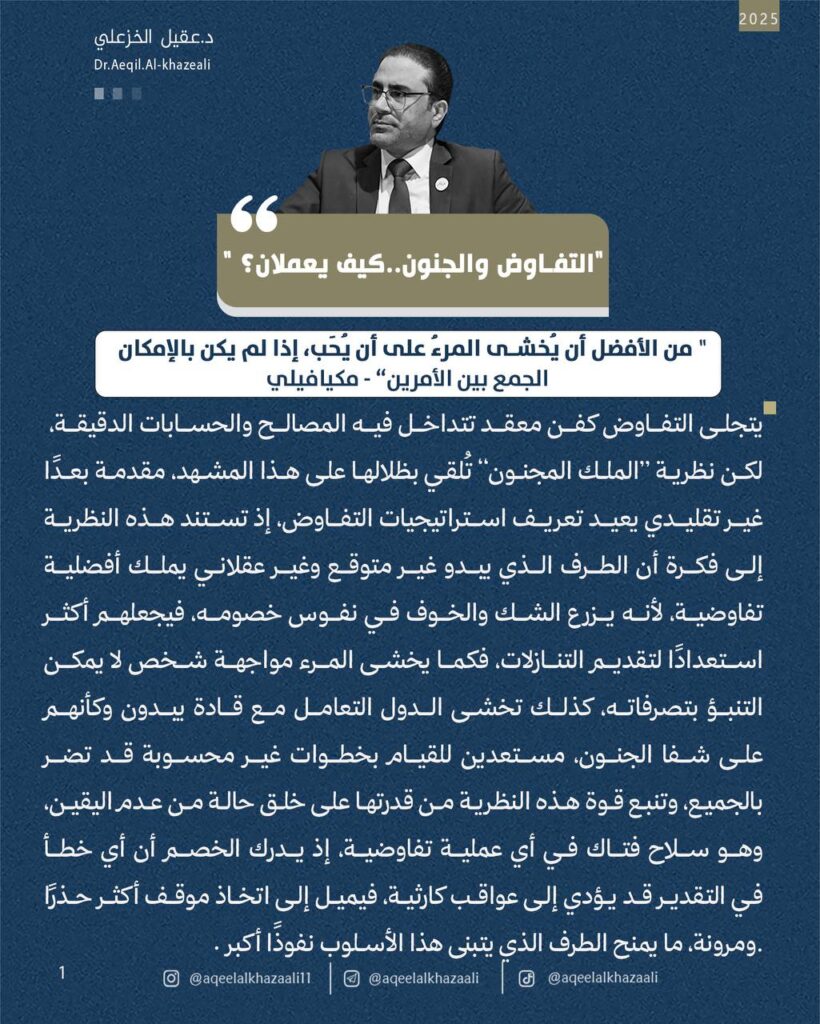
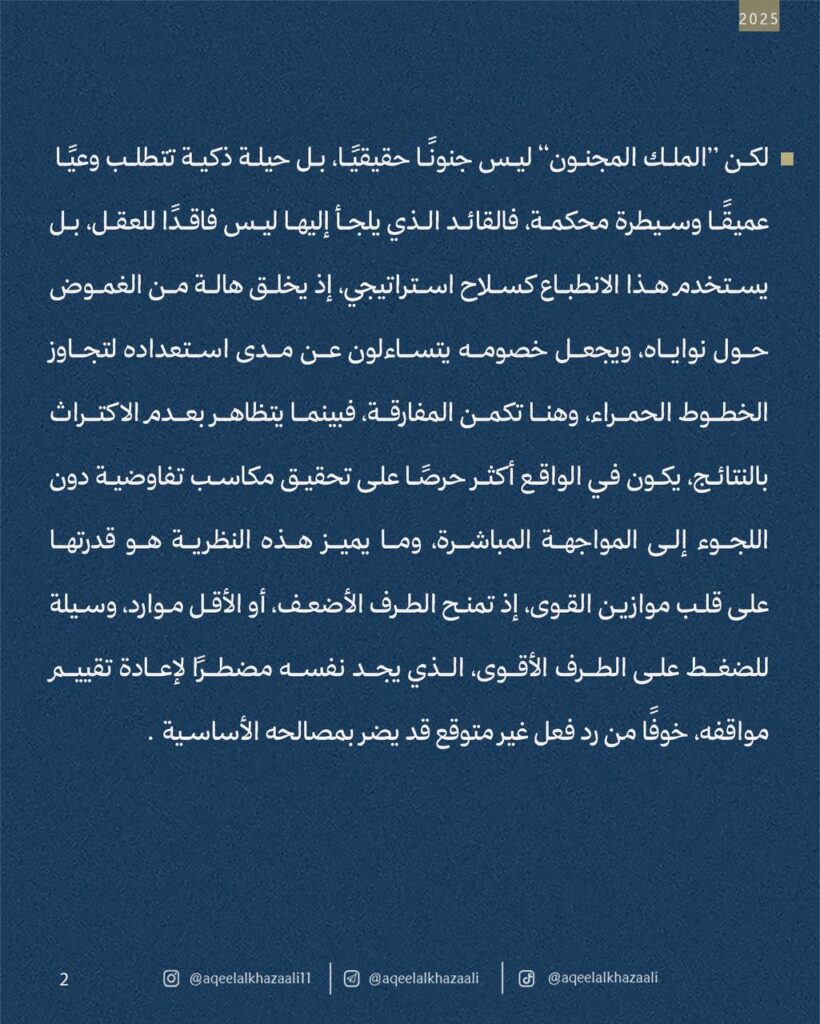
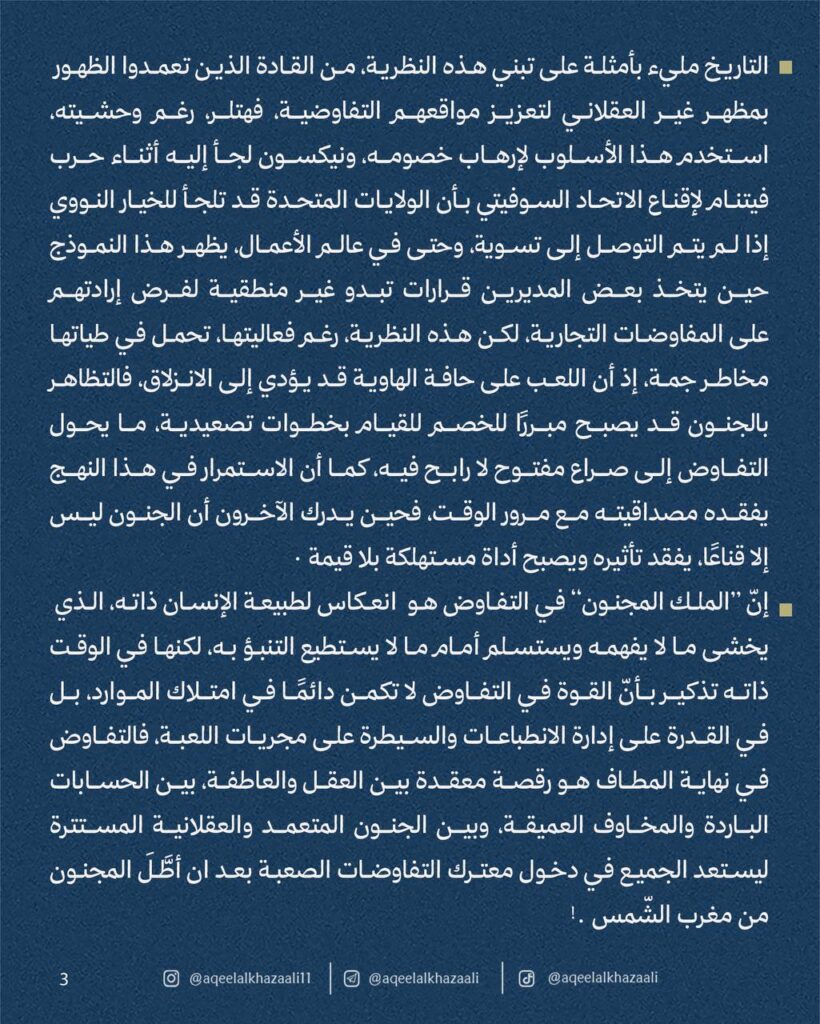
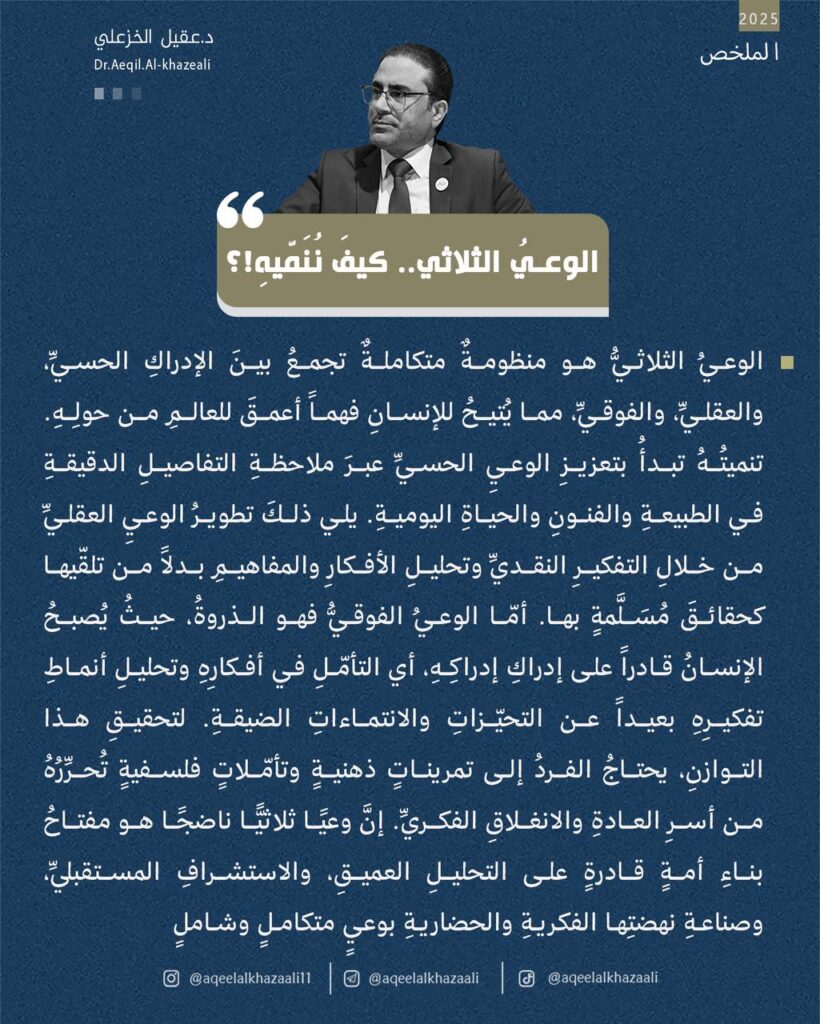
🧠. الوعيُ الثلاثي.. كيفَ نُنَمّيهِ ؟! 🧠
د.عقيل الخزعلي / رئيس مجلس التنميّة
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
“حينما يكتملُ وعيُ الإنسانِ وإدراكُهُ للحياةِ، إمّا أن يعيشَ في الصمتِ إلى الأبدِ، أو أن يُصبحَ ثائرًا في وجهِ كلِّ شيءٍ”دوستويفسكي
يتدفّقُ على (عقلِ الإنسانِ ) سيلٌ لا ينقطعُ من المعلوماتِ والمعارفِ، تتباينُ مستوياتُها بينَ (الحسيِّ والعقليِّ والروحيِّ). لكنَّ (الوعيَ)، وهو الأداةُ الرئيسةُ التي يُعالجُ بها الإنسانُ هذهِ البياناتِ ويُعيدُ تشكيلَها، ليسَ حالةً جامدةً بل هو سيرورةٌ ديناميكيةٌ يمكنُ توسيعُها وتعميقُها وترقيتُها عبرَ مراحلَ متواصلةٍ من الفهمِ والتدريبِ والتجربة.
إنَّ (الوعيَ الثلاثيَّ) هو النموذجُ الأكثرُ تكاملاً لفهمِ الوجودِ الإنسانيِّ في تفاعلهِ مع (ذاتهِ) ومع (الآخرينِ ) ومعَ (الوجودِ الكونيِّ) الأرحبِ، حيثُ يتداخلُ فيهِ (الوعيُ الحسيُّ، والوعيُ العقليُّ، والوعيُ الفوقيُّ) في منظومةٍ معرفيةٍ متكاملةٍ تُمكّنُ الإنسانَ من الرؤيةِ الشاملةِ للأشياءِ، لا بوصفِها كُتلاً متفرقةً من الظواهرِ، بل باعتبارِها (أنساقاً متداخلةً) ذاتَ أنماطٍ دلاليةٍ عميقةٍ.
إنَّ تنميةَ هذا الوعيِ تتطلبُ {أولاً} الارتقاءَ بالإدراكِ الحسيِّ عبرَ تعزيزِ قدرةِ الإنسانِ على ملاحظةِ التفاصيلِ الدقيقةِ فيما يحيطُ بهِ، فلا يُصبحُ (أسيرَ العادةِ) أو (رهينَ الإدراكِ السطحيِّ) الذي يكتفي برؤيةِ الأشياءِ من زواياها الأكثرِ مباشرةً.
إنَّ الإنسانَ حينَ يُنَمِّي حواسَهُ ليُصبحَ أكثرَ دقةً في ملاحظةِ الألوانِ والأصواتِ والنغماتِ وتدرجاتِها، وحينَ يُعزِّزُ (حاستَهُ الجماليةَ) في رؤيةِ الانسجامِ الكامنِ في المشاهدِ البصريةِ أو في إيقاعِ الحركاتِ اليوميةِ، فإنهُ يوسّعُ من استيعابِهِ للعالمِ بطريقةٍ أكثرَ ثراءً وعمقاً، فتتحوَّلُ حياتُهُ من تجربةٍ عاديةٍ متكررةٍ إلى نهرٍ متدفقٍ من (الإحساسِ بالجمالِ والدهشةِ والوعيِ باللحظةِ الآنيةِ) بكاملِ أبعادِها.
لكنَّ (الوعيَ الحسيَّ) وحدَهُ لا يكفي، فالأشياءُ ليست مجردَ مشاهدَ حسيةٍ، بل هي (شيفراتٌ) ينبغي تفكيكُها وإعادةُ بنائِها في إطارٍ معرفيٍّ أكثرَ اتساعاً، وهنا تأتي أهميةُ الوعيِ العقليِّ بوصفِهِ المرحلةَ الأعمقَ التي يتحولُ فيها الإدراكُ من مستوى الشعورِ إلى مستوى الفهمِ والتحليلِ والاستنتاجِ ، فالعقلَ، حينَ يكونُ في أعلى حالاتِ يقظتِهِ، لا يكتفي بتلقي المعلوماتِ بل يُعيدُ بناءَها ضمنَ شبكاتٍ دلاليةٍ متناسقةٍ، مما يسمحُ للإنسانِ بالانتقالِ من مستوى (المعرفةِ السطحيةِ) إلى مستوى (التأملِ الفلسفيِّ) الذي يكشفُ الأبعادَ غيرَ المرئيةِ في الظواهرِ المحيطةِ بهِ. فمن ينظرُ إلى التاريخِ، على سبيلِ المثالِ، بعينِ الوعيِ العقليِّ، لا يراهُ مجردَ سلسلةِ أحداثٍ متعاقبةٍ، بل يُدركُ (أنماطَهُ العميقةَ) التي تتكررُ في دوراتٍ حضاريةٍ تُعيدُ إنتاجَ ذاتِها عبرَ الزمنِ، مما يُمكّنُهُ من (فهمِ) الاتجاهاتِ المستقبليةِ و(استشرافِ) المآلاتِ الكبرى.
وإذا كانَ (الوعيُ الحسيُّ) يُعلّمُ الإنسانَ كيفَ يرى الأشياءَ بدقةٍ، و(الوعيُ العقليُّ) يُعلّمُهُ كيفَ يُفسّرُ هذهِ الأشياءَ في سياقٍ أعمقَ، فإنَّ (الوعيَ الفوقيَّ) هو الذروةُ التي يُصبحُ فيها الإنسانُ قادراً على التأملِ في ذاتِه، أي أنْ يُصبحَ (واعياً بوعيهِ)، (مدركاً لإدراكِهِ)، قادراً على النظرِ إلى أفكارِهِ كما لو كانَ يراقبُها من مستوى أعلى. هذا النوعُ من الوعيِ هو الذي يتيحُ للإنسانِ التحررَ من أسرِ (الأفكارِ المسبقةِ)، والخروجَ من قوقعةِ (الذاتِ المغلقةِ)، والنظرَ إلى نفسِهِ والعالمِ من زاويةٍ تتجاوزُ الإطارَ المحدودَ للخبرةِ الشخصيةِ. إنَّهُ الوعيُ الذي يُمَكِّنُ الإنسانَ من (التسامي على التحيّزاتِ)، والتفكيرِ بشكلٍ أوسعَ من حدودهِ الضيقةِ، ورؤيةِ الأشياءِ من (منظورٍ كونيٍّ) يتجاوزُ الانتماءاتِ العرقيةَ أو الثقافيةَ أو الإيديولوجيةَ، ليصلَ إلى مُقارَبَةِ جوهرِ (الحقيقةِ) في صورتِها الأكثرِ موضوعيةً واتساعاً.
إنَّ تحقيقَ هذا المستوى من الوعيِ ليسَ أمراً عفوياً، بل هو (مسارٌ) يتطلبُ تمريناً وتدريباً مستمراً. فمن أرادَ أن يُنَمِّي (الوعيَ الحسيَّ) عليهِ أن يُمارسَ التأملَ في الطبيعةِ والفنِّ والأدبِ، وأن يُنَمِّي (حسَّهُ الجماليَّ) عبرَ تعلُّمِ ملاحظةِ التفاصيلِ الدقيقةِ التي لا يلتفتُ إليها العقلُ المنشغلُ بعجلةِ الحياةِ السريعةِ. ومن أرادَ أن يُعزِّزَ (وعيَهُ العقليَّ) عليهِ أن يُمارسَ التفكيرَ النقديَّ، وأن يتعوّدَ على تحليلِ الأفكارِ المطروحةِ أمامَهُ لا بوصفِها حقائقَ مُسَلَّماً بها، بل باعتبارِها منظوماتٍ معرفيةً تحتاجُ إلى تمحيصٍ وتقييمٍ عقلانيٍّ دقيقٍ.
أما من أرادَ أن يرتقي إلى مستوى (الوعي الفوقيِّ)، فعليهِ أن يُمارسَ ما يُمكنُ أن نُسمِّيهِ “التأملَ في التأملِ”، أي أنْ يُدرّبَ عقلَهُ على مراقبةِ أفكارِهِ الخاصةِ وتحليلِ أنماطِها وأُطُرِها المرجعيةِ، حتى يُصبحَ قادراً على الخروجِ من أسرِ تفسيراتِهِ الذاتيةِ للأحداثِ ورؤيةِ الواقعِ (كما هو، لا كما يريدُهُ أن يكونَ).
إنَّ الوعيَ الثلاثيَّ هو (المفتاحُ الحقيقيُّ للنهضةِ الحضاريةِ)، وهو الأداةُ التي يمكنُ بها بناءُ مجتمعٍ أكثرَ وعياً، قادرٍ على (التحليلِ العميقِ، والتفكيرِ النقديِّ، والاستشرافِ المستقبليِّ). فلا يمكنُ أن تنهضَ أمةٌ أفرادُها لا يزالونَ يعيشونَ في نطاقِ الإدراكِ الحسيِّ وحدَهُ، ولا يمكنُ أن تتقدّمَ حضارةٌ تفتقرُ إلى منهجياتِ التفكيرِ التحليليِّ والعلميِّ، ولا يمكنُ أن يُبدعَ شعبٌ لا يمتلكُ القدرةَ على رؤيةِ ذاتِهِ في سياقِ الكونِ الأوسعِ.
يبقى التحديّ الأكبر الذي يواجهُ البشريةَ اليومَ ليسَ نقصَ المواردِ أو قلةَ الإمكاناتِ، بل هو ضعفُ الوعيِ في مستوياتهِ المختلفةِ، وحينَ يتمُّ تطويرُ الوعيِ الثلاثيِّ بشكلٍ متكاملٍ، يُصبحُ الإنسانُ أكثرَ قدرةً على بناءِ مستقبلِهِ بوعيٍ حقيقيٍّ يدمجُ بينَ (الإدراكِ الحسيِّ الدقيقِ)، (والفهمِ العقليِّ العميقِ)، (والتأملِ الفوقيِّ المتحرِّرِ) من القيودِ التقليديةِ، وحينَها فقط، يُمكنُ القولُ إنَّنا قد بدأنا أولَ خُطوةٍ حقيقيةٍ نحوَ تحقيقِ وعيٍ إنسانيٍّ أكثرَ نضجاً وكمالاً.
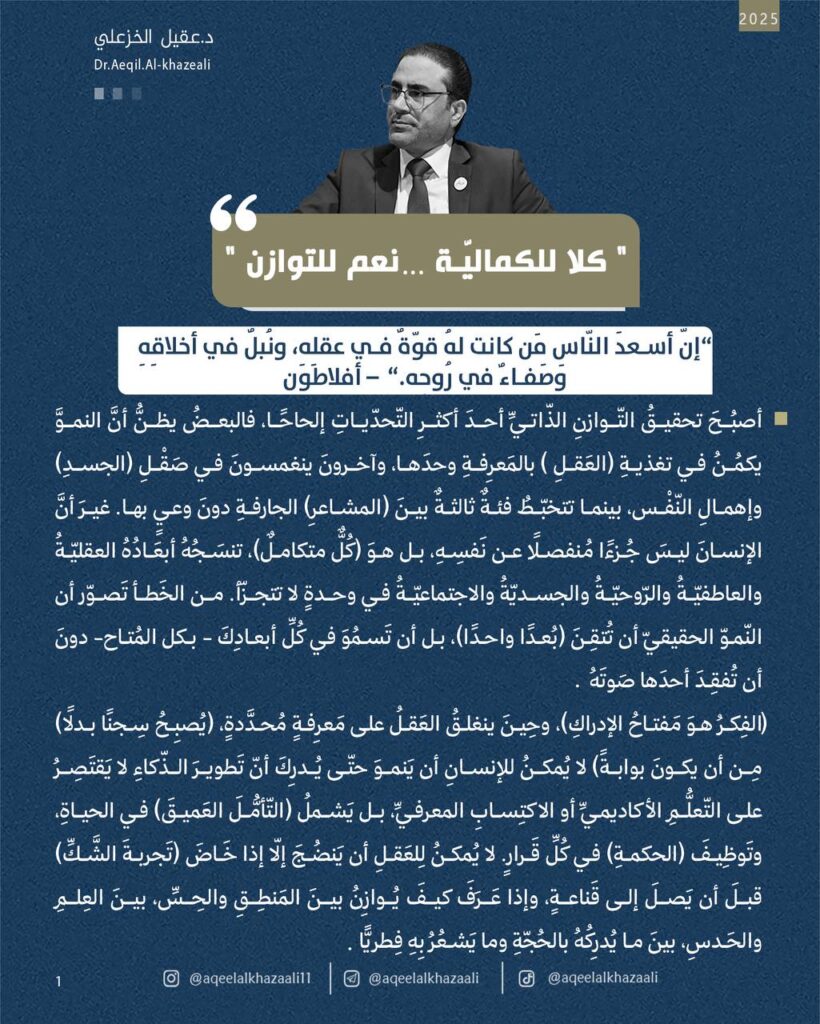
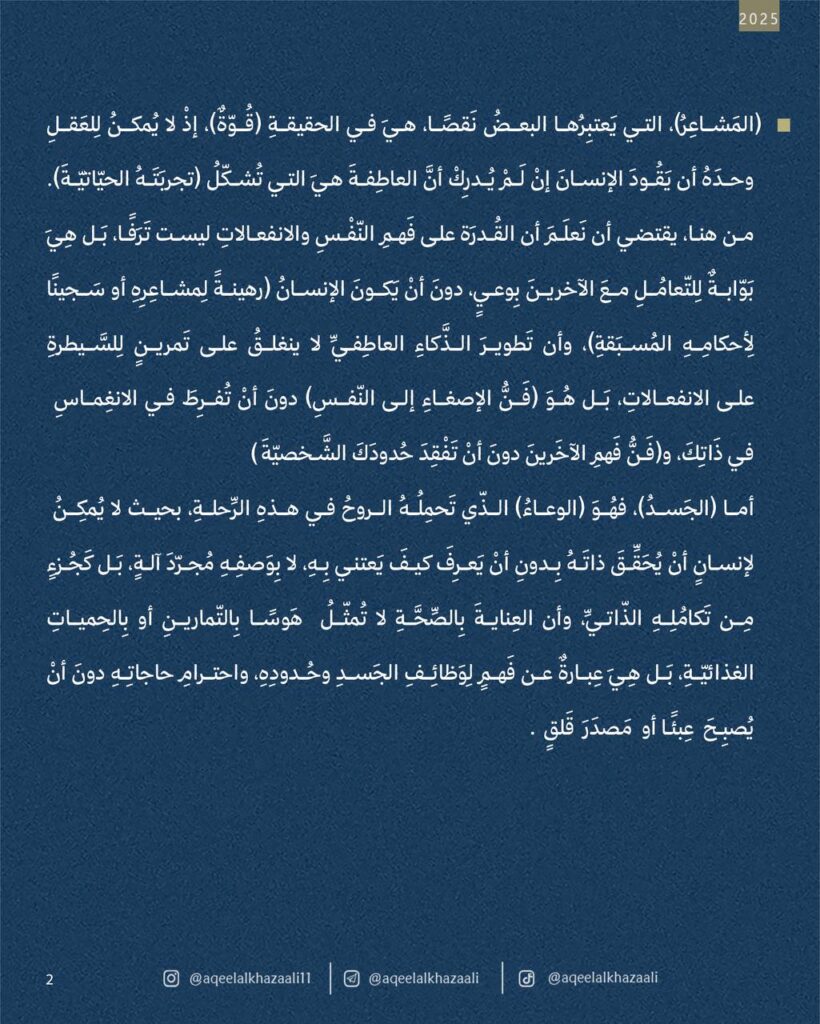
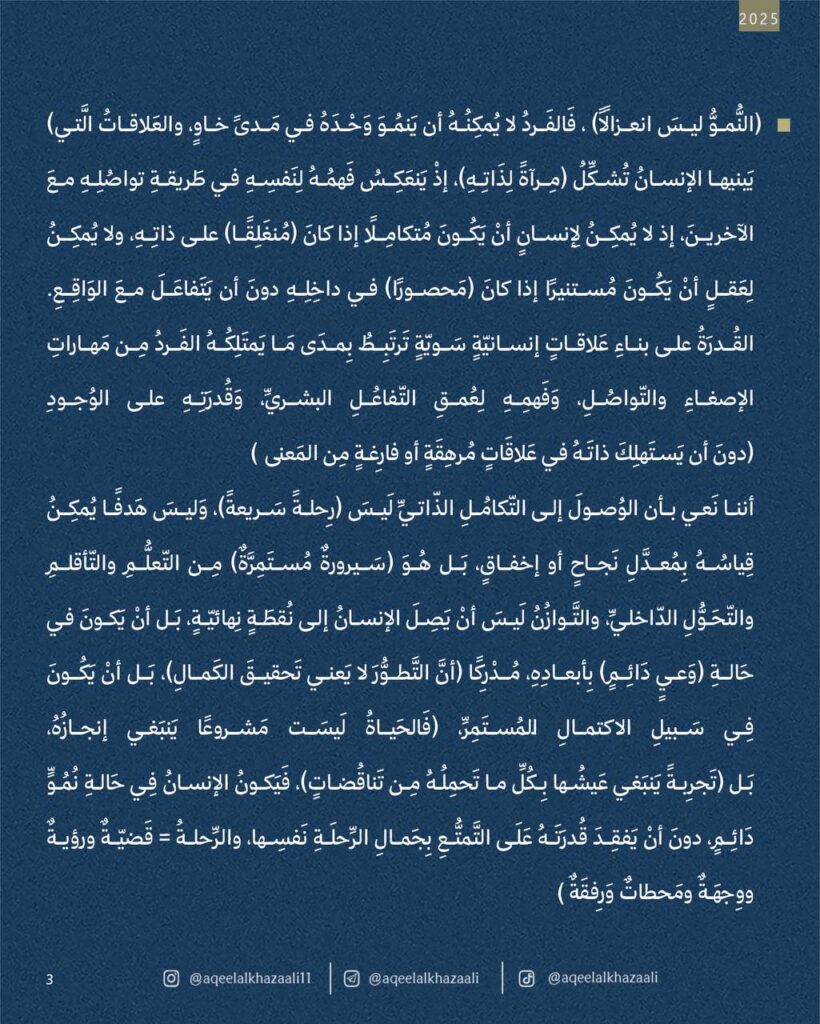
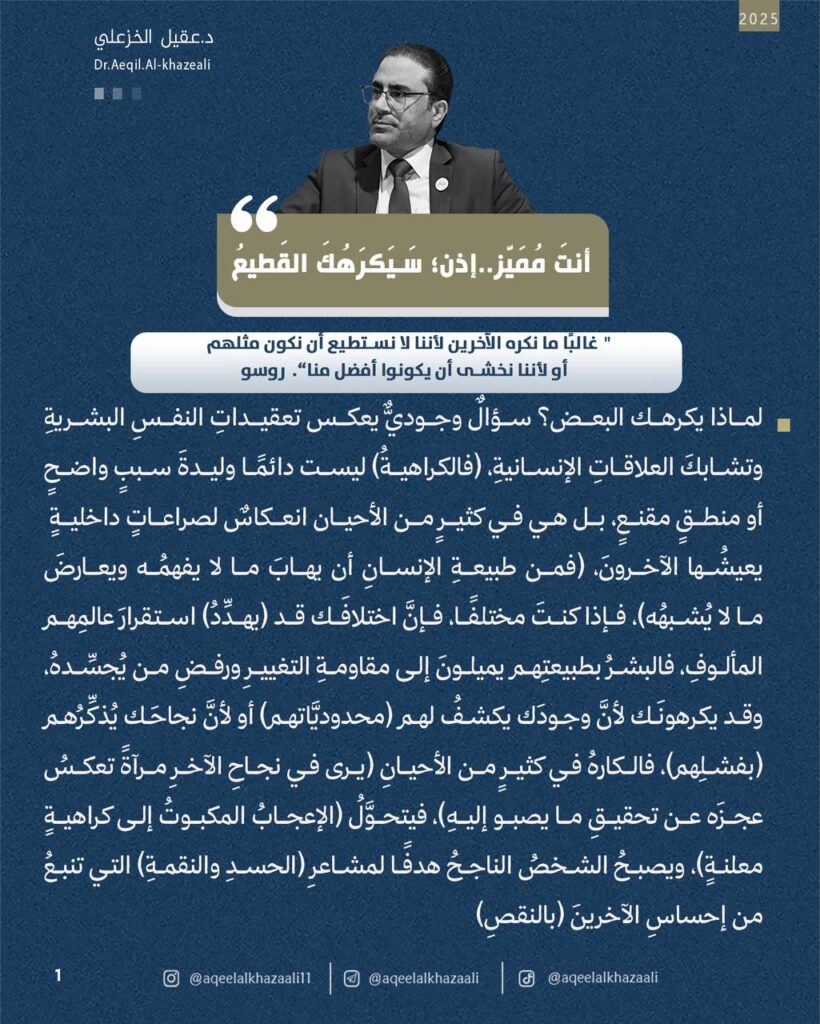
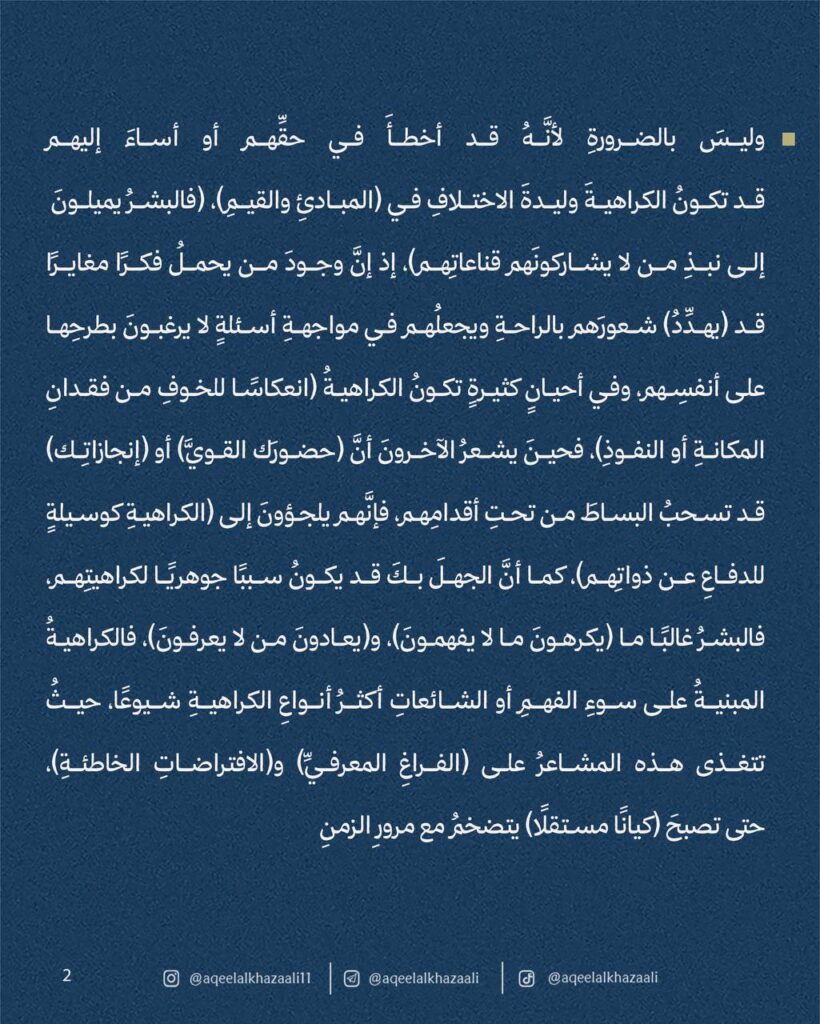
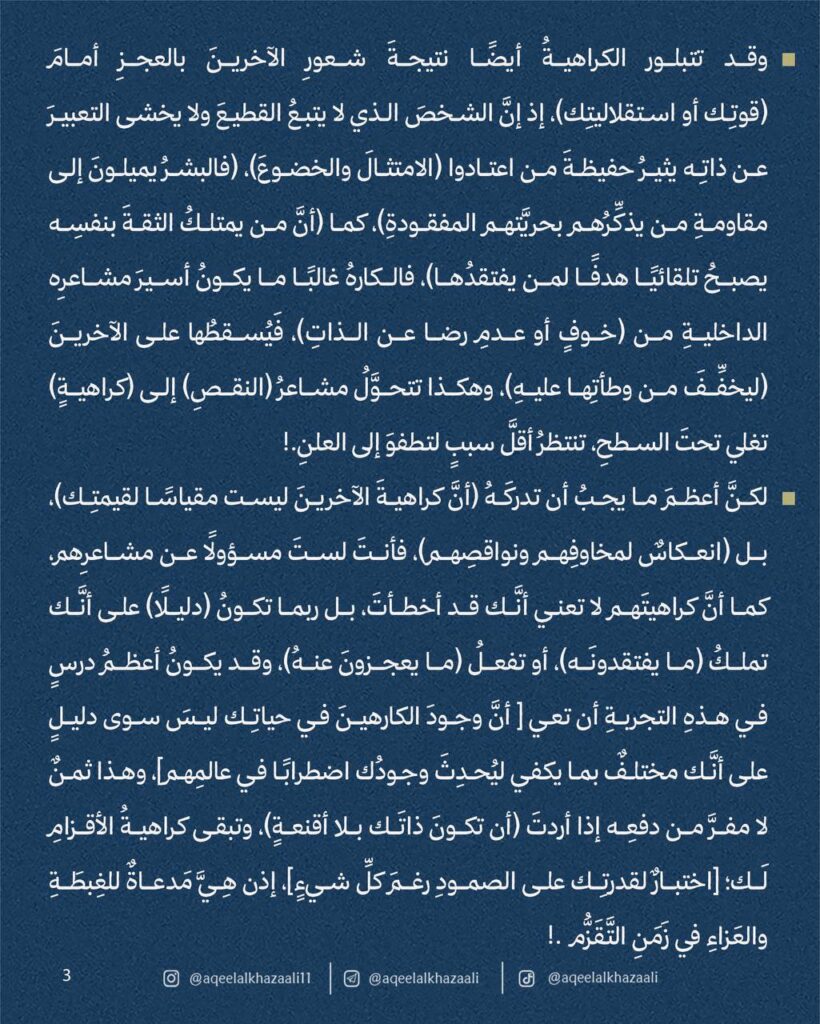
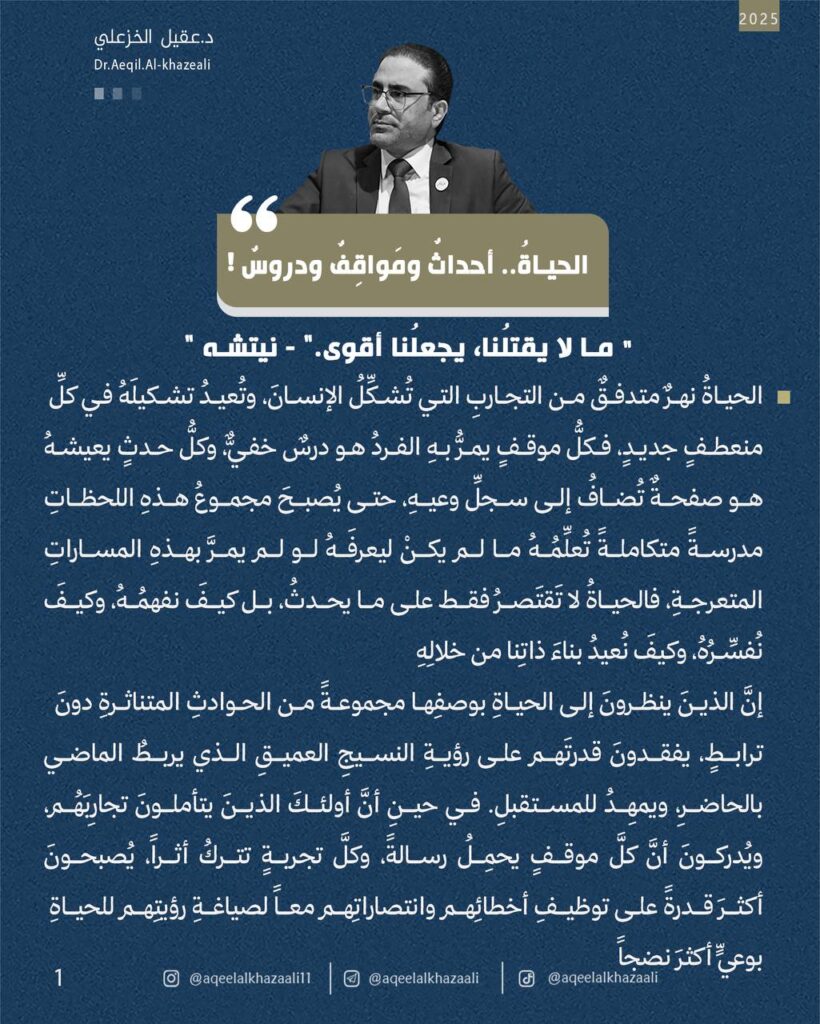
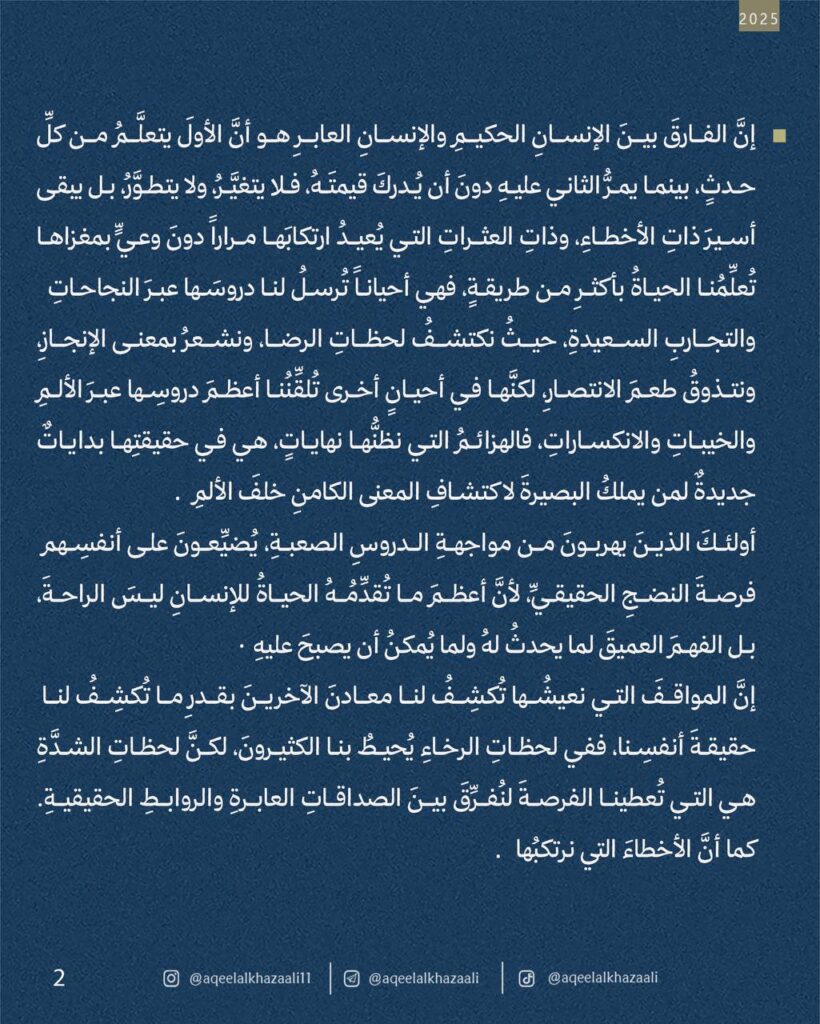
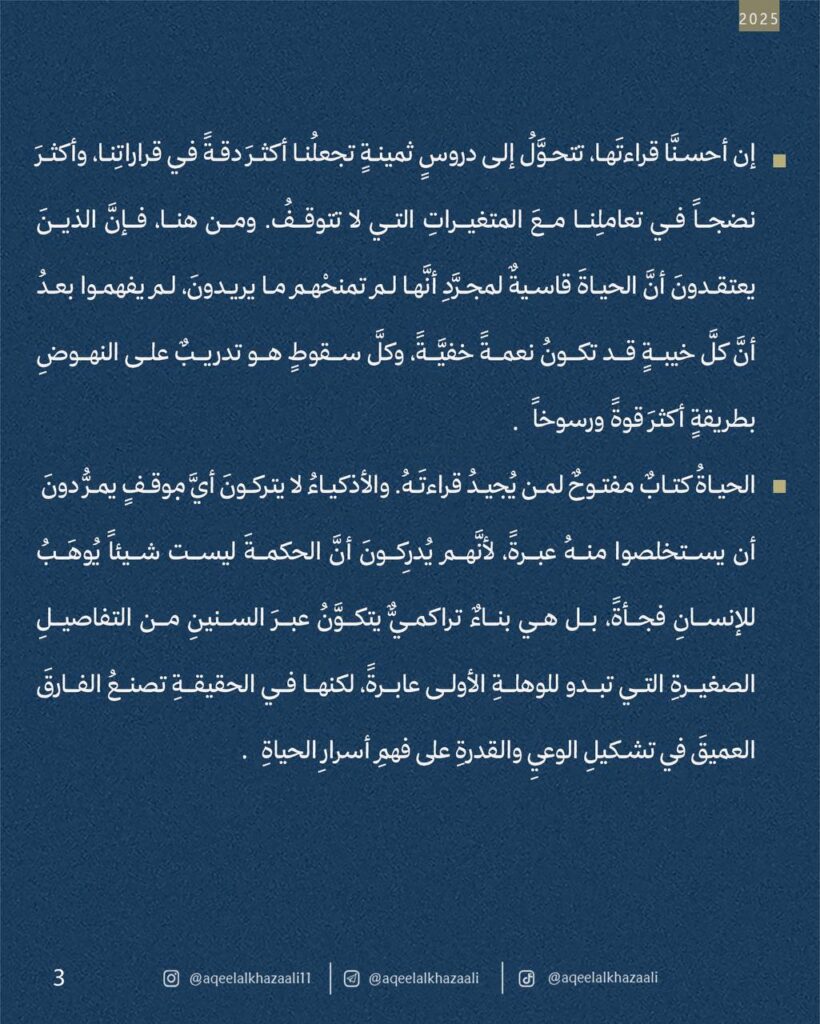
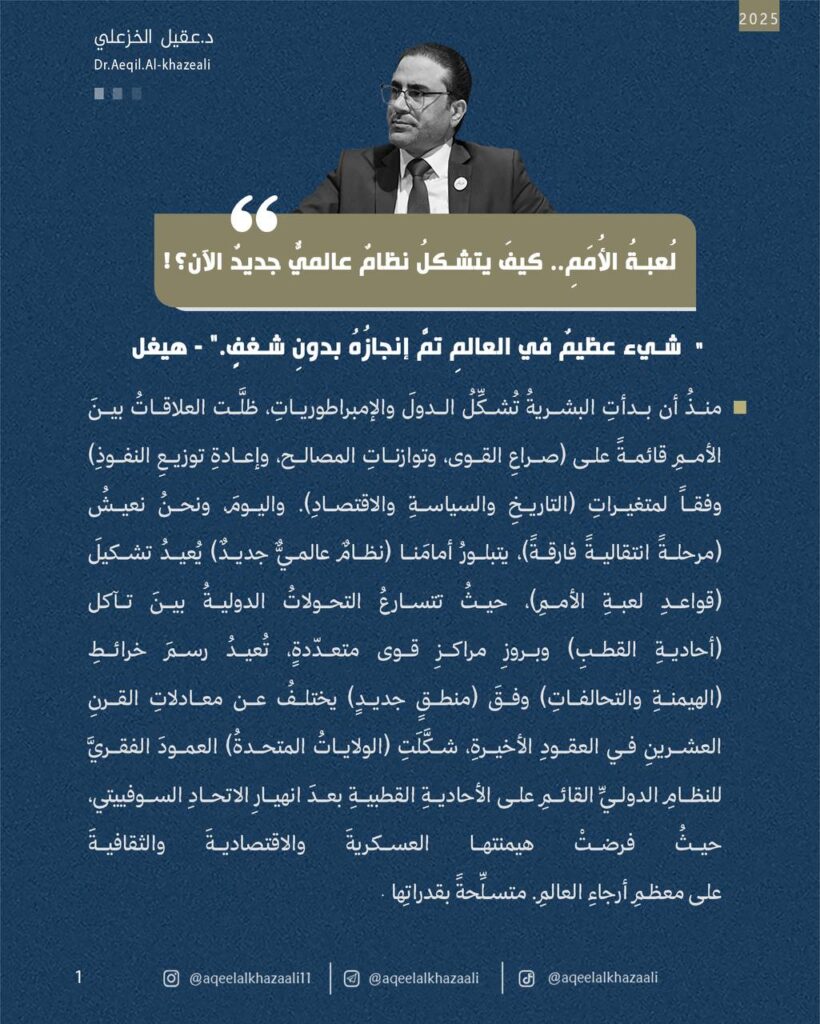
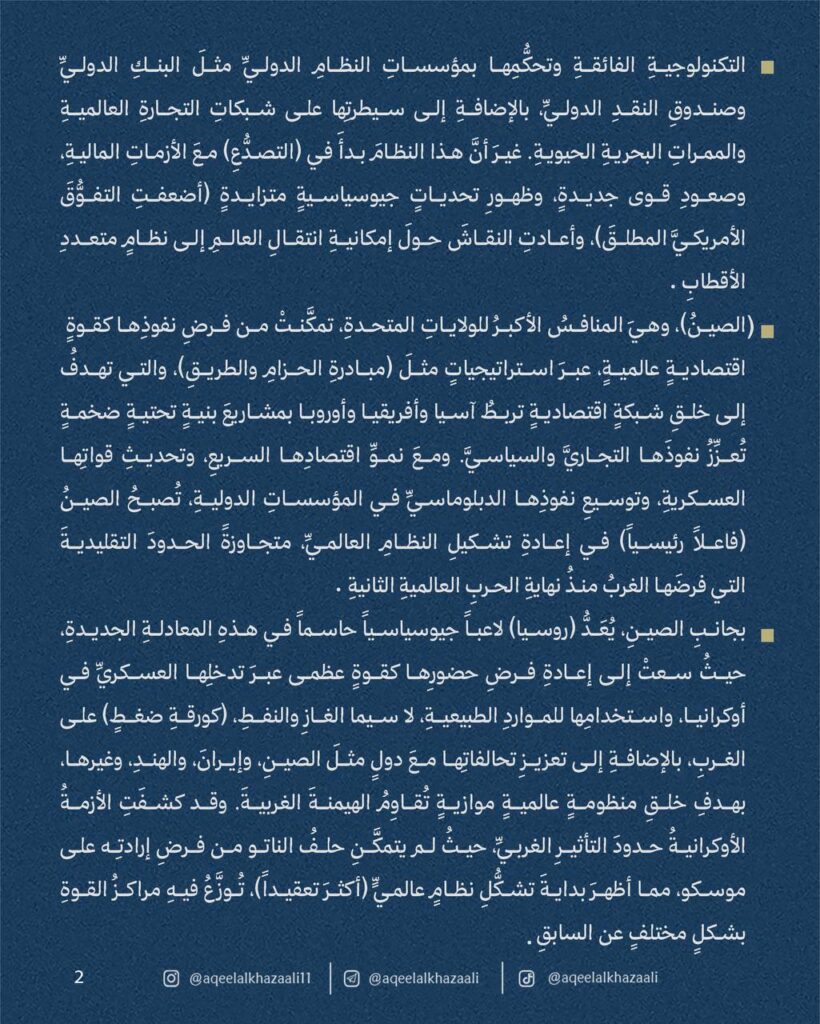
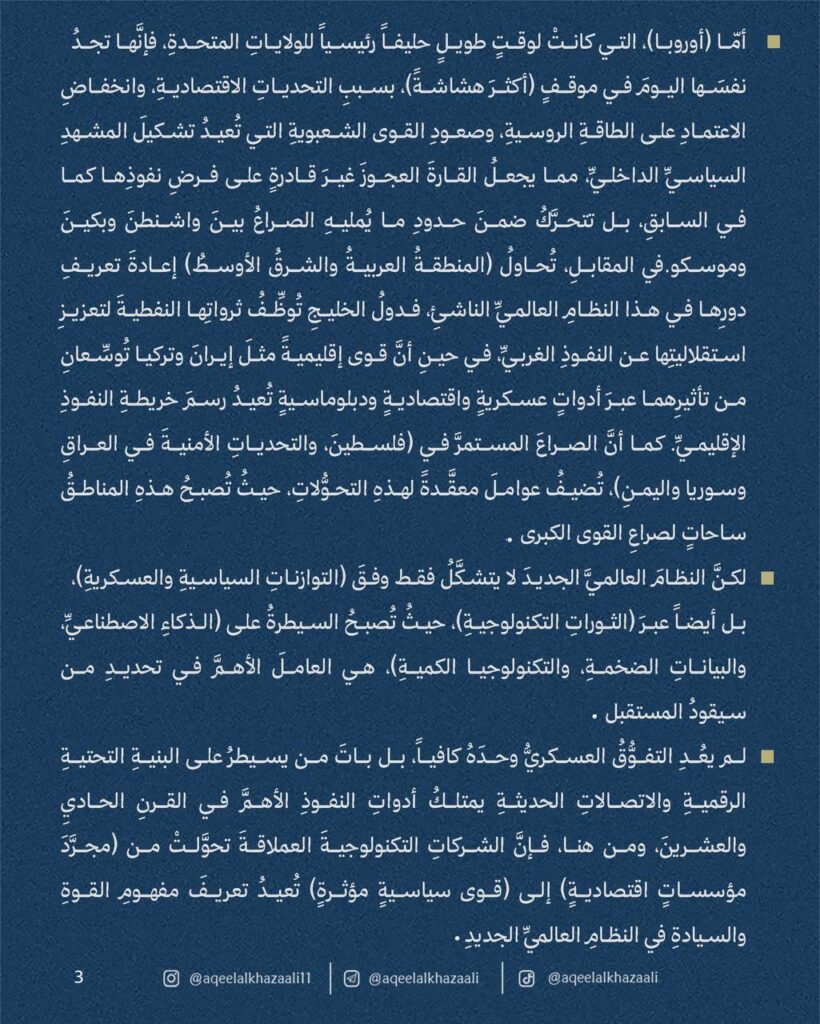
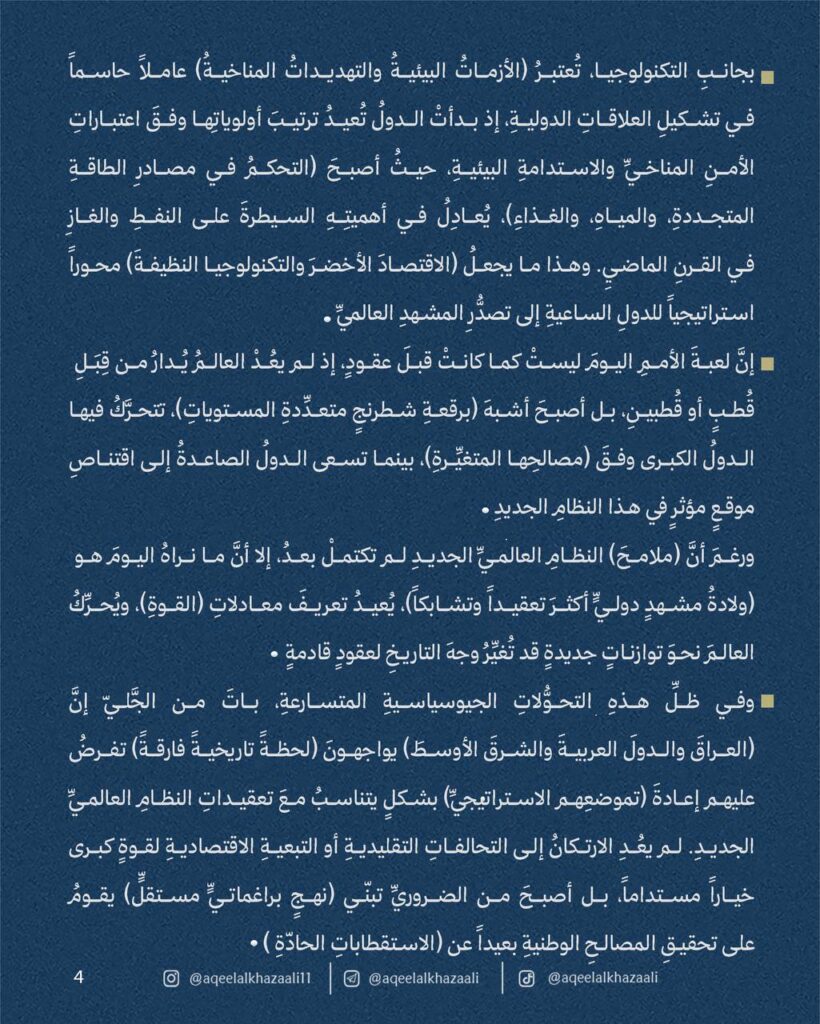
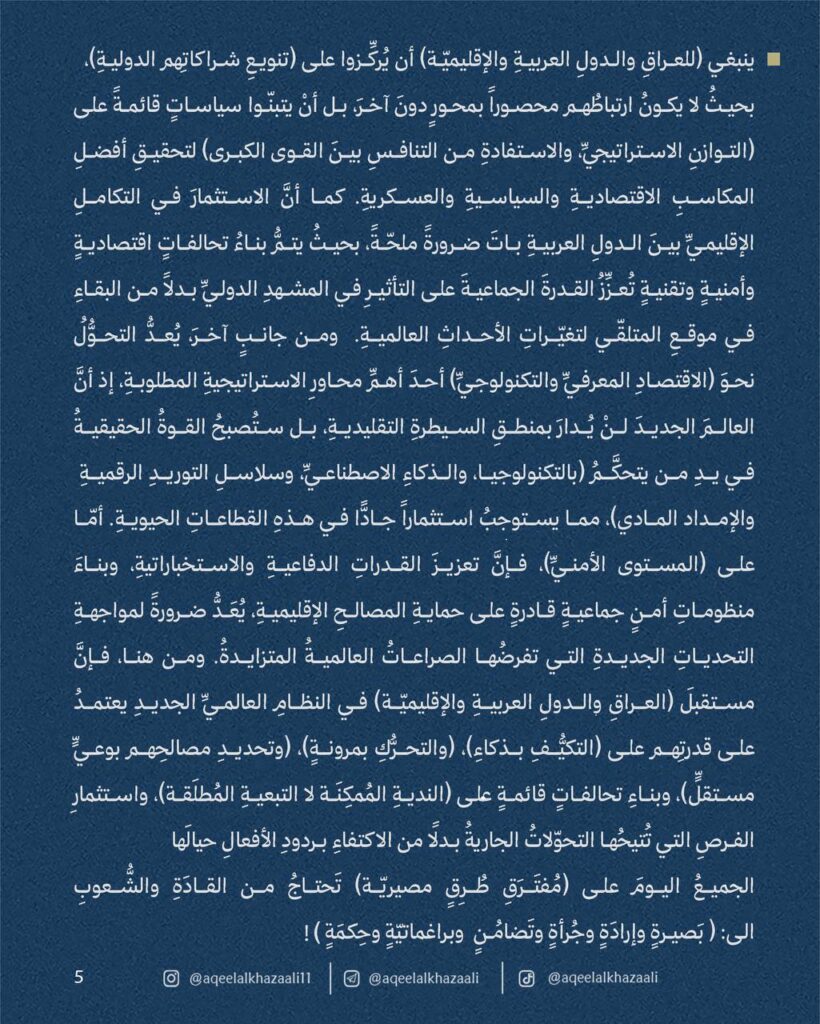
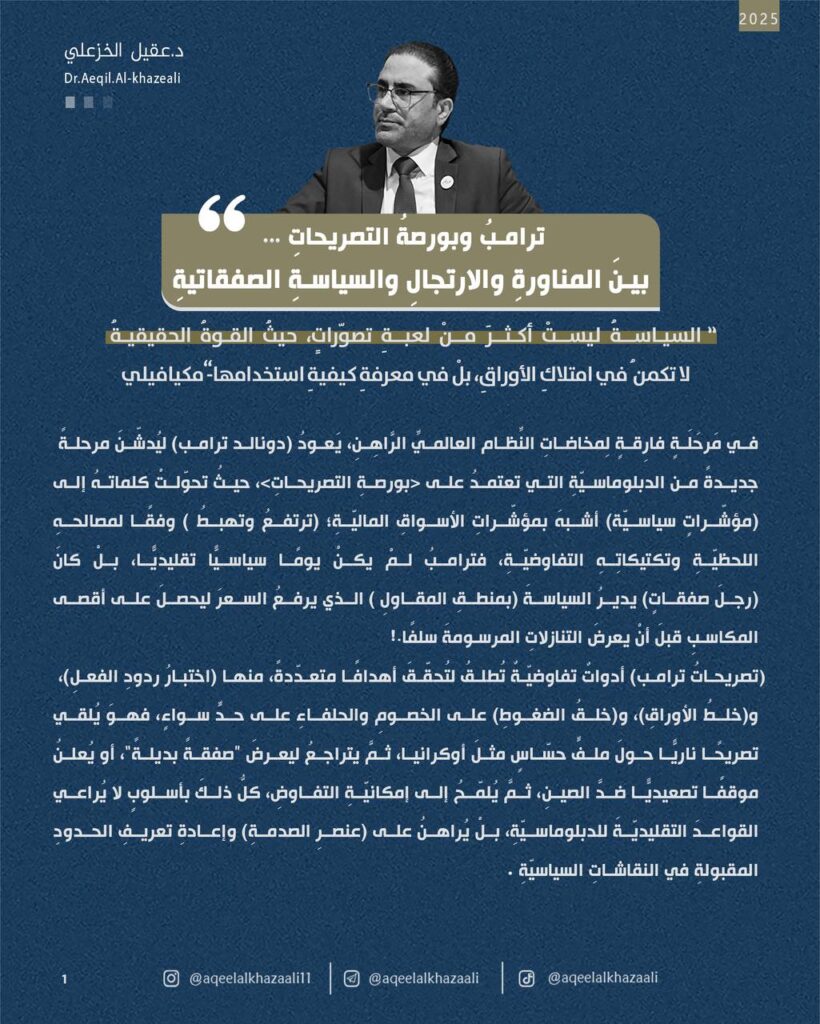
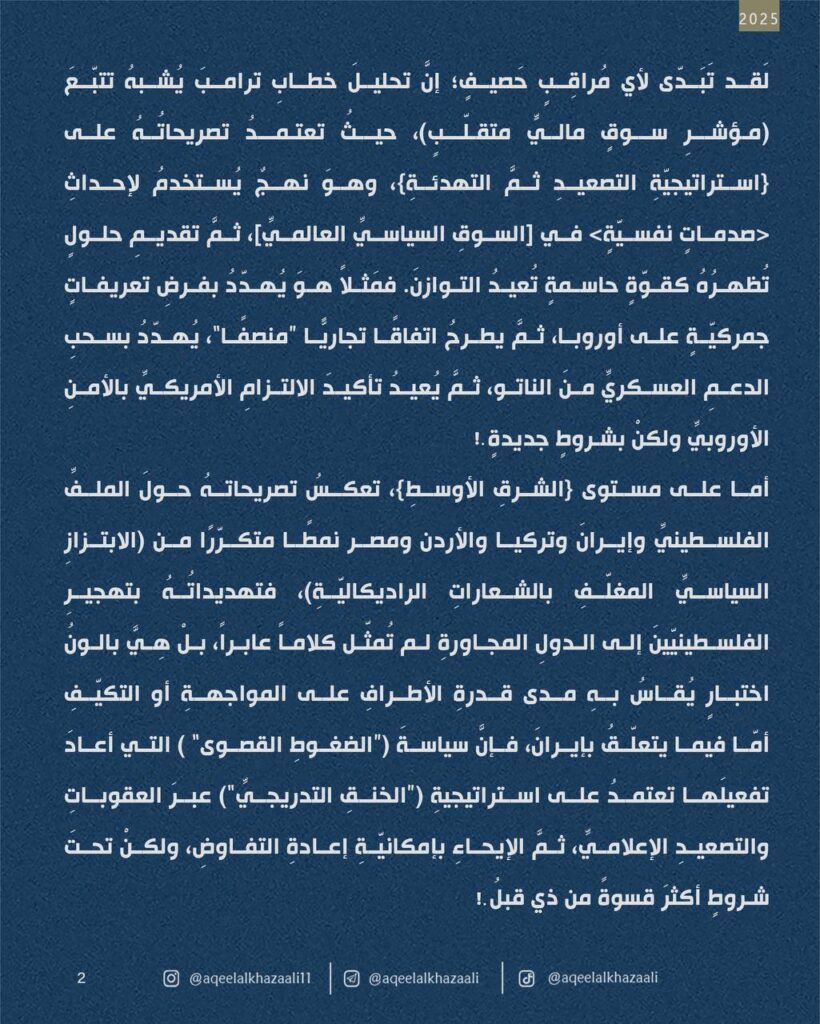
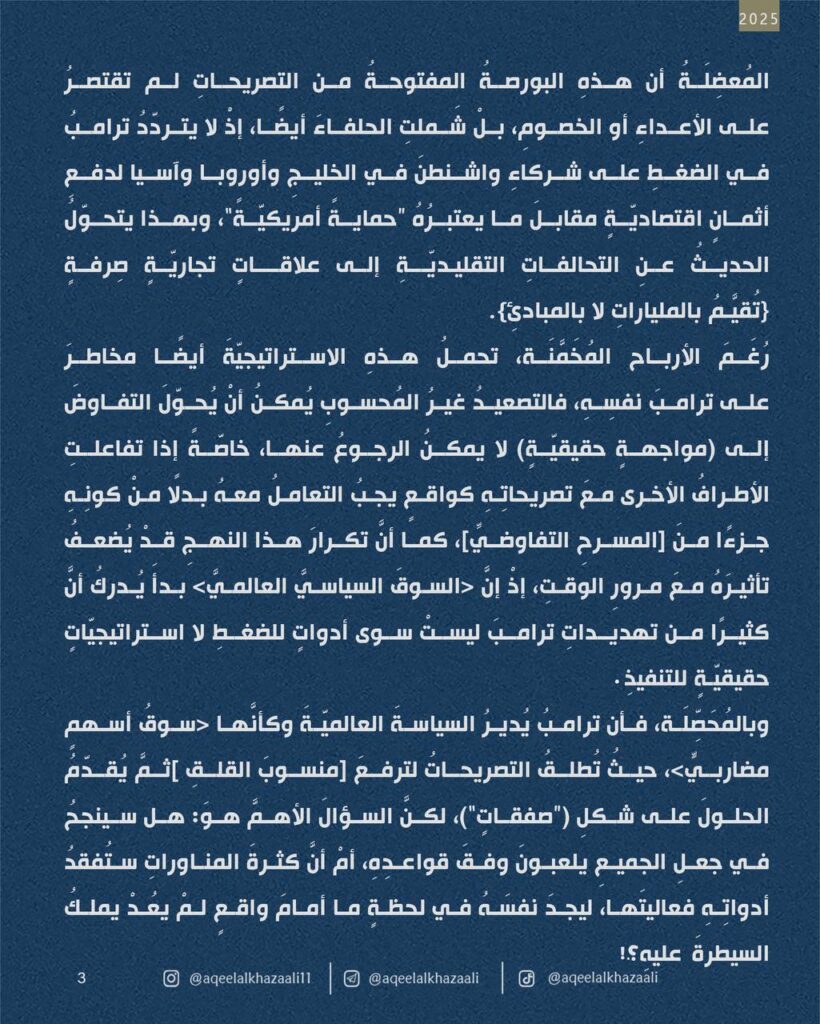

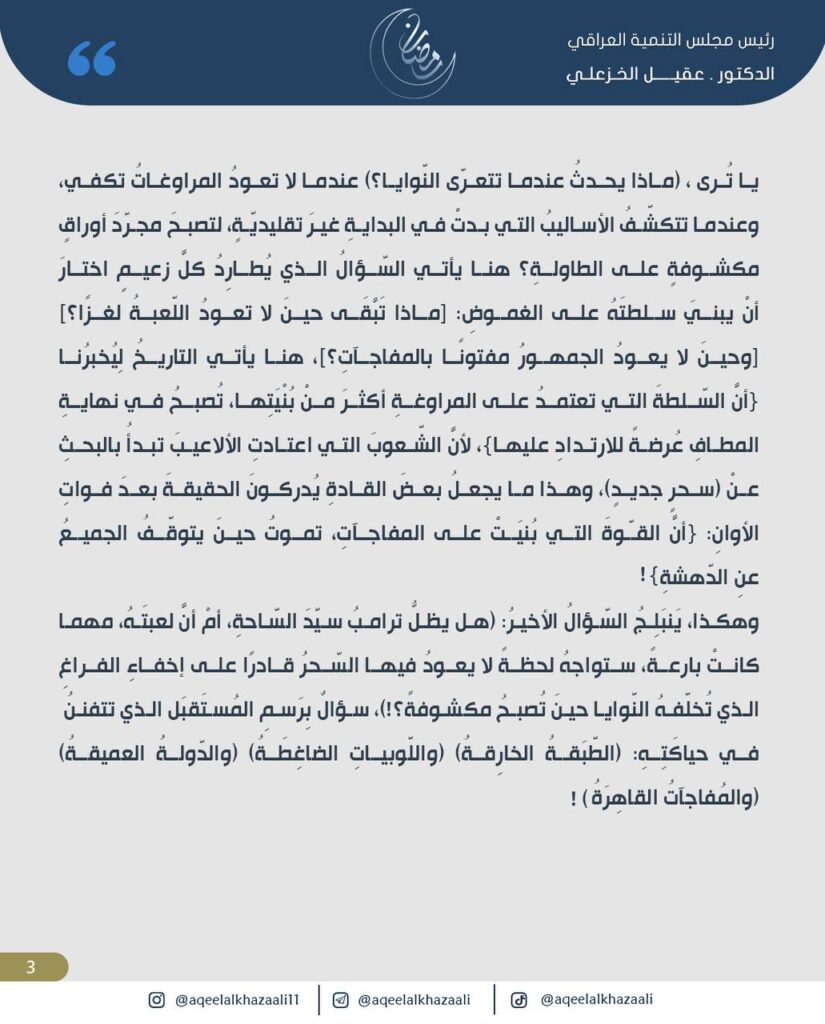
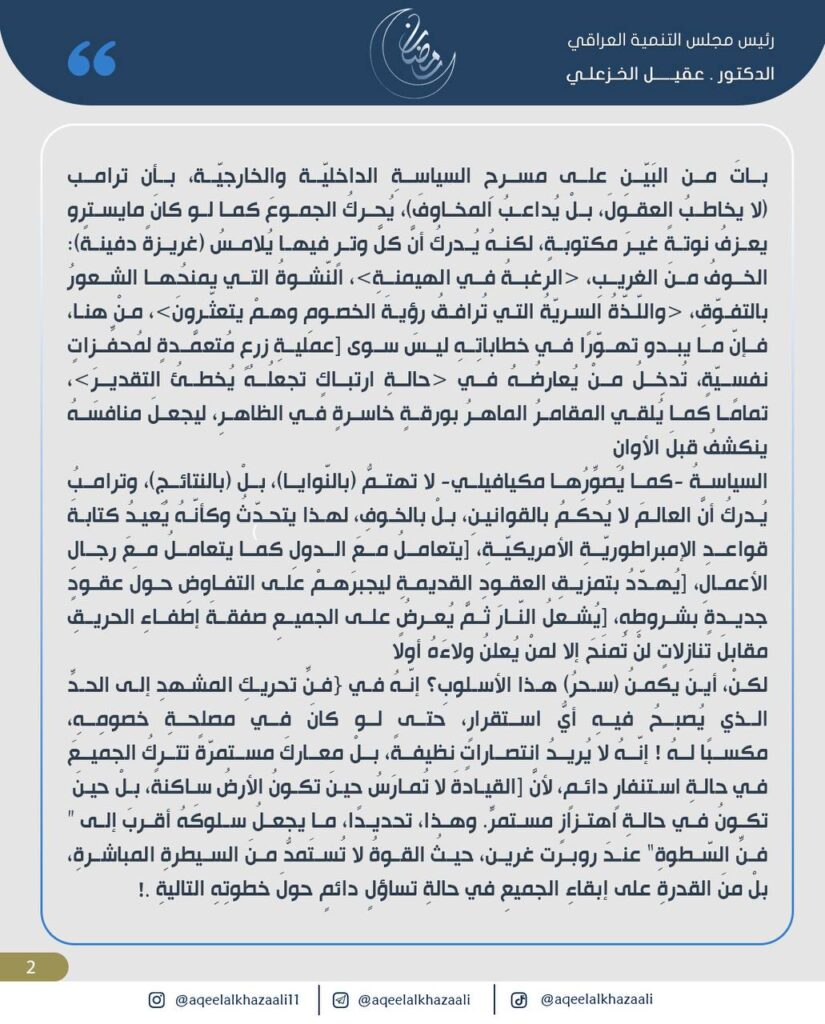

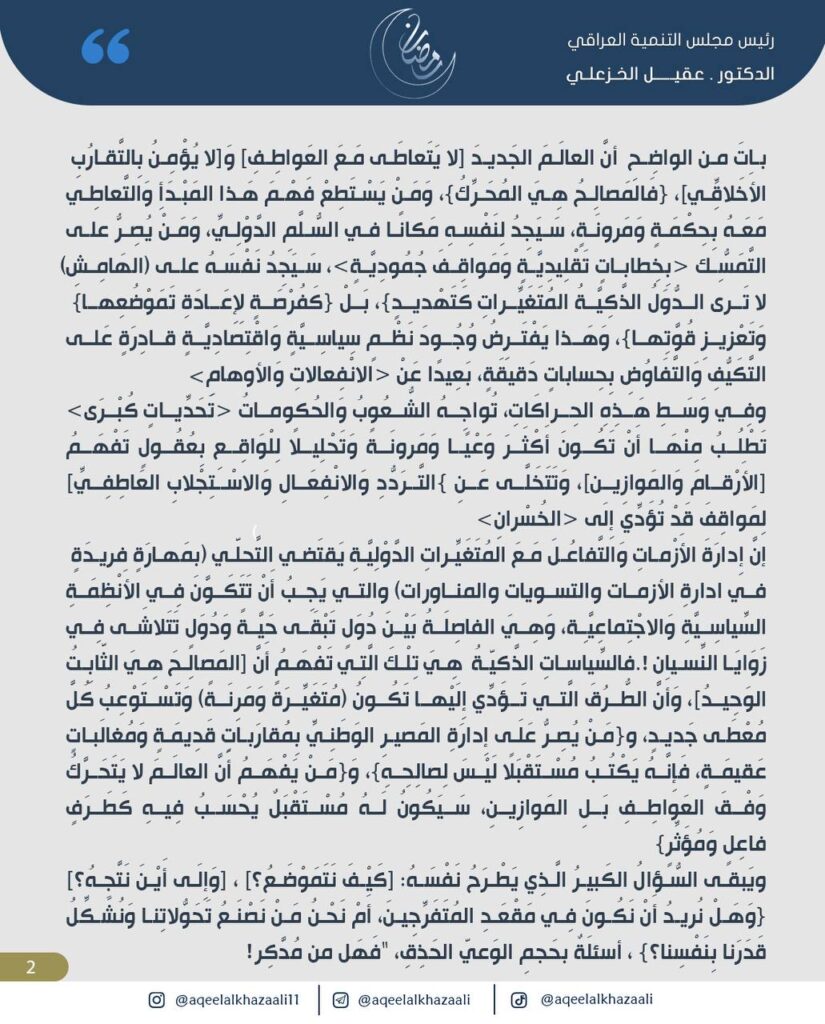

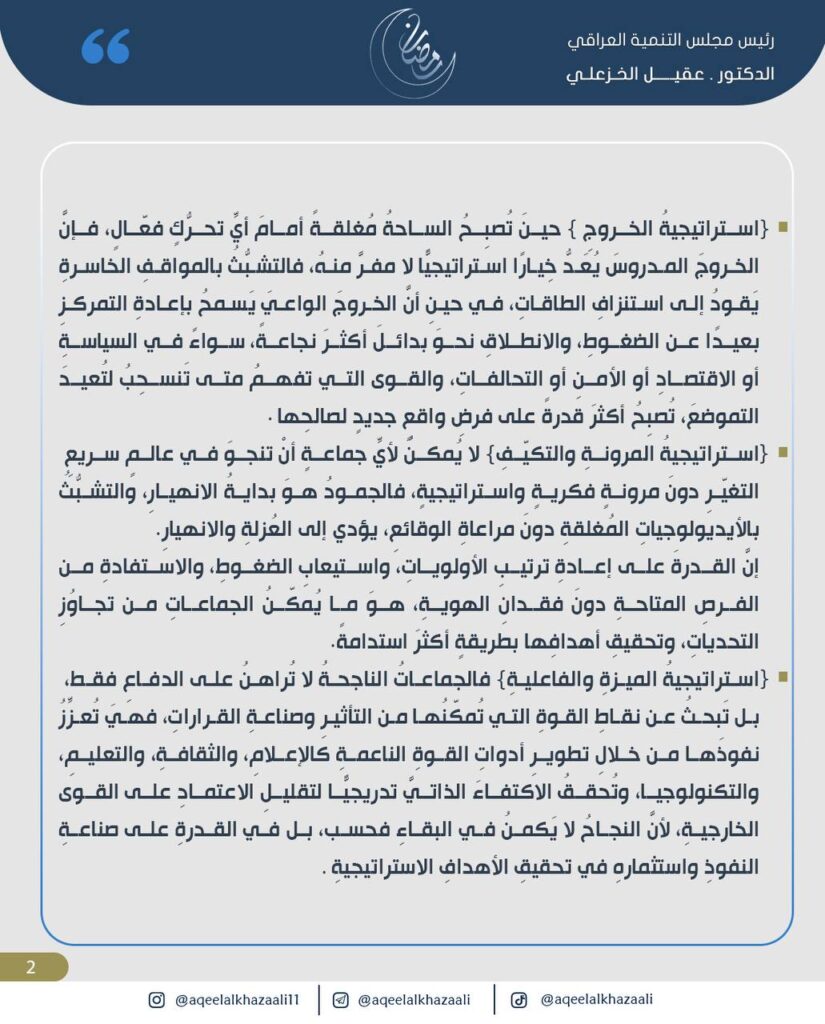
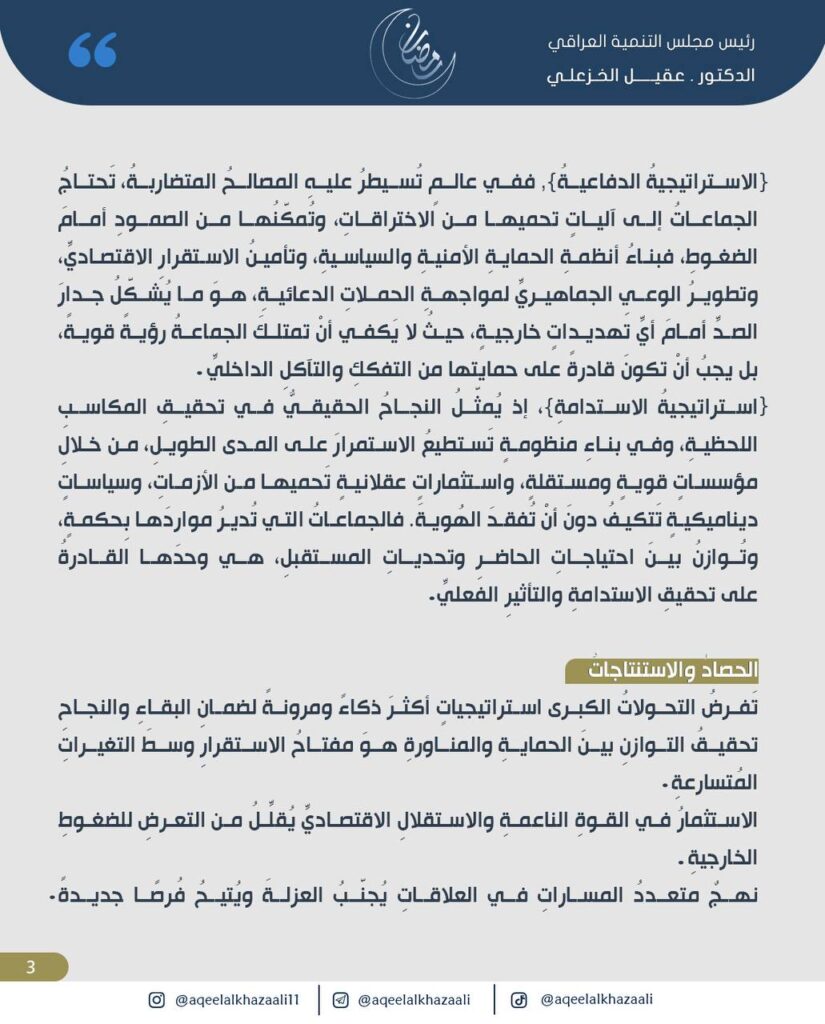

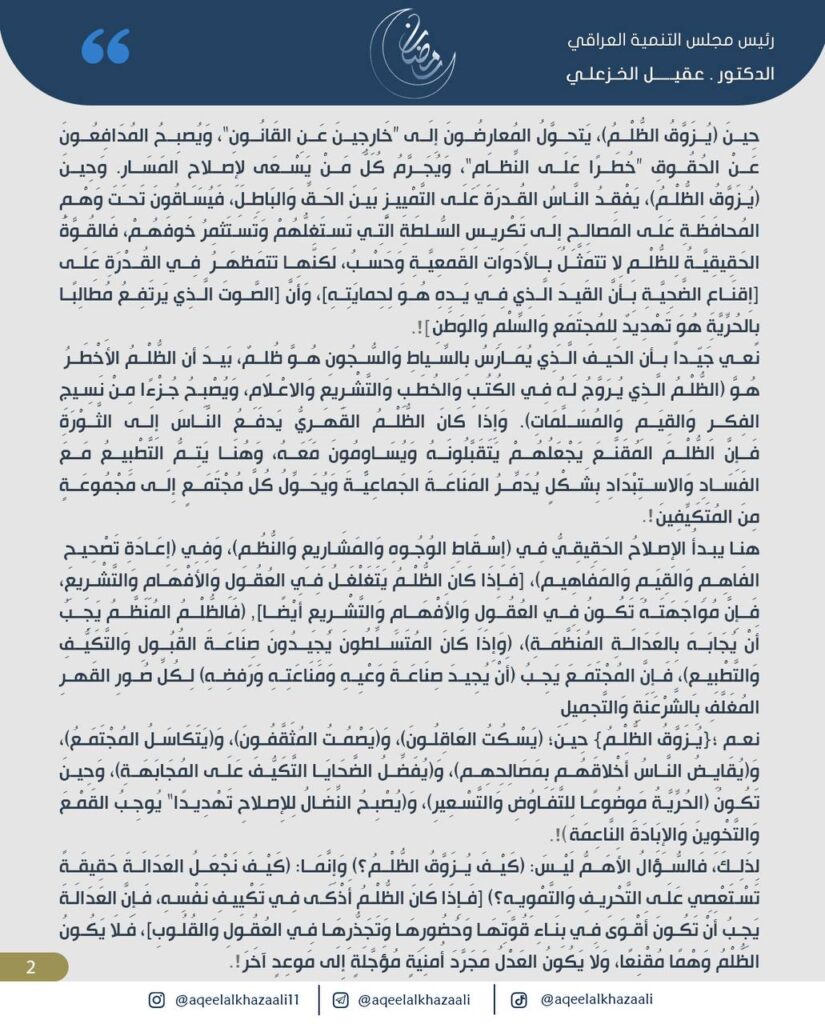

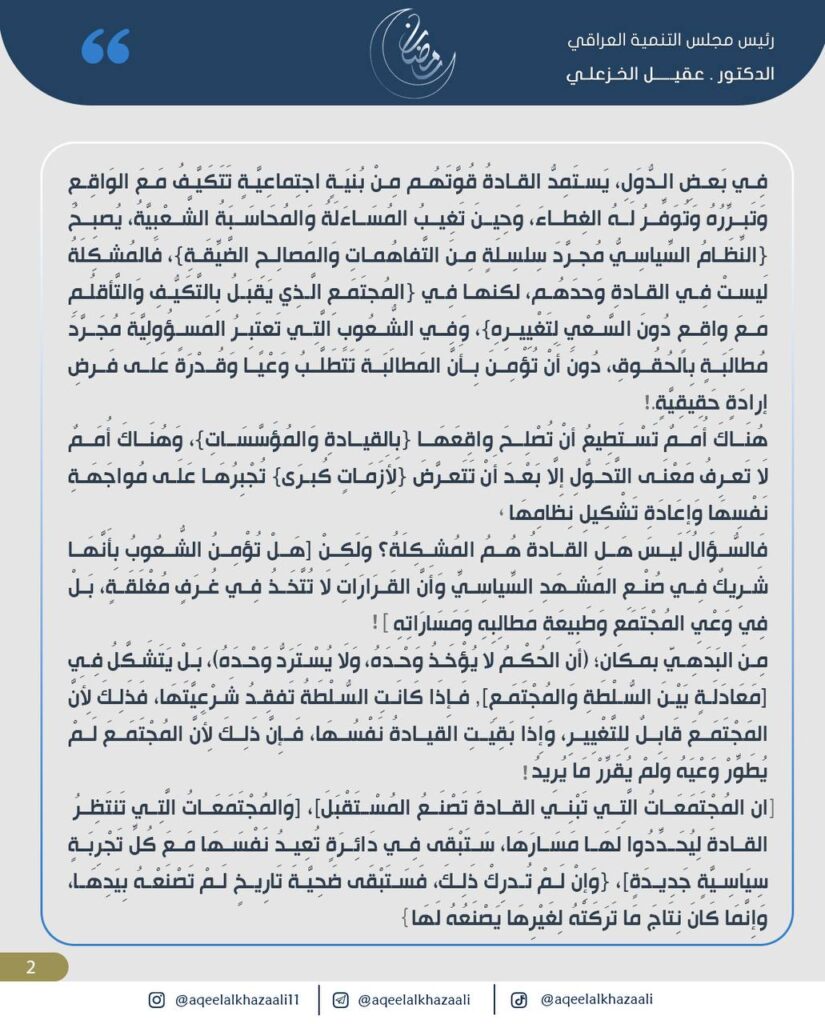
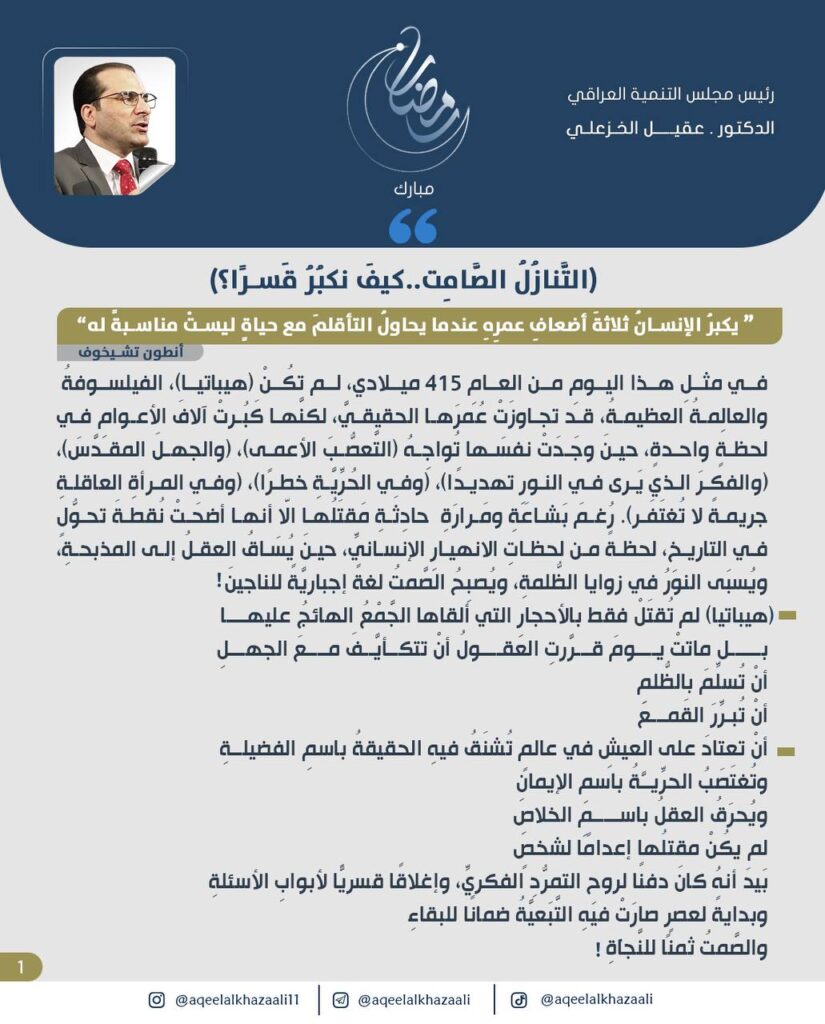
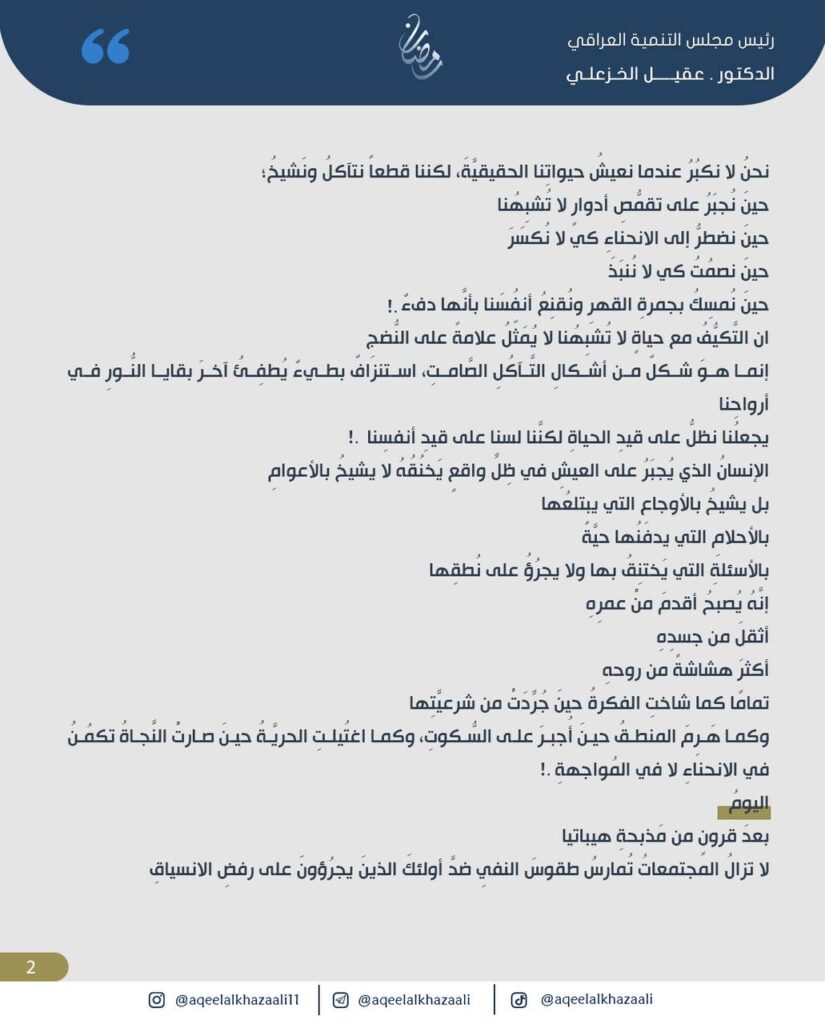
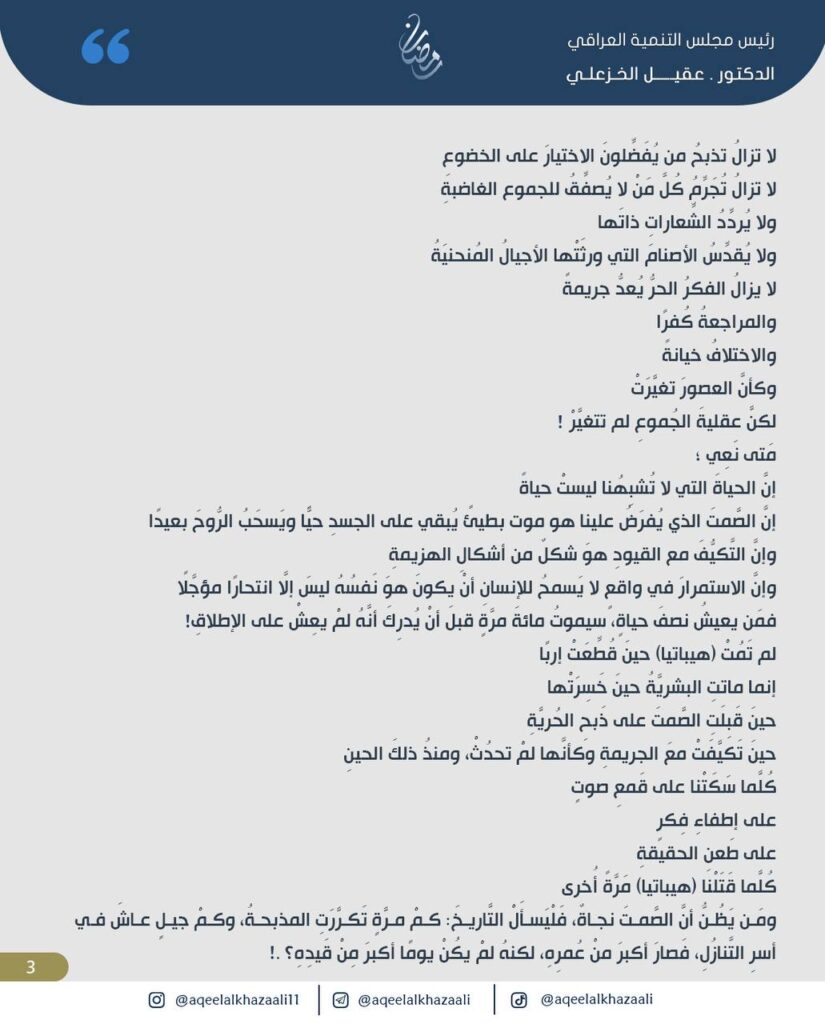



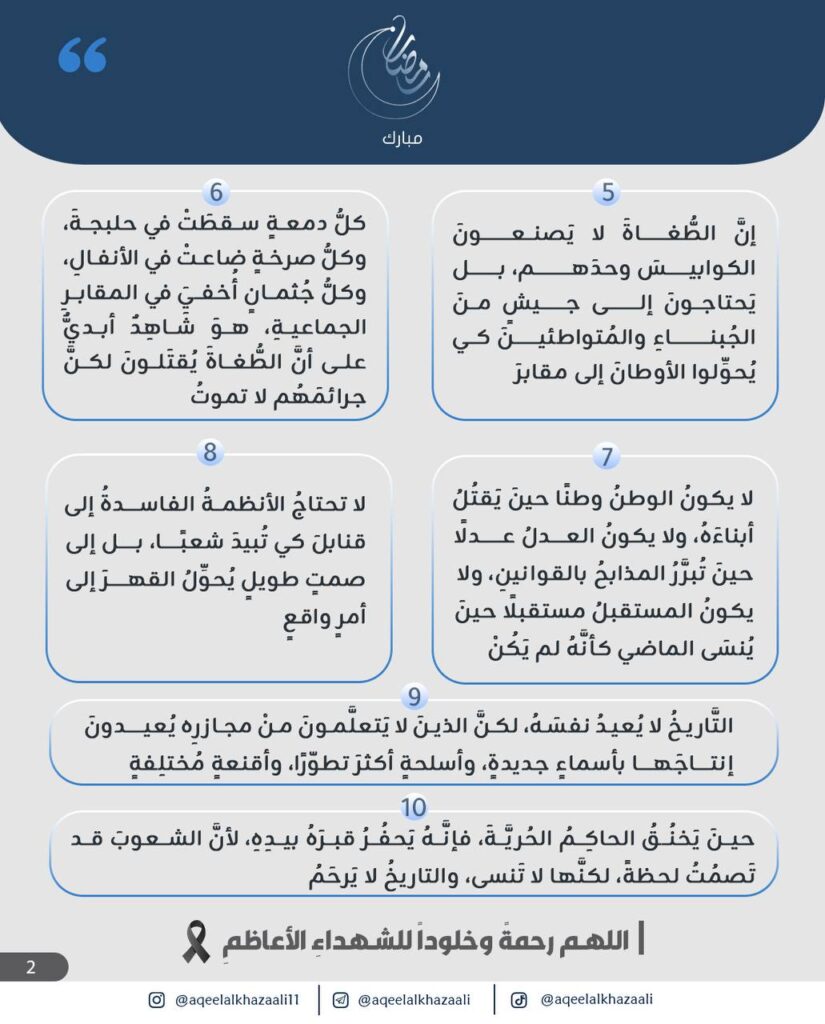
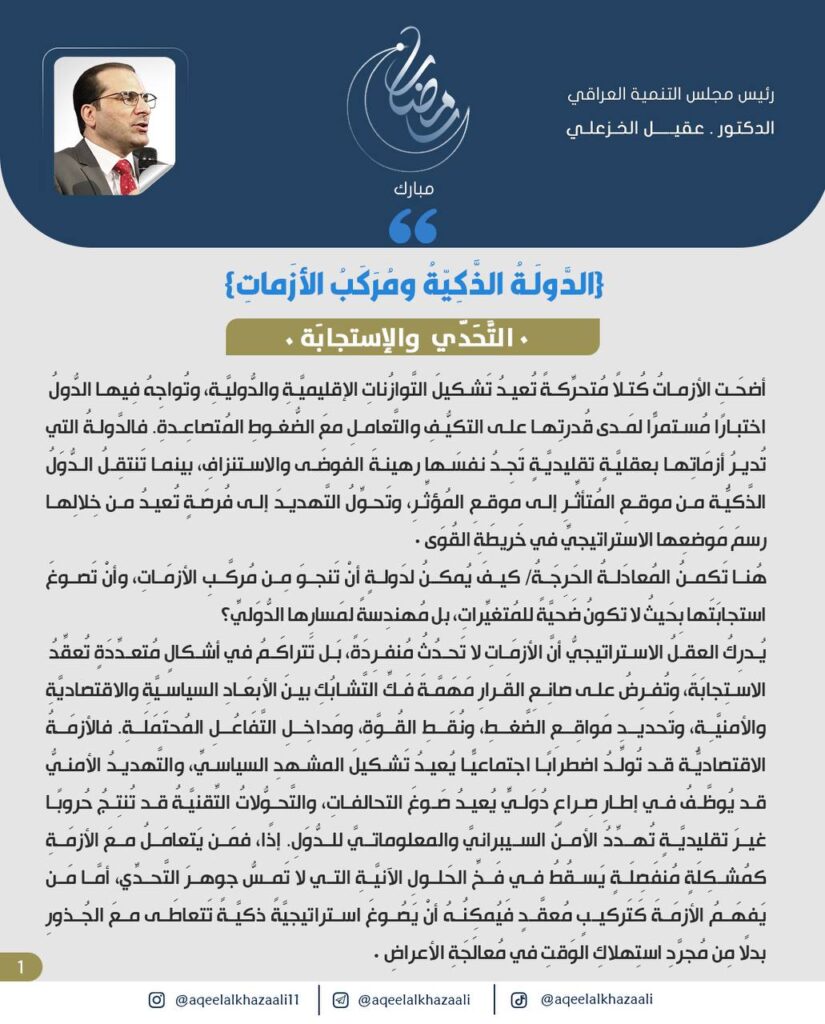
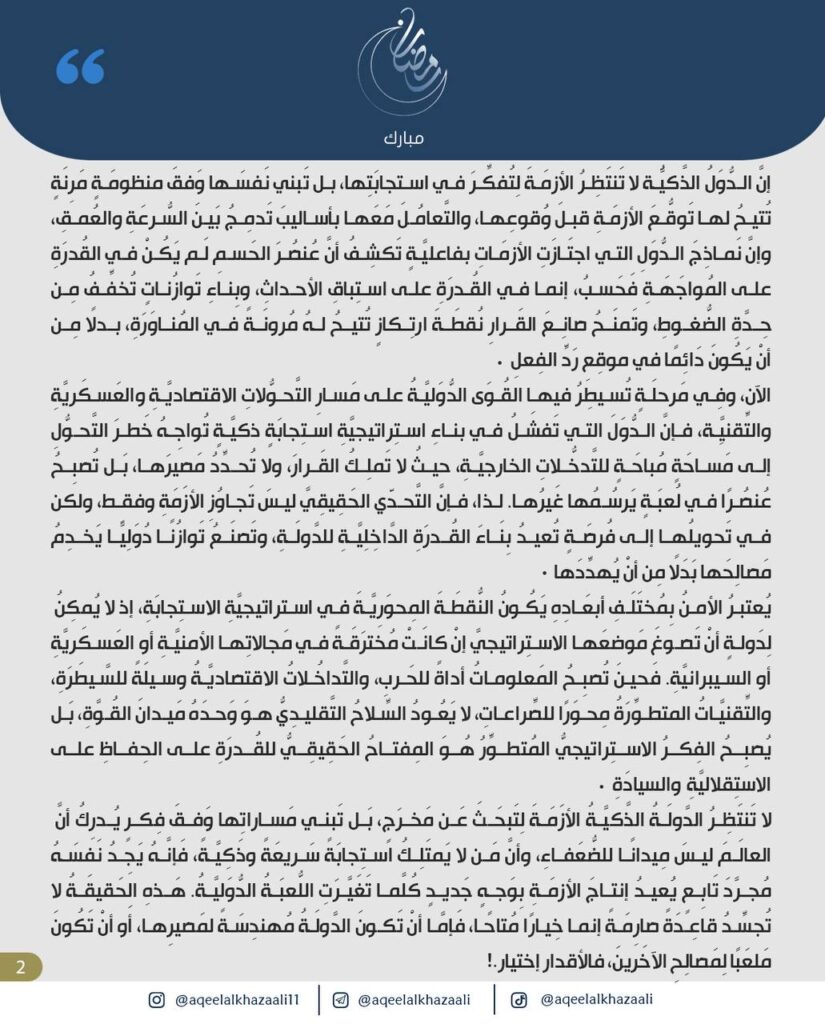

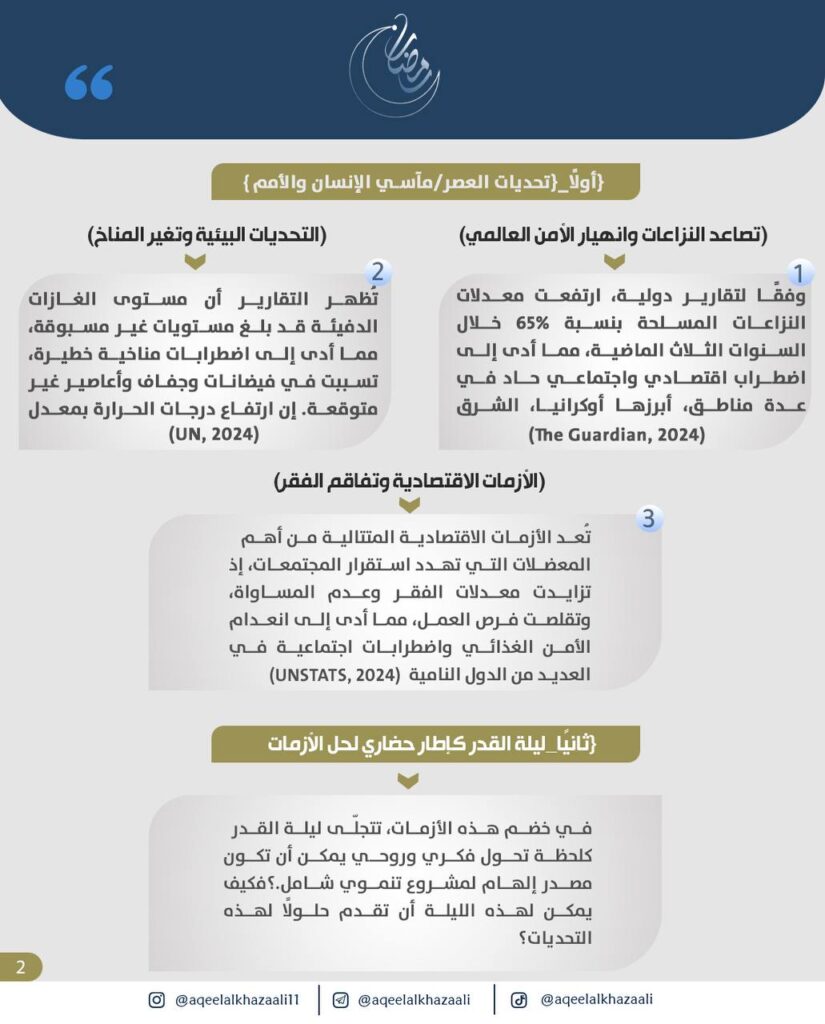
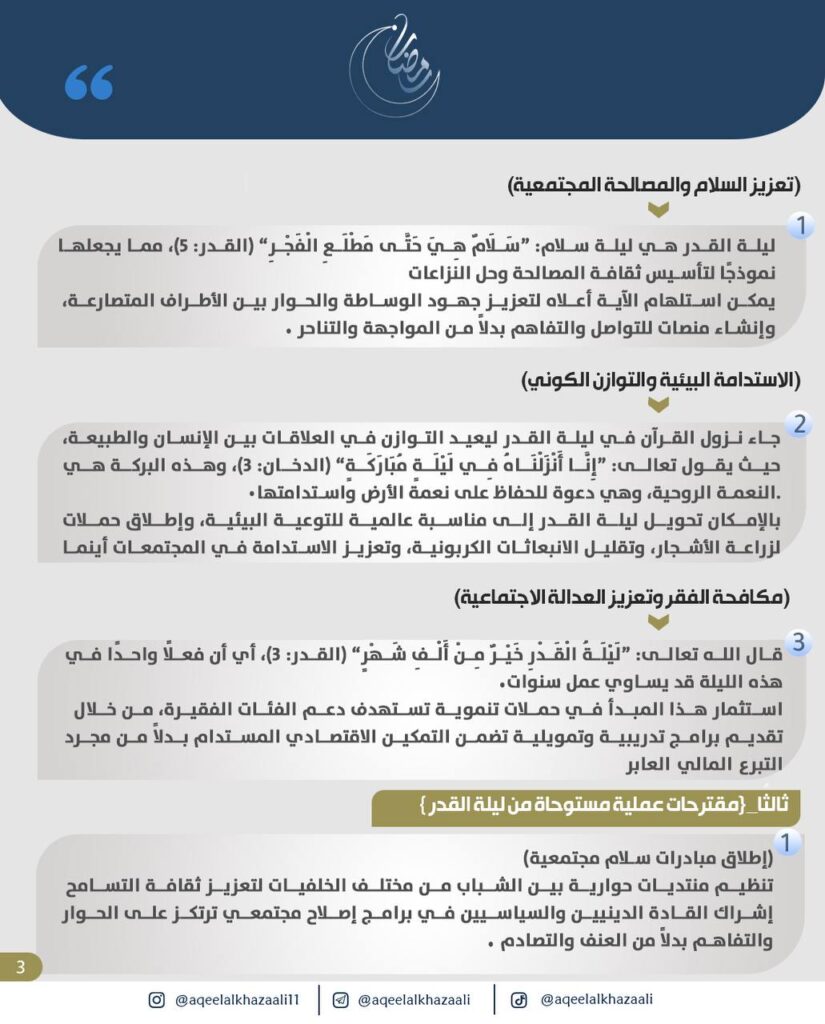
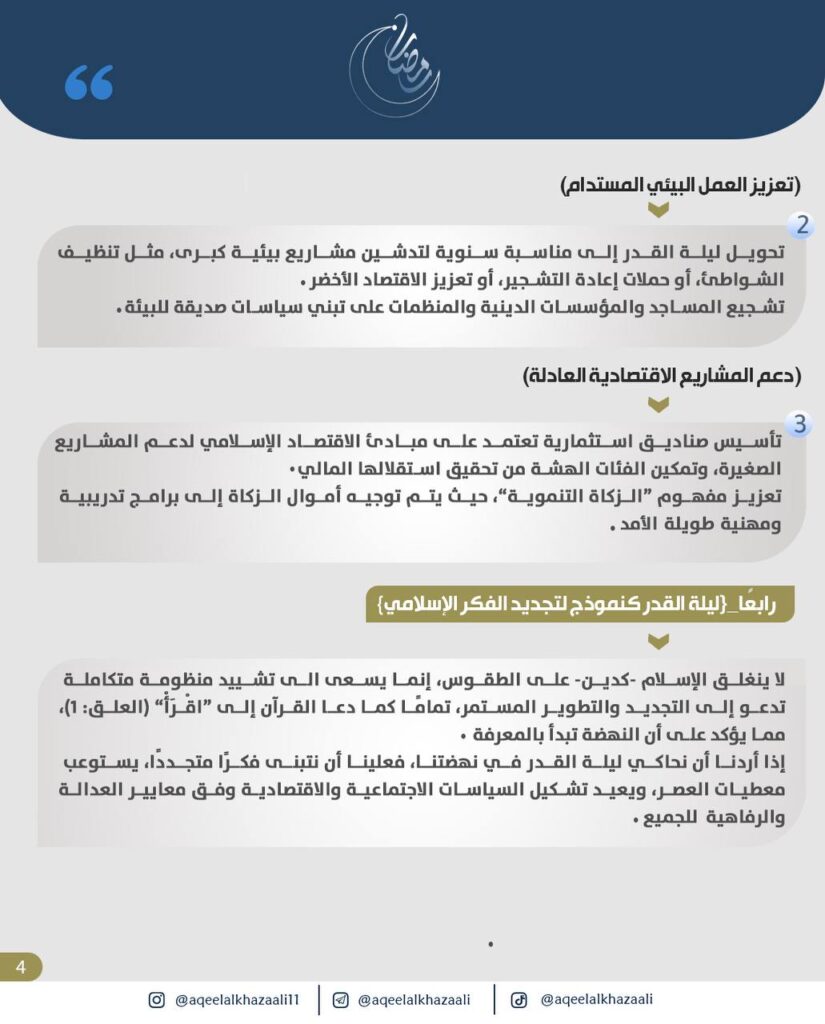
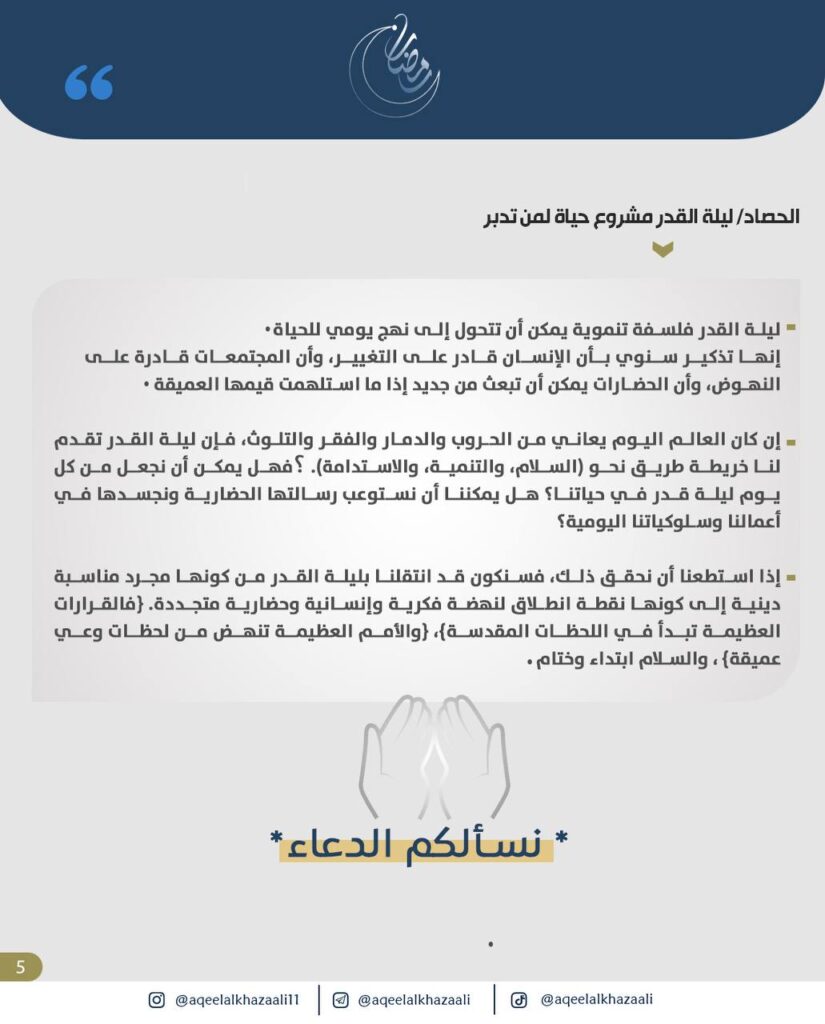
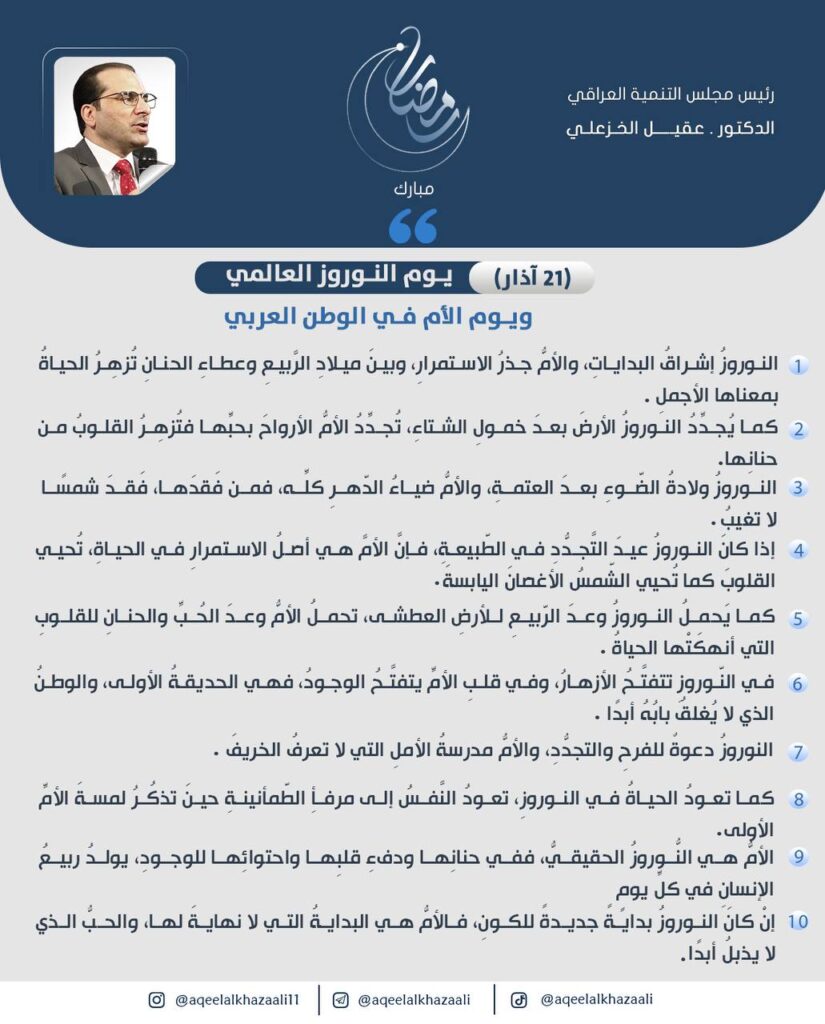
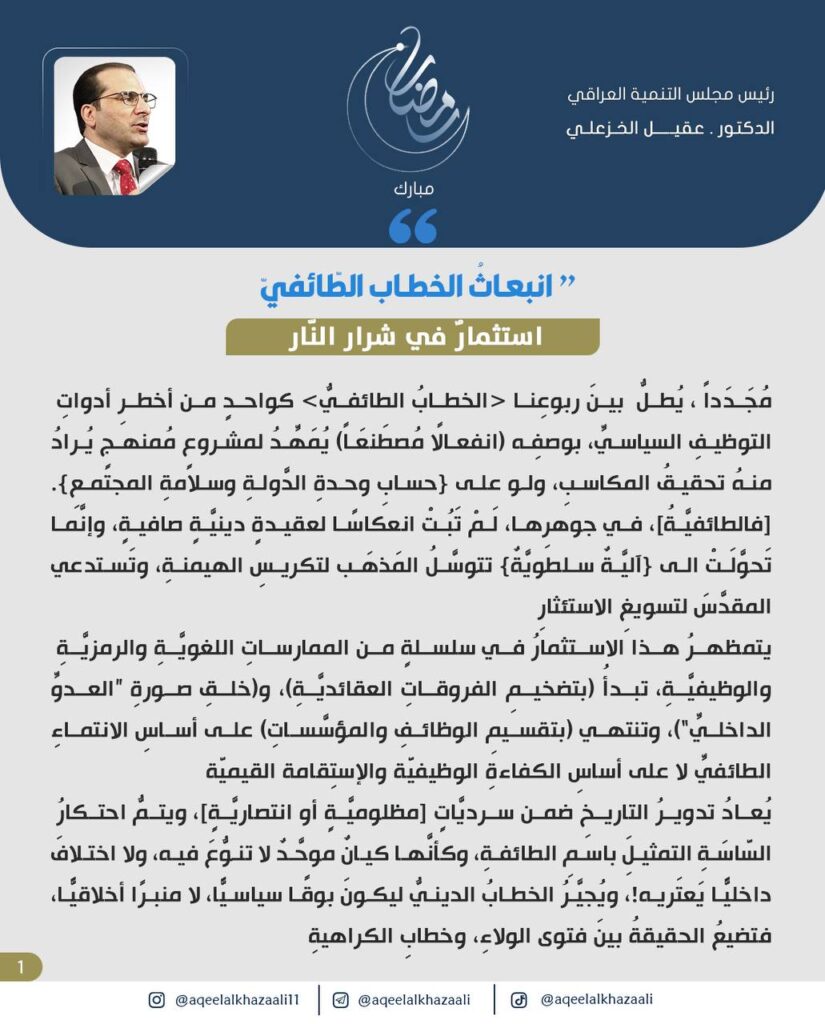
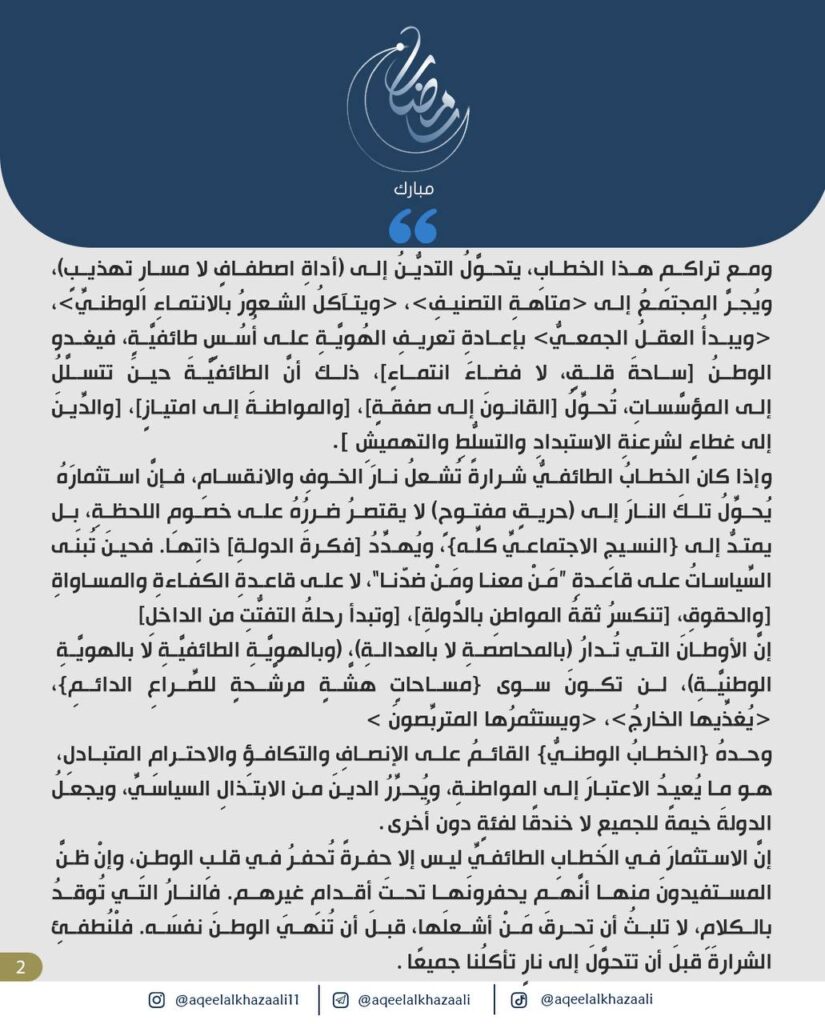
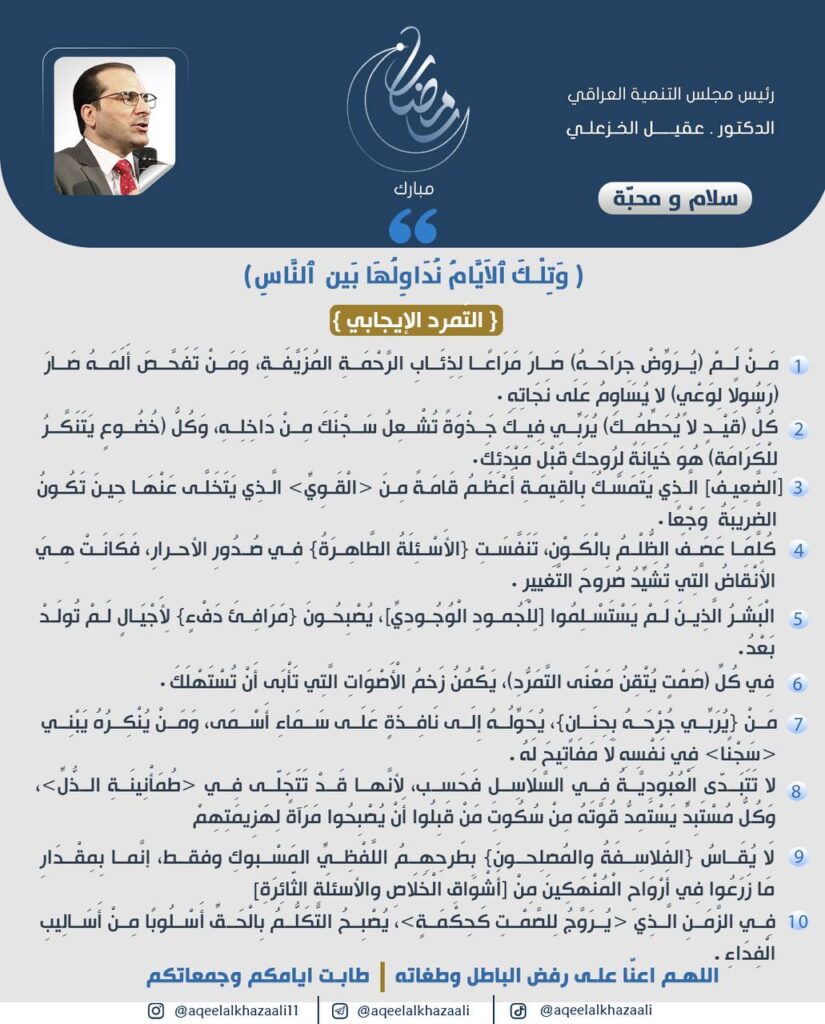
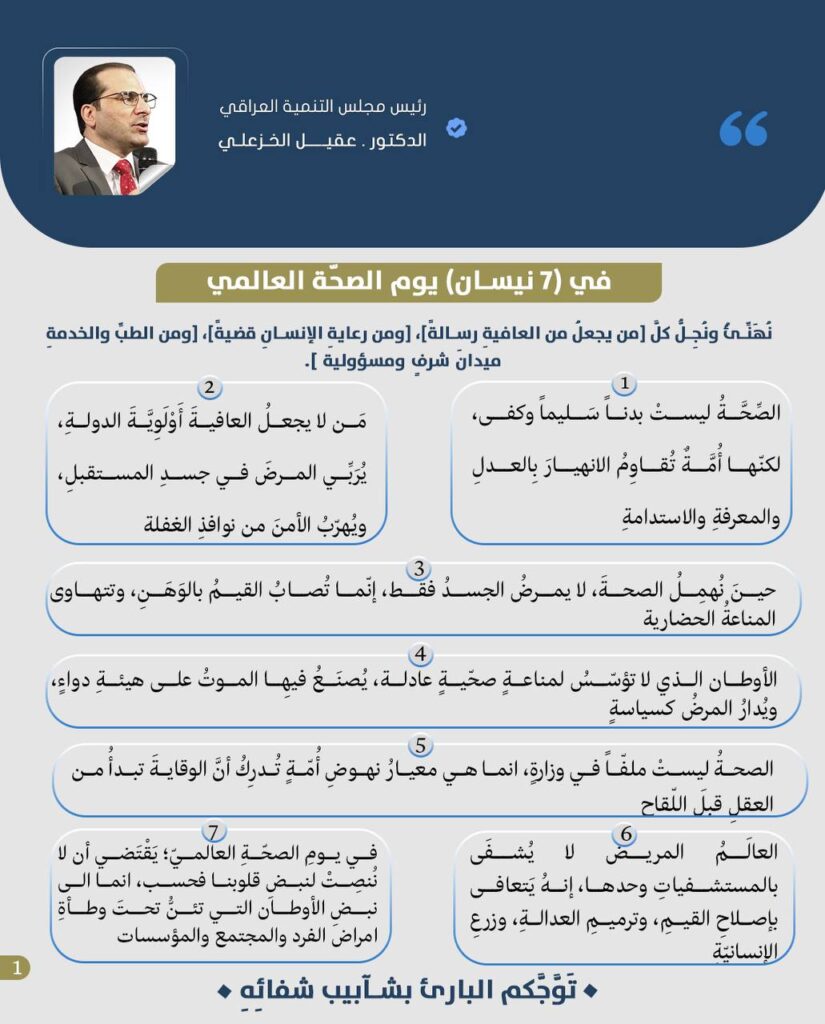
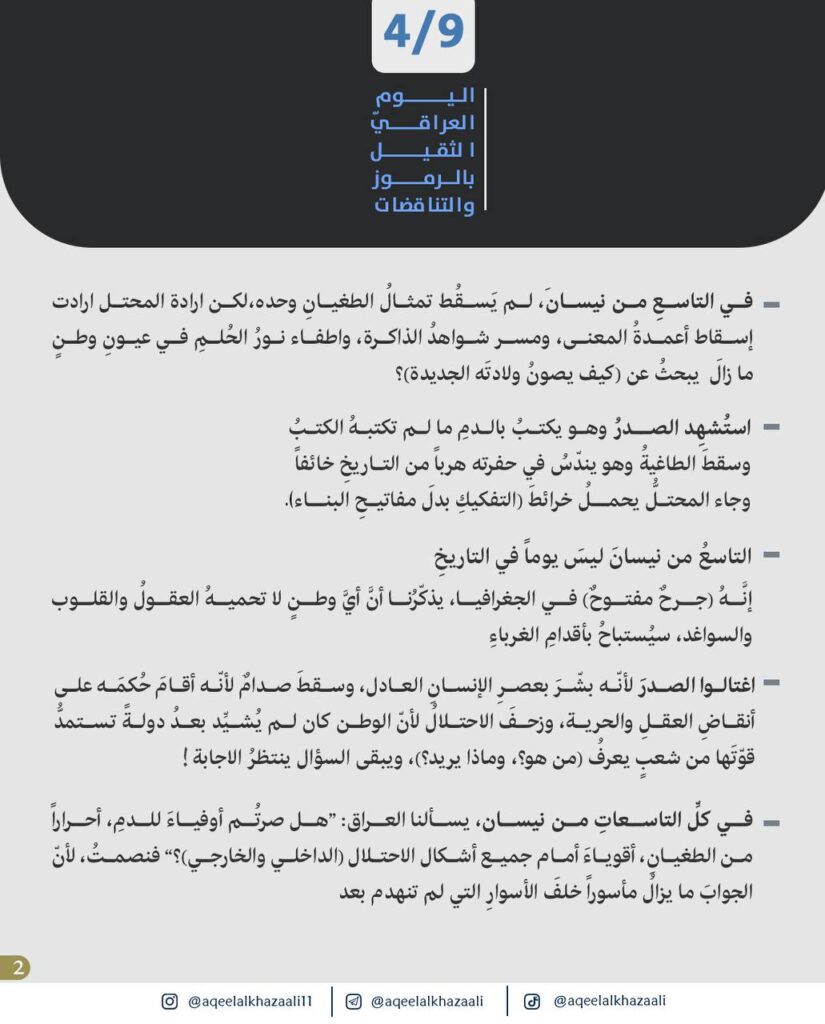
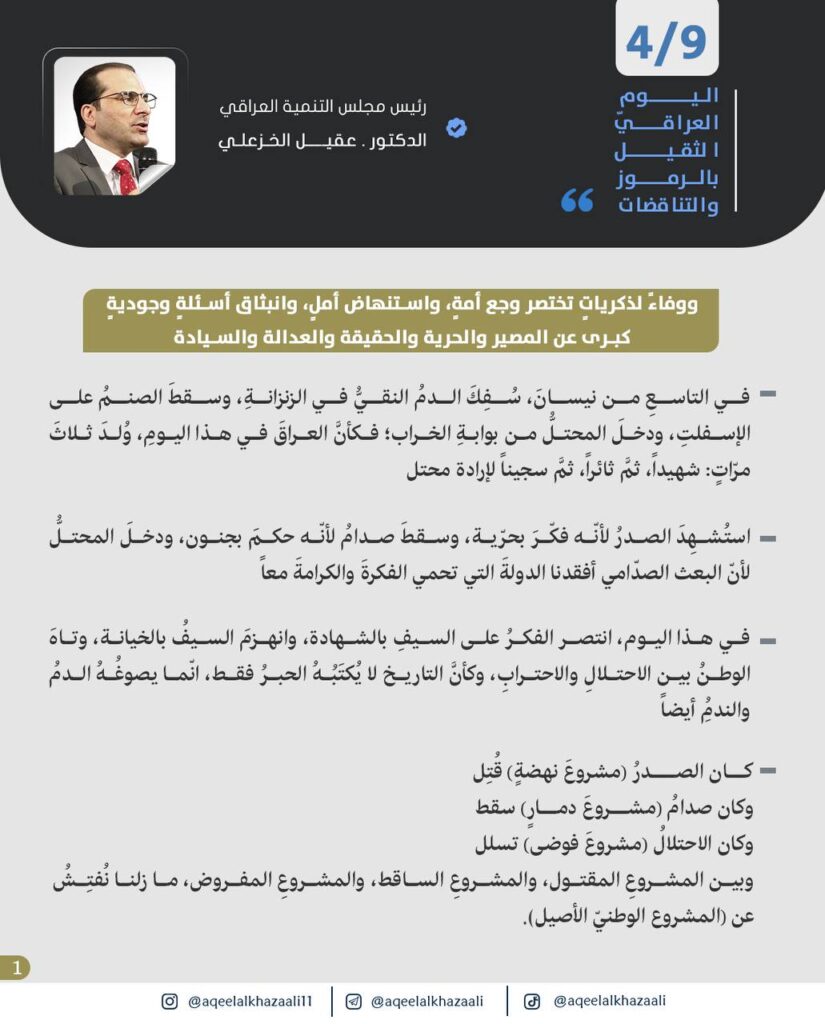
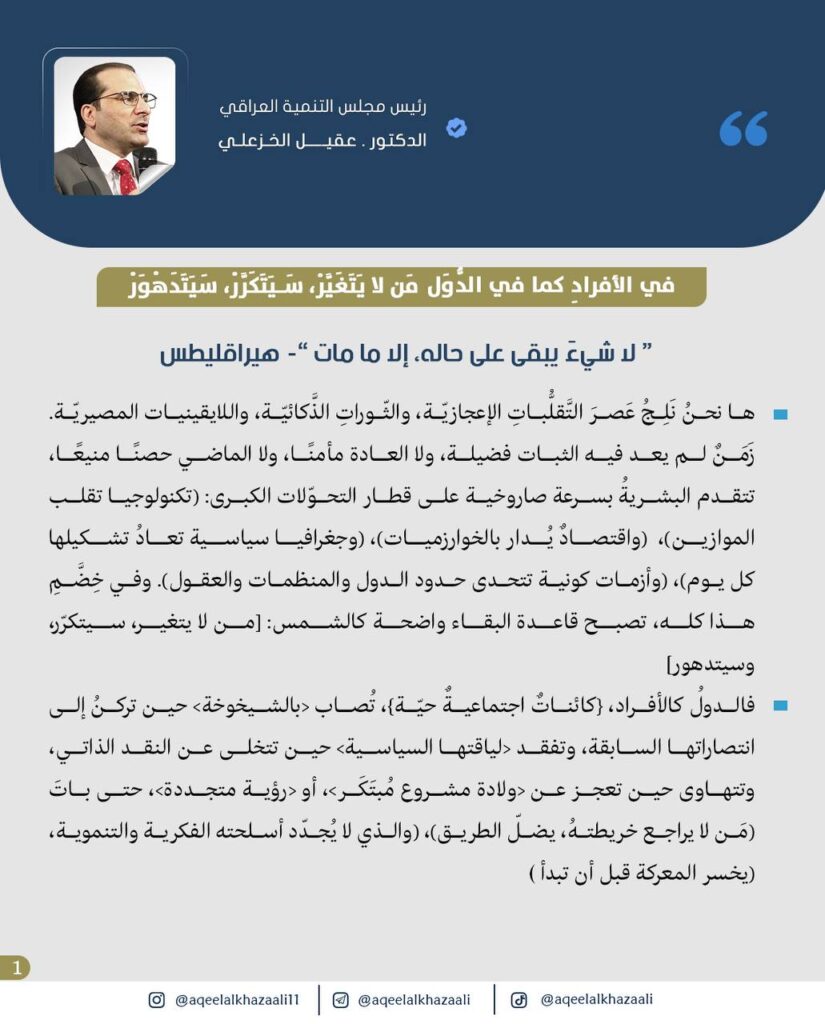
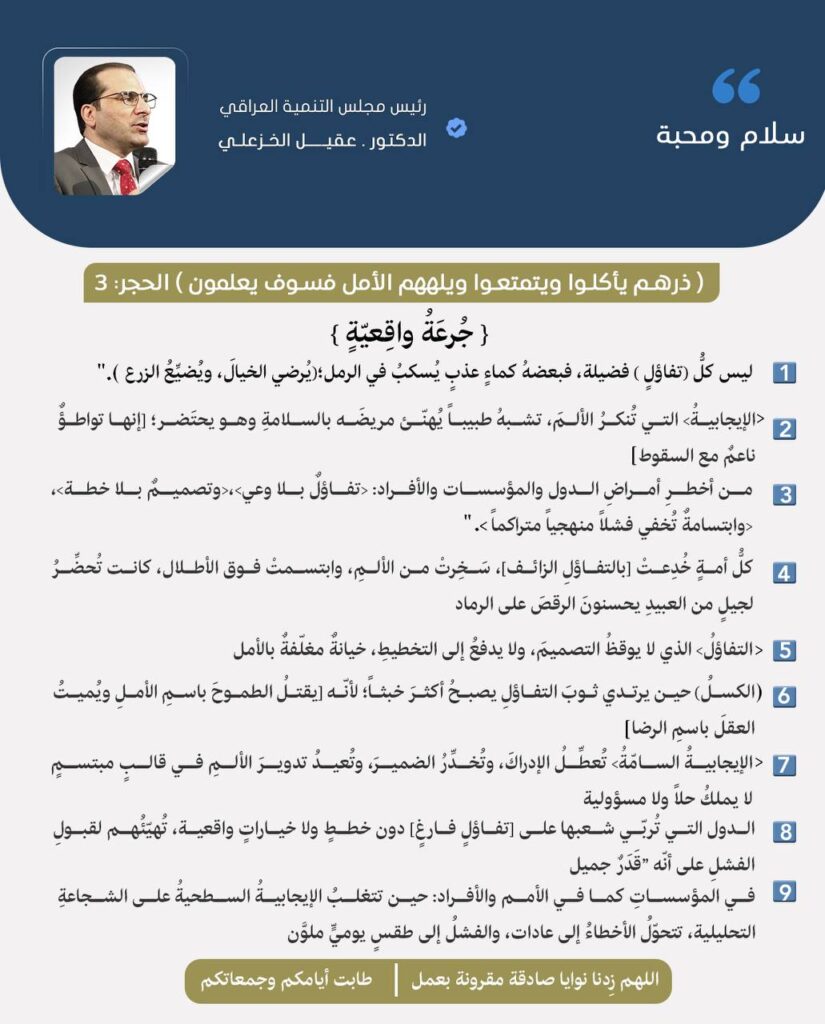
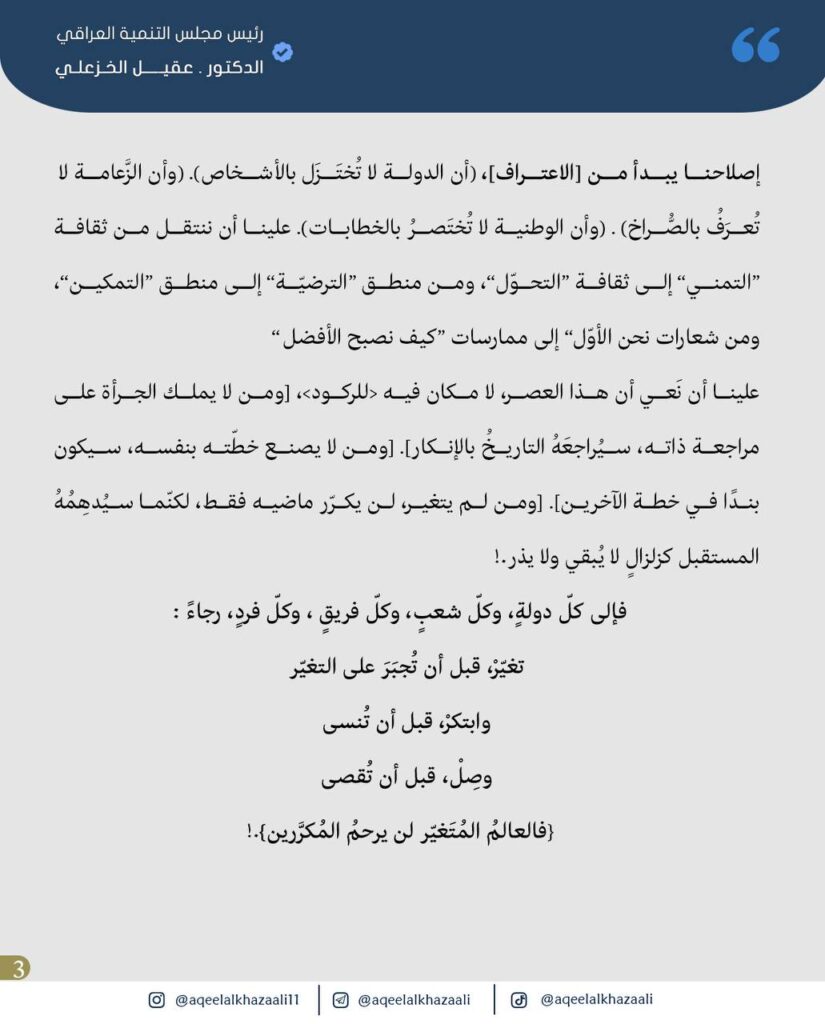
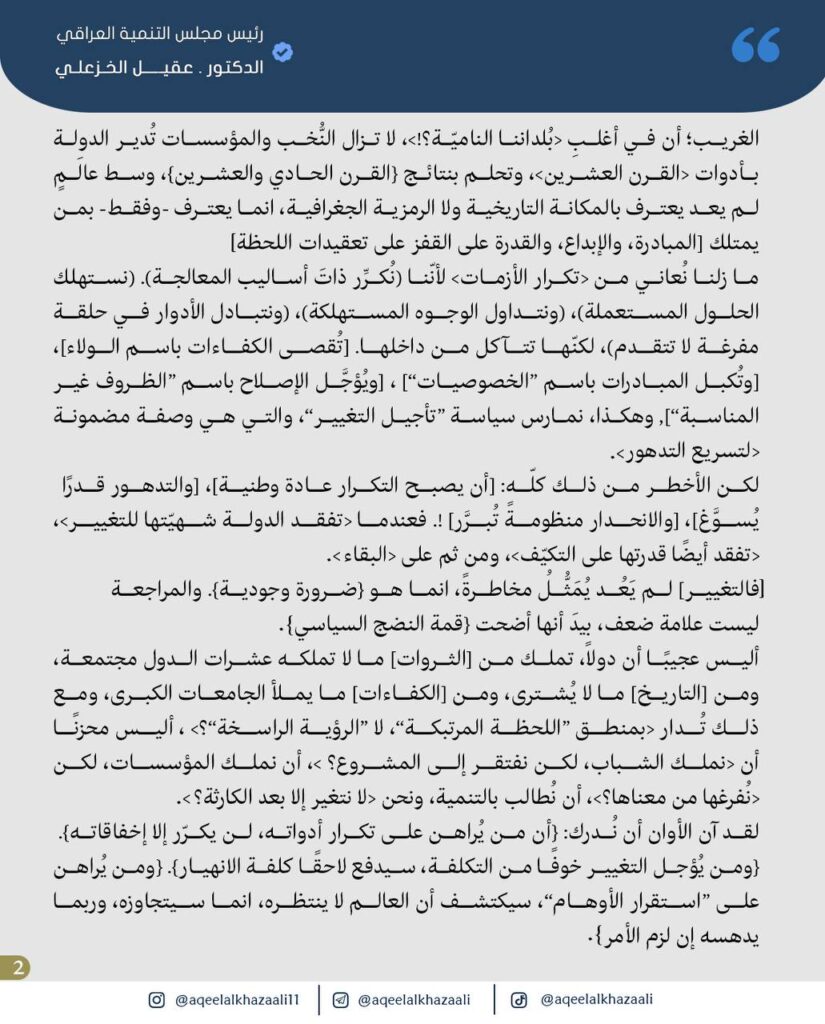
🌾 *(١٥ / نيسان) يوم الفلّاح العراقي* 🌾
1. يا فلّاحَ العراقِ، يَدُكَ التي تحرثُ الترابَ، إنّما تكتُبُ مجدَ الوطنِ في سطورِ السنابلِ.
2. أرضُ العراقِ لا تُزهِرُ إلّا إذا مرّتْ يَدُكَ عليها، فمِنْك تنبتُ الكرامةُ، ومَعَكَ يُثمرُ الأملُ.
3. في كلِّ حفنةِ ترابٍ ترفعُها، نبضٌ من قلبِ دجلةَ والفرات، ونَفَسٌ من رئةِ التاريخِ.
4. ليستِ الفلاحةُ مهنةً، انها رسالةٌ مقدّسةٌ تُقاوِمُ الجوعَ، وتزرعُ السيادةَ في جذورِ القمحِ.
5. أيّها الفلّاحُ العراقيُّ، سِلْمُكَ حياةٌ، وحربُكَ صمودٌ، وصبرُكَ هو الذي يُعلّمُ المدنَ كيف تبقى.
6. حين يتعبُ الجميعُ من الكلامِ، تَصمُدُ أنتَ في الحقولِ، تحاورُ الأرضَ بصمتِ الجهدِ والوفاء.
7. يومُكَ ليس ذكرى، انما هو جذرٌ أخضرُ في هويةِ العراقِ، وأُفُقٌ نقيٌّ في مستقبلهِ.
د. عقيل الخزعلي
رئيس مجلس التنمية العراقي
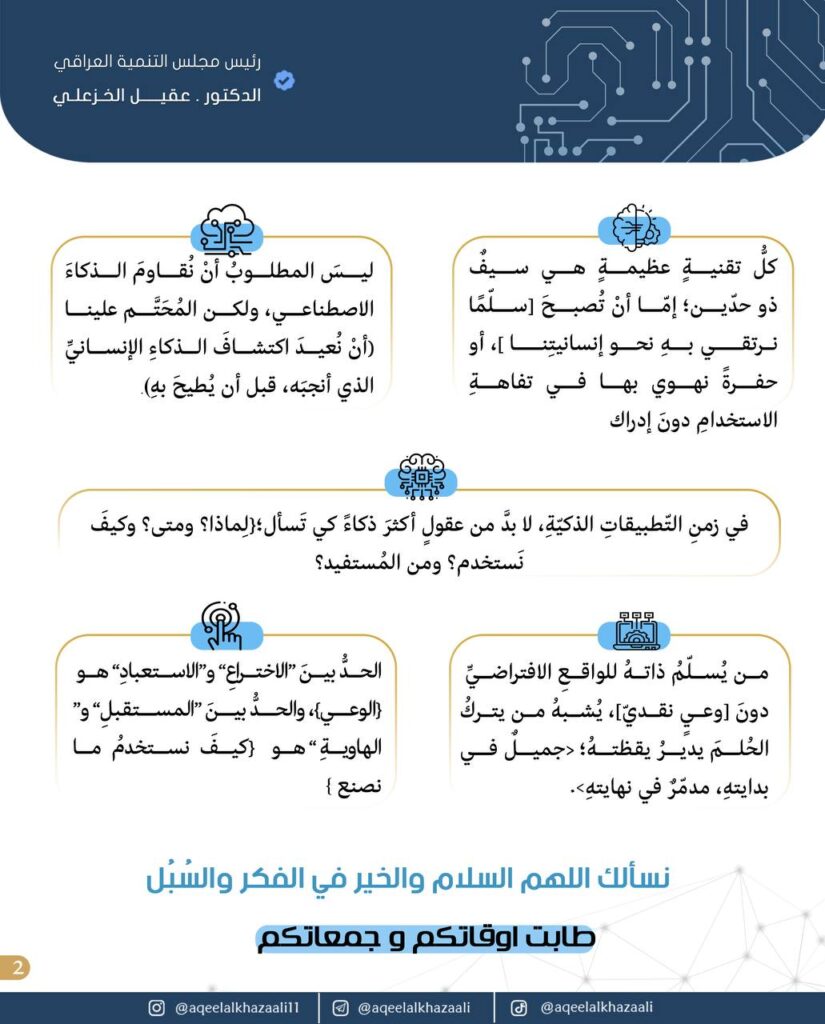
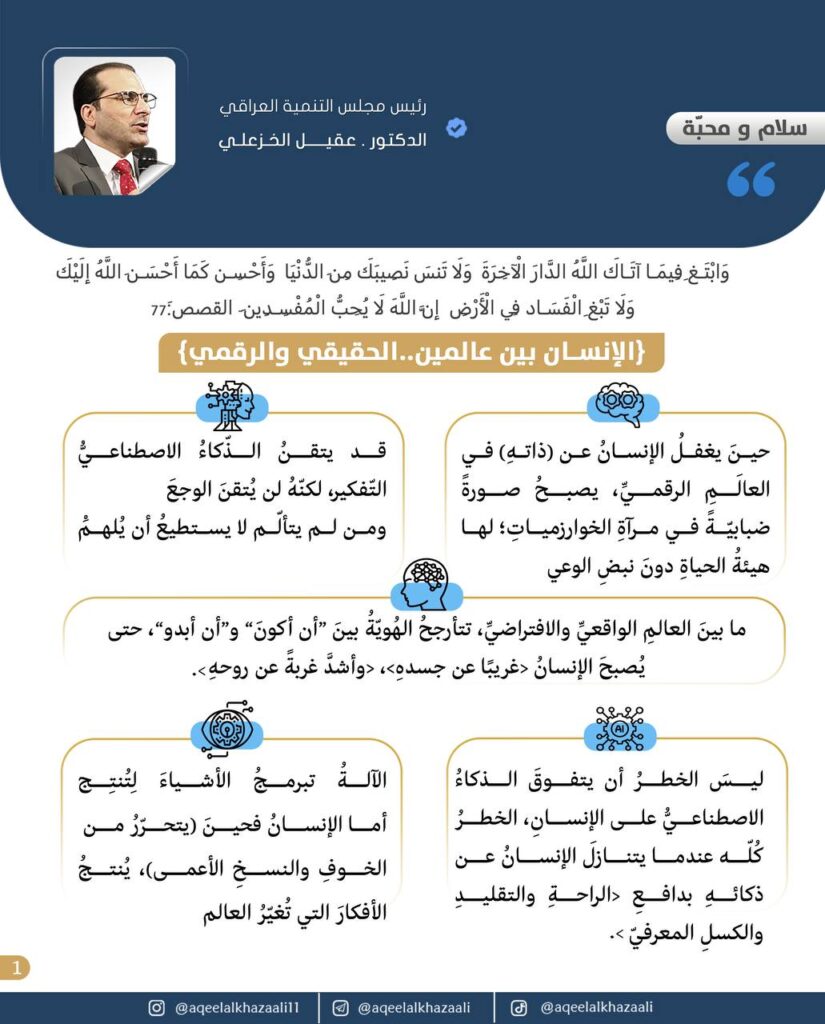
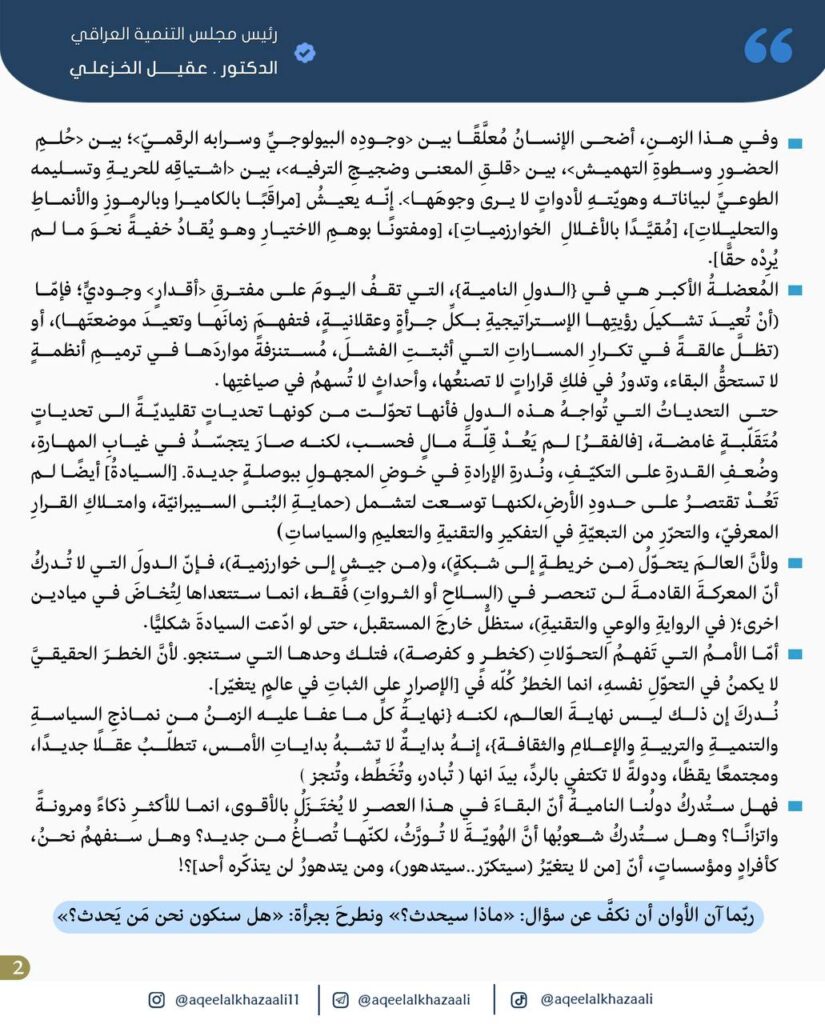
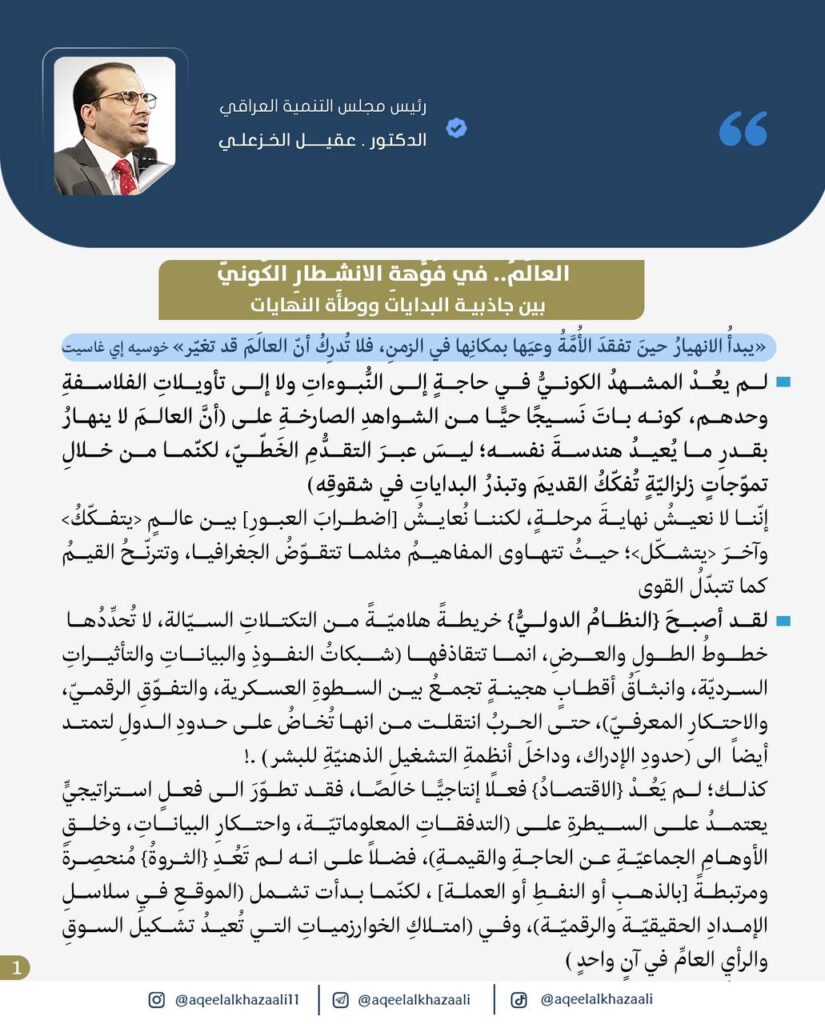
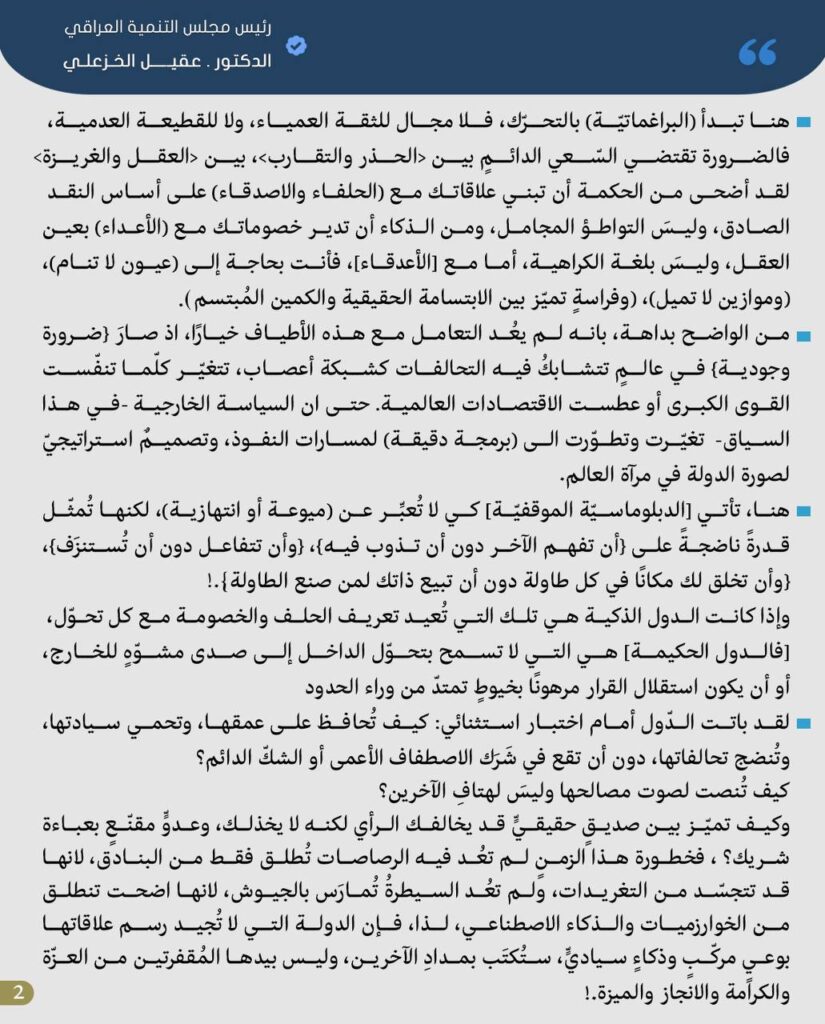
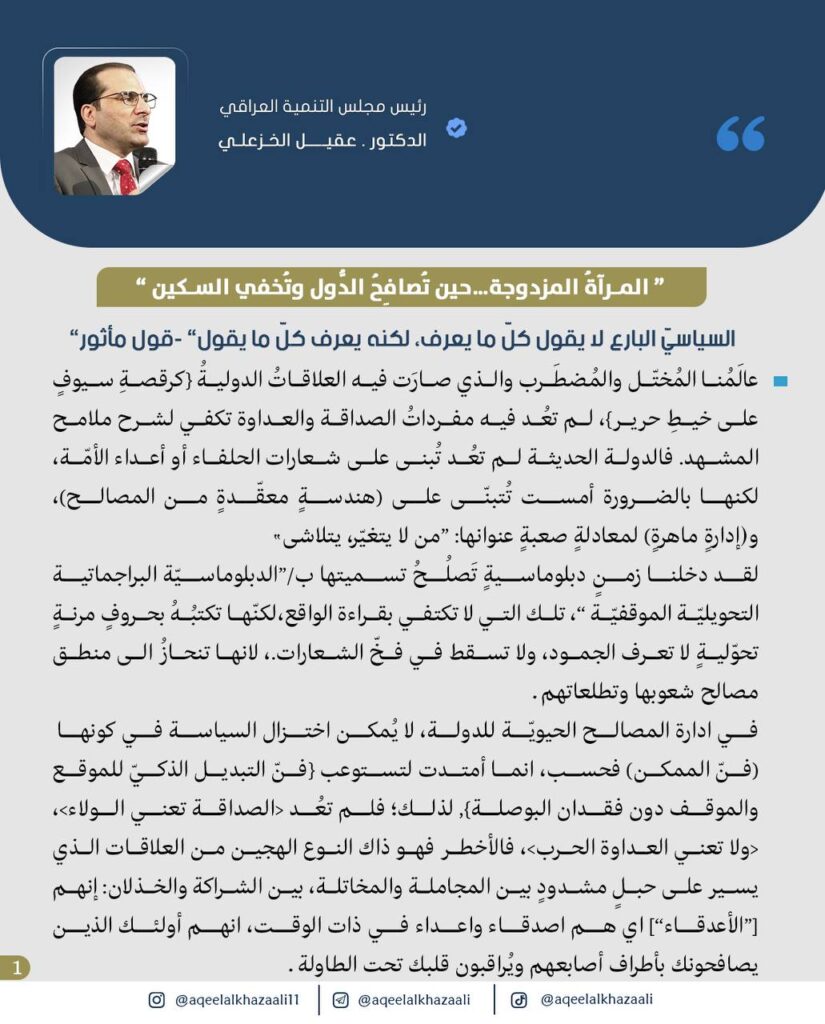
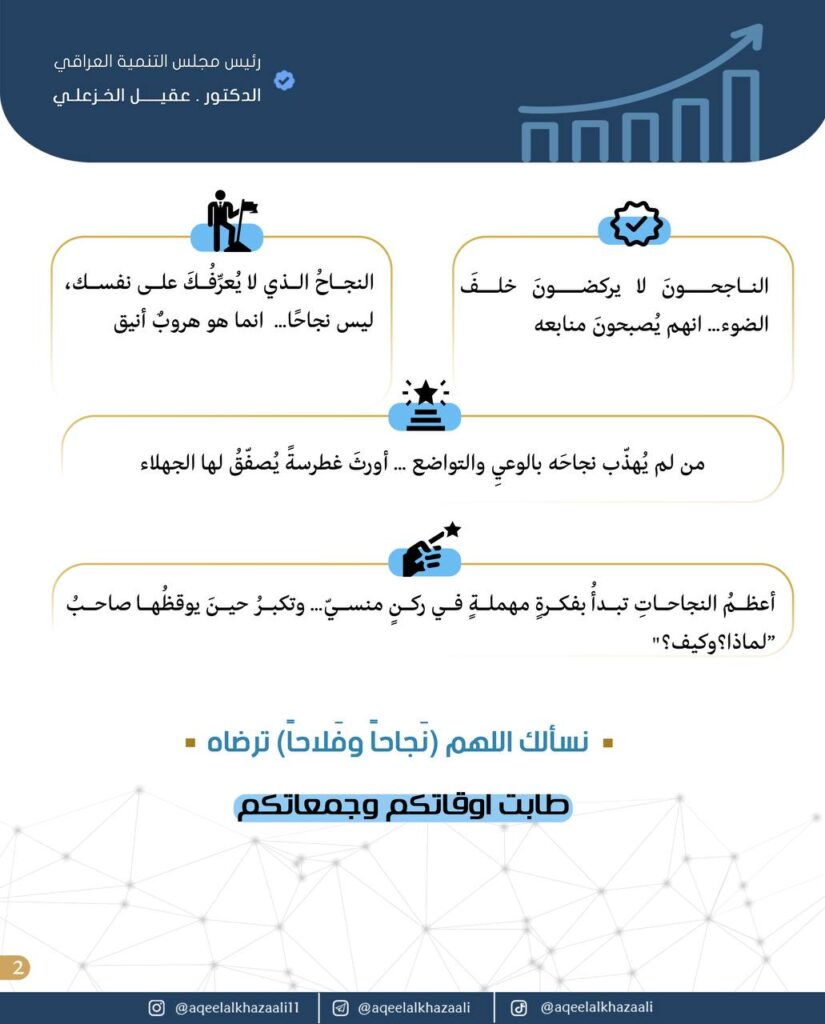

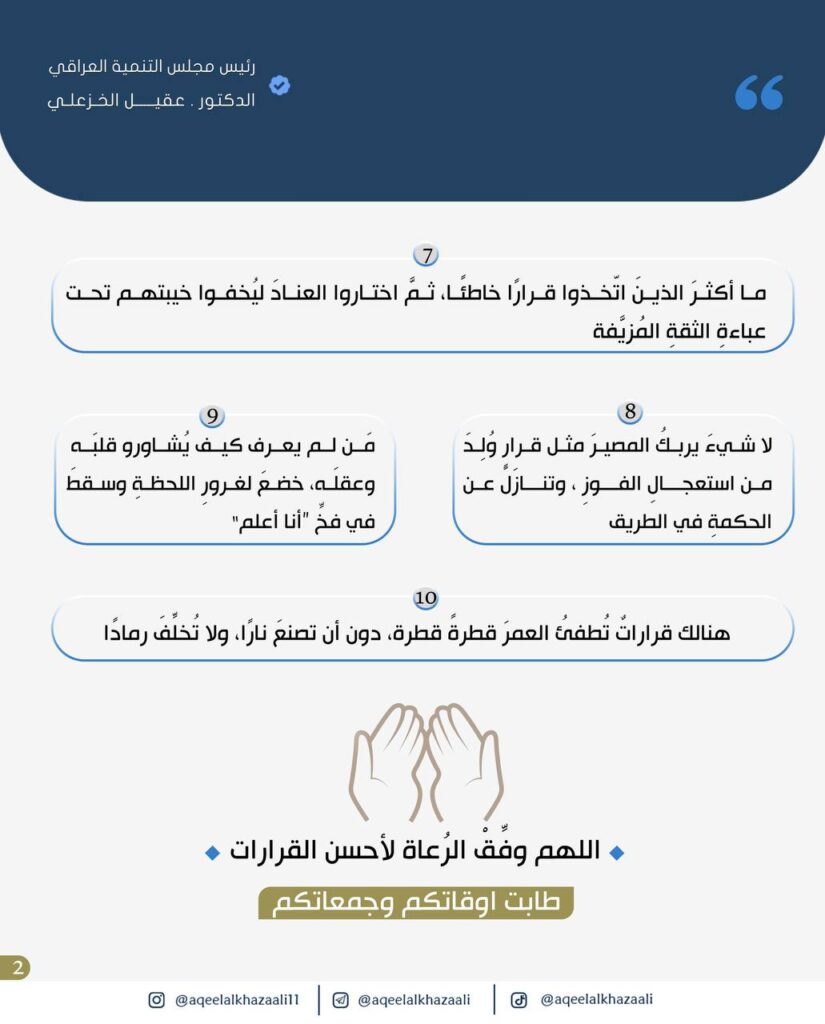
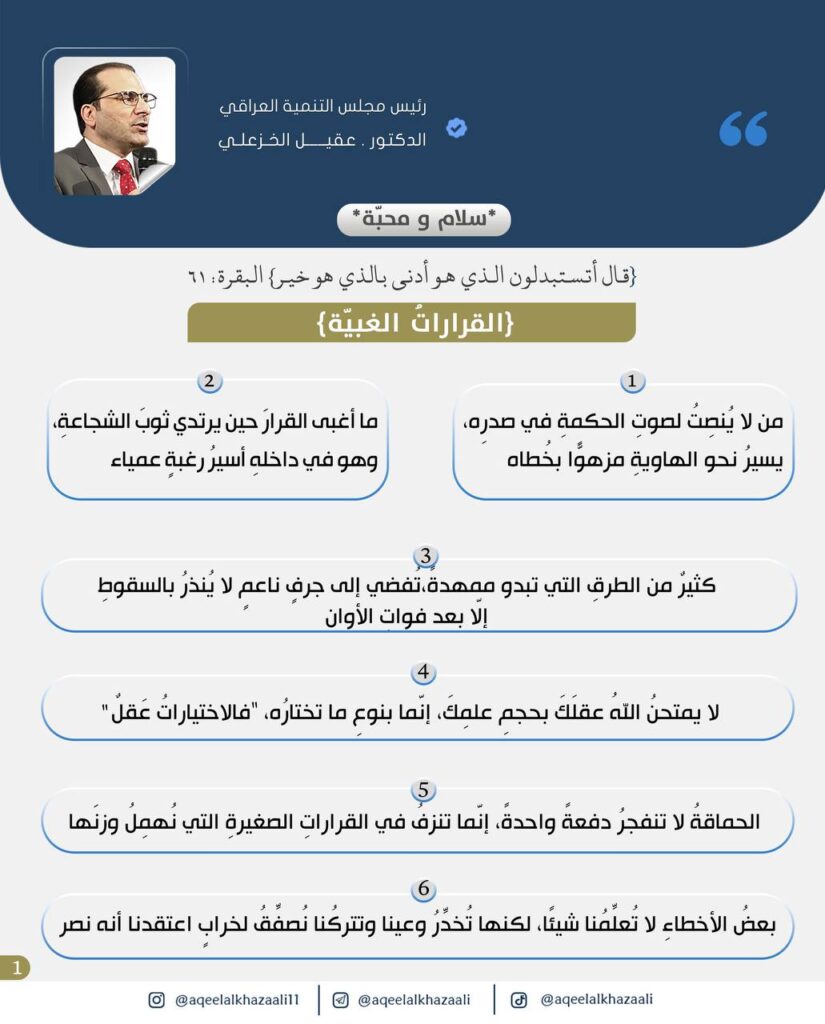
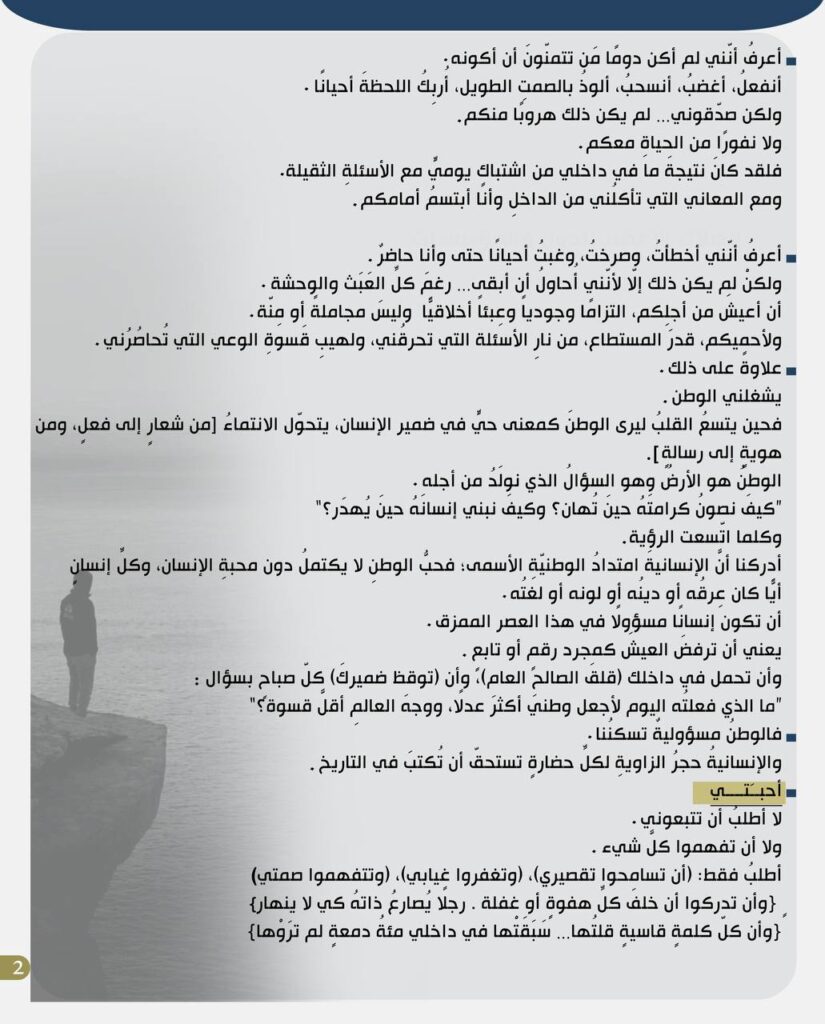
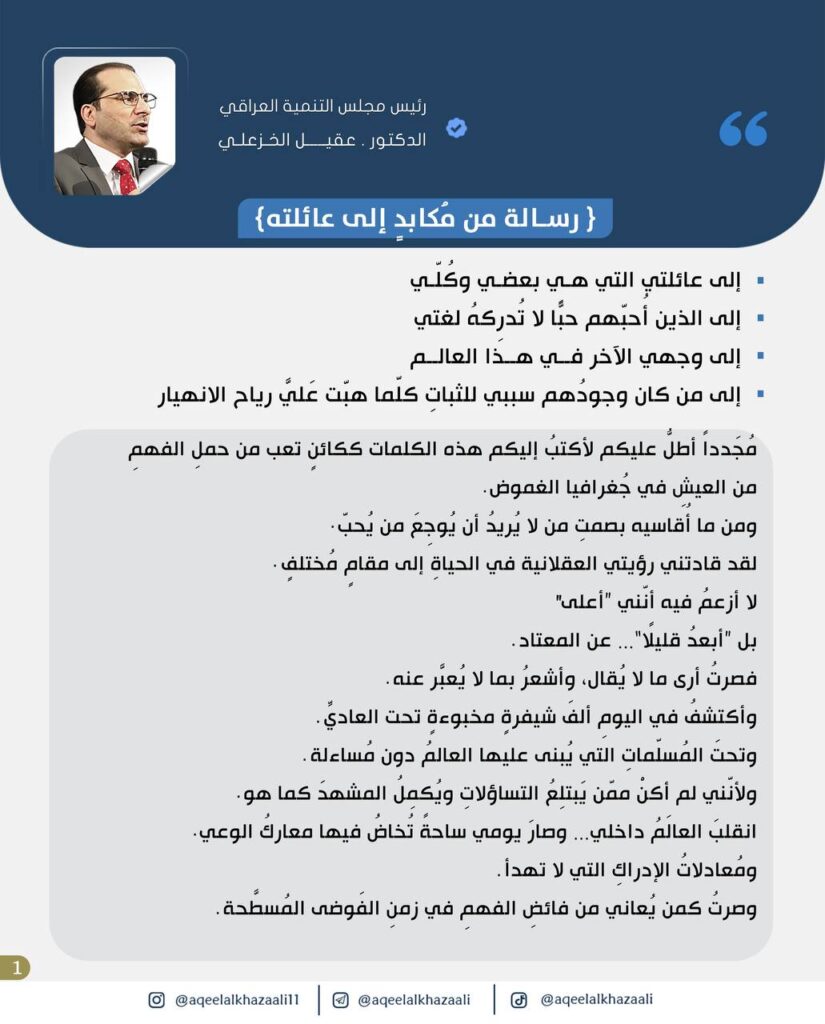
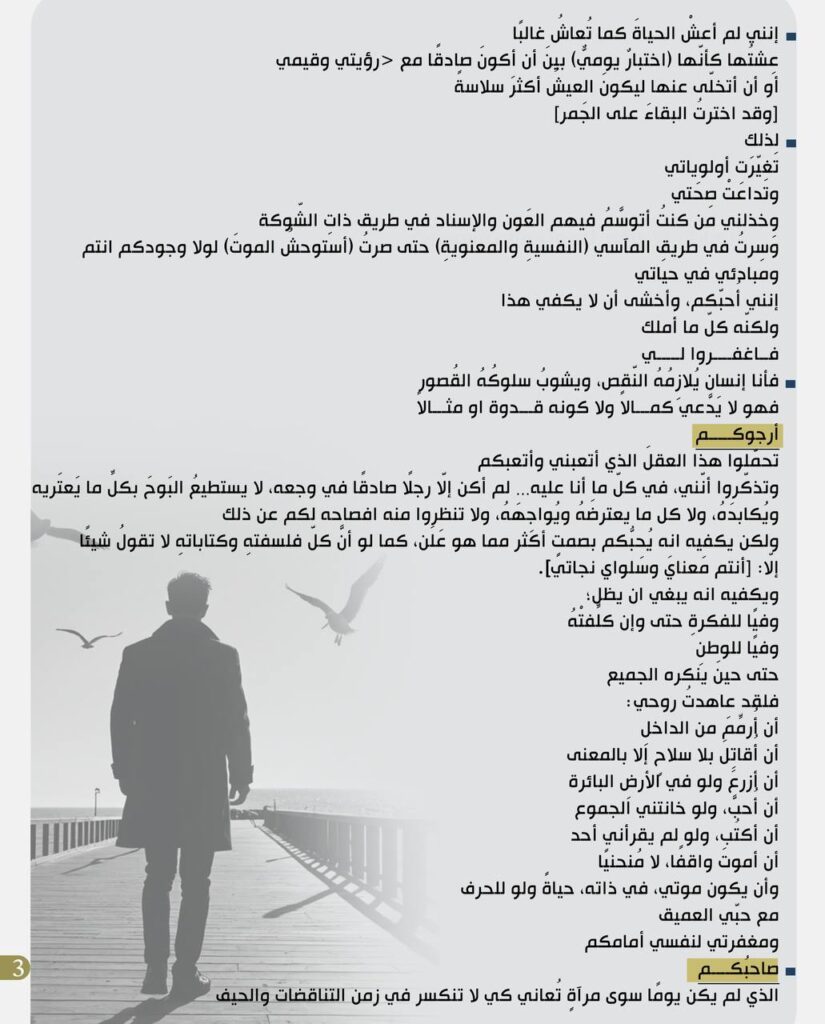
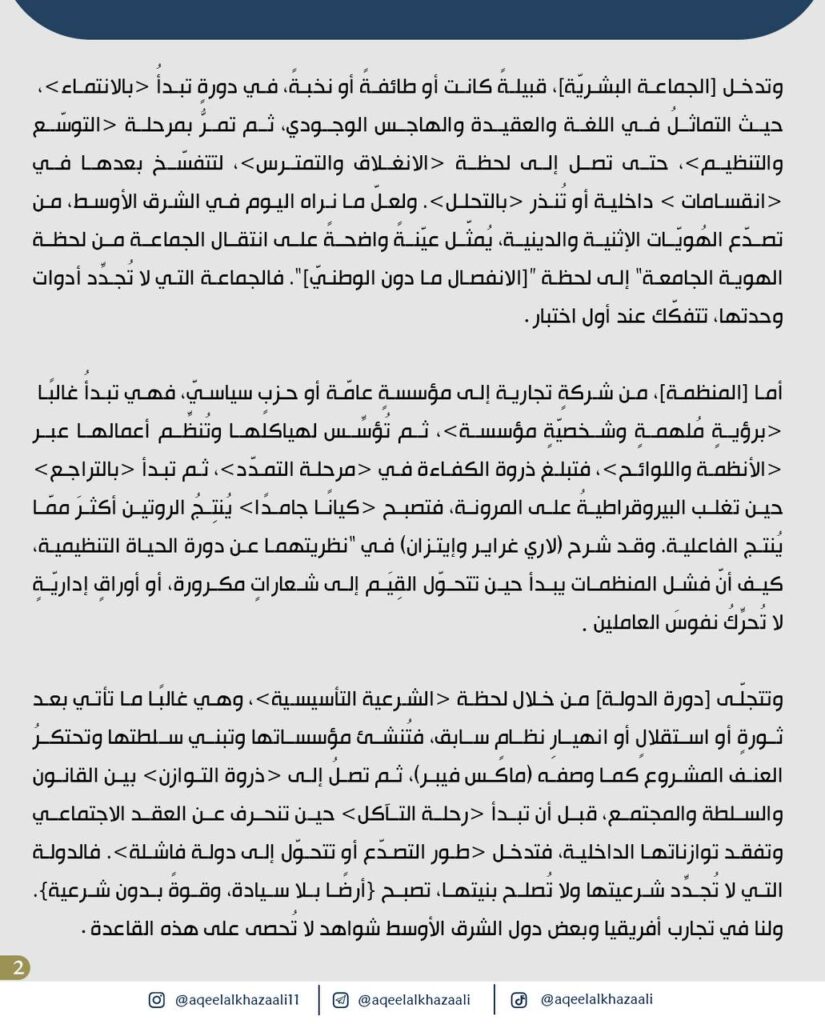
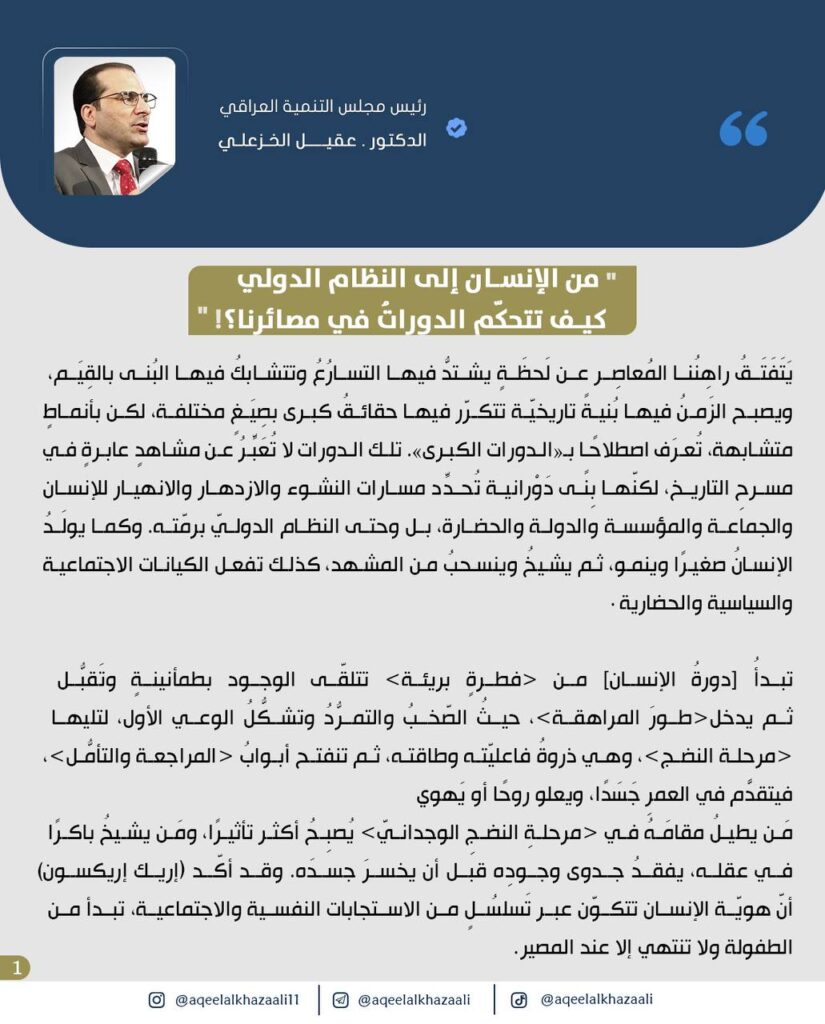
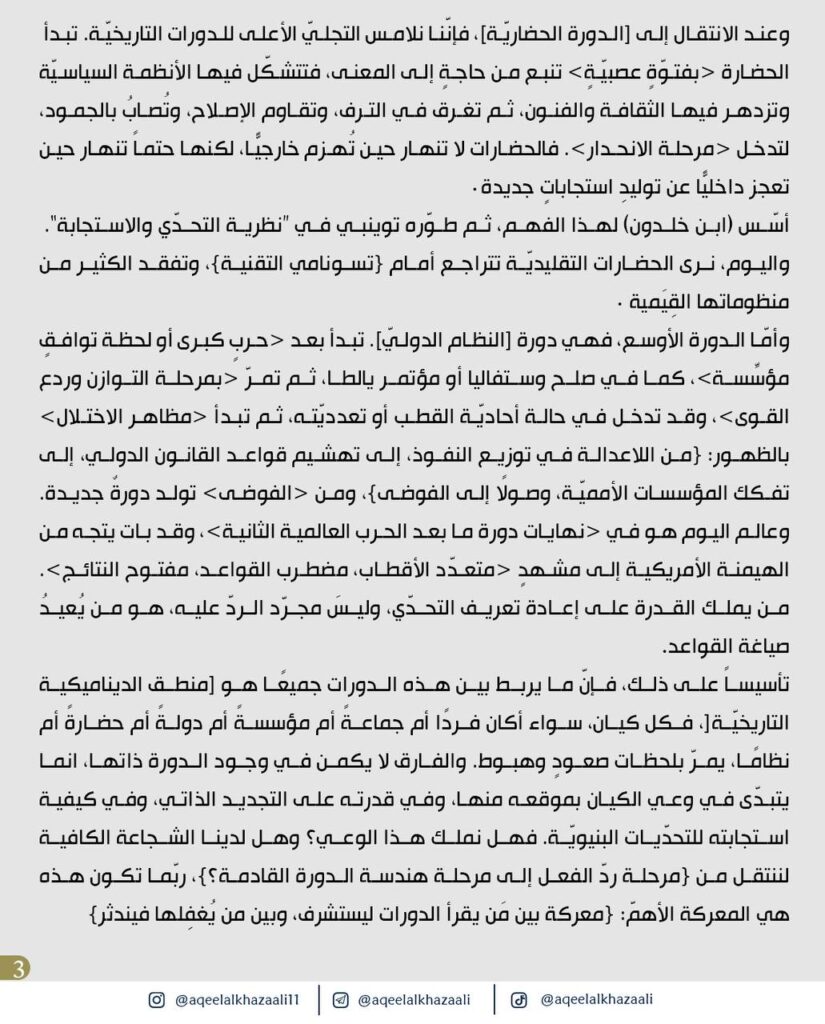
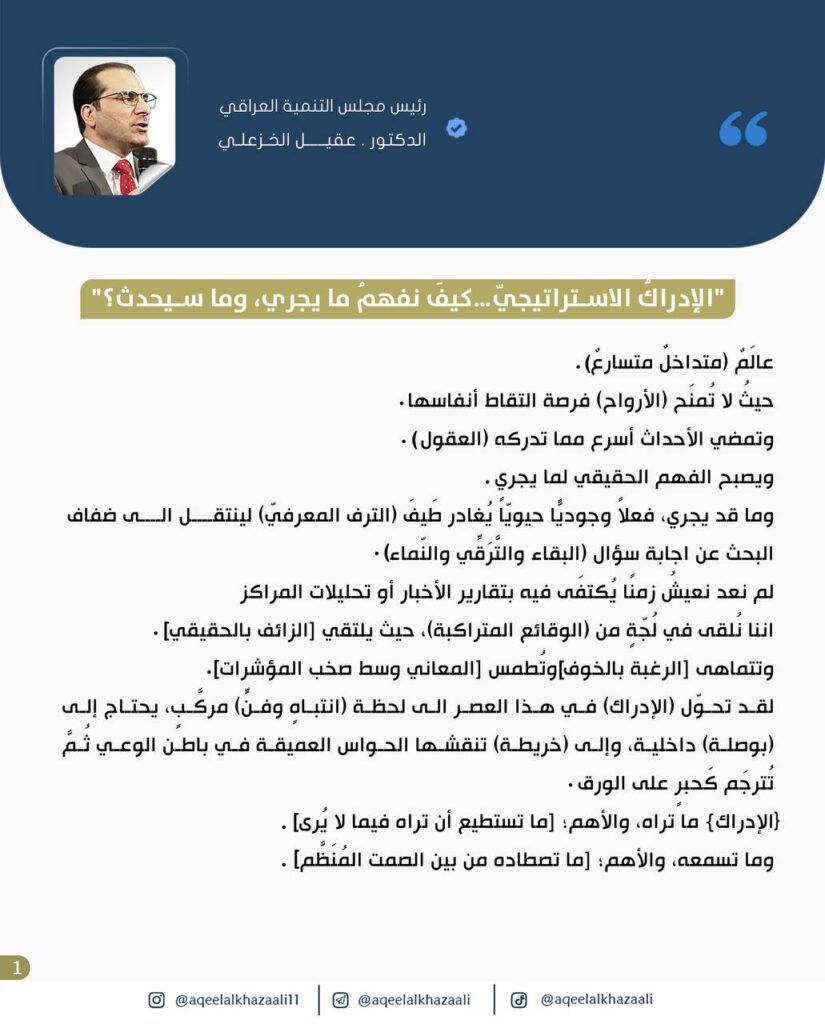
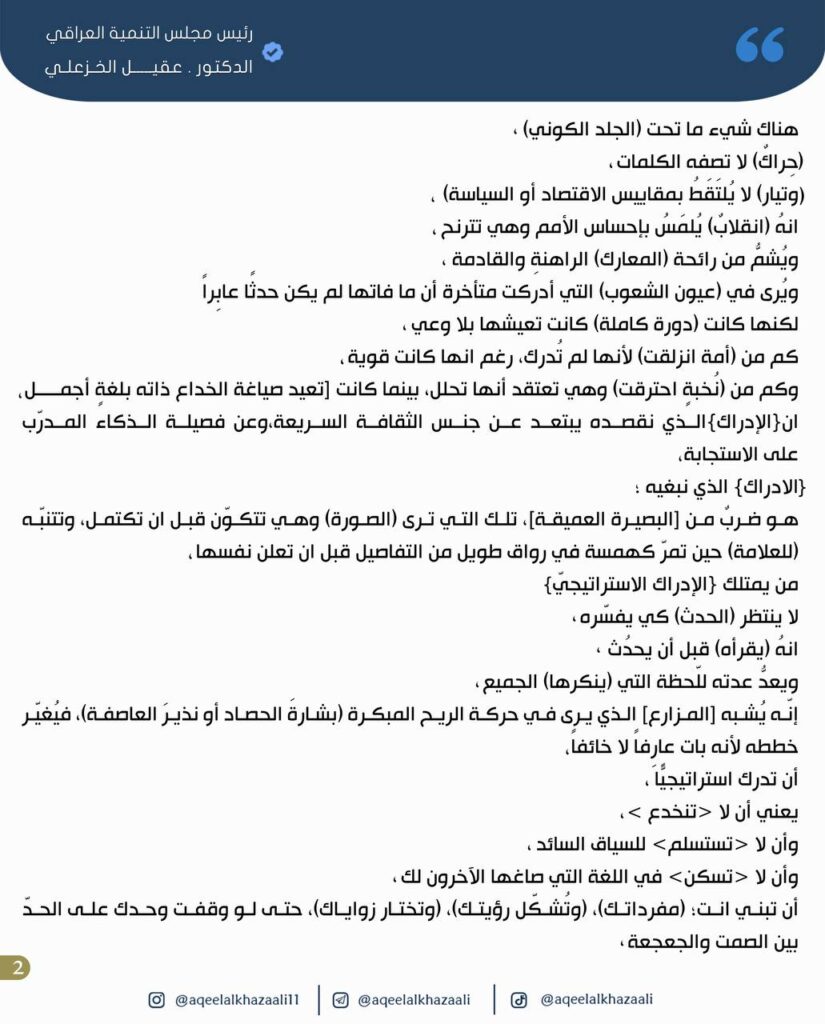
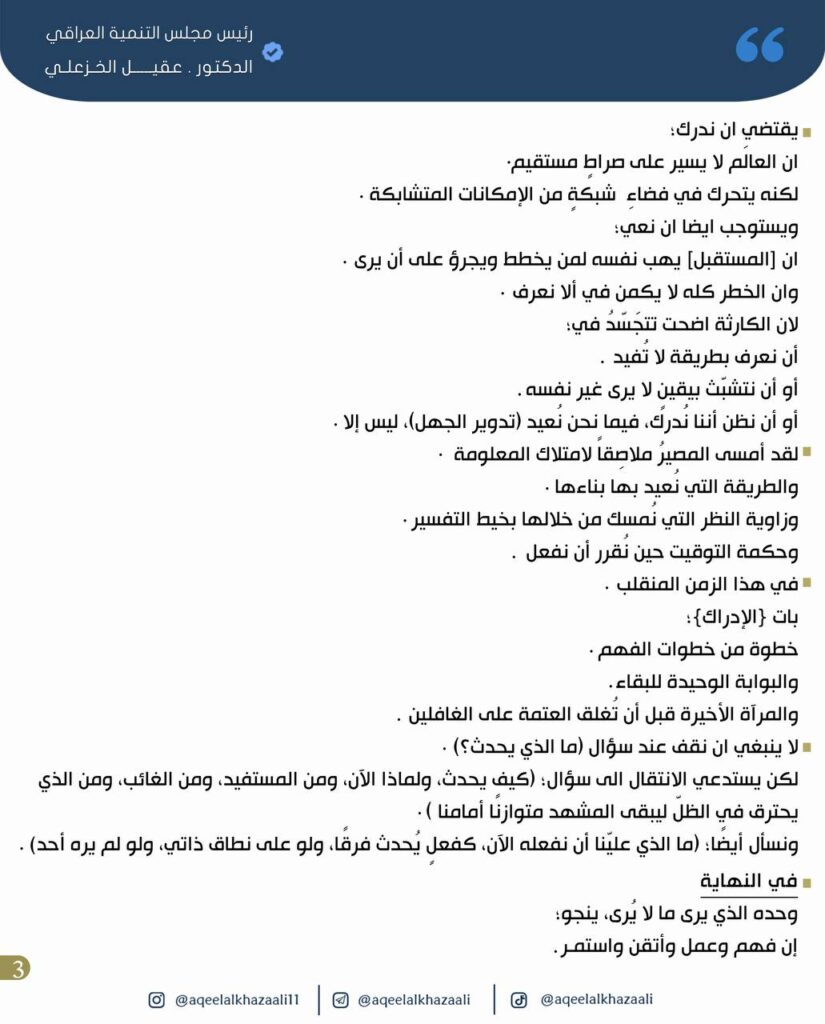
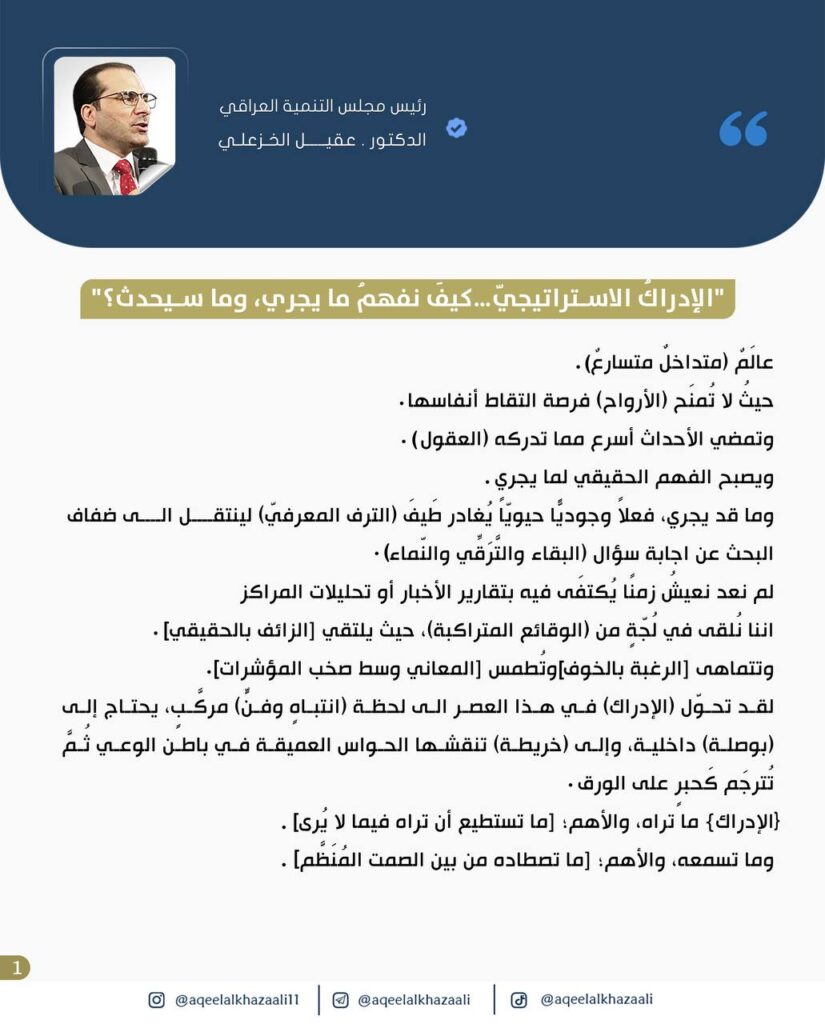
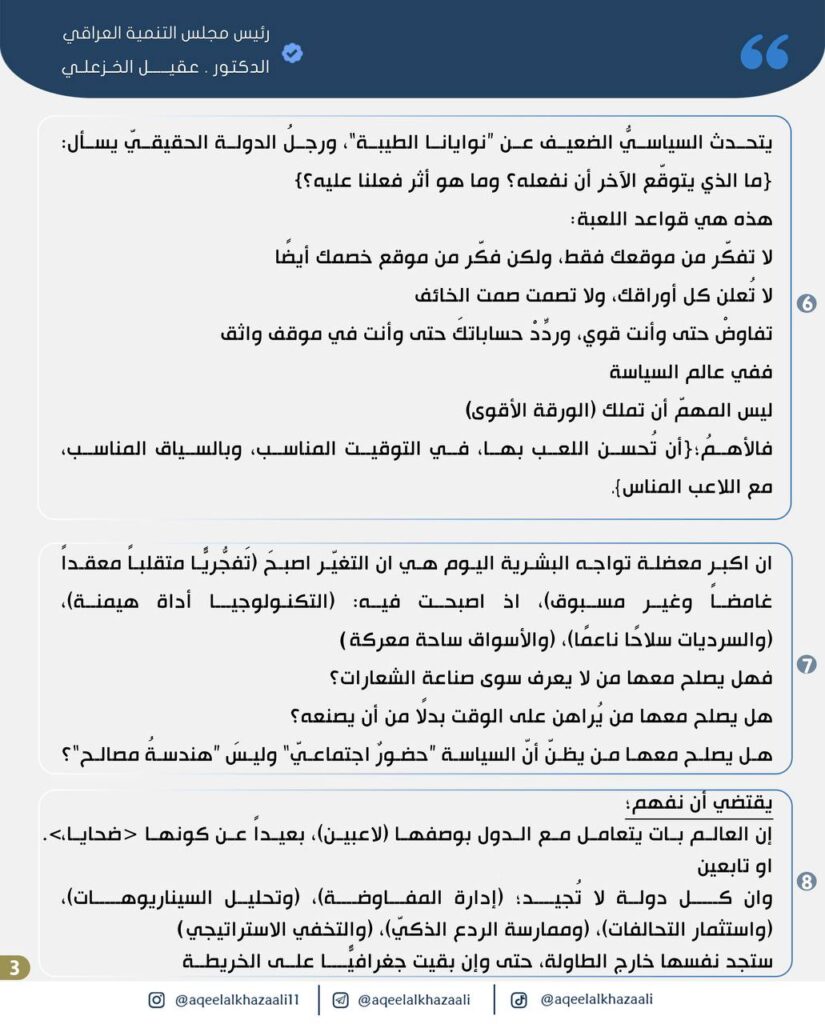
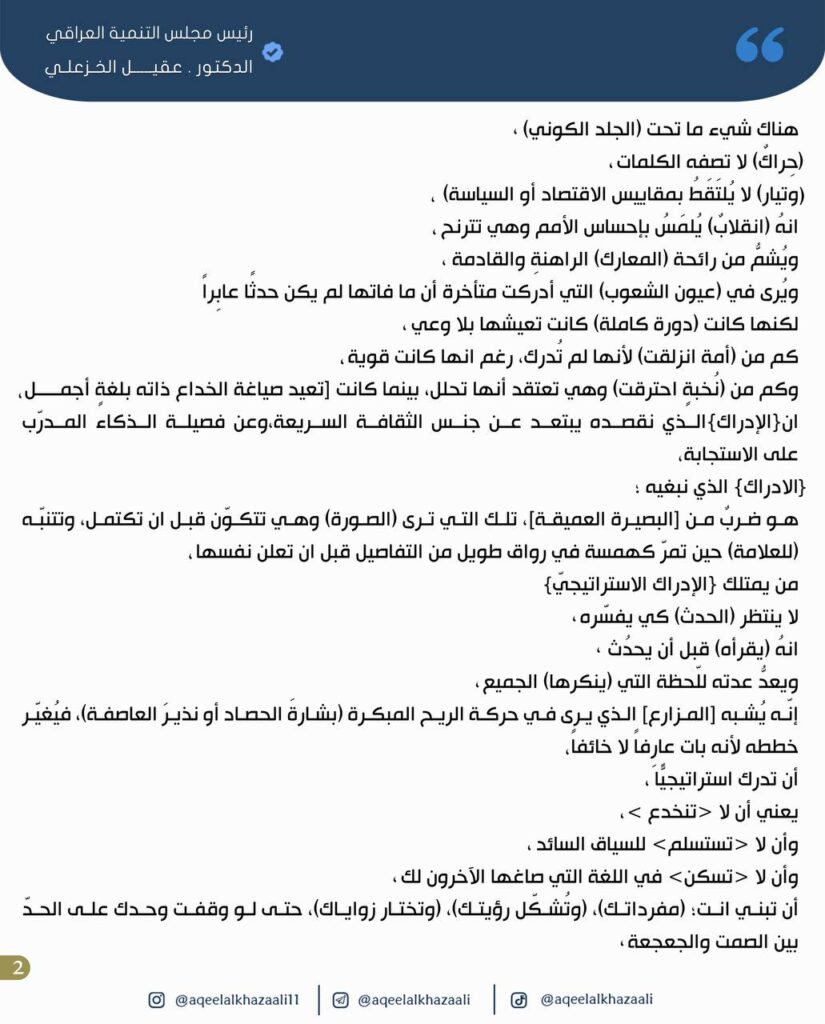
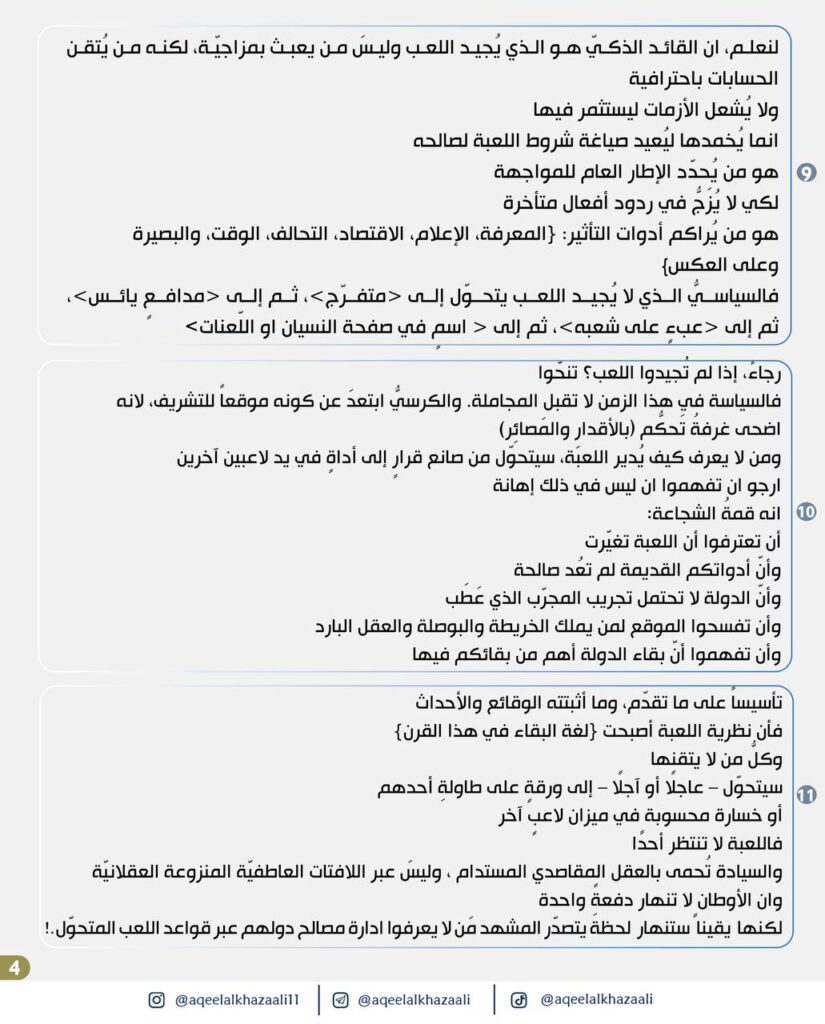
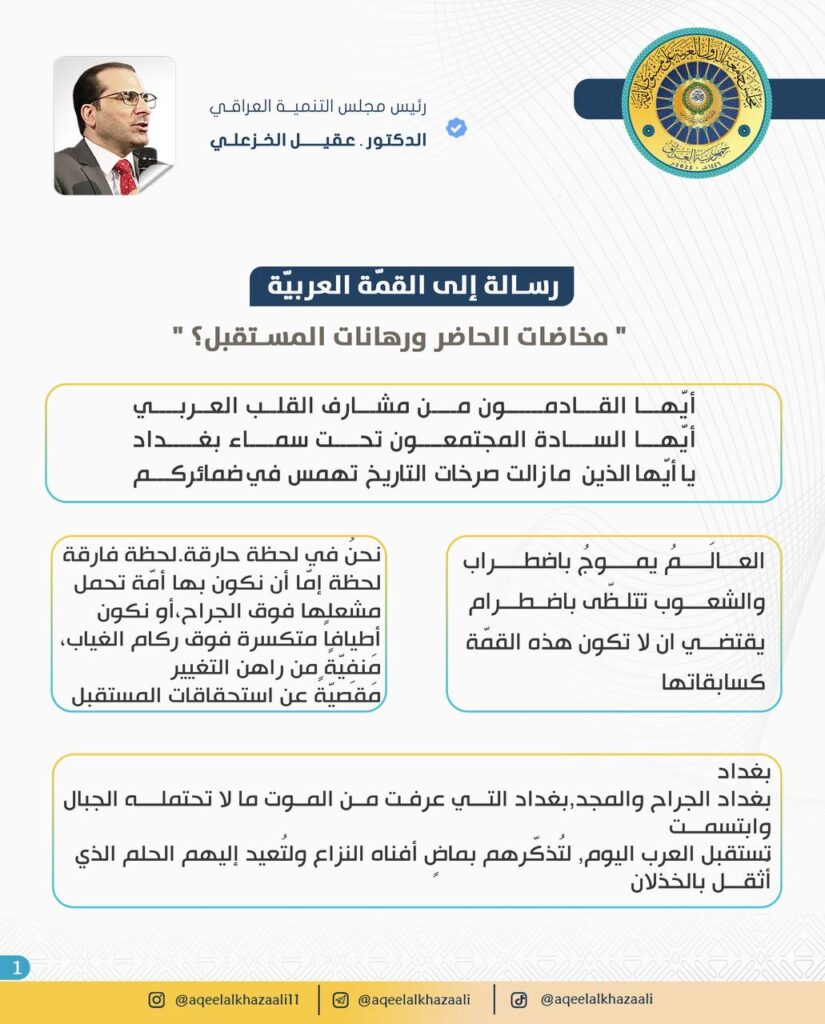
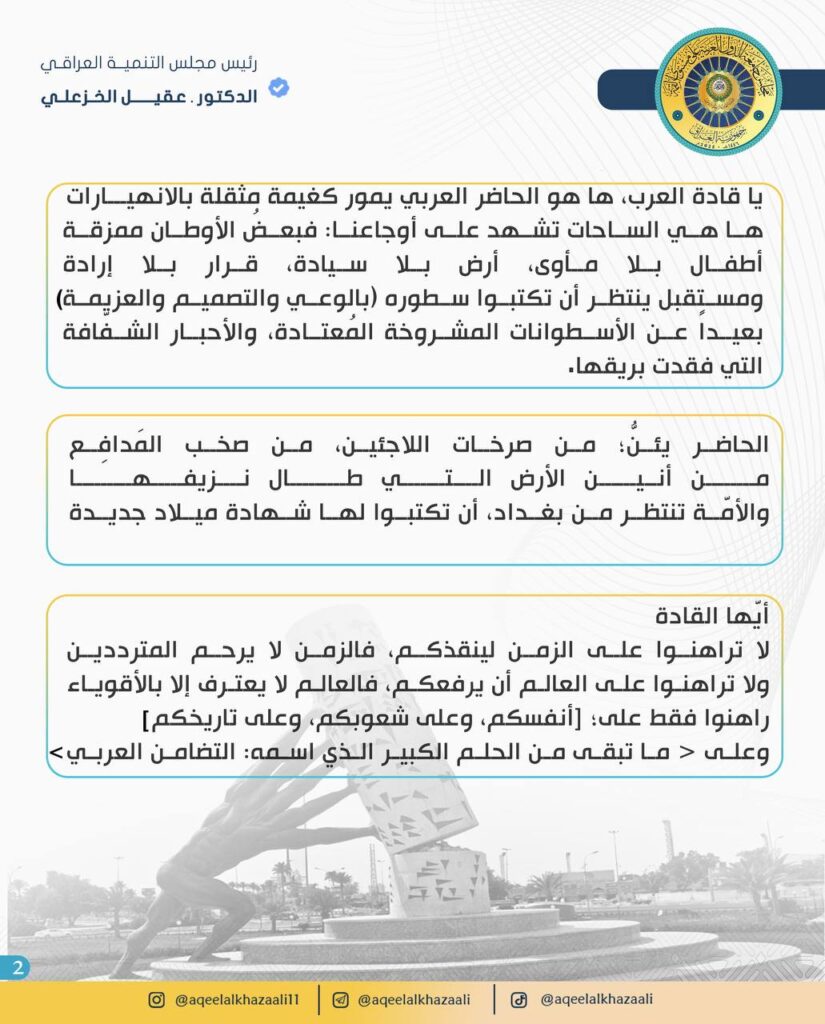
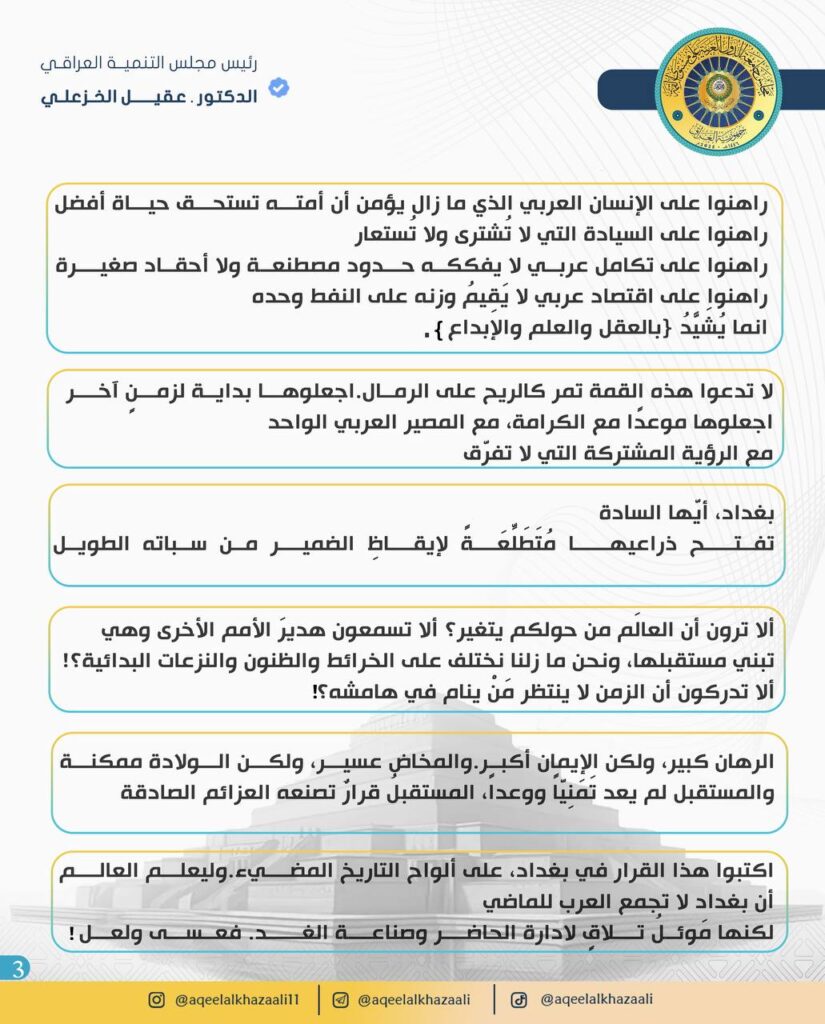
رسالة إلى القمّة العربيّة..
“مخاضات الحاضر ورهانات المستقبل؟!”
د.عقيل الخزعلي
رئيس مجلس التنميّة العراقيّ
#مخاضات_الحاضر_ورهانات_المستقبل
#عقيل_الخزعلي

قَواعِدُ اللُّعْبَةِ بينَ خرائطِ التَّحوُّلاتِ ومُتغيّراتِ النُّفوذ..هَلْ نَتَعِظ؟!
(لَفَحاتٌ فِكريَّةٌ إستراتيجيَّة (14)في عصورِ التَّحوُّلِ والسِّجالِ والسِّيادةِ المُعادِ تعريفُها)
د.عقيل الخزعلي
رئيس مجلس التنمية العراقي
1. [حينَ تتكلَّمُ الخرائطُ بلغاتٍ جديدة، لا يُسمَعُ فيها صوتُ الصامتين.
فَكلُّ دولةٍ لا تُعرِّفُ نفسها بالأفعال، يُعرِّفها الآخرون بالهوامش].
2. [الوجودُ للدُّوَل لا يَنجو بالشعارات، انما بمراكب المصالح التي تجيد الإبحار في العواصف التي لن تنتهي].
3. [السيادةُ التي لا تُترجَمُ إلى نفوذٍ في التوقيتِ المناسب، تتحوّل إلى عبءٍ على جغرافيا خجولة].
4. [باتَ جَلِيّاً ان التحالفاتُ الكبرى لا تُعلَنُ في المؤتمرات، لكنها تتسرّب عبر ممرات المال، والطموحات المُموَّهة، والخرائط التي تُحرَّك من خلف الستار].
5. [في مواسمِ الصفقات، تتحوّل الجغرافيات إلى أصولٍ قابلةٍ للتداول، إلا مَن حمى أرضه؛ (بفكرٍ مرنٍ وعقلٍ يقظ وتَلاحمٍ جامِعٍ وعُدَّةٍ كافيةٍ وتدبيرٍ شامل)].
6. [كلُّ تراجعٍ عن مركز التأثيرِ والقرار، يُحفَر على الأرض كخسارةٍ (ماديةٍ-معنويةٍ) مؤبَّدَةٍ لن تُمحى بالعواطف ولن تُغسَل بدمع].
7. [الدّولةُ الغائبةُ عن العناوين لا تُحجَبُ عن الحسابات، لكنَّها قد تُستدعى متأخّرًا، بشروطٍ لا تُشارِكُ في كتابتها].
8. [(المستقبلُ) يُعطى للذين يَعرفون كيف يصوغون روايتهم في توقيتٍ يُحسنونَ استثماره، ويُفاوضون عليه دون خضوعٍ لتاريخٍ يستدرّ الحنين].
9. [القدرة في امتلاكِ السلاح والموارد، ولكن القوة في التوقيت الذي تُخرج فيه موقفًا لصالح وطنك يصعُب تجاهله، من دونِ صراخٍ فارغٍ او استعراضٍ مُتَهوّرٍ].
10. [ لم يعد الحيادُ منطقةً رمادية، فالحيادُ المُنتِجُ فنٌّ دقيقٌ في امتلاكِ أوراق التأثير دونَ حاجةٍ إلى إعلان الولاء أو رفع الرايات].
11. [المسافةُ بين من يُسأل “ما رأيكَ؟” ومن يُخبِر “هذا ما سيكون” هي المسافة بين دولةٍ حاضرة، وأخرى تبحث عن صدى صوتها].
12. [التاريخُ لا ينتظر من يرتب بيته… كلُّ لحظةِ ارتباكٍ في الداخل، تُشتَرى بمزادٍ دوليٍّ لا يرحم].
13. [ تحوّلتِ القضيةُ من امتلاكِ الثروات، الى (صناعةِ سرديّةٍ) تجعل الآخر يرى فيك مصلحةً مُغريّةً مُربِحةً وليسَ عبئًا ثقيلاً مُستَنزِفاً، شريكًا موثوقاً مُقتَدِراً وليسَ منطقةً رمادية سليبةَ القرار].
14. [السياساتُ البطيئةُ تُنتجُ اختفاءاتٍ تدريجية، لا تُدرك إلا بعدَ فواتِ النفوذ، ولا تُعالج إلا بكلفةٍ أعلى مما يُحتمل].
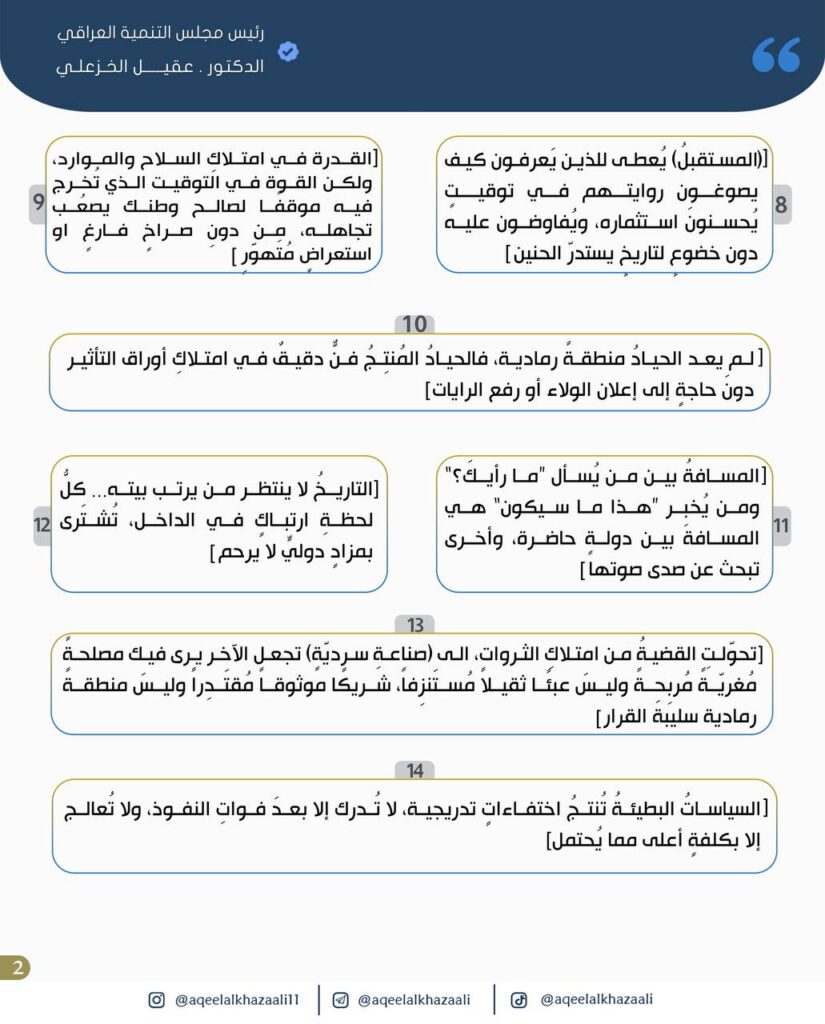

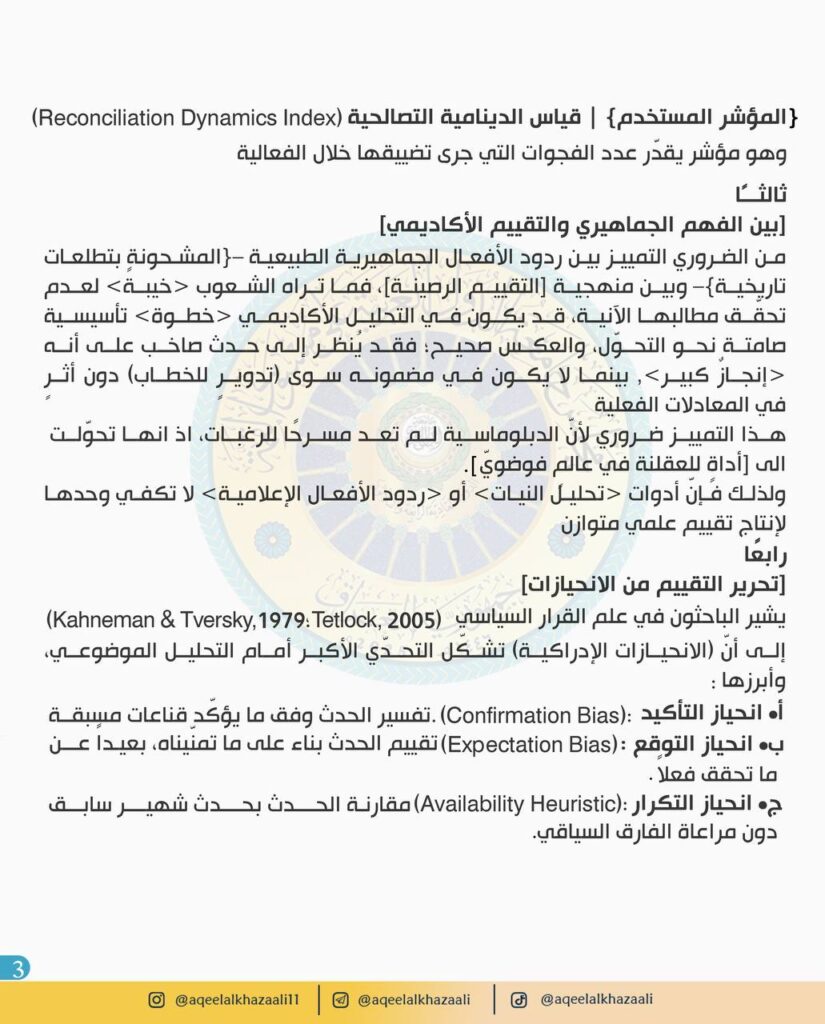
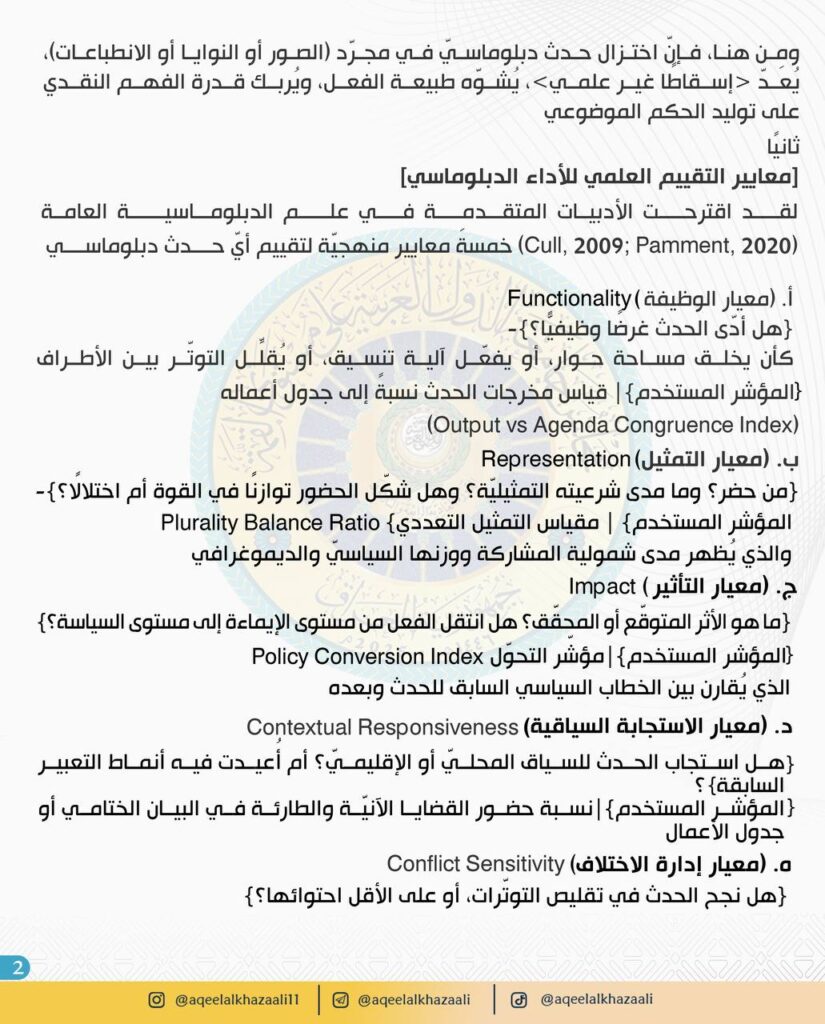
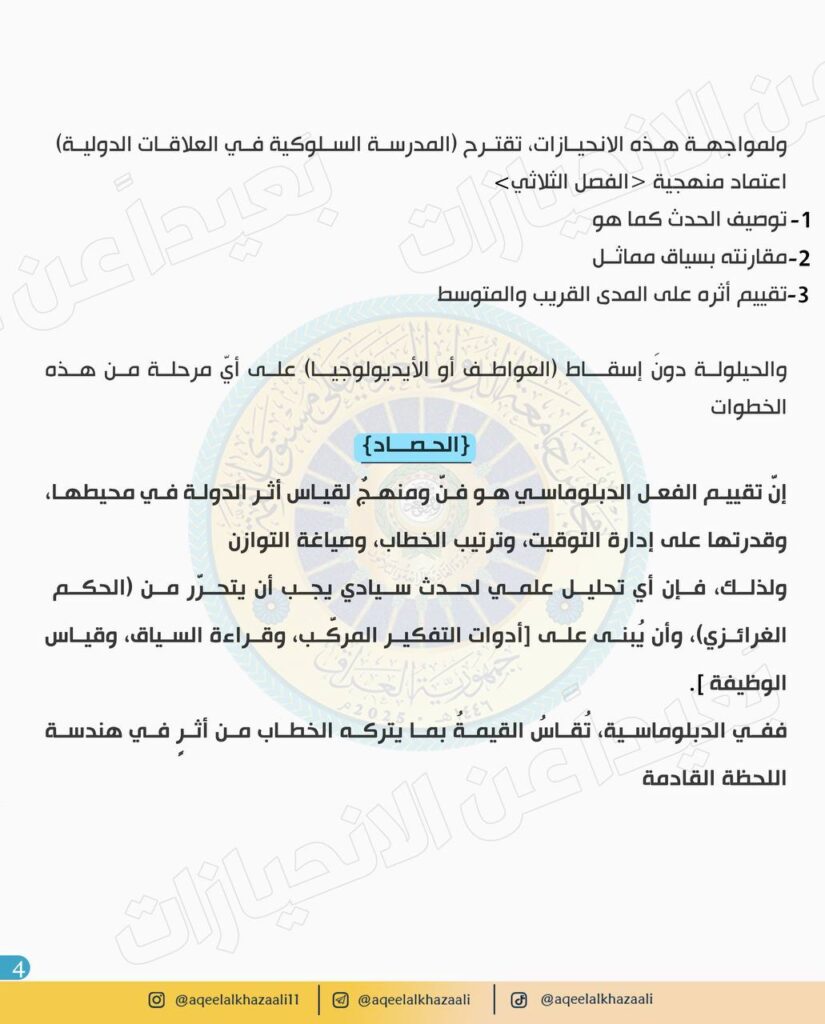
بَعيداً عن الانحيازات..
كيف نُقَيِّمُ حدثًا دبلوماسيًّا؟
د.عقيل الخزعلي
رئيس مجلس التنميّة العراقي


